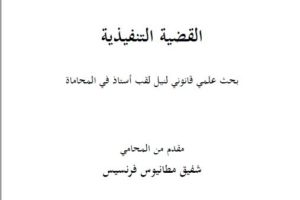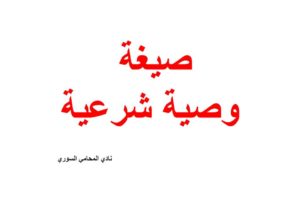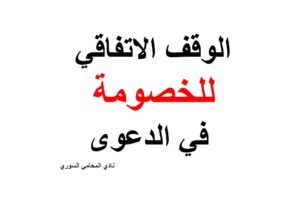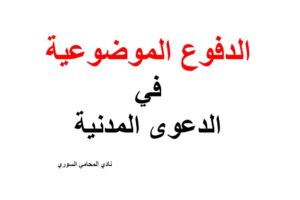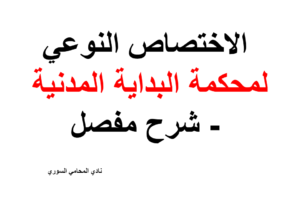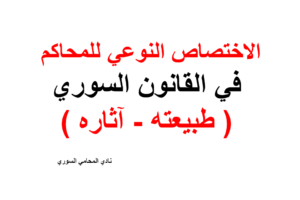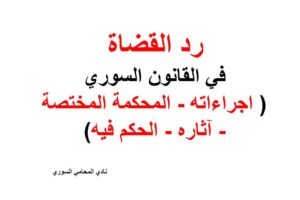يتضمن الاختصاص النوعي تحديد المحكمة المختصة بحسب نوع الدعوى، وقد جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أن
((الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة)).
فلهذا، يقوم الاختصاص النوعي للمحاكم على معيار طبيعة النزاع محل الدعوى، إذ حدد المشرع أنواع معينة من الدعاوى المستمدة من موضوعها وجعل كل منها من اختصاص نوع من أنواع المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات.
لذلك نعرض لطبيعة الاختصاص النوعي وآثاره، وتبين الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي في المطالب الآتية:
الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي :
تفيد النظرية العامة في القانون بتقسيم قواعد القانون ومنها قواعد الاختصاص إلى قواعد آمرة واجبة الاحترام لا يمكن مخالفتها أو التحلل من أحكامها، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وقواعد مفسرة أو مقررة، وهي قواعد مكملة لإرادة الأشخاص يمكن للأشخاص الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ويجوز التنازل عنها، ولكنها واجبة الاحترام والتطبيق إذا لم يتم استبعاد أحكامها أو التنازل عنها .
وهناك عدة ضوابط للتفريق بين القواعد الأمرة والقواعد المفسرة، ويمكن أن نميز بين معيارين بارزين هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي ويترتب على طبيعة الاختصاص النوعي والولائي مجموعة من الآثار.
لذلك نعرض لمعياري تحديد طبيعة القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والآثار المترتبة على اعتبار تلك القواعد آمرة من النظام العام وفق الأتي:
أولا- الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص النوعي والولائي:
يتم تحديد طبيعة القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والولائي للمحاكم وفق المعايير المعتمدة في تحديد طبيعة القواعد القانونية بشكل عام .
ويوجد معیاران في هذه المسألة هما إما بالاستناد إلى المعيار الشكلي من خلال ضوابط النص التشريعي، أو من خلال معيار موضوعي يقوم على أساس مضمون النص التشريعي وذلك وفق الآتي:
1- المعيار الشكلي:
يستمد المعيار الشكلي من ألفاظ النص القانوني، فإذا كانت تفيد هذه الألفاظ أنه لا يجوز الاتفاق على خلافها، أو أنه يترتب على مخالفتها البطلان المطلق، أو أنها من النظام العام، كانت القاعدة أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها، أما إذا جاعت بعبارات عامة، أو أنها تطبق مالم يتفق الأطراف على خلافها، وهذا يعني أنها قاعدة تكميلية مفسرة.
2- المعيار الموضوعي:
يمكن التعرف إلى طبيعة القاعة القانونية من خلال موضوعها أو معناها، ولذلك يقال أيضاً عن هذا المعيار إنه معیار معنوي،
وهذا، يقودنا إلى تحليل مضمون النص، حيث إذا وجدنا أنه يتعلق بحماية مصالح أساسية للدولة أو المجتمع، أو يتعلق بتنظيم المرافق العامة وحسن إدارتها، فإن القاعدة تكون أمرة لا يجوز مخالفتها،
أما إذا لم تتعلق بذلك فإنها تكون قاعدة تكميلية مفسرة يجوز الاتفاق على خلافها.
فبإسقاط هذين المعيارين على قواعد الاختصاص القضائي الولائي والنوعي نجد الآتي:
أ. نصت المادة (146) من قانون أصول المحاكمات على أن
((عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى))
وبالوقوف عند المعيار الشكلي نجد أن النص يفيد أنه للمحكمة إثارة عدم الاختصاص الولائي والنوعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى،
وهذا يعني أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص وإنه يتعلق بالنظام العام، لأنه يتعلق بتنظيم التقاضي أمام الجهات القضائية أو أمام محاكم محددة سابقة من قبل المشرع.
ب- يفيد المعيار المعنوي أن قواعد الاختصاص من حيث المبدأ موضوعة لتنظيم مرفق العدالة وحسن إدارته بوصفه من مرافق الدولة ومن وظائفها الأساسية، وهي بذلك تعد من القواعد الآمرة التعلقها بالنظام العام .
ثانيا- الاثار المترتبة على طبيعة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي:
يترتب على عد قواعد الاختصاص الولائي والنوعي من النظام العام مجموعة من النتائج الهامة تتوضح في الأتي:
1- يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتصدی مباشرة لمسألة الاختصاص، وتحكم به دون
طلب أو دفع من الخصوم دون أن يعد ذلك خروجاً على مبدأ حياد القاضي، وهي لا تملك
هذا الحق لون الاختصاص لارتبط بالنظام العام.
2- النيابة العامة سواء كانت طرفا أصلياً أم طرفاً منضماً أن تثير مسألة الاختصاص المتعلقة
بالنظام العام، ولو لم يثره أحد الخصوم في الدعوى، وهي لا تملك هذا الحق لو لم يكن الأمر يتعلق بالنظام العام عندما تكون طرفا منضماً إلى أحد الخصوم في الدعوى الذي عليه هو أن يتمسك به.
3- للخصوم الحق بالتمسك بعدم اختصاص المحكمة وبالتالي يمكن إثارته من المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل في الدعوى، ولو لم يكن الأمر متعلقة بالنظام العام لما استطاع التمسك به إلا من وضع لمصلحته.
4- للخصوم أن يتمسكوا بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي في أية حالة كانت عليه
الدعوى سواء تم الدخول في الموضوع أم لم يتم ذلك ،كما يمكن التمسك بعد الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الدعوي سواء كان ذلك في مرحلة الاستئناف أم في مرحلة الطعن بالنقض. . 5- لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على اختصاص محكمة للنظر في نزاع قائم أو يحتمل قيامه
فيما بينهما غي مختصة نوعية أو قيمية فيه وفق قواعد تحديد الاختصاص القيمي والنوعي،
ولا يجوز التنازل عن تطبيق قاعدة متعلقة بالنظام العام.
6- يتعين على المحكمة البت في مسألة الاختصاص قبل الدخول في موضوع، وإن الحكم في
هذه المسألة يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف على وجه الاستقلال، لأنه يترتب على عدم اختصاص المحكمة في الفصل في الدعوى رفع يدها عنها، وإن الحكم الصادر لهذه الناحية يقبل الاستئناف،
وإذا قررت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة مختصة في نظر الدعوى عليها أن تعيد الدعوى إليها لا أن تفصل في الموضوع.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )