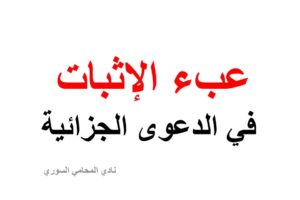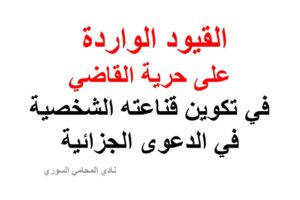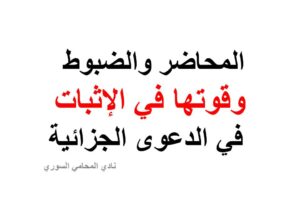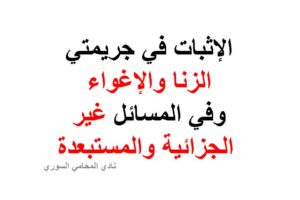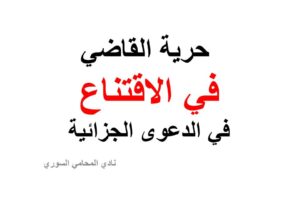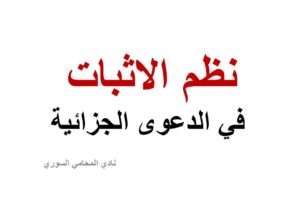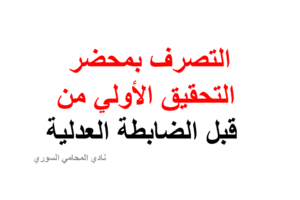يقع عبء الإثبات في القضايا المدنية على عاتق المدعي، فالقاعدة العامة تقول: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .
أما في القضايا الجزائية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة بالدرجة الأولى، لأن عليها أن تتثبت من توافر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية. فهي ليست خصماً ككل الخصوم بل هي خصم عادل يهمها البحث عن الحقيقة وليس الحكم على الأبرياء.
وقد يحصل أحياناً أن تكون الدعوى العامة قد حركت بناء على اتخاذ المجني عليه صفة الادعاء الشخصي وتكون النيابة العامة غير قانعة بوجود وجه لإقامة الدعوى العامة، ففي هذه الحالة يقع عبء الإثبات في الدرجة الأولى على عاتق المدعي الشخصي.
أي إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي أي النيابة العامة والمدعي الشخصي إن وجد.
كما أن القاضي الجزائي لا يقف مكتوف اليدين، فهو يبحث أيضاً عن كل ما من شأنه كشف الحقيقة، كطلبه أدلة لم يتعرض لها الخصوم أو لم يتعرض لها التحقيق. أي يقوم القاضي الجزائي باتخاذ جميع التدابير التي تساعد على إظهار الحقيقة في الدعوى وجمع أدلتها وعناصرها سواء في دور التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة.
أما موانع المسؤولية أو العقاب كالجنون والإكراه والقصر وحالة الضرورة التي يترتب عليها عدم مسؤولية الفاعل، فلا يكلف المدعى عليه في رأي معظم الفقهاء بإثباتها، لأن قرينة البراءة تؤكد أنه بريء حتى يدان.
ويكفي أن يدفع المتهم بوجود أحد موانع العقاب حتى يترتب على النيابة العامة إقامة الدليل على عدم قيام هذا المانع المدعى به.
ولا جدال في أن تطبيق مبدأ القناعة الشخصية يسهل على فريق الادعاء في المواد الجزائية
مهمة الإثبات.
فحرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية بما يرتاح إليه ضميره من الأدلة تجعل المتهم
شديد الحرص على أن لا يقف موقفا سلبية من سير المحاكمة، وانما تدفعه مصلحته إلى اتخاذ موقف إيجابي في دفع التهمة عن نفسه لإثبات براءته أو حتى إثارة الشكوك حول أدلة الاتهام حتى يصل إلى تطبيق المبدأ القائل إن الشك يفسر لمصلحة المتهم .
لكن من الأمور التي يلقي عبء الإثبات فيها على المدعى عليه، وجود الأعذار المحلة، والأعذار المخففة، والأسباب المخففة. وقد حكمت محكمة النقض ب: أن من يدعي بدفع أن يتقدم بأدلته عليه دونما حاجة إلى تكليف بذلك من المحكمة.