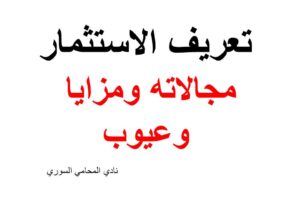تعريف البدل أو القسط وأهميته
أولاً- تعريفه:
القسط هو ثمن التأمين، وهو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن بدفعه لتغطية الخطر الذي تأخذه شركة التأمين على عاتقها.
فهو من الناحية الفنية يمثل قيمة الخطر المغطى، ويمثل من الناحية القانونية مقابل الضمان والأمان الذي تبيعو ش ركة التأمين لزبائنها.
وقد يرفع القسط إلى شركة التأمين بصفة ثابتة لا يتغير -في الأصل – من عام إلى آخر، لذلك يسمى التأمين في هذه الحالة التأمين ذا القسط الثابت.
وهو ما يدفع لشركة التأمين ذات القسط الثابت،كما هي الحال بالنسبة للأقساط التي تحصل عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين التي تقوم بيذا الدور.
أما في حالات التأمين التبادلي أو التعاوني فيمكن أن يكون المبلغ الذي يدفعه المؤمن لهيئة التأمين التعاونية متغيراً ويسمى في هذه الحالة اشتراكاً.
غير أن هذه التفرقة بين المبلغين قد زالت أمام تحديد حد أقصى للاشتراك الذي يدفعه المؤمن.
وبعد أن أخذت شركة التأمين بمبدأ المساهمة في الأرباح وما يترتب عليه من تخفيف العبء على دافعي الأقساط.
لذلك أصبح من الجائز استخدام اصطلاح القسط للدلالة على التزام المؤمن عموماً أياً كان نوع الييئة القائمة بالتأمين.
ثانياً- أهميته:
يعد القسط عنصراً جوهرياً في التأمين، وله ما للخطر من أهمية، فوجوده لازم لقيام التأمين.
فاذا كان لا يمكن التأمين دون خطر، فلا تأمين أيضاً دون قسط فالقسط والخطر وجيان لعملة واحدة.
ومن هنا تبدو الصلمة الوثيقة بين القسط والخطر.
فالقسط مرتبطاً بالخطر، فهو يعبر عن الخطر من حيث قيمته المالية.
ذلك أنه إذا كان المؤمن يلتزم بدفع القسط ، فإن ذلك يتم في سبيل الوصول إلى تغطية الكوارث التي قد تلحق به. فتسوية الكوارث
أو الحوادث يتم عن طريق الإمدادات التي يدفعها المؤمنون على شكل أقساط.
ومن مجموع هذه الأقساط يتسنى لشركة التأمين مواجهة الحوادث وتغطية النتائج الناجمة عن وقوعها.
ولهذا كان من اللزوم أن يعبر القسط عن قيمة الخطر، فتتحدد قيمته في ضوء الأخطار المؤمنة.
ويتم تحديد قيمة تلك الأخطار على أسس فنية، مع الاستعانة بقواعد الإحصاء.
واذا كان القسط معبراً عن قيمة الخطر أو هو ثمن له، بحيث يكون معادلاً لقيمة الخطر وفقاً للقواعد والأصول الفنية مع الاستعانة بقواعد الإحصاء كما ذكرنا، إلا أنه ينبغي أن يدخل في الحسبان، إلى جانب ذلك، عوامل أخرى لها دورها في تحديد مقدار التأمين.
إذن من الضروري توافر القسط لتغطية الكوارث التي تصيب المؤمنين خلال فترة التأمين والحصول على القسط هو السبيل الوحيد لتجميع الأموال اللازمة لتسوية الكوارث، وذلك عن طريق اجتماع أكبر عدد ممكن من طالبي التأمين، وتحملهم بالأقساط المناسبة مع جسامة الخطر المؤمن.
فإذا لم يتوافر هذا الركن- أي القسط – في عملية من شأنها انتقال تبعة الخطر دون مقابل فإن مثل هذه العملية لا تعد تأميناً -وعلى أي حال- يمكن عدها هبة مشروطة .
يتبين مما سبق أن القسط كمحل للتأمين يلعب دوراً مهماً في تكوين عقد التأمين، ويتم تحديده وفقاً لأسس فنية تعتمد على قواعد الإحصاء. فكيف يتم هذا التحديد.
تحديد القسط
يتم مبدئياً تحديد القسط من طرفي العقد، ومع ذلك يشكل التأمين نشاطاً يستند إلى قواعد رياضية مستخدمة في إطار تجاري منظم، هي قواعد الإحصاء، وهذا ما يحدد مكونات القسط التجاري لذلك يدفعه المؤمن ويسميه بعضهم القسط المعلى أو المحمل .
ويقصد بذلك، أن القسط يتحدد على أساس قواعد الإحصاء ويسمى القسط الصافي أو البحت وهو الذي يساوي قيمة الخطر تقريباً وفقاً لقواعد الإحصاء.
تضاف إليه المصاريف والنفقات التي تتحملها شركة التأمين حتى تضاف إلى الأقساط بطريقة نسبية.
وتدخل في الحسبان عند تقدير القسط، وتسمى هذه المبالغ التي تصفيها شركة التأمين إلى القسط الصافي التكاليف أو علاوات القسط.
لذلك ولمعرفة كيفية تحديد القسط لابد من أن نعرض القسط الصافي ثم أعباء القسط أو علاوته
القسط الصافي
ينظر في تحديد القسط الصافي إلى عدة عناصر، من أبرزىا الخطر. فالقسط الصافي يمثل قيمة الخطر على وجو التقريب.
فيه المبلغ الذي يكفي لتغطية الأضرار الناتجة عن الخطر إذا ما تحققت الكارثة أو وقع الحادث، دون أن تتعرض شركة التأمين لخسارة، ودون تحقيق ربح .
والى جانب الخطر هناك عوامل أخرى تدخل في الحسبان عند تحديد القسط ، هذه العوامل الأخرى هي المبلغ المؤمن أو أداء المؤمن، ومدة التأمين، وكذلك سعر الفائدة التي تحصل عليها شركة التأمين من استغلال رصيد الأقساط الذي يتجمع لديها.
وبناءً على ما تقدم فإننا سنتعرض في دراستنا لعوامل تحديد القسط الصافي إلى عامل الخطر (أولاً ) وبعد ذلك ندرس العوامل الأخرى التي تدخل في تحديده ( ثانياً ).
أ- عامل الخطر:
يتوقف تحديد قيمة القسط على عامل الخطر الذي يشكل العنصر الأساسي لهذه العملية، إذ على قدر الخطر يكون القسط. وبناءً على ذلك يتحدد القسط بالنظر إلى احتمال تحقق الخطر المراد تأمينه من جهة، ومدى جسامة هذا الخطر من جهة أخرى. ويتدخل كل من درجة احتمال وقوع الخطر ومدى
جسامته في تكوين القسط. وبذلك لابد أن يكون القسط مناسباً مع هذا الخطر.
1 – درجة احتمال وقوع الخطر:
ويقصد من درجة احتمال تحقق الخطر المؤمن معرفة فرص تحققه. وبما أن الخطر يستجيب لشروط فنية، فإنه لا بد من بيان عدد الحالات التي يتحقق فيها الخطر بالنظر إلى مجموع الحالات التي نواجيهها، وبعبارة أخرى، يجب أن نحدد العلاقة بين عدد الفرص التي تتحقق فيها الكارثة أو الحادثة والعدد الكمي للفرص الملكنة.
ففي التأمين من الحريق إذا تبين وفقاً لطرائق الإحصاء أنه في كل ألف حالة تقع ثمان كوارث، فإن احتمال الكارثة يكون ثمانية من الألف (8/1000) ويعني ذلك أنه إذا كان لدى شركة التأمين ألف
مؤمن فإنه يحتمل احتراق ثمانية منازل من المنازل الألف المؤمنة.
فلو فرضنا أن مدة التأمين هي سنة ومقدار المبلغ المؤمن هو عشرة آلاف ليرة لأمكننا التوصل إلى معرفة القسط الصافي الذي يجب أن يدفعه كل مؤمن.
وذلك أن شركة التأمين ستقوم بتغطية الكوارث التي تتحقق هنا وهي ثمان، وقيمة تعويض كل منها عشرة آلاف ليرة. فيكون المجموع ثمانية آلاف ليرة.
فإذا ما وزع هذا المبلغ على المؤمنين جميعاً وهم ألف لكان كل منهم أن يدفع ثمانين ليرة سنوياً. بفرض أن الضرر قد تحقق كلية.
ومع مراعاة أن شركة التأمين لا تخسر شيئاً من مالها الخاص. فيكون القسط متوقفاً على درجة احتمال تحقق الخطر.
2 – درجة جسامة الخطر المحقق أو الكارثة:
الى جانب درجة احتمال تحقق الخطر يدخل في الحسبان أيضاً عند تحديد مقدار القسط الصافي
درجة جسامته. أي جسامة الكارثة التي تتحقق، ومدى النتائج التي تترتب عليها.
ذلك أن من الأخطار ما يؤدي تحققه إلى هلاك المؤمن هلاكاً كلياً كما في حالة التأمين من الحوادث التي تؤدي إلى وفاة الشخص، وكذلك بالنسبة للتأمين في حالة الوفاة. في هذه الحالة يترتب
على تحقق الكارثة الفناء الكلي، ويستحق مبلغ التأمين كاملاً. فالجسامة هنا لا تدخل في الحسبان لأن الكارثة أدت إلى فناء المؤمن، ولذلك فإن تقدير القسط الصافي يتوقف على درجة الاحتمال وحدها دون أن تدخل الجسامة في الحسبان.
ومع ذلك يظهر دور جسامة الخطر في تحديد القسط في حالات التأمين من الأضرار عندما تكون الكارثة كلية. ويكون الضرر جزئياً. ولهذا لا يستحق المؤمن كامل مبلغ التأمين بل قدراً يتناسب مع ما لحقه من ضرر.
وفي هذه الحالة بما أن جسامة الخطر تتناقص فإنها تؤثر بالضرورة في مقدار القسط وتنقصه، نظراً لأن التزام شركة التأمين سيكون أقل.
وتستخدم الإحصائيات للدلالة على درجة جسامة الخطر، فتبين، بالإضافة إلى تحديد درجة احتمال تحقق الخطر متوسط درجة جسامة الحوادث.
فإذا تبين من الإحصاء أن الكوارث لا تؤدي عادة إلا إلى هلاك ثلاثة أرباع الأشياء المؤمن عليها مثلاً، فإن التزام شركة التأمين يقتصر على الوفاء بقيمة القدر الذي أهمكته الكارثة.
واذا كان القسط الصافي يتحدد في ضوء الخطر، فإنه يجب أن يخفض إلى النسبة التي تمثل متوسط إهلاك الخطر للأشياء المؤمنة أيضاً.
ففي مثالنا في الفقرة السابقة، إذا فرضنا أنه ثبت أن الحريق في بعض المنازل لا يفتك إلا بنسبة معينة كالنصف مثلاً، وكان القسط الذي يجب دفعه طبقاً للاحتمالات وحدها هو ثمأنون ليرة، فإن إدخال
درجة جسامة الكارثة في الاعتبار، وهي هنا الخسارة بقدر نصف المبلغ المؤمن، يستوجب إنقاص مقدار القسط إلى النصف وهو مبلغ أربعون ليرة فقط بدلاً من ثمانين .
من خلال ذلك يتبين أن هناك علاقة وثيقة تربط بين الخطر و القسط وأنه يوجد تناسب بينهما.
وعلى قدر الخطر يكون مقدار القسط، فهو يرتبط بالخطر من جهة درجة احتمال تحققه، ودرجة جسامته من جهة أخرى, وهذا ما يسمى بمبدأ ” تناسب القسط مع الخطر”.
3 – مبدأ تناسب القسط مع الخطر:
يقضي تحديد القسط الصافي الاعتماد على الخطر بشكل أساسي من حيث احتمال تحققه ودرجة جسامته.
وبما أن عامل الخطر هو مقياس القسط الواجب دفعه لذلك يجب أن يكون هنالك تناسب بين القسط وبين الخطر. وهذا هو مبدأ تناسب القسط مع الخطر.
ويترتب على تطبيق هذا المبدأ النتائج التالية:
آ – لا تستحق شركة التأمين القسط إذا لم يوجد الخطر. فإذا كان الخطر غير موجود أو كان قد زال أو تحقق وقت التعاقد كان العقد باطلاً بغض النظر عن حسن أو سوء نية المتعاقدين أو أحدهما.
ب – إن تحديد القسط يتبع الخطر من حيث ثباته أو تغيره. فإذا كان الخطر ثابتاً، كان القسط ثابتاً أيضاً. واذا كان الخطر متغيراً، فإن القسط ينبغي أن يتغير كذلك، وبالنسب نفسها، فيكون تصاعدياً أو تنازلياً بحسب طبيعة الخطر.
وان كان يراعى عممياً جعل القسط ثابتاً في هذه الحالة، مع قيام شركة التأمين بعمل احتياطي كما ذكرنا عند كلامنا عن الخطر الثابت والخطر المتغير، ورأينا كيفية معالجة شركات التأمين لمخطر المتغير وتفادي تفاوت الأقساط وذلك عن طريق الاحتياطي.
ج – إذا كان الخطر ثابتاً بطبيعته، وطرأت ظروف أو تغيرات خلال مدة العقد، سواء من فعل المؤمن أو من غير فعله، تزيد من درجة احتمال تحققه، فإن مبدأ تناسب بين القسط والخطر يستدعي التدخل لإعادة هذا التناسب عن طريق زيادة القسط تبعاً لذلك وبالنسبة نفسيا من التزايد.
فإذا ا زد احتمال تحقق الخطر بفعل المؤمن أو بفعل الغير أو بتغير الظروف نفسها وجب تغير القسط بنسبة زيادة الخطر، واذا رفض المؤمن تلك الزيادة من حق شركة التأمين إنهاء العقد، على أنه يجب أن تكون زيادة الخطر متعلقة بتغير يطرأ على أحد العناصر التي يكون لها اعتبارها لدى المتعاقدين من جهة وألا تكون زيادة الخطر من شأنها أن تجعل الخطر غير قابل للتأمين.
– وقد ذهب المشرع الفرنسي في هذا الشأن مذهباً متطورأً فقد نصت المادة التشريعية 113-4 من قانون التأمين الفرنسي لعام 1976
” إذا تسبب المؤمن بفعله في زيادة الأخطار المؤمنة، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت التعاقد لامتنعت شركة التأمين عن التعاقد. أو لما تعاقدت إلا نظير مقابل أكبر وجب على المؤمن قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلم شركة التأمين برسالة مسجلة”.
فإذا لم يكن للمؤمن في زيادة الأخطار وجب عليه إعلام شركة التأمين خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بهذه الزيادة.
وفي الحالتين، لشركة التأمين الخيار، إما أن تطلب فسخ العقد، أو تفرض زيادة في مقدار قسط التأمين.
فإذا لم يقبل المؤمن هذه الزيادة، يفسخ العقد، ويحق لشركة التأمين في الحالة الأولى أن تطلب تعويضاً أمام القضاء.
ومع ذلك، لا يجوز لشركة التأمين أن تتذرع بزيادة الأخطار إذا كانت قد علمت بها بأي وجه كان وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد بوجه خاص إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض بعد تحقق الكارثة.
وقد تبنى المشرع اللبناني هذا النص حرفياً بأحكام قانون الموجبات اللبناني المادة 977 منه. أما المشرع السوري فلم يأتِ بأي نص قانوني مماثل، فيما يتعلق بهذا الموضوع، لذلك نعود إلى القواعد العامة التي تحكم العقود.
د – إذا كان القسط قد تحدد عند العقد على أساس ظروف معينة وردت في عقد التأمين، كان للمؤمن الحق في طلب فسخ العقد إذا لم تستجب شركة التأمين لطلبه في تخفيض القسط، بحيث يتلاءم مع الخطر عن المادة اللاحقة لزوال تلك الظروف.
في هذا الصدد ذىب المشرع الفرنسي بأحكام المادة التشريعية 113-7 المعدلة بالقانون الصادر عام 1981 :
” إذا كانت وثيقة التأمين تشير إلى ظروف خاصة، أخذ بها بعين الاعتبار عند تحديد القسط ، وكان من شأنها زيادة الأخطار, كان من حق المؤمن، إذا زالت هذه الظروف أثناء فترة التأمين، أن يطلب فسخ العقد، ودون أي تعويض، إذا رفضت شركة التأمين تخفيض القسط بما يقابلها، وفقاً للتعرفة
المطبقة وقت إبرام العقد”.
وقد تبنى المشرع اللبناني هذا النص حرفياً بأحكام المادة 978 موجبات وأضاف: “….
“……، وان يكن هناك اتفاق على العكس”.
ومن الواضح هنا أنه يجب أن تزول هذه الظروف التي نظر إليها عند تحديد القسط على أن من شأنها أن تزيد الخطر. فلا يكفي هنا مجرد نقصيا أو التخفيف منيا فقط دون زوالها. ويجب أن تكون هذه الظروف قد ذكرت من قبل في العقد، وقد حسب القسط على أساس وجودها.
هـ – كما ينجم عن تطبيق مبدأ التناسب بين القسط والخطر، أنه إذا لم تتمكن شركة التأمين من الإجابة، بشكل حقيقي، بالخطر المؤمن، وبسبب عدم إدراك المؤمن وقت التعاقد للبيانات التي تعطي فكرة كاملة عن مدى الخطر، ولم يكن ذلك عن سوء قصد منه، كما لو سكت عنها بحسن نية.
أو أعطى بيانات خاطئة بغير عمد. ففي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تطالب بزيادة القسط بحيث يتناسب مع جسامة الخطورة، كما يحق لها أن تفسخ العقد.
واذا لم تتبين شركة التأمين حقيقة الوضع إلا بعد وقوع الكارثة, كان ها أن تخفض مبلغ التعويض المستحق للمؤمن بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح وتام.
وهذا الحل – التخفيض النسبي للتعويض – لا يطبق إلا إذا كان المؤمن، أثناء تنفيذه لالتزامه بإعلان شركة التأمين عن ظروف الخطر، حسن النية أو جاهلاً لهذه الظروف أو سكت عنها بغير سوء نية ودون قصد الغش لديه .
ويجب أن نشير إلى أن هذه النتائج المستمدة من تطبيق مبدأ تناسب القسط مع الخطر تفرضها العدالة التي يقتضييا التعاون المعتبر أساساً للتأمين، فمن ساهم في الرصيد المشترك بقسط غير متناسب مع الخطر المستهدف له، يجب أن يخفض نصيبه من هذا الرصيد بنسبة عدم كفاية اشتراكه فيه.
ب – العوامل الأخرى التي تؤثر في تحديد القسط:
إذا كان تحديد القسط يتوقف بشكل أساسي على تحديد درجة احتمال تحقق الخطر وجسامته، فإن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديده.
فهناك مقدار مبلغ التأمين (أداء شركة التأمين)، ومدة التأمين، وسعر الفائدة كعنصر مالي.
1- مبلغ التأمين (أداء شركة التأمين) :
تقوم بين القسط ومبلغ التأمين علاقة حسابية وثيقة، فعن طريق تطبيق قواعد الإحصاء على هذه العلاقة يتحدد مقدار القسط. وبالتالي فإن القسط يتغير تبعاً لتغير المبلغ المؤمن، وطبعاً فإنه كلما زاد مقدار المبلغ المؤمن ازاد مبلغ القسط الواجب دفعه.
ذكرنا بأن القسط يتحدد في ضوء درجة احتمالات وجسامة الخطر. وبالنظر إلى ذلك يعد وحدة نقدية معينة. وحدة نقدية تتخذ أساساً للحساب. فإذا كانت قوائم الإحصاءات تبين مثلاً أن كل قسط في حالة التأمين من الحريق هو أربعون ليرة – كما ذكرنا في مثالنا السابق – فإنه إنما ينظر إلى هذا التحديد على افتراض أن المبلغ المؤمن هو عشرة آلاف ليرة. فمبلغ عشرة آلاف ليرة هو الوحدة النقدية التي تتخذ أساساً للحساب.
فإذا أمن الشخص من الحريق بمبلغ عشرة آلاف ليرة لمدة سنة، فإنه يدفع أربعين ليرة سورية قسطاً لهذا التأمين.
فإذا ا زد المبلغ المؤمن زيدت قيمة القسط، أي أنه إذا صار المبلغ المؤمن عشرين ألف ليرة مثلاً زاد القسط السنوي إلى ثمانين ليرة سورية، واذا ا زد المبلغ المؤمن إلى مئة ألف ليرة زاد القسط إلى أربعمائة ليرة سورية وهكذا فإن القسط يزداد كلما ازداد مبلغ التأمين.
على أن هناك حالات لا يتحدد فيها مبلغ التأمين وهو ما يحصل في حالة التأمين غير المحدد أو التأمين الكمي، حيث لا يبدو هذا النظام الخاص المتعلق بتزايد القسط مع مبلغ التأمين، وان كانت شركة التأمين تقوم بعمل حسابها على أساس مبلغ مرتفع جداً ويتأثر القسط بهذا المبلغ المرتفع في هذه الحالة. وبالتالي فإن تحديد القسط مرتبط بمبلغ التأمين وان لم يكن محدداً سلفاً في عقد التأمين.
2 – مدة التأمين:
يرتبط تحديد البدل بمدة التأمين. فالتأمين هو أصلاً من العقود الزمنية ويتدرج تنفيذه لزمن معين، والتي لا بد من تحديدىا في عقد التأمين، لحساب القسط وتحديده، هذه المدة الزمنية هي سنة من حيث المبدأ، ومدة السنة هي المدة العادية التي تتخذ أساساً للإحصاءات.
ومع ذلك فقد يتم التأمين لمدة أقل من السنة، كالتأمين على الحياة لسفرة واحدة بالطائرة مثلاً، والتأمين الذي يتم على البضائع أثناء نقلها فقط، وقد يتم التأمين ضد بعض الأخطار التي تحتسب على أساس سنوي، ولكن لمدة أقل من السنة
كتأمين السيارة لموسم معين مثلاً أو لمدة ستة أشهر.
ومع ذلك فإن القاعدة العامة لتحديد مدة التأمين، والتي تتخذ لحساب البدل على أساس الوحدة – الزمنية، هي السنة. لذلك فإنه عند النظر إلى قوائم الإحصاء بالنسبة إلى حالة التأمين من الحريق مثلاً، إذا كان القسط السنوي يتحدد بالنظر إلى الوحدة النقدية، ولتكن عشرة آلاف ليرة، فإنه يتحدد على أساس الوحدة الزمنية، وهي عادة تكون سنة.
فإذا ا زدت مدة العقد على السنة زاد القسط كذلك. فإذا كان القسط السنوي أربعين ليرة مثلاً لكل وحدة نقدية مقدارها عشرة آلاف ليرة، فإنه إذا زادت مدة العقد فإن معنى ذلك زيادة القسط الذي يدفع بمقدار هذه الزيادة في المدة، بحيث يكون أربعين ليرة عن كل سنة، أي يتحمل المؤمن بالقسط السنوي مضروباً في عدد السنين التي اتفق عليها في العقد.
ولا صعوبة في هذا الصدد إذا كان الخطر ثابتاً، من سنة إلى أخرى، على أن الأمر يظهر بعض التعقيد بالنسبة للخطر المتغير، فقد يتغير القسط متأثراً بمدة التأمين وبخاصة في التأمين على الحياة.
فيختلف مقدار القسط تبعاً لطول مدة العقد، فيكون مخفضاً إذا كان واجب الأداء مدى الحياة، ثم يطرد إطراداً عكسياً مع المدة، بحيث يزاد القسط كلما نقصت مدة التأمين.
فمثلاً القسط المقرر على التأمين لمدة عشر سنوات أكبر من قسط التأمين لعشرين سنة، وهكذا…
ولكن ذلك لا يمنع من بقاء القسط السنوي موحداً طوال مدة التأمين المتفق عليها، فيكون أثر المدة قاصراً إذن في مقدار القسط وحدته.
3 – سعر الفائدة:
يتوقف تحديد مقدار القسط أيضاً على عامل آخر، وهو عامل مالي وليس إحصائي وهو سعر الفائدة.
ذلك أن الأقساط، عموماً، تدفع مقدماً وتظل خلال مدة من الزمن في صندوق شركة التأمين قبل استخدامها في تغطية أثار الكوارث.
ولهذا فإن شركة التأمين تستغل الأموال خلال هذه المدة فتحصل من ورائها على فائدة تحقق لها إيراداً، ويؤدي ذلك إلى إنقاص مقدار القسط. ذلك أن الفوائد التي تحصلها شركة التأمين تساعدها على مواجهة المصروفات العامة فتخففها.
ولهذا يتوجب على شركة التأمين أن تضع في حسابها عند تحديد القسط ما تحصل عليه من فوائد نظير استغلال ما يتجمع لديها من أقساط.
أي تخفض القسط بنسبة الزيادة التي تنتظر الحصول عليها من الفوائد لقاء توظيف المبالغ التي تتجمع لديها.
ويظير هذا الدور الذي يلعبه عامل سعر الفائدة في تحديد القسط بشكل واضح في حالة التأمين على الحياة، إذ يتجمع لدى شركات التأمين مبالغ كبيرة من الاحتياطي تقوم باستثمارها.
ويتم تخفيض مقدار الفوائد التي تحصل عليها شركات التأمين من مقدار القسط في ضوء ما تحصل عليه من استثمارات للمبالغ المتجمعة لديها، بالنظر إلى الظروف المحيطة بالنسبة لاستثمار رؤوس الأموال.
بالتأكيد يمكن أن يدخل عامل سعر الفائدة في علاوة القسط عندما تتم المقاصة بين الفوائد التي تحصل عليها شركة التأمين وبين نفقات ومصاريف الشركة.
ولكن يعد سعر الفائدة، تقليدياً، عاملاً من عوامل القسط الصافي، ذلك لأن سعر الفائدة ثابت نسبياً، وتستطيع شركة التأمين أن تكوّن، في هذه الحالة، احتياطات مالية، كما هي الحال بالنسبة للاحتياطات الإحصائية التي تكونها شركة التأمين فيما يتعلق بالخطر.
أعباء القسط أو علاوته
إن قيام شركة التأمين بأعمالها من تجميع للأقساط الصافية وتوزيعها على أولئك الذين تحقق الخطر بالنسبة إليهم. من خلال العام، يتطلب منها دفع نفقات وتكاليف يجب إدخالها في الحساب، واضافتها إلى القسط الصافي. فيكون القسط الصافي مضافاً إليه هذه التكاليف هو القسط التجاري، أي القسط الفعلي الذي يدفعه المؤمن للشركة.
فالتكاليف أو الأعباء هي مبالغ يجب إضافتها إلى القسط الصافي لتأمينٍ ما لتغطية عدد معين من النفقات اللازمة لإدارة شركة تأمين وادارة العقد المسجل.
ذلك أن تنظيم عملية التأمين بين المؤمن وشركة التأمين يحتاج إلى أجهزة ونفقات متعددة، لا تتحملها هذه الشركة في النياية.
وتحتوي هذه الأعباء أو التكاليف التي تدفعها شركة التأمين، إلى جانب القسط، على عناصر متعددة، يمكن حصرها في ما يلي:
– 1 – مصاريف اكتساب العقود،
2- مصاريف تحصيل الأقساط،
3 – مصاريف الإدارة،
4 – الضرائب،
5- الأرباح التي تهدف الشركة إلى تحقيقيا.
وسنعرض هذه العناصر بشيء من التفصيل.
أولاً- مصاريف اكتساب العقود أو عمولة الوساطة:
غالباً، لا يقبل الأفراد من تلقاء أنفسهم على التأمين، ولهذا تحاول شركات التأمين الوصول إليهم عن طريق مندوبين، هم الوسطاء الذين يجلبون العملاء إلى الشركات، وهم وكلاء التأمين وسماسرته، ويدعون “بالمنتجين“.
وان كثيراً من الناس لا يدركون فوائد التأمين إلا إذا أبصرهم هؤلاء الوسطاء، ومن يدرك منهم فوائده، لا ينشط من تلقاء نفسه للتعاقد مع شركة التأمين، وانما الوسيط هو الذي يستحثه على التعاقد، وييسر له سبله ويشرح له طرائقه المتنوعة.
وهؤلاء الوسطاء الذين يحترفون هذا العمل، يجب أن يحصلوا على مكافأة نظير مهمتهم. وهذه المكافأة هي عمولة تمنح لهم عن كل عقد يتم إبرامه عن طريقهم بين المؤمن وشركة التأمين، تتحدد بنسبة قد تصل إلى مقدار القسط 15 %من القسط، وذلك إما على أساس مقدار القسط، واما على أساس مبلغ التأمين.
ويراعى- في الواقع- عند تقدير هذه العمولة للوسيط ليس فقط مجرد إتمام العملية بين الشركة والمؤمن، ولكن أيضاً ما يبذل في ذلك من جهود مع العملاء قد تنجح وقد لا تنجح.
ولاشك أن العمولة التي يتقاضاها الوسيط لا تتحملها شركة التأمين، وانما تلقى على عاتق العملاء المؤمنين فتضاف إذاً إلى القسط الصافي.
ثانياً- مصاريف تحصيل الأقساط:
القاعدة أن الدين محصلاً وليس محمولاً، أي أنه يجب تقاضيه في محل المدين. والمدين في عقد التأمين هو المؤمن، وبالتالي فيجب أن تدفع الأقساط في محل إقامة المؤمن ماعدا القسط الأول فغالباً ما يدفع عند إبرام العقد مع الشركة.
وبناءً على ذلك فإن شركة التأمين عندما تسعى إلى عملائها لتحصيل الأقساط عن طريق محصلين يتقاضون أجوراً تدفعها الشركة وتنفق بالإضافة لذلك مصاريف انتقاليه تسمى مصاريف التحصيل.
ولا شك أن تلك المصاريف ينبغي في النهاية أن يتحملها المؤمن، وتضاف تبعاً لذلك إلى القسط الصافي بمقدار ما تتناسب تلك المصروفات مع قيمة القسط أو مقدار الأقساط .
على أن المشرع الفرنسي خفف من عبء هذه النفقات عندما عد أن الأقساط لم تعد محصلة في موطن المؤمن، وانما محمولة إلى شركة التأمين وبالتالي يجب على المؤمن دفعها في موطن الشركة.
فقد نصت المادة التشريعية 113- 3 الفقرة الأولى:
” يدفع القسط في موطن شركة التأمين أو لدى الوكيل المعين لهذا الغرض”.
ثالثاً- مصاريف الإدارة:
ويقصد بذلك النفقات كافة التي تتحملها شركة التأمين في سبيل قيامها بعملها، فالشركة لها مكان تقيم فيه، قد تشغله مقابل بدل إيجار، كما يصرف أعمالها مدير أو مديرون، ويعمل فيها عددٌ كبيرٌ من الموظفين والمستخدمين، تدفع لهم أجور ومرتبات.
وكثيراً ما تلجأ إلى خبراء تستعين بهم للكشف ولتقدير الأضرار، وترفع كما يرفع عليها الكثير من القضايا، مما يستدعي دفع نفقات لا يستهان بها، كما تدفع نفقات عن وسائل الوقاية التي تتخذها. ونفقات تسوية الكوارث.. وغيرها من النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل الإدارة .
وكل هذه النفقات التي تقوم بها شركة التأمين في سبيل الإدارة لا تتحمل عبأها الشركة، وانما تقع على كاهل عملائها، فتضاف إلى الأقساط بقدر يتناسب مع قيمتها حسب الظروف.
وتتجه الدول حالياً نحو تخفيض تلك الأعباء عن طريق التنظيم العلمي للتأمين.
ففي فرنسا صدر قرار عام 1965 يبين إمكان خفض نفقات الإدارة أياً كان نوعيا، بما فيها عمولة الوسطاء وذلك بالنسبة لتأمين المركبات بنسبة 38 % عن عام 1970 وبنسبة 42 % عن عام 1980 وكذلك صدر قرار مماثل لهذا الصدد في حالة التأمين على الحياة يهدف إلى الحد من المصروفات عام 1970 الخاصة بإدارة واستغلال شركات التأمين على الحياة .
رابعاً- الضرائب:
يضاف إلى التكاليف التجارية سالفة الذكر العبء الضريبي، أي الضرائب التي تلتزم شركات التأمين بدفعها إلى الدولة.
فالضرائب التي قد تفرض على عمليات التأمين لا تتحمل بها الشركة ولكنها تلقى على عاتق المؤمنين بإضافتها للقسط. وهذا بطبيعة الحال مع مراعاة ما قد يفرض على شركة التأمين من ضرائب على المؤمنين مباشرة تحصل مع القسط السنوي.
ويجب أن نشير إلى أنّ قد تفرض، أحياناً، رسوم أو ضرائب تفرض على شركة التأمين ولكن يلقى بعبئها على المؤمنين عن طريق رفع مقدار القسط.
خامساً: أرباح الشركة:
بما أن شركات التأمين هي تجارية تهدف إلى الربح وهذا هو الأصل، فإنها تدخل في اعتبارها عند تحديد الأقساط التي يلتزم بها العملاء، ضرورة الحصول على قدر من الربح.
وتدخل هذه الأرباح في الحسبان دائماً عند تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن، وبذلك تضاف نسبة ولو ضئياة تدخل ضمن أعباء القسط، وبالتالي ترفع مقداره.
وتستخدم شركات التأمين جزءاً من هذا الربح إلى جانب علاوة أخرى إما عن طريق نسبة معينة تضاف إلى القسط الصافي في تكوين احتياطي الامان أو ما يسمى باحتياطي التقلبات العكسية. ويقصد به الاحتياط ضد الحالة التي تكون فيها الخسائر أزيد من المتوسط الذي حسب على أساسه القسط الصافي. وتدخل هذه النسب ضمن أعباء أو تكاليف القسط.
تلك هي أبرز التكاليف أو الأعباء التي تأخذها في الحسبان شركات التأمين عند تحديد القسط الذي يمتزم المؤمنون بدفعه، وذلك إلى جانب العامل الأساسي، وهو الخطر الذي يحسب على أساس جسامته ودرجة احتمال وقوعه القسط الصافي.
وبذلك نكون قد بينا الجانب الفني لبدل أو لقسط التأمين من خلال حسابه وتحديد مقداره.
أما الجانب القانوني لهذا القسط، وهو الالتزام بدفعه إلى شركة التأمين فنؤجل التعرض لو عند بحثنا لالتزامات المؤمن .