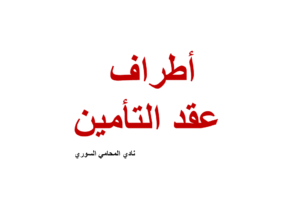نظام الحقوق في تركيا
تركيا دولة قانون ومتبنية مبدأ سيادة القانون.
القانون في تركيا متساوي للجميع دون التمييز بين اللغة ، العرق ، اللون ، الجنسية، الفكر السياسي، العقيدة الفلسفية، الدين ، المذهب وما شابه ذلك من اسباب .
قواعد القانون التركي مكتوبة وهي الدستور ومن ثم القوانين والمرسوم واللوائح والتعليمات والتبليغات وما شابه ذلك من معاملات تنظيمية.
إلى جانب ذلك هناك الإتفاقيات الدولية التي أصبحت سارية المفعول وفق الأصول والتي تعتبر بحكم القانون.
الدستور التركي المنظم عام 1982 يتضمن بأوسع شكل من اشكال الدولة وبنيتها وطريقة حكمها وأجهزتها ووظائف تلك الأجهزة والعلاقات فيما بينهم والحقوق الأساسية الخاصة بالأفراد.
يطبق القانون التركي على الأجانب الذين يدخلون تركيا للحصول على الحماية الدولية وتكون المحاكم التركية هي صاحبة الصلاحية في حل الخلافات المتعلقة بهم.
القانون الذي يتم تطبيقه على المهاجرين الشرعيين في تركيا والأجانب الذين لا يزالون يحملون جنسية بلادهم يتم تحديدها وفق أحكام القوانين الدولية وعلى أساس جنسية الأجنبي وقانون بلاده.
تمنح القوانين في تركيا حقوقا عديدة للأفراد ولكن لا توجد حرية مطلقة لإستخدام تلك الحقوق.
عند إستخدام الفرد لحقوقه تكون هناك حدود قانونية لذلك وعلى أساسها يجب أن يتصرف الفرد. على سبيل المثال :
بإمكان الفرد أن يتصرف بمنزله كما يشاء ولكن لا يحق له إزعاج جيرانه.
بإمكان الفرد إستخدام املاکه كما يشاء ولكن لا يحق له ان يستخدمه بشكل منافي للأخلاق والأدب.
يجب على الفرد أن يستخدم حقوقه بشكل يحترم به حقوق الآخرين.
إجراءات كاتب العدل
كاتب العدل في تركيا هوالمقام الذي يوفر الصفة الرسمية للوثائق، هي المؤسسة التابعة للدولة والتي تصدق مصداقية المعاملات.
تطلب المؤسسات الرسمية أو الغير رسمية أحيانا تصديق الكاتب العدلي على الوثائق للتأكد من صحتها لذا فقد تحتاجوا أحيانا مراجعة كاتب العدل هناك بعض إجراءات التي لا يمكن القيام بها إلا في كاتب العدل وقد تم أدناه توضیح بعض منها:
إجراءات إصدار الوكالة (حق تمثيل)
إجراءات بيع السيارة تصديق الوثائق المترجمة تصديق الدفاتر التجارية والمالية
عقود البيع ، إصدار وثيقة التعميم للتوقيع
إرسال إنذار وإخطار تنظیم محضر تثبیت إجراءات الكفالة”
إجراءات الأمانة والقبول والحفظ ، تصديق التاريخ و علامة والتوقيع على الوثائق الغير الرسمية
القيم الأساسية لنظام القانون في تركيا
تعتبر تركيا من الدول الأساسية التي تقوم بخطوات مهمة للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
تقوم تركيا اليوم بدمج معايير الحقوق والحريات الأساسية بالقانون الداخلي والإتفاقيات الدولية وتضع عليها أجهزة مراقبة،
كما تقوم مع المبدأ المساواة المواطنة للمواطنين بإجراء بإصلاحات لتحقيق حقوق وحريات واسعة في جميع المجالات. تزايدت الإصلاحات الخاصة بالديموقراطية والحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان منذ عام 2000.
الحقوق والحريات الأساسية سارية على الجميع وهي تحمل الفرد والمجتمع والعائلة مسؤوليات وواجبات تجاه الأخرين.
، الجميع متساوي أمام القانون ،
الجميع يمتلك حق الحياة وحماية وجوده الجسدي والمعنوي وتطويرها ،
لا يمكن تشغيل أي أحد جبراً ،
الجميع يمتلك حق الحرية والأمان الشخصي.
الجميع يمتلك حق أن ينال إحتراما لحياته الخاصة وحياته العائلية وسرية الحياة الخاصة هي تحت الحماية.
هناك حماية الحصانة المسكن ،
والجميع يمتلك حق التخابر
الجميع يمتلك حق الإستقرار وحق السفر ،
الجميع يمتلك حق حرية الدين والضمير
مهما كانت الأسباب فلا يمكن إجبار أي شخص على الإعلان عن أفكاره وقناعته
الجميع يمتلك حق التعبير عن فكره بالكلام والكتابة والرسم والطرق الأخرى سواء أن كان بمفرده أو مع مجموعة ،
الإعلام حر ولا يوجد تحديد للإعلام.
الجميع يمتلك حق تأسيس جمعية دون الحصول على إذن مسبق ويوجد حق العضوية في الجمعيات وحرية الخروج من العضوية.
لا يمكن منع أي شخص من حصوله على التعليم.
الجميع يمتلك حق العمل في جميع المجالات وعقد عقود للعمل.
لا يمكن تشغيل أحد بعمل لا يتناسب مع عمره وجنسه وقوته.
المعلومات الأساسية بخصوص قانون العقوبات
قانون العقوبات هو قانون يتحدث عن التصرفات التي تعتبر جرمأ وما هي العقوبات التي قد يتعرض لها الفرد في حال إرتكاب تلك التصرفات.
طوال إقامتكم في تركيا فأنتم ملزمون بالتقيد بقواعد القانون التركي.
في حال إرتكابكم لفعل يعتبر جرمة في تركيا تتم محاكمتكم وفق قانون العقوبات التركي.
إرتكاب الجرم بشكل كامل أو جزئي في تركيا أمر كافي لتطبيق القوانين التركية.
المباديء الأساسية لقانون العقوبات :
كي يكون فعل المقترف جرمأ يجب أن يكون مذكورة في القانون كجرم.
لا يمكن معاقبة أحد على تصرف لم يذكر في القانون کجرم.
عدم معرفة قوانين العقوبات لا يعتبر عذراً.
لا يوجد في قانون العقوبات التركي جرم أو عقوبة دون تقصير.
لا يمكن تحميل احد جرم الغير ومعاقبته عليه.
يتم وضع عقوبة لمقترف الجرم حسب نوع الجرم وتقصيره وبشكل يتناسب مع العدالة وحقوق الإنسان و لا يمكن معاقبة طفل تحت سن 12 سنة على جرم إرتكبه ولكن يؤخذ بحقه تدابير أمنية.
المعلومات الأساسية عن قانون الإدارة
تقوم الإدارة بجميع إجراءاتها وأعمالها وفق مصلحة الشعب ومع الإلتزام بالقوانين.
في حال إعتقادكم ان الإدارة لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب وللدفاع عن حقوقكم فبإمكانكم مراجعة القضاء الإداري وطلب إلغاء الإجراءات المتخذة بحقكم وتعويضكم عن الأضرار.
يتكون القضاء الإداري من المحاكم الإدارية ومحاكم الضريبة ومحاكم المنطقة الإدارية ومجلس السيادة. للحصول على معلومات مفصلة عن القضاء الإداري بإمكانكم إستشارة مستشار قانوني أو محامي.
الحقوق والإلتزامات المدنية
العائلة
العائلة هي أساس المجتمع التركي.
هناك أهمية كبيرة لحماية العائلة لكون العلاقات العائلية مسألة تؤثر على المجتمع وبنيته.
إستقرار العائلة وحمايتها أمر تحت ضمان الدستور والقوانين.
كما تتكون العائلة في تركيا من الزوج والزوجة والأطفال، وتتكون ايضاً من مجموعة من الأقارب الذين يعيشون معاً.
الولادة
تركيا من الدول التي تقل بها نسبة وفيات الأطفال عند الولادة.
من المعروف أن الولادة في شروط صحية وفي مؤسسة ذات صلاحية ( مستشفي – دار ولادة وما شابه ذلك ) والقيام بالفحوصات اللازمة بشكل منتظم بعد الولادة هي عوامل تقلل من وفيات الأطفال والأمهات.
إذا كنتي إمرأة عاملة في تركيا فلك حق الحصول على 8 أسابيع إجازة قبل الولادة و8 اسابيع إجازة بعد الولادة.
في هذه الفترة تكونين تحت الحماية من الطرد من العمل وتحت الحماية الصحية لك ولطفلك.
عند إنتهاء الإجازة يمكنك الحصول على إجازة إضافية لمدة 6 شهور دون أجرة من خلال تقديم طلب خطي وحتى يصل طفلك لعمر سنة لديك حق إذن الرضاعة كل يوم لمدة ساعة ونصف.
بعد الولادة يجب تسجيل ولادة الطفل خلال 30 يوم في مديرية النفوس وخلال 20 يوم عمل من الولادة يجب إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بالولادة.
أثناء تسجيل الولادة يجب تقديم البيانات الخاصة بالأب والأم وتقرير الولادة.
في حال عدم وجود تقرير ولادة من الممكن قبول المعلومات التي تقدم بيانية.
إن إجراءات تسجيل ولادة أطفالكم إلى مديرية النفوس وادارة الهجرة للمقاطعة يؤدي إلى الاستفادة من الحقوق والخدمات التي سيتم توفيرها لهم.
الخطوبة
الخطوبة والتي تعتبر الخطوة الأولى للزواج في تركيا يتم الإعلان عنها شفهياً. في حال رغبتكم خطبة أحدهم لا ينبغي لكم أخذ إذن من مقام رسمي.
أن تكونوا مخطوبين لاحد لا يعني أنه يجب عليكم الزواج .
في حال رغبتكم فسخ الخطوبة لا ينبغي أخذ إذن من مقام رسمي.
الزواج
سن الزواج المسموح به في تركيا 18 سنة.
الزواجات التي يتم الزواج في تركيا بالإعلان عن الرغبة في الزواج أمام موظف الزواج وعلى الأقل بحضور شاهدين.
لهذا السبب ، الزواج الذي يتم عقده عند الإمام لا يتم قبوله تعقد بشكل ولا يعطي الحقوق القانونية، ولكن بعد عقد النكاح الرسمي يمكن لمن يرغب حسب عقائده الدينية عقد نكاح الإمام.
في دولتنا يقوم الزواج على أساس الزواج الأحادي. لهذا السبب يمكن الزواج في نفس الوقت بزوجة واحدة فقط ، القانون لا يسمح بتعدد الزوجات ، الزواج من أشخاص من نفس الجنس غير ممكن قانونياً (رجل – رجل أو إمرأة – إمرأة).
في مؤسسة الزواج، الرجل والمراة يتمتعون بنفس الحقوق. لا يتمتع جنس على جنس بحقوق إضافية.
لا يسمح على الإطلاق بممارسة الشدة الجسدية ، الجنسية والنفسية بين الجنسين.
في حال تعرضكم للعنف العائلي يمكنكم أخذ معلومات حول هذا الموضوع من قسم الحالات الطارئة الموجود في الكتيب.
يحق لكم خلال إقامتكم في تركيا الزواج من مواطنة تركية او اجنبية.
لهذا عليكم إحضار الوثائق اللازمة ومراجعة بلدية المنطقة التي تقيمون بها.
لمعرفة الوثائق المطلوبة يمكن الذهاب للبلدية والسؤال.
في حال الزواج من مواطنة تركية، بعد 3 سنوات من الزواج يحق طلب الجنسية التركية، إلى جانب هذا يصبح الأطفال عند ولادتهم حاملي الجنسية التركية
منع الزواج
تمنع القوانين في تركيا زواج بعض الأشخاص من بعض الأسباب طبية و أخلاقية. هذه الأسباب هي كالتالي:
، ممنوع الزواج بين الأخوة. أيضا ممنوع زواج الأخوة من أم أو أب واحد.
، ممنوع الزواج من العم، الخال، العمة والخالة، لكن مسموح الزواج مع ابن/بنت العم، الخال، العمة والخالة.
، ممنوع الزواج من الأجداد أو الأحفاد حتى لو كان الزواج منتهي. يعني ممنوع الزواج من والدي أو أولاد الطرف الآخر حتى لو كان الزواج منتهي
، المتبني لا يحق له الزواج ممن تبناه او من النسل الأعلى أو الأسفل لأحد الطرفين.
في تركيا يمكن لكل شخص أن يكون له زوجة واحدة.
إذا كان متزوج في تركيا او له زواج مستمر خارج تركيا فلا يحق له الزواج مرة أخرى.
عند الرغبة في الزواج على الشخص إثبات أن زواجه السابق قد انتهی.
، المريض عقليا اذا لم يكن لديه تقرير صحي يوضح عدم وجود مانع لزواجه فإنه لا يحق له الزواج.
المرأة لا يحق لها الزواج مرة أخرى بعد طلاقها إلا بعد مرور 300 يوم ، لكن في حال إثبات انها ليست حامل بالتقرير الطبي فلا داعي لإنتظار هذه المدة.
بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال. عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل الأعلى درجة.
الطلاق
لا يوجد أي مانع قانوني في تركيا من أجل الطلاق.
دعاوى الطلاق تكون في محاكم الأسرة، يتم طلب الطلاق بالعريضة المقدمة للمحكمة الإصدار قرار الطلاق على الزوجين التواجد في المحكمة،
إذا لم يأت أحد الطرفين فإن الطلاق لا يحدث. بعد الطلاق وخلال 20 يوم يجب إبلاغ مديرية النفوس و مديرية دائرة الهجرة للولاية بتغيير الوضع المدني.
أسباب الطلاق الموجودة في القانون كالآتي:
و إذا زني أحد الزوجين. و إذا حاول أحد الزوجين قتل الأخر.
و إذا عامل أحد الزوجين الأخر بشكل سيء وجارح لغروره.
، إذا مارس احد الزوجين تصرفات لا تليق بمفهوم الشرف والكرامة، وتحول الحياة الزوجية لوضع لا يطاق.
، ترك بيت الزوجية و إذا أصبحت الحياة صعبة بين الزوجين واهتز أساس وحدة الزواج.
و إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي لا يمكن معالجته.
و أيضا يمكن الإتفاق بين الطرفين والطلاق بقرار المحكمة.
بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي للأبوين والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال. عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل لأعلى درجة.
الوفاة
على أقرباء المتوفي تسجيل حالة الوفاة التي حدثت في تركيا بتقديم أوراق الوفاة الى مديرية النفوس خلال عشرة أيام.
يتم كتابة شهادة الوفاة من طرف المستشفى التي حدثت فيها الوفاة ، لكن لو حدثت الوفاة في البيت يمكن أخذ شهادة الوفاة من طبيب مركز صحة المجتمع او الطبيب المناوب.
واقعة الوفاة يجب الإبلاغ عنها خلال 20 يوم لمديرية إدارة الهجرة الموجودة في المحافظة لمزيد من المعلومات حول الوفاة ومعاملات الجنازة يمكنكم النظر إلى قسم ’’ خدمات الجنازة، في الكتيب.
الميراث
الميراث هو عبارة عن ما أكتسبه الشخص وهو على قيد الحياة من مكاسب ، أملاك ، حق وديون. مثل أي شخص في تركيا انتم أيضا لكم حق الميراث ، من ناحية حقوق الميراث فإن الرجل والمرأة متساويان في حق الميراث. إذا كنتم مقيمين في تركيا بطلب الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة ، فإن قضايا الميراث تدور في المحاكم التركية ويتم تطبيق القوانين التركية.
أما المقيمين بوضع أخر فيتم تطبيق قوانین ما بين الملل.
في حال بقاء غير منقول موجود في تركيا كميراث ، يتم تطبيق القوانين المتعلقة باستملاك الأجانب لغير المنقول.
المزيد من المعلومات حول الميراث يمكنكم استشارة مستشار قانوني أو محامي.
إذا كنتم مشمولين في بلدنا في نطاق الحماية الدولية او الحماية المؤقتة فتتم دعاوی الميراث في المحاكم التركية ويتم تطبيق القانون التركي.