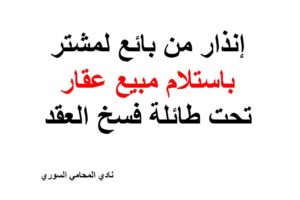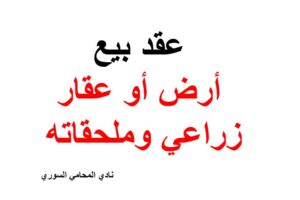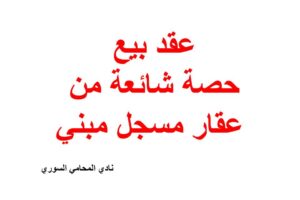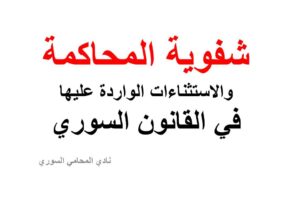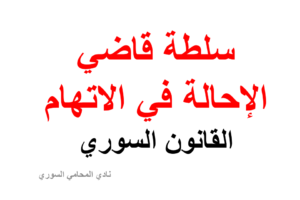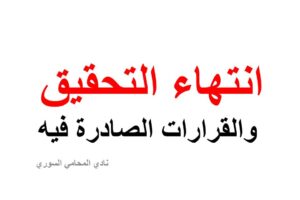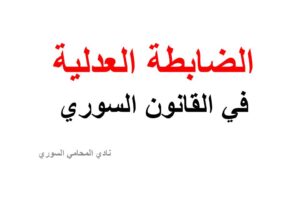الفريق الأول : البائع
الفريق الثاني: المشتري
المقدمة :
لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية في مدينة …… وهو عبارة عن أرض زراعية أميري وقف في قرية …… مساحتها …… مترا مربعا بعل / تزرع ب …… (تذكر أوصافها من قيدها العقاري)(1) أو سقي تسقي من نهر …… بعدان مقداره(2)…… وتحتوي على بناء من لبن وطين وخشب من بلوك وحجر وإسمنت مسلح…… مؤلف من …… طابق لاستعماله كمحل إقامة للفلاحين ومستودع وحوش للبهائم مزود بالكهرباء وتحتوي على …… بناء فيه محرك مضخة بئر ارتوازي مرخص استطاعة …… انش إلى جانبه حوض للماء. وله حق ارتفاق بالمرور (۳) للوصول إلى طريق …… و عليه حق ارتفاق بالمرور المصلحة العقار رقم …… المجاور للوصول إلى طريق …… وهو مزروع بالوقت الحاضر ب ……(4) وهو راغب ببيعه بالحالة المذكورة.
وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه وقد عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة بعد أن اطلع على قيده العقاري وعلى مخططه المساحي وحقوقه بالمياه وتحقق من مطابقة الواقع للقيد.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:
المادة 1-
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة ۲ –
أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني كامل العقار الموصوف بالمقدمة بما له وما عليه من حقوق ارتفاق وبما فوقه من غراس أو زروع و آبار ورخص وإنشاءات قائمة وحقوق مياه وبما للعمال والفلاحين من حقوق و التزامات متولدة عن استثماره (5) بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعية لا رجوع فيه ولا نكول.
ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري وغير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع من التصرف بالمبيع ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه.
المادة 3-
التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على دفعتين أولاهما وقدرها ……ليرة سورية بتاريخ هذا العقد وقد قبضها الفريق الأول منه وأبرأ ذمته منها والثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري.
المادة 4-
التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بتاریخ نقل ملكيته لاسمه في السجل العقاري على أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد.
المادة 5-
أ- أقر الفريق الأول بأنه يستخدم السيد …… كعامل زراعي بأجر شهري قدره …… /بأجر موسمي قدره ……(6) وينتهي عقده بغاية / / وبأن بينه وبين السيد …… عقد مزارعة بالبدل على …… (7) / وبأن بينه وبين السيد ……. عقد مزارعة بالمشاركة …… على…… (8) .
ب- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته بالعقود المبرمة مع العمال والمزارعين المذكورين والتزم الفريق الثاني بها.
أو
المادة 5-
أقر الفريق الأول بأنه يقوم بزراعة وحراثة المبيع بنفسه وليس لديه عمال زراعيون كما أنه غير مؤجر أو مشارك أحدا كمزارع بالبدل أو بالمشاركة
المادة 6-
أ- قوم الفريقان المزروعات القائمة على الشكل التالي (9) :
ب- قوم الفريقان قيمة ( الكاشه ) السماد الطبيعي بمبلغ …… ليرة سورية.
ج- قوم الفريقان قيمة البهائم الموجودة بالمبيع والمكونة من (10) …… و …… بمبلغ …… ليرة سورية.
د- قوم الفريقان قيمة الحبوب والأشياء الموجودة بالمستودع والمكونة من (11) …… و …… بمبلغ …… ليرة سورية.
ه- التزم الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول قيمة المزروعات القائمة والسماد المذكورة والبالغة …… ليرة سورية بتاريخ الاستلام (12).
المادة 7-
أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع (12) يوم قبض الدفعة الثانية من الثمن و إذا هلكت أو استهلكت او خربت بفعله أو بفعل العاملين فيها فتقع عليه تبعة ذلك كله ويكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني قيمة ذلك من الثمن بسبب ذلك.
ب- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.
المادة 8-
تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والحراجية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الثاني من تاريخه ويتحمل الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد و على التفرغ و على البيوع السابقة بالغا ما بلغ ذلك كله خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ)
المادة 9-
يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد
بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة ۱۰ –
اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة 11-
نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
… في | |
الفريق الأول الفريق الثاني
———————————————————————————————-
(۱) وإذا كانت مشجرة فيذكر أنواع أشجارها وعدد الأشجار من كل نوع وإذا كانت کروما معلقة على أعمدة إسمنتية فتذكر أعدادها
(۲) يذكر مقدار المياه وساعات الاستقاء
(۳) تذکر حقوق الارتفاق الأخرى كحق المسيل ونضح المياه وتصريف المياه الطبيعية العالية وما إلى ذلك.
(4) تذكر المزروعات القائمة عند البيع.
(5) تذكر إذا وجدت عقود عمالية أو مزارعة أو مشاركة مع الفلاحين وإلا فتحذف.
(6) تذكر شروط الأجرة وكيفية دفعها .
(7) تذكر الأجرة النقدية و الحصة العينية و المساحة المتفق على زراعتها وحدودها من النواحي الأربع وكذلك يوصف المسكن المسلم للمزارع.
(8) تذكر نسبة الحاصلات المنوية المتفق عليها والمساحة المتفق على زراعتها وحدودها من النواحي الأربع وكذلك يوصف المسكن المسلم للشريك.
(9) تقوم المزروعات القائمة بحسب عمرها ونوعها من الحاصلات يوم التسليم .
(10) تذكر أنواع البهائم وقيمها الإفرادية والإجمالية .
(11) تذكر أنواع المواد وقيمها الإجمالية و أوزانها التقريبية .
(12) إذا وجد في الأرض تراكتور أو بلدوزر أو حصادة أو بارودة للحراسة فتقوم كل آلة بمفردها وتذكر بيانات أوراق رخصة سيرها وملكيتها إذا دخلت بالمبيع وتقوم ويلتزم الفريق المالك بنقل ملكيتها في دوائر النقل والداخلية والدوائر الزراعية الاسم الفريق الثاني بمدة معينة تحدد بمتن العقد.
(13) إذا كان العقار خاليا من عمال زراعیبن فتضاف عبارة ” خالية من أي شاغل” .