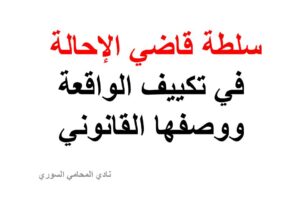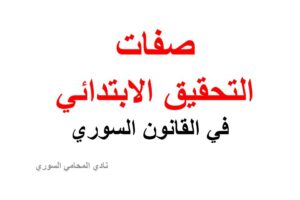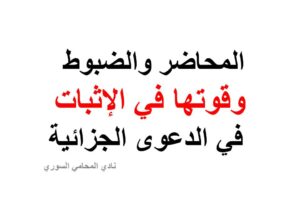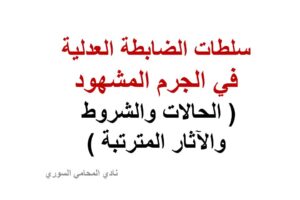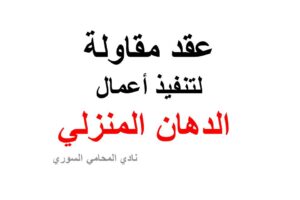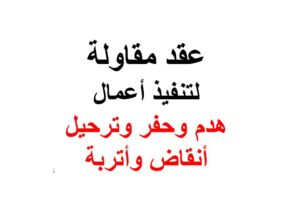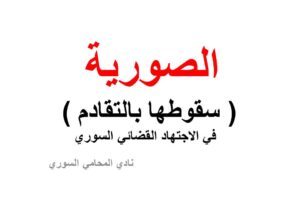أولا : حق التصدي
تعني كلمة (تصدي) أن يضع قاضي الإحالة يده على الدعوى بعد جلبها إليه ليبحث في أساس النقاط التي عرضت عليه عوضا عن إعادتها إلى المرجع الأدني بعد اكتشافه ذهوة أو خطأ فيها.
فالأصل هو أن يتقيد قاضي الإحالة بالوقائع التي طرحت عليه، سواء عن طريق الاستئناف، أو عن طريق رفع ملف الدعوى إليه لإصدار قرار الاتهام بالجناية، أي إنه يملك حق الفصل في مصير المدعى عليهم المحالين إليه، أما الذين لم يحالوا إليه بسبب منع محاكمتهم، أو إحالتهم إلى محكمة أول درجة بجرائم غیر متلازمة مع الجناية، فلا سلطان القاضي الإحالة عليهم. وهذه القاعدة لا خلاف عليها من حيث المبدأ .
ولكن، قد يكتشف قاضي الإحالة أثناء دراسة موضوع الدعوى، أن هناك وقائع جرمية، جنايات كانت أو جنحة، لم تكن موضع قرار قاضي التحقيق، أو أن هناك أشخاص لم يكونوا موضع ادعاء النيابة العامة، فما هو دور قاضي الإحالة في هذه الحالة؟
لقد أعطى المشرع قاضي الإحالة من خلال المادتين 146 و 156 صلاحيات كبيرة للتصدي المثل هذه الأمور .
وقد نصت المادة (146) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:
يتعين على قاضي الإحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه، ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق”.
يتبين من هذه الفقرة أن قاضي الإحالة قد يتكشف له أثناء قيامه بالتحقيق مع الأشخاص الذين أحيلوا إليه بمقتضى قرار قاضي التحقيق، وجود جريمة أغفل قاضي التحقيق إسنادها إلى هؤلاء الأشخاص أنفسهم، فعندئ يصبح من واجب قاضي الإحالة أن يتصدى لهذه الوقائع الجديدة شرط أن يتوافر فيها شرطان:
1 – إعلام النيابة العامة بهذه الوقائع الجديدة، كي تطلب التحقيق فيها.
2- أن يكون ادعاء النيابة العامة مقتصرة على الأظناء المحالين إليه، فلا يسمح له وفقا لهذه المادة إدخال متهمين جدد .
أما المادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نصت على أنه:
“في مطلق القضايا إذا لم يكن قاضي الإحالة قد أصدر قراره باتهام الظنين، أو بمنع محاكمته، فله أن يأمر من تلقاء نفسه إجراء التعقبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيقات سواء كان قد شرع فيها قب؟ أو لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضی”.
أي إنه إذا تبين لقاضي الإحالة أن النيابة العامة قد غفلت عن ملاحقة واقعة معينة أو شريك في الجريمة المدعى بها، أو أن الظنين ارتكب جرمأ لم يبحث فيه قاضي التحقيق، أو أن في القضية مجرماً أخر لم يتناوله التحقيق، فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما .
فالهدف من هذه المادة هو إكمال النقص الذي أغفلته النيابة العامة أو سها عنه قاضي التحقيق. ولكن حتى يمكن تطبيق هذه المادة، لابد من توافر عدة شروط:
1- أن تكون الدعوى قد دخلت في حوزة قاضي الإحالة بصورة قانونية، إما بطريق الاستئناف أو بطلب الاتهام بجناية.
2- أن يكون قد اكتشف الوقائع الجديدة أو الأشخاص الجدد أثناء قيامه بتحقيقاته.
3- ألا يكون قد أصدر قراره النهائي الذي اختتم فيه التحقيق، سواء بالاتهام أو بمنع المحاكمة، لأنها في هذه الحالة تكون الدعوى قد خرجت من ولايته أو حوزته.
4- أن يعلم النيابة العامة بهذه الوقائع التي اكتشفها.
فإذا توافرت هذه الشروط وقدمت النيابة العامة ادعاءها، فعندئذ لقاضي الإحالة أن يباشر التحقيق ويطلب المحاضر والوثائق وكل ما يتعلق بالوقائع الجرمية وبالأشخاص الذين تم اكتشافهم والادعاء عليهم من قبل النيابة العامة.
فالمادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت الحق القاضي الإحالة في أن يبحث كل الوقائع الجرمية المستفادة من التحقيق، ويتناول جميع الفاعلين والشركاء.
إلا أن هذا الحق يبقى مقيداً بما تقضي به المادة (146) أصول جزائية، من أنه يتعين على قاضي الإحالة أن يبحث هذه الموضوعات بطلب من النيابة العامة، بعد أن يطلعها على ما تم اكتشافه.
وطلب النيابة العامة هو في حقيقته ادعاء لاحق. فإذا طلبت الظن على شخص ما بجنحة، أو اتهامه بجناية، فإن طلبها يعني أنها تقيم الدعوى العامة على من طلبت اتهامه أو الظن فيه.
في جميع الأحوال، يمكن القول إن حق التصدي قد شرع حتى لا تبقى جريمة دون ملاحقة ولا عقاب، فقاضي الإحالة يملك بمقتضى هذا الحق أن يأمر بإقامة الدعوى العامة على أشخاص لم يسبق أن وردت أسماؤهم في الادعاء الأولي، ولم يجر التحقيق معهم، ومن أجل أفعال لم يدع بها في الأصل ولم يجر فيها أي تحقيق.
ومع ذلك نحن نعتقد أنه لابد للمشرع من أن يوحد المادتين 146 و 156 لأن المادة 146 تؤدي إلى الغرض نفسه المراد من المادة 156. أي إن المادة 156 تتضمن المادة 146 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني
إن تكييف الواقعة الجرمية، يعني ردها إلى نص قانوني ينطبق عليها، لبيان ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، أي تحديد الطبيعة القانونية للفعل والمادة التي تنطبق عليه حسب نص القانون.
والتكييف القانوني مبدأ أساسي وجوهري، فعندما تعطي النيابة العامة أو قاضي التحقيق وصفاً للفعل، فإن هذا الوصف لا يقيد قاضي الإحالة.
وحق قاضي الإحالة في تكييف الواقعة الجرمية هو حق ممنوح له بحكم القانون، وقد جاء مطلقا من كل قيد أو شرط.
فهو يملك مثلاً عدّ الفعل جريمة سرقة بعد أن كان يعه إساءة ائتمان، أو ع الفعل جناية بعد أن كان يعده جنحة.
ولا حاجة إلى إقامة الدعوى بكل وصف جديد يظهر للأفعال التي هي موضوع الدعوى ما دامت هي نفسها لم تتبدل طبيعتها ومقوماتها.
كما لقاضي الإحالة بحث جميع ظروف الواقعة، فله إضافة الظروف المشددة واعطاء الجريمة الوصف الأشد، كأن يقرر تعديل الوصف من القصد إلى العمد .
كما له أيضا البحث في توافر أسباب الإباحة وموانع العقاب (كالجنون والإكراه المادي والمعنوي والضرورة) والأعذار المحلة والأعذار المخففة القانونية وأسباب انقضاء الدعوى، وكل ما يمتنع عليه هو البحث في الأسباب المخففة التقديرية فهي وحدها من حق المحكمة الفاصلة في أساس الدعوى، لأن الأسباب المخففة القانونية من حق القانون.