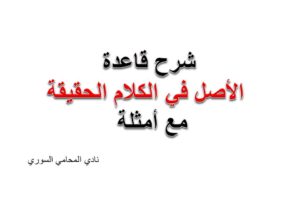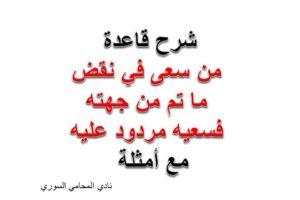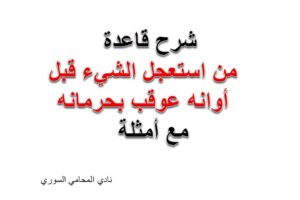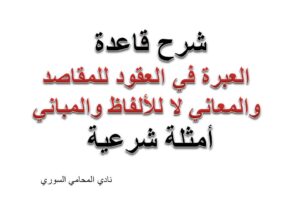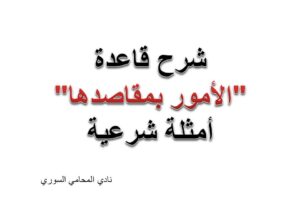الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز فرع فيه وخلف عنها، فكان العمل بها أولى من العمل به، وإن تعذرت الحقيقة لعدم وجود فرد لها في الخارج يصار إلى المجاز.
فالحقيقة هي المعنى الذي وضع اللفظ له أصلاً ويدل عليه لا بلا قرينة ويقابلها المجاز وهو المعنى المفهوم من اللفظ بواسطة قرائن تحيط به على وجه لم يكن ليفهم منه هذا المعنى ،بدونها، وهو معنى تربطه بالمعنى الحقيقي علاقة ، وذلك مثل لفظ النكاح فإنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد لعلاقة استحلال الرجل للمرأة.
إذا أوقف شخص ماله قائلاً : إني أوقفت مالي على أولادي وكان له أولاد وأولاد أولاد، فيصرف قوله على أولاده لصلبه ولا يستفيد أولاد أولاده من الوقف.
فلو انقرض أولاده لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء إلا إذا كان لا يوجد للواقف أولاد حين الوقف، وكان له أحفاد فبطريق المجاز يعد المال موقوفاً على أحفاده.
أما إذا ولد للواقف مولود بعد إنشاء الوقف في الصورة الثانية فيرجع الوقف إلى ولده لصلبه لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة، ولفظ الولد حقيقة في الولد الصبي ذكراً أو أنثى، فعند عدم وجود أولاد للواقف لصلبه يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة (أولاد) مجازاً لأنه لا يمكن استعمال معنى المجاز والحقيقة في لفظ واحد وفي وقت واحد معاً.
ذلك لأن الحقيقة إذا كانت مرادة فلا بد أن يتنحى المجاز أمامها عند الحنفية، أما عند المالكية والشافعية فقد أجازوا الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان ذلك ممكناً.
أما إذا كان المعنى الحقيقي فرداً من أفراد المعنى المجازي فيقدم المجاز على الحقيقة عملاً بعموم المجاز، كما لو حلف بطلاق امرأته على ألا يأكل من هذه الغنم المقتناة للدَّرِّ والنسل، فالمعنى الحقيقي هو الأكل من عينها والمجازي هو الأكل مما يخرج منها، فعند أبي حنيفة يقع الطلاق بالأكل من عينها وعند الصاحبين يقع الطلاق بأكل ما يخرج منها عملاً بعموم المجاز.
و عموم المجاز هو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى كلّي شامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلو قال الواقف وقفت مالي هذا على أولادي نسلاً بعد نسل، فقرينة ( نسلاً بعد نسل )تدل على شمول لفظ الأولاد ولكل ولد سواء أكان ولداً حقيقة أم ولداً مجازاً من أولاد أبنائه وأبنائهم.
ولو أوصى شخص لآخر بثمر بستانه فتحمل وصيته على الثمر الموجود أثناء وفاة الموصي ولا تحمل على الثمر الذي سيحصل في السنين المقبلة؛ لأن الثمر يحمل حقيقة على الثمر الموجود ولا يحمل على الثمر المستقبل إلا بطريق المجاز، وبما أنه من الممكن حمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي فلا يحمل على البدل وهو المجاز. أما ذكر الموصي كلمة (أبداً أو دائماً) حينما ذكر الثمر فيكون من عموم المجاز، فتحمل وصيته على الثمر الحاصل أثناء وفاة الموصي والثمر الذي سيحصل في المستقبل .
لو حلف بطلاق زوجته ألا يتزوج، فوگل آخر فزوجه، حنث ووقع الطلاق، لأن الوكيل بالزواج سفير ومعبر عن الموكل وناقل لعبارته، ولأن حقوق هذه التصرفات لا تتعلق بالوكيل بل بالموكل فاعتُبر الموكل فاعلاً لها فيحنث.
أما لو حلف بطلاق زوجته ألا يشتري كذا فوكل غيره ففعل عنه، لا يحنث، لأن هذه التصرفات يستغني المأمور فيها عن إضافتها إلى أمره ويضيفها إلى نفسه، فلا يعتبر الموكل فاعلاً لها فلا يحنث.
ففي الحالة الأولى يرجح المجاز لأن إرادة الموكل تشمل فعل الوكيل وفي الثانية ترجح الحقيقة لأن الفاعل حقيقة هو الوكيل . .
تنبيه : إن الأفعال بالنسبة لقبول التوكيل وعدمه على ثلاثة أنواع :
1 – أفعال لا تقبل التوكيل أصلاً، وهي الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والنوم… فلو حلف على عدم فعل شيء منها فأمَرَ غيرَهُ ففعل لا يحنث لعدم صحة أمره بها .
٢ – أفعال تقبل التوكيل ولا يجب على الوكيل إضافتها إلى الموكل، بل تقع عنه وتنفذ عليه وإن لم يضفها الوكيل إلى موكله وهي سبعة أفعال من التصرفات : البيع والشراء، والإيجار، والاستئجار، والقسمة، والخصومة، والصلح عن مال بمال، لأن هذه التصرفات يستغني المأمور فيها عن إضافتها إلى آمره ويضيفها إلى نفسه فيقول : بعت، اشتريت . . .
٣ ـ أفعال تقبل التوكيل ويجب على الوكيل ـ لأجل وقوعها عن الموكل ـ أن يضيفها إليه ,كالنكاح والطلاق والإبراء والصلح عن دم العمد والصدقة وغيرها، لأن الوكيل في هذه التصرفات سفير ومعبر، وحقوق هذه التصرفات تتعلق بالموكل فقط ولذلك يصح لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد في هذه الأمور عند الحنفية . تنبيه آخر : اللفظ عند اللغويين ثلاثة أقسام: حقيقة ومجاز وكناية، وعند الأصوليين قسمان: حقيقة ومجاز، وكل منهما على ثلاثة أقسام :
١ – حقيقة لغوية كلفظ حصان في الدلالة على الحيوان المعروف ،
٢ ـ حقيقة شرعية : كلفظ صلاة للدلالة على الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ،
٣ – حقيقة عُرفية : كلفظ دابة للدلالة على الحيوانات التي تمشي على أربع .
٤ – مجاز لغوي : وهو مرادف للحقيقة العرفية ،
٥ ـ مجاز شرعي : كلفظ النكاح في الدلالة على العقد لا الوطء،
٦ ـ مجاز عقلي: ويسمى المجاز الحكمي، وهو إسناد غير حقيقي ويكون في التركيب دون اللفظ، وإدراك المراد يكون بالعقل لا بالقرائن المانعة.