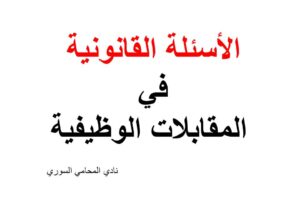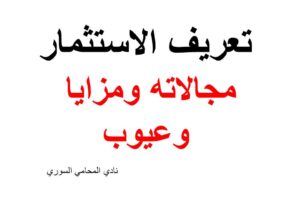من خلال استعراضنا لعقد تقديم الاستشارة يتضح لنا أن الفقه القانوني قد استقر على أن لهذا العقد طرفين الأول هو المستشار والثاني هو المستفيد .
ولذلك فأننا نبحث في هذا المطلب اطراف عقد تقديم الاستشارة في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول: المستشار القانوني
الفرع الثاني: المستفيد
الفرع الأول
المستشار القانوني
تطلق تسمية المستشار بشكل عام على الشخص الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو قانوني أو نحوه ، وبشكل خاص في موضوع دراستنا المستشار القانوني كطرف من أطراف عقد الاستشارة القانونية وهو المهني المتخصص في مجال القانون الذي يقوم بتقديم أداء للمستفيد هذا الأداء هو الاستشارة القانونية التي يعدها بناء على دراسة وتحليل الوضع المستفيد ، وفي ضوء حاجات الأخير ، وكذلك الأصول الفنية المرعية يقدم المستشار القانوني دراسته التي تعد بمثابة رأي يهدي المستفيد إلى اتخاذ قرار معین .
كما يعرف المستشار القانوني بأنه كل مهني متخصص في مجال القانون سواء أكان شخصأ طبيعية ، معنوي يحترف مهنة معينة ، يقوم بتقديمها لعميل ليهديه إلى اتخاذ قرار معین .
فالمستشار شخص يمتلك قدرة من المعرفة الفنية يفوق حتمأ ما يمتلكه المستفيد ، فالفرض في المستشار القانوني انه فني متخصص في فرع من فروع الأنشطة الإنسانية ، ويجب أن نلاحظ أن درجة التخصص لدى المستشار القانوني من الدقة بمكان بحيث تعد الفارق الذي يعيننا على التمييز بين المستشار القانوني والمستفيد ، فالمستشار يقدم خبراته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة قانونية للمستفيد و هي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية ، فالمستشار القانوني لا يكون مجرد عامل على أله أو كونه يطبق نظريات فنية معينة وإنما هو نتاج عقل بشري وخبرة أنسان ، فهو مهني متخصص يتمتع بمهارات فنية خاصة ويمتلك معارف متميزة يقدمها للمستفيد على وجه الاستقلال .
ويثار بهذا الصدد مسألة ألا وهي أذا ما ابدى الحرفي نصيحة أو استشارة لشخص ما، فهل يعد هذا الحرفي مبرمة لعقد تقديم الاستشارة ويلحق به وصف المستشار ؟
والمتمعن في مفهوم الحرفة يرى أنها تتمثل في تكريس نشاط الفرد العمل معين واتخاذه مهنة له ، أي أنه كل عمل يمارسه الفرد بصورة يدوية أو ميكانيكية ، أما مهنة المستشار فأنها تعتمد بالدرجة الأساس على التفكير والتحليل وتستند إلى معلومات مسبقة أو مستنبطة ،
فمتى ما استنبط الحرفي وحلل وابدي رأيه في أمر معروض عليه عد ذلك ممارسة المهنة تقديم الاستشارة.
ويذهب اتجاه أخر إلى عدم إضفاء صفة الاستشاري على الحرفي ذلك لأن فكرة الاحتراف خاصة بالشخص الطبيعي ولا تمتد إلى الشخص المعنوي في حين أن مهنة تقديم الاستشارة قد يقوم به شخص طبيعي أو معنوي.
ألا أن هذا الكلام ينطبق فيما اذا كنا بصدد عقد مشورة في غير مجال القانون ذلك لأن القانون حصر إعطاء الاستشارة القانونية في طائفة المحامين وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات الحقوق والقانون .
ولكل ما تقدم يمكن تعريف المستشار القانوني بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي مختص في مجال القانون يمتلك بحكم تفوقه ومعرفته ما يؤهله لتقديم مشورة قانونية للمستفيد تكون هادية ومرشده له في اتخاذ قرار من عدمه.
من هذا التعريف يتبين لنا إن المستشار القانوني قد يكون شخصأ طبيعة وقد يكون شخصاً معنوياً وعلى ذلك فأننا نبحث في صور المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعة وباعتباره شخصاً معنوياً وحسب الاتي:
أولاً : المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعية:
سبق وأن عرفنا المستشار بصورة عامة ، بأنه شخص مهني متخصص يقدم أداء ذهنية وعقلية يتمثل في رأي قانوني يقود المستفيد لأتخاذ قرار معين إزاء مشكلة معينة ، وهو بهذا يتمييز عن مقدمي الخدمات الأخرى ، كالمساعد الفني ، والمدير ، والخبير، وهذا يقودنا إلى التمييز بين المستشار وبين مقدمي هذه الخدمات.
ويتميز المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية عن المساعد الفني الذي يقوم بنقل المعارف للأفراد في مجال فني ، فيقدم خدمات يغلب عليها الطابع المادي وأن كانت البعض منها ذات طابع ذهني ،
في حين إن ما يميز أداء المستشار القانوني انه يغلب عليه الطابع الذهني والعقلي وأنه يتدخل بشكل مباشر عن طريق الاستشارة القانونية التي من شأنها لو طبقت أن توجه المستفيد نحو قرار معين كما بينا ذلك سابقا.
فالمستشار القانوني يلتزم بتقديم أداء ذهني ، ولا يصبح كمساعد فني يقوم بتنفيذ الاستشارة المعطاة ، ومع ذلك فأن المستشار القانوني عليه أن يقدم العون والمساعدة للمستفيد ، حتى يستطيع الأخير تنفيذ الاستشارة القانونية المقدمة من قبل المستشار القانوني ، وهذه المساعدة تكون في الفترة التي يبدأ فيها المستفيد تنفيذ الاستشارة ووضعها موضع التنفيذ ، وهذه المساعدة تعتبر تطبيق الواجب التعاون المفروض على المستشار القانوني في علاقته بالمستفيد ، لذلك يلزم أن يكون المستشار القانوني مؤهلا متمرنأ ، ذا تخصص متميز يتيح له تقديم مشورة منتجة بناء على ما يملكه من معلومات وخبرات تؤهله لأعداد وتقديم مشورة قانونية تعكس تفوقه في هذا المجال .
ونؤيد الرأي في أن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن المدير الذي يتولى أدارة مشروع معين أو ينظم شيئا معيناً ، في كون الأخير يتولى إدارة مشروع معين أو تنظيم بعض نواحيه في حين أن المستشار لا يدير الأعمال ، وإنما يكون دوره توجيه المستفيد بأبداء مشورة تبين له ما يجب فعله إزاء مشكلة معينة دون أن يكون له حق إدارة هذه المشكلة فهو يمد المستفيد بأداء ذا طبيعة ذهنية وعقلية محضة وبالتالي لا يعد مسؤولاً عن المشروع ككل .
ومع هذا القول هناك من يرى أن تمييز المستشار عن المدير ليس مطلقة ، وذلك أنه لا توجد خطوط فاصلة بين المستشار والمدير ، إذ أن كل من أداء المستشار والمدير هي اداءات ذات طبيعة ذهنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن المستشار يتدخل في إدارة المشروع بشكل أو بأخر ففي مجال المشروعات يلجأ المستفيد طالبة الرأي والاستشارة لأجل تنظيم أو إعادة تنظيم مشروعه ، وهذه الاستشارة تؤثر بطريقة أو بأخرى في فاعلية المشروع،
لأنها توجه المشروع نحو اتجاه معين ، وينتهي هذا الرأي إلى القول بأنه لا توجد حدود فاصلة بين المستشار والمدير وحتى لو فرض بوجود فواصل فهي موجودة من الناحية النظرية فقط .
ومما تجدر الإشارة اليه إن مفهوم المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن الخبير ذلك إن الأخير يقوم بأبداء الرأي العلمي أو الفني في واقعة أو وقائع مادية إذ تنص المادة / ۱۳۲ من قانون الأثبات العراقي على أن
(( تتناول الخبرة الأمور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوة دون المسائل القانونية )) ، وهي بالتالي أي الخبرة لا تتوفر لدى الشخص الاعتيادي وانما تتوفر لدى من لديه الدراية العلمية والفنية ، والخبرة تعد من التصرفات التقريرية فهي تقرر أمرأ واقعية ، وتصفه من الزاوية الفنية ولا تضف اليه أو تنقص منه شيء أو تعدله.
في حين إن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يقرر أنشاء امر لم يكن قائمة ، وذلك بتقديم رأي قانوني يوضح للمستفيد ما يجب أن يكون عليه هذا الأمر في ذاته ، أي أنه عمل إنشائي ، بينما الخبير يصف ما عليه الأمر الواقع من الناحية الفنية.
ويبرز الاختلاف بينهما أيضأ في إن الرأي الاستشاري القانوني يقوم به أشخاص وجهات أوكل القانون أليها ذلك ، أما الخبرة فيقوم بها خبراء ذوي دراية علمية واسعة في المسائل المعروضة عليهم لوصفها وصفة فنية بحتأ ، ومن دون تقديم أراء شخصية فيها ، إلا أنه يرد على هذا الاختلاف أن القانون حدد الخبراء الذين يحق لهم تقديم الخبرة وذلك بتحديد شروط التسجيل في جدول الخبراء .
وعلى الرغم من مما ذكر سابقاً بشأن التفرقة بينهما ، فأن الحدود الفاصلة بين المستشار القانوني والخبير ليست كبيرة ، فالمستشار القانوني حينما يقدم دراسته ويقوم بتحليل وضع المستقيد أنما يعتمد بدرجة كبيرة على الحالات السابقة التي مرت عليه والمطبقة على أوضاع المستفيد و التي تعكس أثار خبرته على الاستشارة القانونية ، فالمستشار القانوني حينما يقدم الحلول للمستفيد بعد تحليله للوقائع يعتمد على خبرته المكونة من الحالات المعروضة عليه سابقا فتنعكس بدورها على الاستشارة القانونية التي يقدمها للمستفيد .
ثانياً: المستشار باعتباره شخصاً معنوياً:
الصورة الثانية للمستشار القانوني هي صورته المعنوية المتمثلة بالمكاتب الاستشارية ، والتي تكون في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى : وفيها يضم المكتب الاستشاري أكثر من مستشار في تخصص واحد ، فمثلا مكتباً للاستشارات القانونية يضم أكثر من مستشار قانوني مختص بشؤون الشركات مثلاً ، ويكون الهدف من تجمع واشتراك أكثر من مستشار للعمل من خلال مكتب واحد ، هو حسن تقديم الاستشارة ففرصة تحقيق النتيجة المرجوة من الاستشارة المقدمة من اكثر من مستشار والتي تتمثل بخلاصة آراء المستشارين مجتمعين أكبر من فرصة نجاح الاستشارة المقدمة من استشاري بمفرده.
الحالة الثانية : وهي صورة المكتب الاستشاري الذي يضم أكثر من استشاري في أكثر من تخصص ، بمعنى أن يكون هنالك مكتب للاستشارات يضم مستشار قانوني مختص بالعقود ومستشار مختص بالشركات ، ومهندس استشاري ، واستشاري مالي وغيرهم .
فاذا ما طلب المستفيد مشورة بشأن وضع مشروع ما فيقوم المكتب الاستشاري بدراسة وضع المشروع وشكله القانوني ومدى مطابقته للاشتراطات المقرر قانونأ ، وكذلك ملكية المشروع وكل ما يتصل بالنواحي القانونية ويأتي الاستشاري الهندسي فيقيم أصول المشروع ومدى سلامة أدوات الإنتاج به ، ويأتي الاستشاري المالي ليدرس السوق ومدا استيعابه لمنتج المشروع وقدرته التنافسية بين المشروعات القائمة. وفي النهاية تصدر الدراسة متضمنه خلاصة آراء الاستشاريين مجتمعين ومتضمنه الرأي الذي يراه المكتب .
هذا وقد يكون تأسيس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص وكالأتي :
١ – المكتب الاستشاري العام .
يمكن أن يؤسس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام ، إذ نظم بقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة ۱۹۹۷ إذ تنص المادة / ۱/ اولا /۱ منه على
(( اولاُ: ۱- لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على دراسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة أو متعدد الاختصاصات عند توفر الإمكانات ))
من خلال هذا النص يتبين لنا انه لكل جمعية أو كلية أو هيئة التعليم التقني والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكاتب خدمات استشارية متخصصة أو متعددة الاختصاصات عند توفر الإمكانات.
ويتمتع المكتب الاستشاري العام بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أهدافه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى وهذا ما نصت عليه المادة / ۱ / ثانية من القانون أعلاه حيث نصت
(( يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أغراضه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى )).
وتتمثل أهداف المكتب الاستشاري العام ، بتقديم الاستشارة والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتقدم هذه الخدمات القاء أجور مناسبة ، حيث نصت المادة / ۲/ أولا من قانون المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على
(( اولاً: تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني وأي نشاط يقدر الوزير بأنه مفيد للقطاع الخاص لقاء أجور مناسبة )).
ويتكون المكتب الاستشاري العام من أشخاص يتولون الأشراف عليه يتمتعون بالخبرة العلمية والفنية بحسب حقل الاختصاص ، حيث نصت المادة / ۳/ اولا على
(( أولاً: يتولى الأشراف على المكتب مجلس يتألف من:
1- العميد أو احد رؤساء الأقسام العلمية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد بالنسبة للجامعة أو الكلية أو المركز ، ومدرس بالنسبة اللمعهد ، يرشحه مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو مجلس المركز ، على أن يقترن ذلك بمصادقة الوزير
۲- أربعة من التدريسين في الأقل يختارهم مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو المركز يمثل كل منهم حقل اختصاصه ، وبأعلى المراتب العلمية المتوفرة على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة ورئيس المعاهد أو رئيس المركز
ثانياً: يختار المجلس مديرة من بين أعضائه على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية أو رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه
ثالثاً: مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ أول اجتماع له قابلية التجديد لمرة واحدة ))
۲ – المكتب الاستشاري الخاص
للشخص الطبيعي أن يؤسس مكتبة استشارية قانونية على أن يكون حاصلا على إجازة تأسيس المكتب الاستشاري من نقابة المحامين . وينضم المكاتب الاستشارية غير الحكومية في العراق القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ حيث تنص المادة / ۲ من هذا القانون على
(( اولا : لا يجوز فتح مكتب استشاري إلا وفق أحكام هذا القانون. ثانيا : تتولى النقابة المختصة منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري لأعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة أو عدم انتماء صاحب الطلب إلى نقابة مختصة )).
كما أشترط القانون في الشخص الطبيعي الذي يبغي تأسيس مكتب استشاري قانوني ، أن يكون شخص طبيعي أو أكثر ، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في مجال القانون ، وأن تكون له ممارسة فعليه في النشاط الذي يمارسه لمدة معينة تحددها القوانين المعنية تلي الشهادة الجامعية ، وكذلك أن يكون له محل مناسب ، وغيرها من الشروط التي تشترطها القوانين المنظمة لعمل هذه المكاتب .
وقد تتخذ هذه المكاتب الاستشارية شكل الشركة المدنية المهنية ، ولا يوجد في العراق تنظيم للشركة المدنية المهنية ، وإنما تنظم عمل هذه الشركات القواعد العامة في قانون الشركات عموما .
أما في مصر فان الحال لم يختلف كثيراً عن العراق ، فلم يوضع تنظيم خاص بالشركات المهنية من قبل المشرع المصري ، غير القواعد العامة في الشركة عموما التي ينظمها المشرع المصري في القانون المدني من المادة / 505 إلى المادة 537 ، وكذلك المادة 4 وه من قانون المحاماة المصري حيث نصت المادة /4 من القانون الأخير على أنه
(( يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة ))
وتنص المادة / ه من نفس القانون على أن
(( للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية )).
فشركة المحاماة المدنية لا تعدو في كونها صورة للشركات المدنية بصفة عامة ، ونموذج للشركة المدنية المهنية وهي عبارة عن شخص معنوي ، ينشأ بأتفاق بين عدد من المحامين بغرض ممارسة المحاماة ممارسة جماعية بصورة مشتركة واقتسام ما يتحصل عن ذلك من أرباح ، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدة من أسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته ، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على انه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته استمرار الشركة بين الشركاء الأخرين .
أما الوضع في فرنسا فأنه يختلف عما هو عليه الحال في العراق ومصر . فقد نظم المشرع الفرنسي عمل الشركة المدنية المهنية بالقانون رقم (۲۹) نوفمبر ۱۹۹۹ الخاص بالشركات المدنية والمهنية، والقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ الخاص بالشركات الممارسة للمهن الحرة الذي اصبح ساري المفعول من الأول من يناير عام ۱۹۹۲.
ويمكن حصر الشركات المدنية المهنية في فرنسا في ثلاث جهات : الأولى: المهن الطبية : وتضم الأطباء ، جراحي الأسنان ، البيطريين ، الممرضين ، أطباء العلاج الطبيعي ، أطباء العظام والأطباء النفسيين الثانية: المهن القانونية والقضائية : وتضم المحامين ، الاستشاريين القانونين ، الموثقين ، وكلاء الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ، مأمور التفليسة ، المدير القضائي والخبراء المثمنين. الثالثة: المهن الفنية : وتضم المهندسين ، الخبير المحاسبي ، مراقب الحسابات ، وكيل التأمين ، استشاري براءات الاختراع والملكية الصناعية ، استشاري الاعلان ، استشاري التوظيف والتعيين.
وهذه الطوائف الثلاثة للمهن الحرة المتصور ممارستها من خلال الشركة المدنية منظمة بالقانون ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۹ بالإضافة إلى القانون ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۰ الذي أحدث بعض التغيرات على الوضع القانوني للشركات المهنية في فرنسا.
بعد استعراض مفهوم المستشار القانوني في القوانين المقارنة يمكننا أن نعرف المستشار القانوني بوصفه شخصأ معنوية بأنه كيان مهني متخصص في مجال القانون يتمتع بالشخصية المعنوية يؤسسه شخص طبيعي أو معنوي لتقديم الاستشارة القانونية والخبرة العلمية والفنية والتدريبة باختصاص القانون إلى المستفيد لقاء أجر معين.
الفرع الثاني
المستفيد
لما كان الهدف من أبرام عقد تقديم الاستشارة القانونية يتجلى بالحصول على المعلومات القانونية التي يرغب بالحصول عليها ، والتي من شأنها إرشاد طالبها إلى اتخاذ قرار معين ، وهذا ما يتطلع اليه الكثير من الأشخاص لتحقيقه ، فأن نهاية سلسلة المفاوضات التي تسبق مرحلة الاتفاق ، تتمثل بالعقد الذي يبرمه الشخص طالب الاستشارة القانونية والذي يسمى بالمستفيد مع المستشار القانوني.
فالمستفيد ليس بالضرورة أن يكون على علم ودراية بكل القواعد القانونية الناظمة في الدولة ، ذلك أن الأنسان اذا كان يحوز قدرة من المعرفة الفنية في فرع من فروع النشاط الإنساني ، فأنه لا شك سوف يصبح غير عالم بباقي الفروع ، ففي نهاية القرن العشرين ، وبعد أن أصبحت العلوم تقوم على أسرار خفية لا تتوفر ملكة فهمها إلا لطائفة معينة ، فأن الشخص غير العالم بهذه الأسرار الخفية سيصبح غير متخصص في هذا الفرع من فروع المعرفة إلا أنه قد يصبح متخصصاً في فرع أخر.
عليه يمكن تعريف المستفيد بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي ( العام أو الخاص) المتعاقد مع المستشار القانوني بغية الحصول على المعلومات والخدمات القانونية من الاخير اليهديه إلى اتخاذ قرار معين) ، فالمستفيد قد يكون شخصأ طبيعية عادية يهدف من حصوله على الاستشارة القانونية تلبية حاجاته الخاصة ، وقد يكون المستفيد ، شخص معنوي عام أو خاص کالمؤسسات العامة الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والأندية .
فالمستفيد هو الشخص غير المتخصص الذي لجأ إلى المستشار القانوني طالبة الرأي والاستشارة القانونية، والذي يعرف بأنه الشخص الذي لا يكون على علم ودراية بأصول القانون .
إلا أن هناك من عارض فكرة عدم اختصاص المستفيد ، أذ أن من يطلب تقديم الاستشارة القانونية قد يكون متخصصة في القانون الا انه حتى وأن كان متخصصة في القانون إلا أن التخصص لا يمنع من أن يجهل المستفيد الحل المناسب لمسالة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل .
وبدورنا نتفق مع هذا الرأي حيث أن تخصص المستفيد لا يمنع من أن يجهل الحل المناسب لمسألة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل.
هذا ويذهب جانب من الفقه إلى استعمال ألفاظ يراها مرادفة للفظ المستفيد ومن هذه الألفاظ المستخدم النهائي – العميل – المستفيد ، فالمستخدم النهائي ينصرف مفهومه إلى الباحث عن المعلومة ، أما العميل فقد يكون مجرد معاون لهذا الباحث يتوسط بينه وبين مصدر المعلومة.
أما المستفيد فأنه ينصرف إلى المعنيين معا ، فالمستفيد قد يكون هو الباحث عن المعلومة القانونية ، وقد يكون وسيطا يستفيد من الاستشارة القانونية ويقوم بدوره بنقلها إلى من يحتاجها بمقابل .
وتذهب مع من يرى ، بأن لفظة المستفيد هي اعم وأشمل من الألفاظ الأخرى ولذلك سنلتزمها في كل البحث ، وذلك لأن صفة المتعاقد مع المستفيد لا تنتفي حتى لو ادعی المستفيد أن الاستشارة القانونية لم تعد عليه بالنفع ، لان الاستفادة هنا تتمثل بالحصول على المعلومة القانونية سواء استخدمت هذه الاستشارة أو لم تستخدم من قبل المتعاقد مع المستشار”.