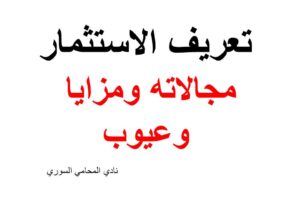قد يشتبه الالتزام بالمشورة القانونية بغيره من الالتزامات المتشابهة ، كالالتزام المشورة نفسها باعتبارها التزام تبعي أو واجب المشورة ، والالتزام بالأعلام و بالتحذير ،
والفقه في هذا الصدد منقسم بين اتجاهين يذهب الأول إلى عد هذه الالتزامات ، التزاماً واحداً ويعتبر هذا الألفاظ اي المشورة والأعلام والتحذير مترادفات لمعنى واحد فمن الصعب وضع حدود فاصلة بين هذه الالتزامات فهي مرتبطة برابط مشترك وهو حماية الدائن سواء كان ذلك عن طريق المشورة او التحذير او الأعلام ، في حين يذهب الاتجاه الأخر من الفقه إلى ذاتية واستقلالية كل التزام من هذه الالتزامات عن الأخر ،
لذلك يتعين علينا البحث في التفرقة بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية وغيرها من الالتزامات المشابهة ، وهذه التفرقة تكون بين الالتزامات السابقة والالتزام بالمشورة باعتباره التزام أصلي في عقد تقديم المشورة القانونية نتناول ما تقدم في ثلاثة فروع وحسب الاتي
: الفرع الأول : التمييز بين الالتزام بتقديم الاستشارة القانونية بطبيعتها وبين واجب المشورة .
الفرع الثاني : التمييز بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية والالتزام بالأعلام .
الفرع الثالث : التمييز بين الالتزام بتقديم الاستشارة القانونية والالتزام بالتحذير .
الفرع الأول التمييز بين الالتزام بتقديم الاستشارة القانونية بطبيعتها وبين واجب المشورة
تبين لنا عند تعريف عقد تقديم المشورة القانونية، إن المشورة القانونية هي المحل الأساسي لهذا العقد ، والتي تعرف بأنها الرأي القانوني الذي يدل على ما يجب فعله ، وهذا الرأي يرشد طالبه إلى ما يجب أن يفعله في المسألة القانونية التي يطلب الرأي فيها.
إن تعریف عقد تقديم المشورة القانونية ليس بالضرورة أن يكون ملازمة لتعريف الالتزام بتقديم المشورة ، ذلك لأن الالتزام بتقديم الاستشارة القانونية يجد مصدره في عقد تقديم الاستشارة القانونية ذاته كالتزام اصلي ، وقد يجد مصدره في أي عقد أخر ، وعندئذ يكون الالتزام بتقديم المشورة القانونية التزام تابع أو يطلق عليه واجب المشورة ،
ومثال ذلك عقد المحامي مع موكله فانه يرتب في ذمة المحامي إضافة للدفاع عن موكله التزام تبعي بالمشورة القانونية ، حيث إن المحامي ملزم بتقديم الاستشارة القانونية كالتزام تبعي للعقد الأصلي المتمثل بعقد الدفاع عن موكله.
وعلى ذلك فهناك فارق بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية باعتباره التزام أصلية ينشأ بموجب عقد تقديم المشورة القانونية وبين واجب المشورة ، ويبرز هذا الاختلاف من حيث مصدر هذين الالتزامين ومن حيث الأجر.
1- من حيث مصدر هذين الالتزامين :
فمن حيث مصدر هذين الالتزامين ، فأن الالتزام بالمشورة القانونية باعتباره التزاماً اصلياً في عقد تقديم المشورة يجد مصدره في هذا العقد ذاته ، بحيث لا يعد المدين منفذا لالتزامه إلا بأداء المشورة محل العقد ويطلق على هذا العقد ، بعقد المشورة بطبيعته ، وهو العقد الذي يبرم مع المستشار المهني الذي يمتهن مهنه معينه ويقدم مشورة تتصل بتخصصه ،
وأمثله هذا العقد كثيرة ولها تطبيقات متعددة سواء كانت في المجال القانوني أو المالي أو في مجال التشييد والبناء أو في المجال الطبي وغيره ،
أما الالتزام بتقديم الاستشارة بوصفه تابعأ أو واجب المشورة ، قد يجد مصدره في العقد بأتفاق الطرفين أو بحسب طبيعة العقد ،
وقد يجد مصدره في القوانين الخاصة المتعلقة بحماية المستهلك ، حيث إن المستهلك بحاجة ماسة إلى استعمال و استغلال التقنية الحديثة التي لا تتوفر ملكية استغلالها وفهمها إلا لطائفه معينه ، وهم الفنيون والمهنيون ، لذلك وجب على هؤلاء التزاماً بالمشورة والنصيحة لمن يتعاقد معهم ، يدلون بها على كيفية استعمال واستغلال هذه التقنية.
ومما تجدر الاشارة اليه أن نصوص القانون تقرر حماية للمستهلكين في مواجهة المهنيين عمومأ على أساس عدم التعادل في المراكز التعاقدية بين المستهلكين من ناحية والمهنيين من ناحية أخرى سواء كان هذا التعادل راجع إلى التفاوت الفني أو إلى المركز الاقتصادي ،
وعلى هذا فالالتزام بتقديم الاستشارة باعتباره التزاماً تابعاً موجوداً في كثير من العقود ، والذي يفرضه القضاء تحقيقا للعدالة ولإيجاد توازن في العلاقة التعاقدية ، بيد أنه يجب أن نلاحظ أن الالتزام بالمشورة باعتباره تابعأ يحده أحيانا الالتزام بضمان السلامة ، حيث عادة ما يلجأ القضاء لتقرير حماية المتعاقدين استنادا للالتزام بالمشورة باعتباره التزامأ تابعة كوسيلة بيد القضاء يحقق بها حمايه للمتعاقدين وبصفة خاصة في العلاقة بين المهنيين والمستهلك .
۲ – من حيث الأجر :
أما من حيث الأجر . فعنصر الأجر الذي يحصل عليه المستشار ، هو الذي يميز بين عقد تقديم الاستشارة بطبيعته ، والذي ينشأ ألتزاما اصلية بالمشورة ، وبين الالتزام بتقديم المشورة باعتباره التزام تبعية .
فالمستشار الذي يقدم المشورة لقاء أجر يحصل عليه من المستفيد ، يكون التزامه التزامأ أصلياً ورئيساً، أما في العقود التي يقدم فيها المستشار المشورة مجانا وبدون مقابل ، أو أن المستشار يكون قد حصل على الأجر مسبقاً لقاء قيامه بتنفيذ الالتزام الأصلي ، أو كونه مقابل المشورة منضمة ضمن الالتزام الأصلي ، ففي جميع هذه الفروض يكون الالتزام بتقديم المشورة التزاما تابعأ.
ومما تجدر الإشارة أليه أن الالتزام بالمشورة باعتباره التزاما اصلية في عقد الاستشارة قد يخلف التزاما تابعة بالمشورة كما هو الحال في مجال أنظمة المعلومات ، بينما واجب المشورة أو الالتزام المشورة بوصفه التزاما تابع غير مرتبط بوجود عقد تقديم المشورة.
وخلاصة القول فأن الفرق بين الالتزام بالمشورة بوصفه التزام أصلية وبين الالتزام بالمشورة بوصفه التزاما تبعية يكمن في النقاط الأتية :
١ – الالتزام بتقديم المشورة في عقد تقديم المشورة القانونية التزام أصلي وهو محل الأداء الرئيسي في العقد فلا يصح العقد من دون تقديم المشورة وذلك لتخلف ركن من أركان هذا العقد وهو ركن المحل المتمثل بالمشورة ، أما الالتزام بالمشورة التبعي أو واجب المشورة فأنه التزام تابع ، ومحل العقد الرئيسي أداء قانوني أخر غير تقديم المشورة.
۲ – إن أساس الالتزام بالمشورة باعتباره التزام تابع يجد مصدره في قوانين حماية المستهلك وذلك لإيجاد نوع من التوازن بين المتعاقدين ، بينما أساس الالتزام بالمشورة باعتباره التزامأ اصلية هو عقد تقديم المشورة القانونية.
3 – يعد الأجر من العناصر الرئيسية للتمييز بين الالتزامين ، فالأجر الذي يحصل عليه المستشار هو الذي يميز عقد تقديم المشورة بطبيعته عن مجرد الالتزام بالمشورة باعتباره التزام تبعي.
4 – ويمكن أن نميز بين الالتزام بالمشورة باعتباره التزام أصلية ، وبين الالتزام بالمشورة بأعتباره التزام تبعي وذلك بوصف الأخير واجب المشورة ، فواجب المشورة التزام تابع والالتزام بالمشورة مصدره عقد تقديم المشورة القانونية ، وهذا التمييز يمتاز بأنه يوضح الفروق في استخدام التعبيرات والألفاظ ،
ففي الحالتين لدينا التزام بتقديم المشورة ، الأول يكون أصلية والثاني يكون تبعية ولكي نمييز بينهما بما لا يحقق خلطأ في الألفاظ يكون ذلك بأن نوصف الالتزام بتقديم المشورة القانونية أو عقود تقديم المشورة بطبيعتها ، ونصف الالتزام عندما يكون تابع ، بأنه واجب المشورة .
الفرع الثاني التمييز بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية والالتزام بالأعلام
اذا كان الأعلام في الاصطلاح الصحفي محدداً ومضبوطأ كونه المحل الخصب له فأن الأمر ليس كذلك في الاصطلاح القانوني ، فهو مصطلح دخيل على القاموس القانوني ،
ومثلما يلقي كل ابتكار قانوني جديد جدة فقهية ، فأن الالتزام بالأعلام لم يسلم من هذا الجدل الفقهي ، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني ، الطبيعة القانونية ، النطاق القانوني ، لا بل حتى حول مسميات هذا الالتزام ولن نخوض في هذا الجدال الفقهي للأعلام وذلك لخروج الموضوع عن نطاق البحث ونكتفي بالإشارة إلى نقاط الالتقاء والافتراق بينه وبين الالتزام بالمشورة القانونية ، بداية يعرف الالتزام بالأعلام بأنه
(( التزام ملقى على عاتق المدين يفرض عليه أن يعلم الدائن بكل المعلومات والبيانات التي تكون لازمة له لتكوين رضاء حر مستنير ، وتكون الازمة كذلك لضمان حسن تنفيذ العقد ))).
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن الالتزام بالأعلام يوجد في مرحلة تكون العقد ، كما يوجد في مرحلة تنفيذ العقد .
ولا يخفى من أن هنالك صعوبة في التمييز بين الالتزام بالأعلام والالتزام بالمشورة القانونية ، حيث حصر هذا الاختلاف في درجة المعلومات المنقولة ، أكثر من طبيعة الالتزام ومضمونه ، إذ أن الاختلاف هو فكرية أكثر مما هو عملية ، ورغم ما قيل بشأن صعوبة التمييز بين الالتزامين إلا أنه يمكن التمييز بين الالتزامين في النقاط الأتية:
اولا: من حيث الأشخاص:
إن المدين بالالتزام بالأعلام بصفة خاصة كل ممتهن متخصص وبصفة عامة هو كل بائع يملك من المعلومات ما يؤثر في الانتفاع بالمال المبيع، سواء كان محترفا أم غير محترف ولا يلزم أن يكون هناك اتفاق بعكس الالتزام بالمشورة القانونية في عقد تقدیم المشورة القانونية فلا يلزم إلا المستشار القانوني الذي تم الاتفاق معه.
أما الدائن بالالتزام بالأعلام والمشورة القانونية فهو عاد غیر متخصص ، إلا أن الفرق بين الاثنين هو كون المبادرة في طلب المشورة عادة ما تكون من قبل الدائن ، في حين المبادرة في الالتزام بالأعلام تكون من قبل المدين ، وتعطى عفوية دون أن يطلبها الدائن .
ثانيا : من حيث الطبيعة
فأن الالتزام بالأعلام يعد التزاماً عاماً سابقة على التعاقد ، يتمثل في أحاطة الدائن بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتكوين رضا حر ومستنير ، سواء تعلقت هذه البيانات والمعلومات بمحل الشيء الذي يرد عليه التعاقد أو بأطراف التعاقد انفسهم” ،
كذلك قد يكون التزاماً عقدياً وذلك لضمان تنفيذ العقد بحسن نية ، أما الالتزام بتقديم المشورة القانونية الناشئ عن عقد تقديم المشورة القانونية ، فهو التزام عقدي ، أي ليس التزاما سابق وإنما هو التزام اصلي ، وهو محل العقد ذاته ولا يعد المستشار القانوني منفذا لالتزامه إلا بأداء المشورة القانونية، فالالتزام بالأعلام باعتباره التزاما تعاقدية يختلف عن الالتزام بالمشورة القانونية باعتباره التزام أصلية في عقد تقديم المشورة القانونية ، فالالتزام بالأعلام التعاقدي هو التزام تابع لالتزامات أخرى يوجب على المدين أن يعلم المتعاقد معه بكل البيانات والمعلومات التي من شأنها أن تضمن تنفيذ العقد بحسن نيه ، في حين نجد كما بينا سابقا أن الالتزام بالمشورة القانونية في عقد تقديم المشورة القانونية هو التزام أصلي فهو محل العقد والأداء الرئيسي فيه.
ثالثا : من حيث مجال التطبيق:
إن الالتزام بالأعلام يجد محله في تكوين العقد أي قبل أبرام العقد ، في حين إن الالتزام بتقديم المشورة القانونية يجد مكانه في مرحلة تنفيذ العقد بأعتبار أن المحل الرئيسي والأساسي للعقد هو تقديم المشورة القانونية ، وهذا لا يتحقق إلا بتنفيذ المدين لالتزامه بتقديم المشورة القانونية محل العقد) .
رابعا : من حيث المضمون
إن الالتزام بالأعلام يتميز عن الالتزام بالمشورة القانونية في مضمون كل منهما ، فالمدين بالأعلام يتوجب عليه أن يحيط المتعاقد الأخر بكل مخاطر العمل الذي يراد أجراؤه ومزاياه ويوضح له المعلومات كافة لكي يجري خياره على ضوئها ولا يتوجب عليه أن يقترح أو أن يفضل حل معين دون الأخر ،
ومن هنا تظهر الحدود الفاصلة بين الالتزام بالأعلام والمشورة القانونية في أن الالتزام بالأعلام صفة موضوعية لا تتصل بشخص المستفيد ، بل تتناول خصائص ووقائع تتصل مباشرة بالمال موضوع التعاقد ، أما المشورة القانونية فلها طابع شخصي لأنها تأخذ بالاعتبار الثقة في شخص المستشار القانوني فهو يقود خيارات المستفيد ويوجهه ويحثه على اتخاذ قرار في موضوع المشورة القانونية ، فالملتزم بالأعلام يقتصر على مجرد أعلام الدائن دون التعدي إلى تحديد الخيار الأفضل.
هذا وقد يخلط البعض بين الالتزام بالأعلام وبين الالتزام بالمشورة التبعي أي واجب المشورة؟
للتميز بين الالتزامين ذهب البعض من الفقه إلى القول بأن الاختلاف بين الالتزام بالأعلام والمشورة في هذا الصدد هو اختلاف في درجة المعلومة المنقولة ، على أساس أن كل من الالتزام بالأعلام والمشورة هنا ينطوي على أعلام المتعاقد الأخر بكل البيانات اللازمة الحسن تنفيذ العقد ، وأن احدهم يتقدم على الأخر في الدرجة فقط ، فالأعلام يأتي أولا وبعده المشورة.
غير أننا نرى أنه ينبغي النظر إلى المدين عند التفرقة بين الالتزام بالأعلام والمشورة ، فالمدين بالأعلام لا يعلم ولا يعرف رغبات وحاجيات الدائن بالضبط ، في حين أن المدين في عقد تقديم المشورة القانونية المتمثل بالمستشار القانوني يكون عالما بدوافع وبواعث المتعاقد معه.
واستنادا لما تقدم يمكننا القول أنه من المتصور أن ينشأ عن عقد تقديم المشورة القانونية التزام تابع بالأعلام ، حيث يجب على المستشار القانوني أن يعلم المستفيد بكل البيانات والمعلومات التي من شأنه أن تجعل تنفيذ عقد تقديم المشورة القانونية يتم بحسن نية .
ومن جهة أخرى فأن الالتزام بالأعلام يتواجد باستقلالية عن الالتزام بالمشورة ولا يعادله فالمشورة تشمل الأعلام وتتجاوزه ، ونقطة التقاء الأعلام بالمشورة هي الإفصاح عن المعلومات التي تشكل أسباب طلب المشورة ، وبقدر معرفة الطرف المدين بالالتزام بالأعلام أو المشورة ، بحاجات المستفيد وأهدافه ، نقترب من المشورة أكثر من الأعلام ، وعلى الرغم من الاختلافات السابقة فأن بعض الفقه الفرنسي يذهب إلى عدم التفريق بين الالتزامين والبعض الأخر يستعمل المصطلحين حين يقصد الالتزام بالمشورة؟.
الفرع الثالث التمييز بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية والالتزام بالتحذير
الالتزام بالتحذير هو الالتزام الذي يتضمن لفت انتباه المتعاقد من مخاطر محتملة سواء أكانت مادية أم قانونية ، فلا يكتفي أن يقوم المدين في العقد بإحاطة الدائن بطريقة الاستخدام الصحيح والتي تكفل له الانتفاع بمحل التعاقد أي كان ، بل يجب عليه فضلا عن ذلك ، أن يبرز له كافة الاحتياطات التي يجب عليه أن يتخذها وأن يحذره بكل وضوح من مغبة عدم اتخاذ هذه الاحتياطات .
إذ يرى البعض أن الالتزام بالتحذير هو التزام وسط بين الالتزام بالأعلام والالتزام بالمشورة فهو اقوى من مجرد أعلام لكنه لا يصل إلى درجة المشورة ، فالالتزام بالتحذير هو ابعد من أن يكون مجرد أخبار أو أعلام إذ يفترض مخاطر معينة يجب التحذير منها إلا أنه لا يرقى إلى الالتزام بالمشورة.
فلم يكتفي الفقه بمجرد الزام الطرف الأخر بالإفصاح عن البيانات اللازمة ، وإنما تشدد في وجوب التحذير ووضع شروط حتى يعد المنتج أو الصانع أو البائع موفيأ بالتزامه بالتحذير، وحتى يكون المدين بالتحذير موفيأ بالتزامه فأنه ينبغي أن يكون تحذيره وافية ، ومفهومة ولصيقة بالمنتج.
ولا يقتصر التحذير على المخاطر المادية فحسب بل يتصور وجوده كذلك أذا كانت هناك مخاطر قانونية تترتب على تصرفات المستفيد ، فيتعين على المتعاقد معه أن يلفت أنتباهه ويحذره من المخاطر التي قد تترتب على تصرف معين كالمستشار القانوني الذي يحذر المستفيد ن مغبة فوات ميعاد الطعن في حكم أو قرار ما.
أما كون الالتزام بالتحذير التزام سابق على التعاقد ، فأن التميز بينه وبين الالتزام بالمشورة يكون على أساس مجال ونطاق عمل كل منهما ، فالالتزام بالتحذير يهدف إلى لفت انتباه المتعاقد إلى خطورة الشيء المبيع ، فمحل العقد الأصلي ليس هو التحذير وانما هو نقل الملكية ، ويثار الالتزام بالتحذير في المرحلة السابقة على أبرام العقد . أما الالتزام بالمشورة فيعتبر محل الأداء الأساسي في عقد تقديم المشورة القانونية ، ولا يعد المدين منفذا لالتزامه إلا بتأدية المشورة ، ومن ثم فأنه يثار في مرحلة تنفيذ العقد.
مما تقدم يتضح لنا إن الخطر هو مناط الالتزام بالتحذير ، وأن الالتزام بالمشورة هو التزام مشدد بالتحذير أي إن المشورة تضم كل من الالتزام بالتحذير و الالتزام بالأعلام ، وأن الالتزام بالتحذير يضم الالتزام بالأعلام وعليه فأن الالتزام بالتحذير هو التزام وسط بين الالتزام بالأعلام والمشورة ، فالتحذير يعد أقل درجة من المشورة ، فهو لا يتضمن توجيه المتعاقد بشأن الهدف الذي يبتغيه ، بعكس الالتزام بالمشورة فأنه يتوجب على المستشار أضافة للأعلام والتحذير تقديم النصائح الدقيقة للمستفيد.