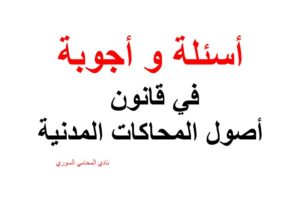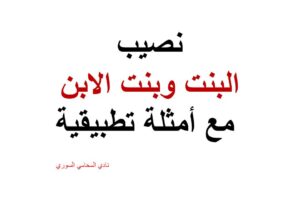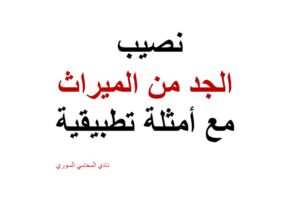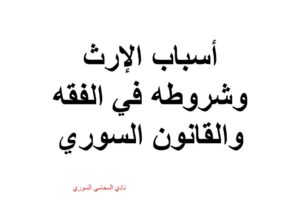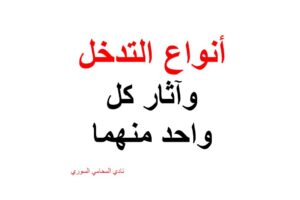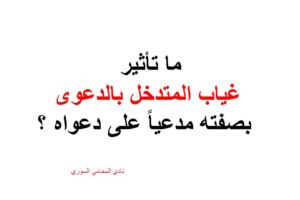تعريف الوقف لغة واصطلاحاً ومشروعيته:
أولا- تعريف الوقف في اللغة:
الوقف: الحبس والمنع، وجمعه أوقاف، يقال : وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسله بمعنی واحد.
وأما في الاصطلاح: حبس الواقف العين على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب.
ثانيا – مشروعية الوقف:
الوقف مشروع باتفاق الفقهاء، وهو مباح ومندوب إليه لمن كان غنية لأنه صدقة، والصدقة قد ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع ومنها قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
جون وما تفقوا من شيء فإن الله به عليم) (آل عمران: 92) أما مشروعية الوقف خاصة فالأصل في مشروعيته السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إجماع الأمة.
أما السنة: ففي الصحيحين « أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه ؟ قال: “إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث »
فتصدق بها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
والوقف مما اختص به المسلمون، قال جابر – رضي الله عنه -: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف
حكمة مشروعية الوقف ::
– يرغب من وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات فيخصصوا شيئا من أموالهم العينية ما يبقى أصله وتستمر المنفعة منه خشية أن يؤول المال بعد مفارقة الحياة إلى من لا يحفظه ولا يصونه فينمحي عمله ويصبح عقبه من ذوي الفاقة والإعسار، ودفعا لكل هذه التوقعات ومشاركة في أعمال الخيرات شرع الوقف في الحياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه ويضعه في موضعه الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة كما كان في الحياة.
الوقف سبب رئيسي في قيام المساجد والمدارس والربط ونحوها من أعمال الخير والمحافظة عليها، فإن أغلب المساجد على مدى التاريخ قامت على تلك الأوقاف، بل إن كل ما يحتاجه المسجد من فرش وتنظيف ورزق القائمين عليه كان ولا يزال مدعوما بالأوقاف.
ألفاظ الوقف وأنواعه:
أولا – ألفاظ الوقف:
له ألفاظ صريحة وهي: وقفت وحبست وسبلت. وأما الألفاظ الكنائية فهي: تصدقت وحرمت وأبدت. وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بواحد من ثلاثة أمور:
1 – النية، فإذا نطق ونوى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية صار موقفا .
2- إذا اقترنت الألفاظ الكنائية بواحدة من الألفاظ الصريحة أو الكنائية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة.
3- أن يصف العين بأوصاف، فيقول: محرمة لا تباع ولا ترهب. وكما يصح الوقف بالقول كواحد من الألفاظ الصريحة أو الكنائية على ما أكر فإنه يصح بالفعل كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها.
ثانيا- أنواع الوقف:
ينقسم الوقف باعتبار الجهة الأولى التي وقف عليها إلى نوعين:
1 – خيري
2 – وأهلي.
1 – الوقف الخيري:
الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة، ويكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة ثم من بعد ذلك على أولاده.
2 – الوقف الأهلي أو الثري :
وهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ويجعل آخره لجهة خيرية.
كأن يوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على جهة خيرية من بعدهم.
محل الوقف وشروطه:
1- محل الوقف
هو المال الموجود المتقوم من عقار أرضا أو دارا بالإجماع، أو منقول ككتب وثياب وحيوان وسلاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: « وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ». واتفقت الأمة على وقف الخصر والقناديل في المساجد من غير نكير.
ويصح وقف الحلي للبس والإعارة ؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.
2-شروط الواقف:
يشترط في الواقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:
1- أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.
2 – أن يكون الواقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.
3 – أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
4 – أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.
3- شروط الموقوف:
ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:
1- أن يكون مالا متقوما من عقار وغيره.
2 – أن يكون الموقوف معلوما محددا.
3 – أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.
4 – أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع
5 – أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.
6 – أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.
7 – أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.
الفرق بين الوقف والوصية:
1- أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع
2 – أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق »
أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.
3- الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصی له.
4- تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وللتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.
5- الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.
6- الوقف يجوز الوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.
إدارة أمور الوقف
ذهب الجمهور إلى أن الواقف هو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياته، وله أن ينيب غيره عنه ويكون وكيلا عنه، فإذا مات الواقف، فإن إدارة الوقف تنتقل لمن يعينه لإدارة الوقف، فإن لم يعين كانت لوصيه إن كان له وصي، وإلا انتقلت إلى القاضي، فيشرف عليه ويعين نائبا عنه يسمی الناظر، وربما يسمى المتولي أو القيم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المتولي والقيم هما المشرفان على أعمال الوقف والناظر مراقب على أعمال المتولي والقيم.
1- شروط الناظر على الوقف:
يشترط فيه البلوغ والعقل والرشد والعدالة والقدرة على إدارة الوقف، وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الإسلام والحرية والذكورة إضافة لما سبق، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك.
2- واجبات الناظر:
عليه الالتزام بشروط الواقف الصحيحة أولا، ثم يقوم بما فيه صلاح الوقف، من عمارة وإجارة وترميم، ويوزع ما يتوفر لديه من غلة الوقف على مستحقيه، فإن أساء التصرف فإنه يعزل.
3- أجرة الناظر:
إذا عين له الواقف أجرة أخذها، وإن لم يعين له شيئا، جاز للقاضي أن يحدد له أجرة المثل، سواء أكان غنيا أم فقيرة ؛ لأنه يحبس نفسه لمصلحة الوقف.
هل تكون الأجرة من غلة الوقف ؟
ذهب الجمهور إلى أنها من غلة الوقف مطلقاً، وذهب بعض المالكية إلى أنها من بيت المال إلا أن يعين الواقف شيئا له فتكون في الوقف.
4- بيع مال الوقف:
ذهب الفقهاء إلى أن بيع عين مال الوقف باطل ؛ لأنه مناقض لمعنى الوقف أصلا، إلا أنهم استثنوا حالات على اختلاف فيما بينهم في هذه الحالات، وذلك بشرط مجمع عليه وهو أن يجعل ثمنها وقفة بدلا منها، وهو ما يسميه الفقهاء بالاستبدال.
5- الوقف في القوانين السورية:
كانت الأوقاف الأهلية ” الذرية ” والخيرية والمشتركة في سوريا قبل عام 1949 تدار بید النظار والقضاة على وفق الأحكام الشرعية المتقدمة، وفي عام 1949 بعد انقلاب حسني الزعيم صدر مرسومان تشریعیان عنه يقضي الأول بمنع الأوقاف الذرية، وحل القائم منها وتصفيته، وتوزيع أعيانه على المستحقين، ويقضي المرسوم الثاني بضبط الأوقاف الخيرية وعزل النظار القائمين عليها، ونقل الأشراف عليها بدلا منهم إلى مديرية الأوقاف العامة، ودمج هذه الأوقاف كلها مع بعضها، وإلغاء شروط الواقفين.