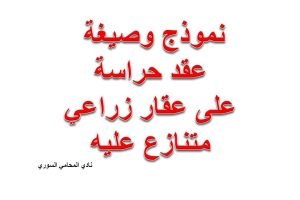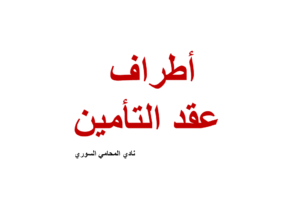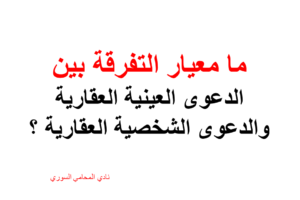عقد حراسة على عقار زراعي
عقد حراسة على عقار زراعي
الفريق الأول :……………………. متنازع
الفريق الثاني:…………………….. متنازع
الفريق الثالث:…………………… الحارس
المقدمـة :
لما كان الفريقان الأولان يتنازعان (۱) على ملكية (۱) /أو حيازة كامل/أو حصة قدرها…… / ٢٤٠٠ سهم من العقار رقم …… من منطقة العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية بعل /سقي/سليخ/مشجرة بمساحة…… متراً مربعاً في قرية…… التابعة لمحافظة……
وخشية منهما على فوات المنفعة من استغلاله فقد اتفق تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة و هم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:
المادة 1 –
تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة ٢ –
عهد الفريقان الأول والثاني إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة العقــــار المقدمة المذكور في بجميع زروعه وغراسه ومنشأته وأباره وأدواته الزراعية ومواشیه المبينة بالكشف الملحق والتكفل بحفظه واستثماره وإدارت وبرده بكامل داته موجود مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه منهما وريثما يحل هذا النزاع رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخـر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.
المادة 3 –
التزم الفريق الثالث ب :
أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك ويكون مسؤولاً عن كل يبوسة أو هلاك في المزروعات والغراس بشكل خاص.
ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خـــــاص إنشاء العلاقات الزراعية كالمشاركة على البدل أو الحصة أو التأجير وتبديــــــل وجـــه استغلال المحروس وطريقته وقلع الغراس وهدم الإنشاءات أو إزالتها أو تعديلها
ج- صيانة العقار المحروس وغراسه وإنشاءاته وموجوداته واستغلاله زراعياً واستيفاء حقوق الفريقين الآخرين والوفاء بديونهما المتعلقة بالمحروس وبيع المحاصيل وتضمينها وكل ما يلزم لاستغلاله زراعياً.
د- مسك دفتر حساب منظم بما تسلمه من واردات المحروس ومــا أنفقــه مــن مصاريف تدون فيه واقعاتها يوماً بيوم ويكون مؤيداً بالمستندات اللازمة والاحتفاظ بصافي الغلة بعد تنزيل المصاريف وضريبة الاستثمار الزراعي(2) وأجوره من الواردات وتقديم حساب سنوي للفريقين الآخرين بذلك في مطلع تشرين الأول من كل عام ميلادي.
المادة ٤ –
يحق الفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــــــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية والإخطارات ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.
المادة ٥-
أ- إستلم الفريق الثالث المحروس بحالة جيدة صالحاً لما أعد له خالياً من أي شاغل أو نقص أو كسر أو عطب أو يبوسة و التزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما مع غلته الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.
ب- حدد الفرقاء (3) أجر الفريق الثالث الشهري بمبلغ مقطوع قدره………. ليرة سورية أو بنسبة ……. من غلة المحروس السنوية بعد حسم مصاريفه/أو بمبلغ …… سنوي مقطوع قدره ……….. ليرة سورية يصرفه لنفسه من واردات المحروس بعد تقديم الحساب السنوي.
أو
ب تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كـــل حـــق ودعوى وطلب بإدعاء وخلاف ذلك.
ج- تنتهي الحراسة بحسم النزاع بين الفريقين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره والتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم الحساب والغلة المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمن يعينانه بدلاً منه أو لمن لـــــه الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة.
ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير.
المادة ٦ –
يعتبر الفريق الثالث معذراW بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة ٧ –
اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة ٨ –
نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء الثلاثة بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
… في / /
الفريق الأول الفريق الثاني الفريق الثالث
(۱) يمكن أن تثور المنازعة على الملكية الزراعية نتيجة تصرف أحد الطرفين للآخر بعقار أو جزء من عقار بعوض أو بغير عوض ويختلفان قبل أن يتم تسجيل الملكية في السجل العقاري. كما يمكن أن تثور نتيجة اختلاف النوع الشرعي للأرض وتحولها من أميرية إلى ملك أو بالعكس بسبب إدخالها في منطقة مبنية أو قلع غراسها وتأثر الحصص الإرثية وانطباق قواعد الإرث الشرعي أو الانتقال القانوني.
ويمكن أن تثور المنازعة على الحيازة سواء نتيجة التصرف أو نتيجة الإجارة أو المشاركة بالبدل أو على الحصة.
(2) الاستثمار الزراعي معفى من ضريبة الدخل سواء كان زراعياً أو حيوانياً ولكنه يكون مشمولا بها إذا استهدف تصدير المنتجات
(3) يجوز أن تكون الحراسة مجانية. وإذا كانت كذلك ترتب إيراد نص خاص بذلك.
———————————————————————–
لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج
يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا