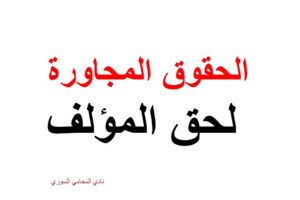أولاً : تعريف الخطأ:
يعتبر الإنسان مخطئاً، بالمعنى القانوني، عندما لا يتخذ في سلوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص العادي الحريص اتخاذه لمنع ما يترتب على سلوكه من ضرر للغير.
ولقد حدد المشرع السوري صور ومفهوم الخطأ وعناصره في المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات.
فالمادة 189 عددت صور الخطأ كما يلي يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة”.
أما المادة 190 فلقد حددت ماهية الخطأ وعناصره ومتى تكون الجريمة غير مقصودة، كما يلي
“تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها”.
ثانياً- عناصر الخطأ:
يقوم الخطأ استنادا للنص التشريعي الوارد في المادة 190 على عنصرين أساسيين :
1- الإخلال بواجب الحيطة والحذر المعتادین.
2- عدم توقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين على الرغم من أنه كان بإمكانه أن يتوقعها، أو أنه توقعها وحسب أن بإمكانه أن يتجنبها.
فالعنصر الأول يتمثل بإخلال الشخص بالواجب العام الملقى على عاتق كل إنسان أن يتوخى في سلوكه الحيطة والحذر کي لا يضر بالأخرين.
فسائق السيارة عليه أن لا يسرع كي لا يصدم أحدا، ومن يحفر حفرة أمام داره عليه أن يضع عليها إشارة تنبه الأخرين کي لا يقعوا بها.
فالسرعة من السائق وعدم وضع تتبيه للمارة على الحفرة هو إخلال بواجب الحيطة والحذر المطلوب من كل إنسان.
ومعيار الحيطة والحذر يستند على أساس موضوعي لا شخصي.
فليس المقصود منه الفاعل ذاته في سلوكه المعتاد، وإنما المقصود هو سلوك الشخص العادي، أي الشخص المجرد الذي يمثل جمهور الناس، الذي يتبع في تصرفاته القدر الكافي و المألوف من الحيطة، والذي يظل مقبولا من جميع الناس وصالحة للتطبيق في جميع الحالات.
إلا أن هذا الأساس، أي سلوك الرجل العادي، ليس مطلقاً، وإنما يجب عند تقدير هذا السلوك أن يوضع الرجل العادي في ظل الظروف نفسها التي أحاطت بالمدعى عليه، سواء أكانت ظروف متعلقة بالزمان أو المكان أو بحالة المدعى عليه الجسدية أو النفسية كالمرض أو الخوف أو العمر، لكي يمكن الحكم على سلوكه.
فالحيطة أو الحذر المطلوب من الإنسان المكتمل الإدراك يفوق ما هو مطلوب من الإنسان المسن أو الفتى المراهق.
وقيادة سيارة في شارع مزدحم يقتضي حيطة وحذرا يفوق ما هو مطلوب عند قيادة هذا السيارة في شارع فارغ أو فرعي أو طريق سفر .
فإذا قام الشخص بقيادة سيارته بسرعة في شارع مزدحم وصدم شخصاً فهو مسئول عن خطأ ارتكبه لأنه أخل بواجب الحيطة والحذر المطلوب من الشخص العادي و هو التسهل في هكذا ظروف.
أما العنصر الثاني، فيتمثل بقيام علاقة نفسية بين الفاعل والنتيجة الجرمية المترتبة على فعله. فوجود الخطأ وبالتالي ترتب المسئولية مرتبط بهذه العلاقة وجود و عدم .
و هذه العلاقة النفسية تظهر في صورتين أوضحتهما المادة 190 ق.ع.
الأولى: عدم توقع الفاعل للنتيجة الناجمة عن السلوك الخاطئ رغم أنه كان باستطاعته أن يتوقعها، أو كان يجب عليه، على الأقل، أن يتوقعها .
وهذه الصورة يطلق عليها الخطأ بلا تبصر أو الخطأ غير الواعي أو غير الشعوري .
والمثال على الخطأ غير الواعي أن يخطئ الصياد هدفه ويصيب إنسانا أخر أو أحد الصيادين معه بدلا عن الطريدة.
الثانية: توقع الفاعل النتيجة الناجمة عن سلوكه الخاطئ، إلا أنه لا يرضى بها ويسعى إلى عدم حدوثها معتمدا على كفاءته أو مهارته في تجنبها.
وهذه الصورة يطلق عليها الخطأ بتبصر أو الخطأ الواعي أو الشعوري
فلاعب السيرك الذي يطلق السكاكين باتجاه شريكته في اللعبة يتوقع أن تصيب إحداها شريكته إلا أنه لا يريد ولا يقبل هذه النتيجة بل يعتمد على مهارته في تجنب الإصابة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ الواعي أو الشعوري يقترب كثيرا من القصد الاحتمالي المساوي للقصد المباشر، والتمييز بينهما دقيق للغاية.
ففي حين أن الفاعل في الخطأ الواعي يتوقع النتيجة إلا أنه لا يرضى بها، ويعتمد على مهارته في تلافيها، نجد أن الفاعل في القصد الاحتمالي يتوقع النتيجة ويرضى بها مقدما إذا وقعت، فيقبل المخاطرة.
كمن يضع السم لقتل غريمه ويتوقع أن تأكل زوجته معه فيرضى أن تموت هي الأخرى في سبيل تحقيق هدفه الأساسي في قتل غريمه.
ثالثاً :صور الخطأ
عدد المشرع في المادة 189 صور الخطأ وهي: الإهمال – قلة الاحتراز – عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
ثم كرر التعداد ذاته في المادة 550 التي عاقبت على القتل الخطأ.
وعلى الرغم من أن المشرع قد أورد هذه الصور على سبيل الحصر إلا أنها في الحقيقة تخضع للتفسير الموسع والمرن كونها متداخلة مع بعضها بحيث يصعب التمييز أحيانا بين صورة وأخرى، ووضع حدود فاصلة حاسبة بينها.
فهذه الصور، كما أسلفنا، كثيرا ما تتداخل فيما بينها ويحل بعضها محل بعض.
فقد تنشأ الوفاة مثلا عن إهمال مرده قلة أحتراز، أو عن قلة احتراز مصدرها الإهمال.
وقد ينطوي عدم مراعاة القوانين والأنظمة بحد ذاته على إهمال أو قلة احتراز .
وليست الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التعداد سوى الإحاطة بكل أنواع الخطة التي يمكن تصورها.
وسنحاول، مع ذلك، توضيح كل صورة على حدة.
1– الإهمال :
تنصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن سلوك الإنسان السلبي أي عن الترك أو الامتناع.
وفيه يغفل الشخص عن اتخاذ احتياط يوجبه الحذر، بحيث أنه لو كان اتخذه لما وقعت النتيجة الضارة من موت أو إيذاء.
أي أن هذا الشخص يمتنع عن القيام بما ينبغي على الشخص العادي الذي يتواجد في الظروف نفسها القيام به.
من أمثلة هذه الصورة:
الشخص الذي يحفر حفرة قرب بيته ويهمل وضع ما يشير إليها، فيقع بها أحد الأشخاص ويموت أو يتعرض لأذى.
أو سائق الحافلة الذي ينطلق بها دون التأكد من دخول الركاب وإغلاق الباب، مما يؤدي إلى سقوط أحد الركاب وموته.
أو مالك البناء الذي لا يجري الصيانة اللازمة لترميمه، فيسقط أحد الأسقف على المستأجر ويموت.
أو الشخص المكلف بالعناية بطفل أو عاجز أو مريض، فيهمل بهذه العناية، ويؤدي إلى موت هذا الشخص.
أو الأب الذي يترك سلاحه المحشو بالرصاص في مكان ظاهر فيتلقفه أبنه ليلعب به فتخرج إحدى الرصاصات وتقتله.
2- قلة الاحتراز:
تصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن سلوك الإنسان الإيجابي الذي يدل على الطيش أو عدم التبصر أو عدم تقدير العواقب .
فالفاعل في هذه الصورة يدرك خطورة تصرفه أو سلوكه وما يترتب عليه من آثار ضارة، ورغم ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصوله.
من أمثلة هذه الصورة:
السائق الذي يقود بسرعة في مكان مزدحم فيدهس أحدهم. أو الشخص الذي يقود سيارته ليلا وهي مطفأة الأنوار فيصطدم أحد المارة.
أو الشخص الذي يقود سيارة بالرغم من الضعف الشديد في قوة بصره مما يؤدي لدخوله في حائط أحد المنازل وانهيار الحائط على أحد السكان.
أو الشخص الذي يشهر مسدسا محشوة بالرصاص بوجه صديقه مازحا، فتنطلق رصاصة وتصيبه إصابة قاتلة.
وتندرج في هذه الصورة أيضا حالة الأم التي تنام مع رضيعها في سرير واحد فتنقلب عليه أثناء نومها وتقتله.
وحالة الشخص الذي يسلم حيوانه الخطر إلى شخص غير قادر على السيطرة عليه، لصغر سن أو عدم دراية، فيؤدي فعله إلى إيذاء الشخص أو موته من قبل الحيوان.
3- عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.
المقصود بالشرائع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، أما الأنظمة فهي القواعد الصادرة عن السلطة التنفيذية، أي الجهات الإدارية من وزارات ومحافظات وبلديات. والخطأ الجزائي يقع، والمسئولية الجزائية تقوم على النتيجة الجرمية الحاصلة من موت أو إيذاء، بمجرد مخالفة القوانين أو الأنظمة ولو لم يرتكب المخطئ إهمالا أو قلة احتراز.
ومن أمثلة هذه الصورة:
الشخص الذي يعير سيارته لصديقه مع علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة، فيدهس هذا الصديق شخصا ويقتله.
فصاحب السيارة يعتبر مخطئا لمخالفته قانون السير وبالتالي تترتب مسئوليته الجزائية مع صديقه عن وفاة الشخص.
الشخص الذي يقود سيارته بسرعة تفوق السرعة المحددة بالقانون أو النظام، فهذا يرتكب هذا الشخص خطأ لمخالفته القوانين والأنظمة،
فإذا أدت سرعته إلى صدم أحد المارة، فيسأل عن قتله أو إيذائه ولو الم يقع منه أي إهمال أو قلة احتراز.
أو القيادة في اتجاه معاكس للسير فيؤدي ذلك إلى صدم أحد الأشخاص.
ونلاحظ في المثالين الأخيرين أن عدم مراعاة القوانين والأنظمة ينطوي على جرمين:
مخالفة قانون السير، وجرم القتل أو الإيذاء الخطأ الناجم عن مخالفة القوانين والأنظمة.