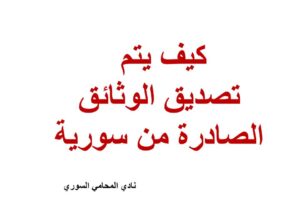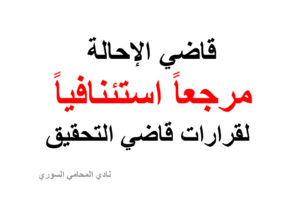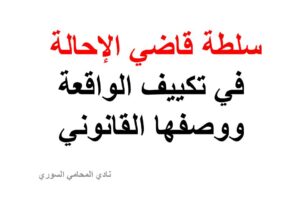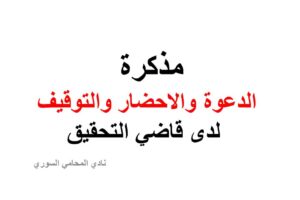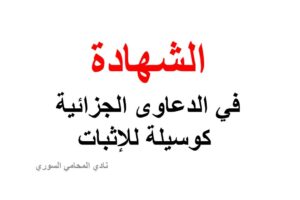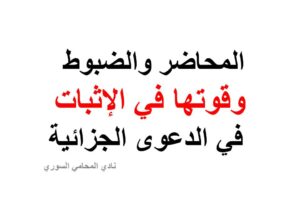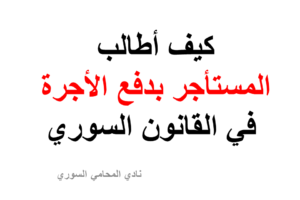معلومة قانونية : يعتبر القانون رقم / 49 / لعام 1977 هو المرجع الأساسي الناظم لعملية تصديق الوثائق القنصلية.
حيث تنص المادة رقم 3 : “كل وثيقةٍ منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدَّةٍ لتبرز في البلاد الأجنبية، يجب أن تكون مصدَّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية”.
ويُقصد بالتسلسل هنا هو المرجعية التي وافتنا بها الجهات العامة من تواقيع و أختام معتمدة للتصديق، وتتغير تلك التواقيع لتلك الجهات العامة من تواقيع وأختام معتمدة للتصديق, وتتغير تلك التواقيع باسترار وفقاً لتلك الجهات .
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الأختام والتواقيع التي تحملها أي وثيقة معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين بحسب ما وافتنا به تلك الجهات.
تذكر :
- تشترط الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين لتصديق أي وثيقة حضور صاحب العلاقة شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية، مع ابراز ما يثبت صلة القرابة.
- أن تصديق وزارة الخارجية والمغتربين لأي وثيقة صادرة من سورية هي آخر خطوة ينبغي القيام بها من جانب السلطات السوربة، قبل استعمال الوثيقة في الخارج.
أولاً : وثائق الأحوال المدنية
تعتبر وثائق الأحوال المدنية من أكثر الوثائق التي يحتاج المواطن استعمالها خارج سورية.
وفيما يلي ضوابط تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة من سورية :
- لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية من وزارة الخارجية والمغتربين ) إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ( يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم وتوقيع مدير الأحوال المدنية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو بالخاتم والتوقيع المُعتمدين من المديرية العامة للاحوال المدنية.
- يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية آنفة الذكر مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين إن كانت صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن المعتمدة في سورية.
- لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية الخاصة بالإخوة الفلسطيين المقيمين في سورية ( إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ) يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سورية.
- لتصديق وثائق الأحوال المدنية (بيان زواج – إخراج قيد – شهادة عماد .. الخ) الصادرة عن المحاكم الروحية أو المذهبية، يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم و توقيع المرجع الروحي لكل طائفة، والمعتمد لدى وزارة الخارجية والمغتربين.
- بالإضافة إلى شروط و ضوابط التصديق آنفة الذكر، إذا كانت وثائق الأحوال المدنية تحتوي على واقعة وفاة بين عامي ( 1952 و 2004 ) فيجب الحصول على موافقة مديرية المالية – دائرة التركات في المحافظة التي توجد فيها قيود المتوفى.
تذكير : لا تقبل للتصديق في وزارة الخارجية والمغتربين وثائق الأحوال المدنية المكتوبة بخط اليد، إلا في حالات استثنائية بالتشاور مع مديرية الأحوال المدنية.
ثانياً :الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية وإداراتها:
نبذة : قد تحتاج – في بعض الأحيان – إلى تصديق بعض الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية أو أحد اداراتها في المحافظات قبل استعمالها خارج سورية.
شروط تصديق وثائق وزارة الداخلية و إداراتها:
أ– خلاصة السجل العدلي “لاحكم عليه”: يمكن تصديقه بإحدى الحالات التالية:
1 – صادر عن أحد فروع الأمن الجنائي : ويُصدق من قائد شرطة المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو من يفوضه أصولا.
2 – صادر عن إدارة الأمن الجنائي :و يصدق من مدير إدارة الأمن الجنائي.
3 – صادر عن أيّ من مراكز خدمة المواطن: يُصدق من قبل رئيس المركز المختص.
ب – وثائق الهجرة والجوازات :
1 – بيان حركة قدوم ومغادرة: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، وأن تكون موجهة إلى وزارة الخارجية والمغتربين وليس إلى شعبة التجنيد.
2- صور جوازات السفر: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، أو من يفوضه أصولا
وثائق مختلفة : يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية مثل :
1 – صورة إجازة السوق : يجب أن تصدق من مدير إدارة المرور .
2- الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية الأخرى ( إدارة مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص، المرور.. الخ ) يجب أن تمهر بخاتم و توقيع مدير الإدارة المختص أو من يفوضه أصولا.
هام جداً :
: يجب أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها معدّة للاستخدام خارج سورية، وبالتالي لا تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على المُخاطبات الرسمية والكتب الصادرة كمراسلات عن الجهات العامة أو الخاصة.
ثالثاُ : الوثائق الدراسية
تقبل وزارة الخارجية والمغتربين تصديق الوثائق الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية السورية والمُراد استخدامها في الخارج وهي :
1: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي.
2: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي.
3: وثائق وشهادات متفرقة.
الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي:
- الشهادات الدراسية الأصلية أو صورها طبق الأصل: تصدق من مدير التربية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة أو مدير دائرة الامتحانات أو المفوض أصولا بالتوقيع في وزارة التربية، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
- الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية: تصدق من رئيس دائرة التعليم (الأساسي أو الثانوي أو الخاص) بحسب نوع الوثيقة، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
- الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس الاجنبية المرخصة في سورية : تصدق من دائرة التعليم الخاص المعنية، ثم من سفارة الدولة التي تتبع علمها، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
- يمكن الاستعاضة عن خاتم وتوقيع مديريات التربية بتوقيع المعتمدين لدى ديوان مديرية التربية، أو بخاتم وتوقيع معاون وزير التربية المختص.
الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي:
- لتصديق الشهادات الدراسية الجامعية يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع نائب رئيس الجامعة المعتمد، أو من تفوضه وزارة التعليم العالي بذلك.
- الشهادات الدراسية الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي، أو معاون الوزير المختص.
- الشهادات الدراسية الصادرة عن المعاهد المتوسطة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزارة التي يتبع لها المعهد.
- بالنسبة لباقي الوثائق الجامعية الأخرى (حياة جامعية – اشعار تخرج – توصيف مواد – بيان وضع – رسالة توصية .. الخ) فيُكتفى بخاتم وتوقيع عميد الكلية بالنسبة للجامعات الحكومية، ورئيس الجامعة بالنسبة للجامعات الخاصة.
وثائق دراسية متفرقة:
بالإضافة للوثائق الدراسية الصادرة من وزارتي التربية والتعليم العالي: يمكن لوزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة القنصلية تصديق العديد من الوثائق الدراسية المختلفة المستوفية لشروط التصديق ومنها:
- لتصديق الشهادات الصادرة عن المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة في سورية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير المركز، وسفارة البلد الذي يتبع له المركز.
- الوثائق الصادرة عن معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: يجب أن تكون مصدقة من مدير المعهد و من وزارة التربية أصولا.
- الوثائق الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم المهني: يجب أن تكون مصدقة من مدير مركز التدريب والتأهيل المهني في وزارة الصناعة، أو مدير صناعة دمشق، أو معاون الوزير.
- شهادات المعلوماتية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
- شهادات التدريب الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع معاون الوزير المختص أو النقابة التي يتبع لها المركز أصولاً.
- لتصديق الشهادات الصادرة عن الاونروا، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التربية في الأنروا أو مدير المنظمة في سورية.
- لتصديق الشهادات الصادرة عن وزارة الاوقاف و معاهدها أو شهادة ختم القرآن الكريم، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف أو معاون الوزير المختص.
مُلاحظة : لا تمنح وزارة الخارجية والمغتربين صوراً طبق الأصل عن الوثائق الصادرة من سورية والمصدقة من قبلها، وإن احتجت إلى صور مصدقة اضافية للوثيقة فيمكنك الحصول عليها فقط من الجهة المصدرة لها.
رابعاً : وثائق وزارة العدل :
لتصديق الوثائق الصادرة عن وزارة العدل في سورية والمتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية مثل (الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية) يجب أن تحمل تلك الوثائق خاتم وتوقيع كل من المحكمة المختصة، والمحامي العام أو النيابة العامة في المحافظة وعدلية المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة (مكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل).
ولا يشمل ما سبق مراسلات وزارة العدل فتلك بطبيعتها ليست مُعدّة للاستخدام خارج سورية.
أما الوثائق المتعلقة بالمواضيع الأخرى، والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري فستطلب الإدارة القنصلية مراجعة وزارة العدل لمخاطبتها أصولاً قبل تصديق أحكام تلك المحاكم، وكذلك الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعات قضائية فسيخضع تصديقها لموافقة وزارة العدل بموجب مُراسلة رسمية معها.
خامساً : وثائق وزارة الصحة :
يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن وزارة الصحة ومديرياتها والهيئات الطبية
في سورية وذلك وفق ما يلي:
- شهادات: ( الترخيص – مزاولة المهنة – شهادات الاختصاص والخبرة .. الخ) يجب
أن تكون مصدقة من مديرية التراخيص والسجلات في وزارة الصحة، أو معاون وزير الصحة المختص.
- الشهادات الصحية والتقارير الطبية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير صحة المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة، أو رئيس لجنة فحص العاملين “اللجنة الطبية.”
- الوثائق الصادرة عن نقابات : (الأطباء – أطباء الأسنان – الصيادلة) يجب أن تصدق
أولاً من قبل النقيب المختص المركزي.
- شهادات الخلو من الأمراض السارية : يتم تصديق هذا النوع من الوثائق إذا كانت تحمل خاتم وتوقيع مدير مركز تشخيص الأمراض السارية والمعدية أو في المحافظة، للمشافي الحكومية.
المستشفى المعتمد أصولاً.
سادساً : وثائق متفرقة :
بالإضافة إلى الوثائق التي سبق ذكرها ، يمكن تصديق أنماط أخرى من الوثائق الرسمية منها :
1– يمكن تصديق الوثائق والإفادات الصادرة عن وزارة الدفاع أو شعب التجنيد أو المشافي العسكرية بعد تصديقها من الإدارة العامة لوزارة الدفاع .
2– الوثائق الصادرة عن الاتحادات المهنية أو المنظمات الشعبية : بعد تصديقها من قبل النقيب المركزي أو رئيس المنظمة أو رئيس الاتحاد المختص.
3– الوثائق الخاصة بالعاملين في مؤسسات القطاع العام في سورية (قرارات الايفاد إجازة خاصة – استقالة .. الخ ) يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزير المختص.
أما وثيقة “غير موظف” الصادرة عن سجل العاملين في الدولة، فتصدق بعد تصديقها من قبل الأمين العام لسجل العاملين في الدولة، و تصدق مباشرة من قبل الإدارة القنصلية في حال كانت الوثيقة صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن،في حين تصدق وثائق التأمين والمعاشات بعد تصديقها من قبل المدير العام للمؤسسة.
4– يمكن تصديق “بيان القيد العقاري” أو الوثائق المتعلقة بالعقارات في الحالات التالية:
أ: العقار مسجل لدى المصالح العقارية: يمكن تصديقه بعد تصديق المدير العام للمصالح العقارية أو مدراء المصالح العقارية في المحافظات أصولا
ب: صادر عن جمعية سكنية: بعد تصديقه من قبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية.
5– وثيقة “سند اقامة” في سورية للسوريين والأجانب: يجب تصديقها من قبل الموظف المختص في المحافظة أصولاً ، أو من معاون وزير الإدارة المحلية.
6: كشوف الحسابات المصرفية : يُطلب تصديقها أولا من قبل وزارة المالية – مكتب شؤون المصارف والتأمين أصولا سواءً كان كشف الحساب صادرا من مصرف عام أو خاص.
سابعاً : أحكام مختلفة للتصديق القنصلي
ترجمة الوثائق
لتتمكن من استعمال الوثيقة الصادرة من الجهات الرسمية السورية،ستحتاج إلى ترجمتها إلى لغة البلد الذي سيتم استعمال الوثيقة فيه في حال كان البلد غير عربي، وذلك عندما تكون الوثيقة الأصلية مستوفية لشروط التصديق.
تصادق الإدارة القنصلية على النسخ المترجمة من جميع الوثائق التي ذكرت في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة توفر الشروط التالية مجتمعة :
1- أن تحمل الترجمة خاتم وتوقيع الترجمان المحلف
2- أن تكون الترجمة مصدقة من قبل عدلية المحافظة
3- أن تقترن الوثيقة الأصلية والترجمة بخاتم مشترك
أحكام عامة لتصديق الوثائق:
تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الإخوة المواطنين بأن تكون الوثائق المطلوب تصديقها حديثة نسبيا ، لاسيما وثائق الأحوال المدنية ووثائق وزارة الداخلية بما فيها وثائق إدارة الهجرة والجوازات.
لا يوجد تاريخ انتهاء لصلاحية تصديق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، فإن كانت لديك وثيقة قديمة سبق تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، فلا حاجة لإعادة تصديقها بخاتم وتوقيع جديدين.