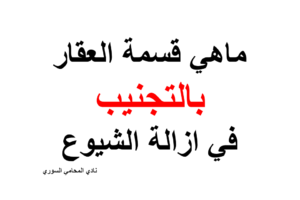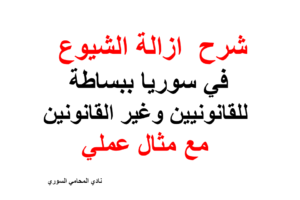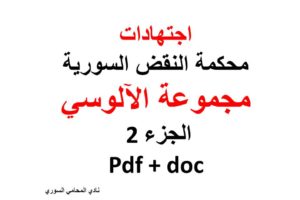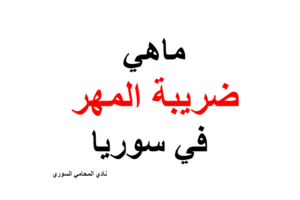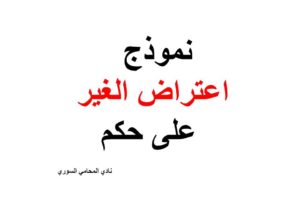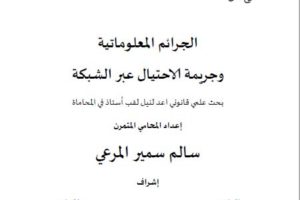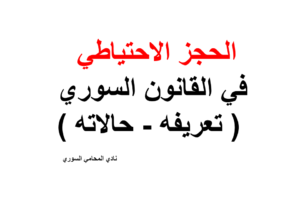تعريف الحجز الاحتياطي في القانون السوري
يقصد بالحجز وضع الما المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه التصرف فيه إما بانتظار نتيجة الدعوى واما لبيعه وتحقيق ثمنه، حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه .
ويكون سبب الحجز في رفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعاً مما يحمل الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ و طلب اقتضاء الإلتزام جبراً عن المدين ، فنكون أمام حالة الحجز التنفيذي، الذي توقعه دائرة التنفيذ ولها وحدها الحق بإيقاعه، وهي المرجع المختص في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته واجراءاته.
أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، فالا بد له من مراجعة القضاء لتثبيت حقه والحصول على حكم به، وقد يطو ذلك ، مما جع المشرع يجيز للدائن وقبل الحصول على السند التنفيذي، أن يلقي حجزًا احتياطياً على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال ويمنع المدين من التصرف بها تصرفاً من شأنه الإضرار بحقه . وينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بِأصل الحق في دائرة التنفيذ عندما ينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بموجب القرار القضائي.
أما إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي فإنه بإمكانه أن يلجأ إلى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين، إلا ما استثني منها بنص قانوني، ويبيع هذه الأموال ليستوفي حقه الثابت بالسند التنفيذي من ثمن ما تم بيعه. وقد وضع المشرع أحكاماً خاصة للتنفيذ على أموال المدين حسب نوع المال منقولاً كان أم عقاراً. وهذا ما سنبحثه بالتفصيل لاحقاً
ويمكننا أن نعرف الحجز الاحتياطي بأنه:
” وضع ما المدين تحت يد القضاء لمنعه من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان العام للدائن الحاجز ” .
حالات الحجز الاحتياطي
الحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراءً تنفيذياً بل هو إجراء وقائي، لأنه لايمكن التنفيذ على المال المحجوز الا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين . ويكون ذلك بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي.
ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة ،سواء أكانت مملوكة منه على وجه الإستقلال أم مملوكة على الشيوع، فيرد الحجز على الحصة الشائعة. واذا كان المال عقاراً وضعت إشارة حجز احتياطي على صحينة العقار في السجل العقاري، أما إذا كان المال منقولاً فيكتفى بحجزه احتياطياً وتسليمه لحائزه كشخص ثالث أمين ، يلتزم بوضعه تحت تصرف دائرة التنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز الاحتياطي، ويبدأ الدائن بالتنفيذ عليه.
أما بالنسبة لحالات الحجز الاحتياطي، فقد عالجه المشرع في المواد 314 -312 من قانون أصول المحاكمات. وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تغيرها مهما كانت الحاجة تدعو إلى الحجز الاحتياطي. وحالات الحجز الاحتياطي التي نص عليها القانون هي حالات عامة وحالات خاصة.
1- الحالات العامة للحجز الاحتياطي:
وفقاً لنص المادة 312 أصول فقد فرض المشرع شروطاً تجب توافرها لإلقاء الحجز الاحتياطي، وذلك عندما عدد الحالات الست التي يمكن في حال توافر واحدة منها إعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي.وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية:
وتقوم هذه الحالة على وضع مدين لا يستقر في موطن معروف في سورية، كأن يكون من الرحل المتنقلين، أو أن يكون موطنه خارج الأراضي السورية. وقد نشأ هذا النوع من الحجز الذي يسمى بالفرنسية Saisie Foraine في القروف الوسطى وأساسه ما كان لسكان المدن من امتياز للحجز على منقوالات المدين الذي لا يقيم فيها عند وجوده مع منقولاته داخل حدودها وذلك لمنعه من إخراجها خارج حدود هذه المدن.
على أن هذه الحالة لوحدها لا تكفي، ونرى أنه لا بد من أن يكون طلب الحجز مؤيداً بدليل تقدره المحكمة كأنفياً لترجيح احتمال وجود دين محقق الوجود. ولا يشترط أن يكون الدليل خطياً وانما قد تكون هنالك قرائن على وجود الدين.
الحالة الثانية: إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية:
في هذه الحالة يكون للمدين موطن مستق الا أنه عزم على الفرار منه والإنتقالل بأمواله إلى محل آخر أو إلى جهة مجهولة، فيجد الدائن نفسه مكتوف اليد أمام مدين سيء النية يخلي محله، ويحزم أمتعته هرباً من المطالبين.
ويعد المدين سيء النية، إذا عزم على الإنتقال من موطنه بمنقولاته دون مبرر أو دون إخطار الدائن بالجهة التي يقصدها، أو إذا كان هناك مبرر لم يقره عليه الدائن ولم تثبت دلائله الجدية ولا فر في ذلك ، أن تكون الجهة ضمن البالد أو خارجها.
وعمى كل حال، فإن على الدائن أن يثبت فكرة القرار المتوقع لمدينه بأدلة أو قرائن، ويعود للقاضي تقدير مدى جديّة الأدلة المقدمة من المدعي بهذا الشأن، وعليه أن يبين في قراره أسباب اقتناعه أو عدم اقتناعه بهذه الأدلة. وبما أن هذا الأمر من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الإساس، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض
الحالة الثالثة: إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع:
ويشترط في هذه الحالة أن يتحقق أمران:
الأول: أن يكون للدائن تأمين يضمن دينه، سواء أكان هذا التأمين عينياً كالرهن الحيازي أم شخصياً كالكفالة الشخصية. ومهما كان مصدر التأمين سواء أكان بنص القانون أم بالإتفاق أو بقرار من القاضي.
الثاني: أن تكون هناك ظروف من شأنها أن ترجح ضياع هذا التأمين أو اضعافه. كأن تكون التأمينات معرضة لنقصان أو النقدان. ومثال ذلك توقف الكفيل عن الدفع أو إعساره أو إقامة دعوى الإفلاس بحقه ، في مثل هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين ضمان اً لحقه ، الا إذا تقدم المدين بتأمين جديد بديل عن التأمين المهدد بالضياع.
الحالة الرابعة: إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط:
وهذه الحالة هي أكثر الحالات شيوعاً والتي يستند اليها الدائنون عملياً في طلباتهم المتعلقة بالحجز الاحتياطي على أموال مدينهم . بحيث يحق لكل دائن يحمل سنداً، رسمياً أو عادياً، مدنياً أو تجارياً، أن يطلب الحجز الاحتياطي، شريطة أن يتحقق لهذا السند شرطان هما:
1- أن يكون هذا السند مستحق الأداء، وقد حل أجله.
2- الا يكون معلقاً على شرط.
وفي هذه الحالة، على القاضي أن يستجيب إلى طلب الحجز الاحتياطي، ولا يملك سلطة التقدير في الإجابة أو الرفض، كما هي الحال في الحالات الإخرى، بل هو مفروض عليه سواء أكان المدين تاجراً معروفاً أم شخصاً مليئاً أم ثرياً. ذلك أن من المفروض عليه أصلاً أن يسارع في تسديد دينه المترتب بذمته عند استحقاقه، فهو بامتناعه عن الدفع أو بتأخيره أو بمماطلته قصَّر وعرَّض نفسه للادعاء عليه. وفي حال وجود مبرر لذلك ، فليس من ضرر يناله في مثل هذه الحالة إيقاع الحجز على أمواله احتياطياً، لأن ذلك لا يعني بالضرورة نزع الأموال المنقولة من يد المدين .
الحالة الخامسة: إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها:
يشترط في هذه الحالة أن يكون المدين تاجراً ولا فر بين أن يكون الدين تجارياً أو مدنياً و أن تقوم ظروف قوية وجدية يتوقع معها قيام المدين التاجر بتهريب أمواله أو إخفائها عن دائنيه كما لو كان مشرفاً على الإفلاس.
ويعود تقدير الإسباب الجدية التي يتوقع معها تهريب أموال التاجر أو إخفاؤها، إلى القاضي الموضوع الذي يتثبت بجميع الوسائل من قيام أسباب واقعية مادية، قبل أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال التاجر.
الحالة السادسة: إذا قدّم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين :
وهذه الحالة غير موجودة في التشريع المصري وقد أخذها المشرع السوري عن أصول المحاكمات الحقوقية العثماني. وبالإستناد إلى هذه الحالة، إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي أو عادي بالدين، جاز له أن يطلب من المحكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه مستنداً إلى أوراق أو أدلة مهما كانت، تعتبرها المحكمة كافية لاحتمال وجود دين في ذمة المدين . وقد منح المشرع، في هذه الحالة، المحكمة سلطة واسعة وغير محدودة في التقدير. وقد أكّد الإجتها د القضائي هذه السلطة التي تستقل بها محاكم الإساس، وأن لا رقابة عليها لمحكمة النقض .
2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة:
بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي فقد نص المشرع في المادتين 313 و 314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة:
الحالة الأولى: الحجز على موجودات المستأجر في العين المؤجرة:
يقوم الحق بالحجز المنصوص عليه بالمادة313 أصول على أساس الإمتياز الممنوح للمؤجر على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها، الذي نصت عليه المادة 1122 من القانون المدني. وأن الدافع الذي حمل المشرع منح المؤجر امتيازاً في ضمان حقه هو افتراض وجود رهن ضمني على المنقولات الموجودة في العقار المؤجر، ويطلق على هذا الحجز بالتعبير الفرنسي بما معناه الحجز الرهني .Saisie gagerie
واذا نقلت الأموال المتعلقة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية عن هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد عاد القانوني، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.
ونشير إلى أن هذا الحجز، في الحقيقة، ليس حجزاً احتياطياً على منقولات المستأجر، الموجودة في العين المؤجرة، وانما هو حجز احتياطي استحقاقي نص المشرع عليه في المادة 314 التي سنتطرق لها مباشرة، وذلك نظراً لما يتمتع بو المؤجر من إلقاء للحجز الاحتياطي وملاحقة الأمتعة والإشياء واستردادها تبعاً للإمتياز القائم له على الإشياء الموجودة في العين المؤجرة.
الحالة الثانية: الحجز الإستحقاقي الاحتياطي:
نصت المادة 314 من قانون أصول المحاكمات على أن:
” لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقو أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والإوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه “.
ويقصد من هذا النص، تمكين مدعي الإستحقاق في عقار أو منقول من ضبطه وحجزه احتياطياً ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه، مهما كانت صفة هذا الحائز.
ويدخل هذا الحجز في مفهوم الحجز الاحتياطي لأنه يرمي إلى وضع المال تحت يد القضاء ومنع صاحبه من التصرف به بما يضر بمصلحة الحاجز، غير أنه يختلف عنه من أنه لا يهدف إلى بيع المال لأجل وفاء دين الحاجز، بل إلى إعادته إلى صاحب الحق فيه، باستثناء حالة صاحب حق الحبس إذ في هذه الحالة يصار إلى بيع المال اقتضاء حقه من قيمته.
ويمكن إيقاع هذا الحجز في مواجهة أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لم تربطه بالحاجز أية علاقة قانونية.