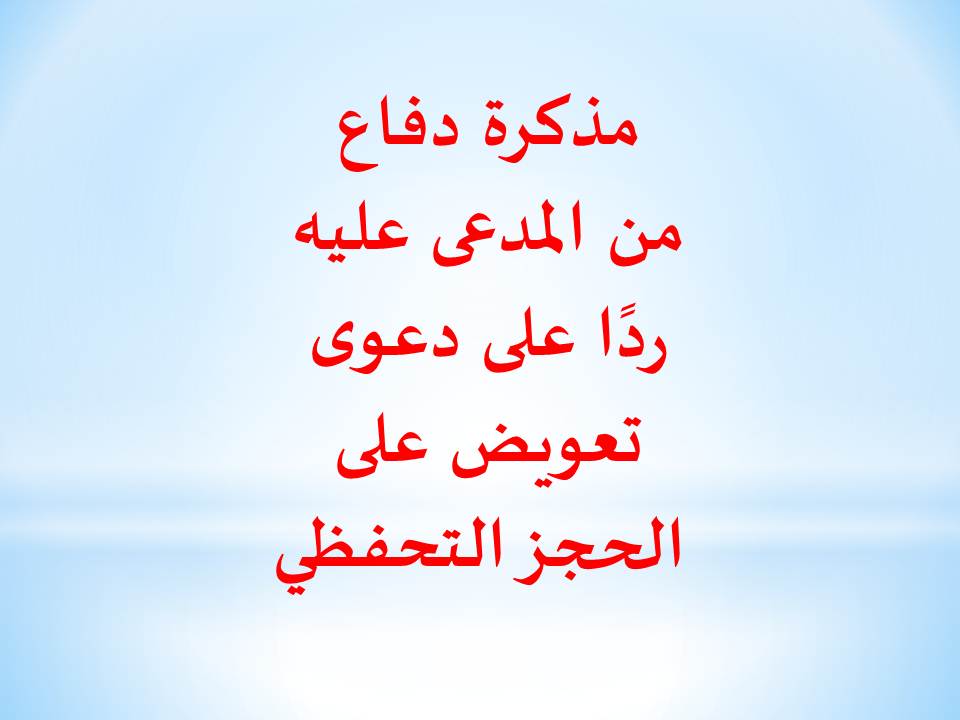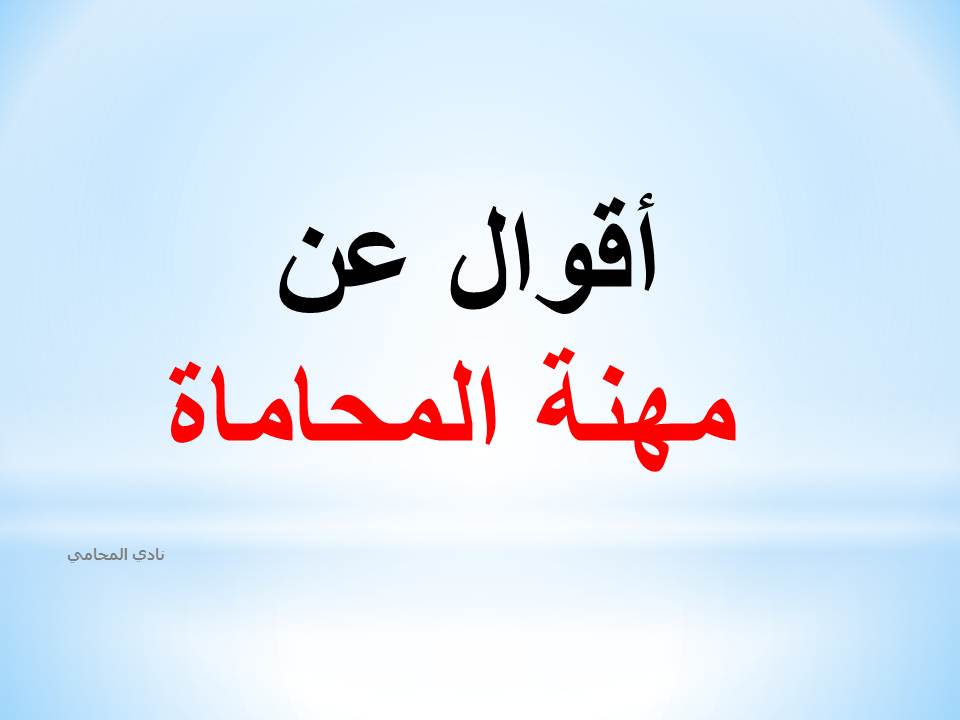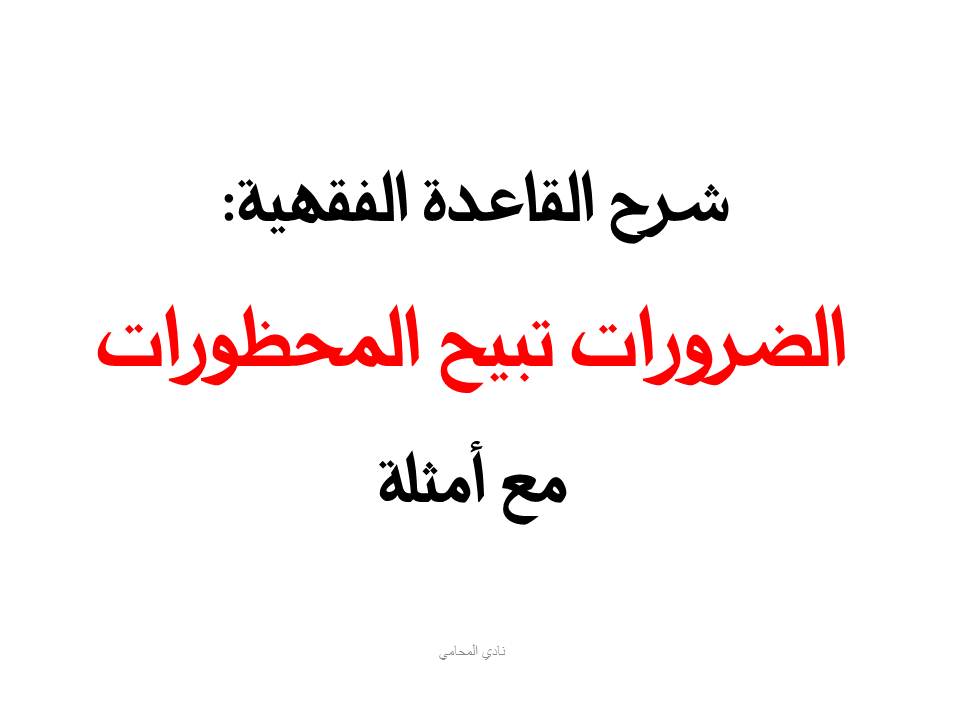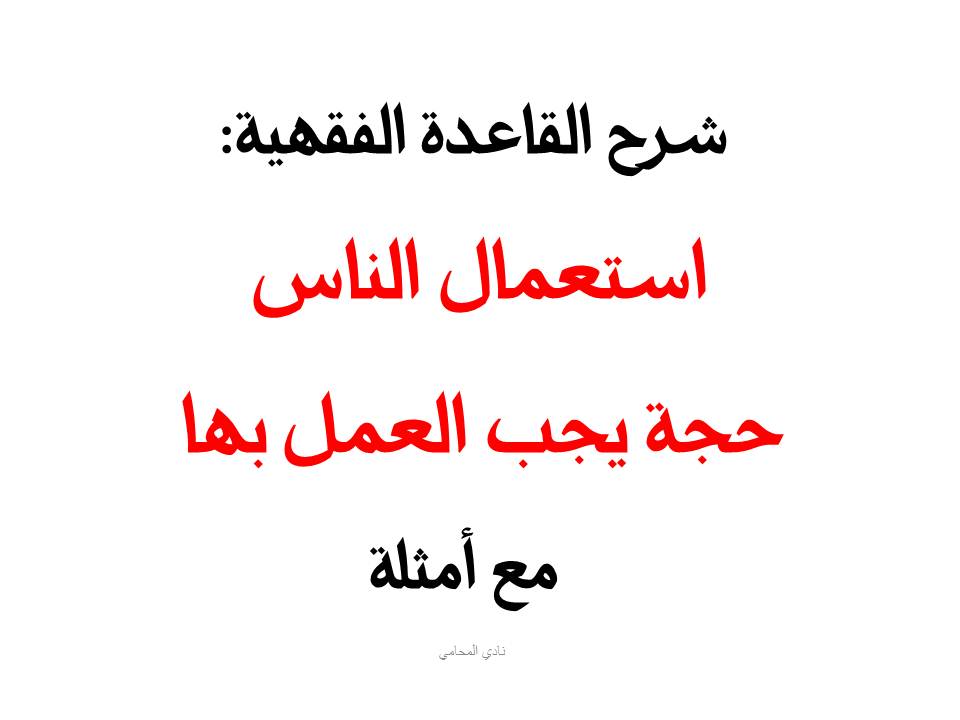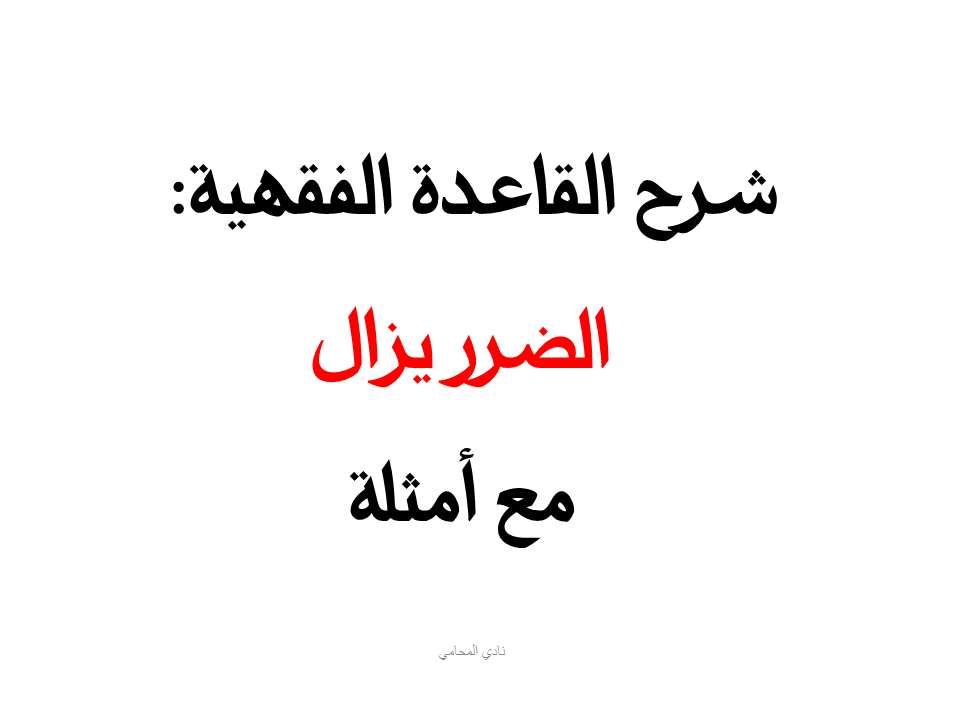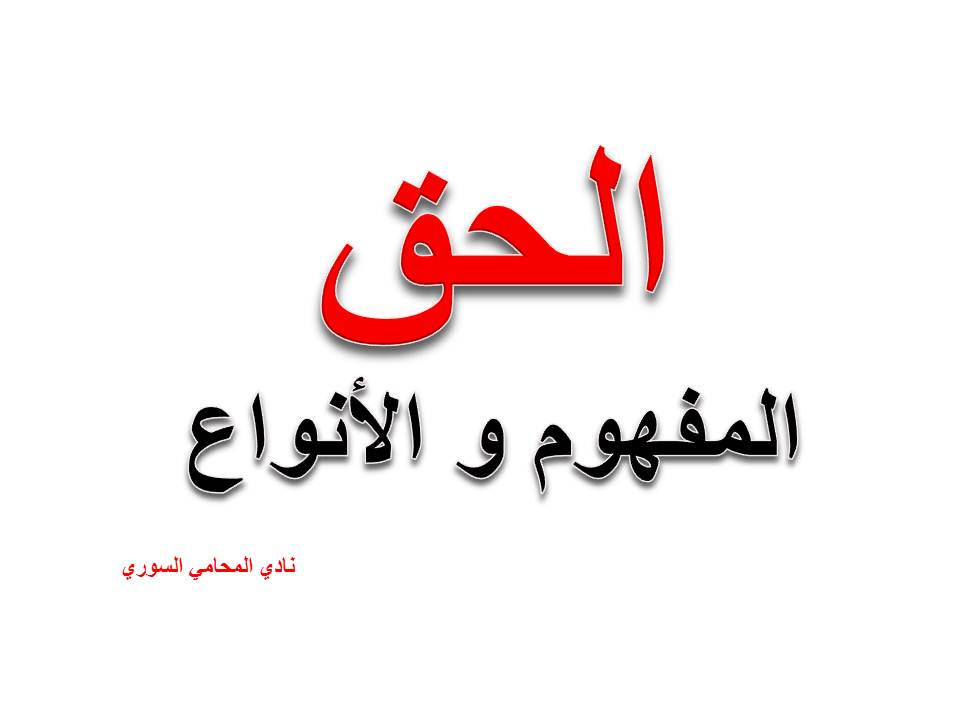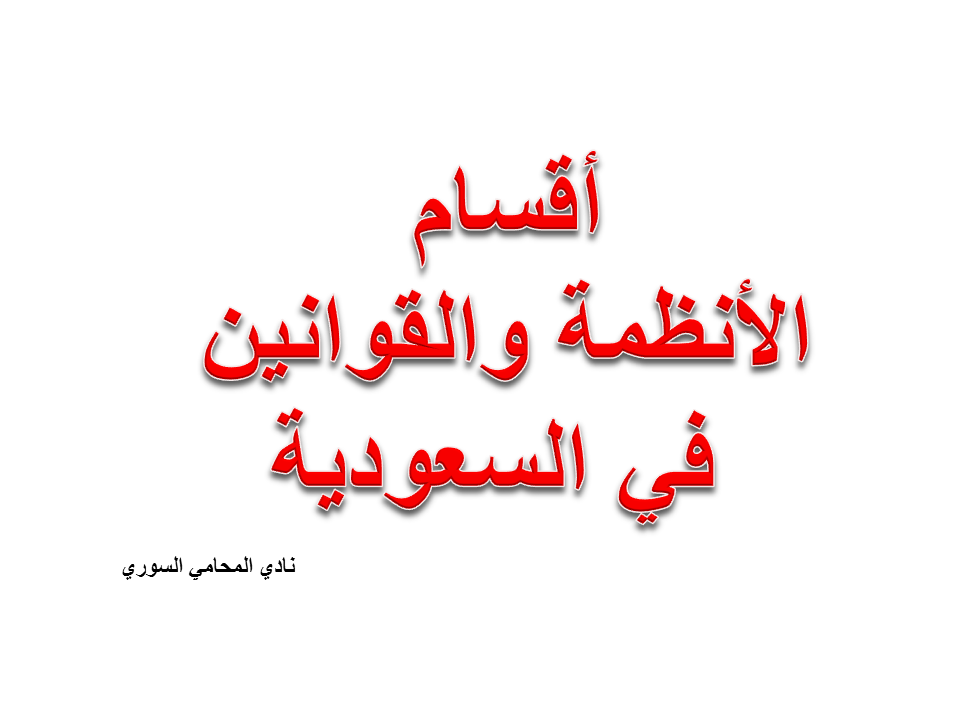مذكرة دفاع من المدعى عليه ردًا على دعوى تعويض على الحجز التحفظي
الصادر في دعوى سابقة بناء على طلب المدعي
صاحب الفضيلة :
قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛
مذكرة دفاع
مقدم من/ ………. (مدعى عليهم)
ضد / …… (مدعي)
الموضوع
إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والتي يطلب فيها المدعي التعويض عن إجراءات الحجز التحفظي نظرا لرد الدعوى السابقة التي أقامها المدعي نوضح أن المدعي لا يستحق ما يطلب والدعـوى غير مقبولة شرعًا للآتي :
1- أن إبل المدعي كانت تحت يده ولم ترفع يده عنها وإجراءات الحجز التحفظي لم تمنعه من انتفـاع مـن مثلـه بها على وجه العادة عدا التصرف بالبيع لحين الفصل في الدعوى وهو أمر طبيعي لحفظ حق الطرفين في الدعوى أما ما قرره المدعي بأنه كان ينفق على الإبل طول فترة الحجز فمردود عليه أنه كان ينفق عليهـا على الإبل على وجه العادة وهي تحت يده لأنه المالك ولا يجوز التعويض عن ما يبذله المدعي في رعايـة مـا يملكه شرعًا.
٢- أن دعوى المدعية مخالفة لما أجمع عليه أهل العلم أن التعويض على حجز المال لا يكون إلا على الغاصب إذا اتجر بالمال والمتأمل من الدعوى أن خلاف الطرفين في الدعوى السابقة على ثمن المبيع حيث أقر المدعي بصحة البيع واختلفا على قدر الثمن فالبائع يقرر أن البيع على ثمن ۱۲۰۰۰ ريال للرأس في حين أن المدعى عليه قرر أنه اشترى بمبلغ ۱۰۰۰۰ للرأس وقضي بفسخ البيع بيمين المدعي وعليه لا غصب أو تعدي والأصل أن الغاصب لا يضمن ما لم يتجر فما بال فضيلتكم أن المدعى عليه ليس غاصب والإبل تحت يد المدعي ورد في شرح منتهى الإرادات « ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصب مال تجارة مدة يمكن أن يربح إذا لم يتجر فيه غاصب كما لو حبس عبدا يريد مالكه أن يعلمه صناعة مدة يمكنه تعلمها فيها لأنها لا وجود لها « (١٢٢/٤) وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار نص عليه أحمد وهو قول جمهور العلماء « (٣٨٤/٧)
٣- بصفة عامة لا يوجد أي كيدية في دعوى المدعين السابقة وإقامتها ضرورة لحسم النزاع نظرا لثبوت البيع واستلام الثمن والخلاف بين الطرفين على مقدار الثمن ورفض المدعي رد الثمن أو تسليم الإبل وأصبح المدعين في الدعوى السابقة متضررين من عدم رد ثمنهم أو تسليم الإبل وأن ناظر الدعوى فصل في الخلاف على الوجـه الشرعي المقرر بأخذ يمين المدعي وعدم وجود بينة لدى المدعين على صحة دعواهم حول الثمن لا يثبت التعدي شرعًا الموجب للتعويض لإقرار المدعي بصحة البيع والتعدي في القضاء لا يكون إلا برفع دعوى كيدية وعدم إثبات الدعوى بقيمة المبيع ليس دليل على الكيدية وفقًا لما استقر عليه قرار المحكمة العليا رقم ٦ بتاريخ ۱۳۹۲/۱/۱۱هـ نضيف حتى لو افترضنا جدلًا أن المدعى عليه استلم الإبل فليس للمدعي تعويض لأن المستقر عليه أن البيع الفاسد لا تلزم فيـه الأجرة من المدعى عليه لأن الغرم بالغنم فهو انتفع بالعين والبائع انتفع بالثمن.
بناء على ذلك:
في موضوع دعوى المدعي نطلب رد الدعوى لما سبق بيانه أو للأسباب التي يراها فضيلتكم.
وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.
مقدمه