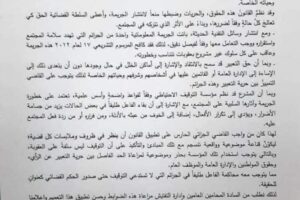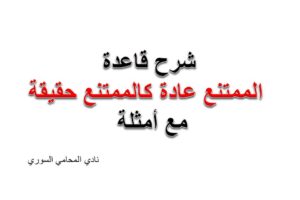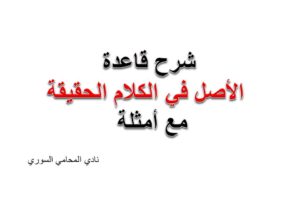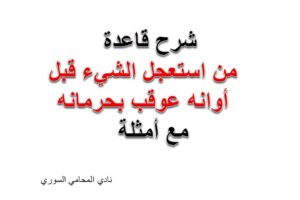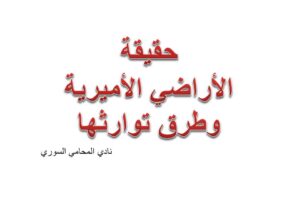حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها
بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد جرى الاختلاف بين فقهاء العصر حول ما يطلق عليه (الأراضي الأميرية) ما هي حقيقتها، وهل هي ملك لمن هي في يده اليوم، سواء ورثها عن أصوله سنين عديدة، أو اشتراها ممن كانت في يده لا ينازعه فيها أحد بثمن مكافئ في يومها، وكان ذلك الإرث أو ذلك الشراء بمعرفة الدولة وإقرارها وتسجيلها واعتمادها، أو أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، وهي في يد من يستعملها اليوم على سبيل الإجارة منها، أو هي وقف للمسلمين عامة، وعلى من يستعملها خراجها وهو إيجارها، وعليه فلا تورث عنه بعد وفاته، ولا يكون له بيعها، ولا إيجارها بغير إذن الدولة في ذلك؟؟.
وإنني في ضمن هذا الاختلاف بين السادة العلماء أدلي بدلوي، وأبين ما ظهر لي في ذلك، فلعله ينهي النزاع، أو يحد منه على أقل تقدير.
فكلمة أراضي أميرية اصطلاح جديد لم يكن منتشرا بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحا في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرآى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.
ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها، وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها، وقال البعض: هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.
وإنني سوف أبين أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي:
أريد بادئ ذي بدء أن أفرق بين ثلاث مصطلحات، أراضي أميرية، وأراضي موات، وأراضي هي ملك للدولة، تسمى في عرفنا أملاك دولة.
فأما الأراضي الأميرية –وهي محل الدراسة- فهي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.
وقد ذهب الحنفية إلى أن أراضي السواد (وهي الأراضي الأميرية اليوم في نظري) هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.
قال في مجمع الأنهر: {(وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا) عِنْدَنَا، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فَآجَرَهَا، لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ: رُدَّ مِنْ وُجُوهٍ فَلْيُطَالَعْ. (يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً لأَهْلِهَا، لَكِنْ إذَا كَانَتْ الْخَرَاجِيَّةُ مَمْلُوكَةً فَكَوْنُ الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً أَوْلَى}.(((مجمع الأنهر 2/458))).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: {يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي الْخَرَاجِ، وَالْقَطِيعَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالإِجَارَةِ، وَالإِكَارَةِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْخَرَاجِ أَرْضُ سَوَادِ الْعِرَاقِ الَّتِي فَتَحَهَا سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ لأَنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَرَاضِيهِمْ، فَكَانَتْ مُبْقَاةً عَلَى مِلْكِهِمْ فَجَازَ لَهُمْ بَيْعُهَا}(((بدائع الصنائع 5/146))).
وقال ابن عابدين في رد المحتار: {وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية، بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها، وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته، وهذا على مذهبنا ظاهر} (حاشية ابن عابدين 4/18).
وقال أيضا: {وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) هِدَايَةٌ، وَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ، فَتْحٌ.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها:
قال الشرواني: {(يمتنع) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا، ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات، ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه، ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج، لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. اهـ مغني. (((حواشي الشرواني9/362)))
وقال النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار. وقال أبو سعيد الإصطخري: وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها، وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، وعليه نص في سير الواقدي، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عقبة ابن فرقد أرضا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره، فقال ممن اشتريتها؟ قال من أهلها، قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا لا، قال فاذهب فاطلب مالك، فإذا قلنا انه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف؟} المجموع 19/454.
- وقال في الحاوي: {فَصْلٌ: فَأَمَّا أَرْضُ السَّوَادِ أرض الخراج فَهِيَ مَا مُلِكَ مِنْ أَرْضِ كِسْرَى وَحْدَهُ طُولا، مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانَ وَعَرْضًا: مِنْ عُذَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ يَكُونُ مَبْلَغُ طُولِهِ مِائَةً وَسِتِّينَ فَرْسَخًا وَمَبْلَغُ عَرْضِهِ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا.
فَهَذِهِ الأَرْضُ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ فَاسْتَطَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفُسَهُمْ عَنْهَا، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهَا وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.
فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا أُجْرَةً تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ فَعَلَى هَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلا رَهْنُهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَهَا عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا ثَمَنًا فِي كُلِّ عَامٍ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَلِلْكَلامِ فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ يُسْتَوْفَى فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى} (الحاوي 6/154).
وقال في كشاف القناع: {(وَلَمْ يَرَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً)؛ لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ) الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ) أَرْضِ (مِصْرَ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ)} (كشاف القناع 4/165)،
وقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، لِيَتَّخِذَ فِيهَا قَصَبًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ، قَالَ: هَؤُلاءِ أَرْبَابُهَا، فَهَلْ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْدُدْهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ، وَخُذْ مَالَك.
وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بِمَحْضَرِ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، فَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلا سَبِيلَ إلَى وُجُودِ إجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا وَشِبْهِهِ، إذْ لا سَبِيلَ إلَى نَقْلِ قَوْلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَلا إلَى نَقْلِ قَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَلا يُوجَدُ الإِجْمَاعُ إلا الْقَوْلَ الْمُنْتَشِر. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ. قُلْنَا: لا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ. وَقَوْلُهُمْ اشْتَرَى . قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَى. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا. وَلا يَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهَا وَجِزْيَتُهَا عَلَى غَيْرِهِ.
وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالصِّغَارِ وَالذُّلِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ هَاهُنَا الاكْتِرَاءُ} (المغني 4/165).
وقال في المغني أيضا: {(فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لا نَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً؛ وَذَلِكَ لأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ مَوْقُوفَةٌ، وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَصِحُّ بَيْعُهَا، وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَيْعِ} (المغني 5/553).
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: {وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الإِجَازَةِ وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ.
وَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا} (الأحكام السلطانية 1/354).
كما جاء في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الكبير: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ} (المغني 1/354).
أما أراضي أملاك الدولة، كالتي توفي صاحبها من غير ورثة، فهذه ملك للدولة، ولها أن تبيعها أو تهبها أو تُقطعها لمن تراه، بحسب ما تراه من المصلحة.
وأما الأراضي الموات، وهي البوادي والصحارى والجبال غير المملوكة ولا المملَّكة لأحد من قبل، فهي ملك لمن أصلحها واستثمرها بأمر الدولة وإذنها، وأجاز البعض تملكها باستصلاحها من غير إذن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رواه ابن ماجه وأبو داود ومالك وأحمد وغيرهم. والأكثرون على الأول.
والله تعالى أعلم.
الأحد 15 شعبان 1429هـ و 17/8/2008م
وعليه فأرى أن الراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثا عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:
1- أنه قول إمام معتبر هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان.
2- وهو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضا، كما تقدم.
3- وهو أحد قولين عند الشافعية.
4- ولأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قرونا متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعا، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.
5- لما ذكره الإمام النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار} (باب خراج السواد).
أ.د.أحمد الحجي الكردي