س 305 -ماذا يوجب عدم رد المحكمة سلباً أو إيجاباً على طلب الإدخال ؟

ج 305 -يوجب ذلك نقض الحكم
( نقض غ م 4 أساس 2243 قرار 3345 تاريخ 9 / 11 / 2004 )
محامون السنة 71 لعام 2006 ص 66 )
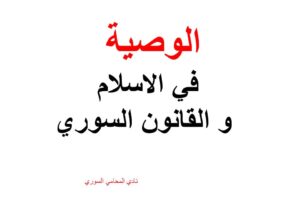

الوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا بمعنی عهدت إليه،
وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به، ومنه قوله تعالى: ( من بعد وصية توصون بها ) [ النساء: من الآية12] ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المؤث جين الوصية) [ المائدة: من الآية106].
ب- في الفقه:
يفرق الفقهاء بين اللفظين فقالوا: إن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا، ومعنى أوصيت له تبرعت له وملكته مالا أو غيره.
وللوصية تعريفات متعددة، أشهرها أنها: ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع ).
فالقول ( تمليك ) يشمل الوصية بالأعيان من منقول أو عقار وغيرهما، كما يشمل الوصية بالمنافع من سکنی دار أو زراعة أرض.
والقول ( مضاف إلى ما بعد الموت ) أخرج نحو الهبة فإنها تمليك في الحال أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد موت الموصي.
والقول عن (طريق التبرع ) أخرج مثل الوصية بأن تباع داره لفلان، فإن هذا تمليك بعوض.
ويلاحظ على هذا التعريف أن الفقهاء يعرفون الوصية التي حث الشارع عليها كعمل الخير يتدارك به الإنسان ما فاته من تقصير، لذلك لا يشمل كل أنواع الوصايا ؛ كالوصايا المتعلقة بأداء الواجبات كالحج والزكاة، والمتعلقة بإسقاط ديونه على الغرماء، والمتعلقة بحق مالي کالوصية بتأجيل الدين عن المدين بعد حلوله أجله، والمتعلقة بتقسيم تركته على ورثته.
ج – أما في القانون:
فقد عرفت الوصية بأنها: ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) المادة 207 وهذا التعريف يشمل كل أنواع الوصايا.
الأصل أن تكون الوصية غير جائزة لأنها مضافة إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله ؛ إذ الموت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها لما فيها من مصلحة للموصي وأقربائه وللمجتمع، وقد ثبتت المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع.
أما في الكتاب:
ففي قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك ځيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (البقرة:180)
وأما السنة:
فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ص أنه قال:
{ ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه }.
وأما الإجماع:
فقد أجمع الفقهاء منذ عصر الصحابة على جوازها ولم يؤثر عن واحد منهم منعها.
تنقسم الوصية إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة.
فالواجبة: وهي الإيصاء بما وجب في ذمة الموصي كالزكاة والكفارات وغيرهما.
ومن الوصية الواجبة بحكم القانون، الوصية لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل موت الجد، ولها مبحث خاص في فقرات آتية.
والمندوبة: وهي الوصية في وجوه الخير كأهل العلم والصلاح وللأقرباء الذين لا يرثون عند الجمهور . وذهب الظاهرية إلى أن الوصية لهم واجبة.
والمباحة: وهي الوصية لصديق أو لغني…
والمكروهة: وهي الوصية بما كره الشارع فعله كبناء القباب على القبور، وكأن يكون ماله قليل وورثته فقراء لقول النبي
: { إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس }
. والمحرمة : كالوصية بما حرمه الله تعالی کالوصية بالخمر، أو للإضرار بالورثة.
أ. ركن الوصية
ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره.
وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزة عنهما انعقدت بإشارته المفهومة. وهذا واضح في انعقاد الوصية بعبارة الموصي أو كتابته أو إشارته.
بماذا تنعقد الوصية ؟
اتفق الفقهاء على انعقادها باللفظ ممن يقدر عليه، فإن عجز فبالكتابة فإن عجز فبالإشارة.
واختلفوا في الكتابة حال القدرة على النطق، وفي انعقادها بالإشارة للأخرس في حال القدرة على الكتابة، فذهب الجمهور إلى أنها تنعقد بالكتابة ولو قدر على النطق، سواء كتبها بنفسه أو كتبت له وأمضاها، وذهب الأكثرون إلى أنها لا تنعقد بالإشارة إذا أحسن الكتابة.
وقد جرى القانون على رأي الجمهور حسب المادة 208.
ب . صحة الوصية
يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بما نهى عنه الشارع ؛ كأن يوصي ببناء خمارة، وهذا ما نصت عليه المادة 209.
تعليق الوصية وتقييدها:
الوصية لا تكون منجزة بل مضافة لما بعد الموت، ويجوز تعليقها بحدوث أمر يقع في المستقبل كأن يقول إذا شفيت من هذا المرض فقد جعلت ثلث مالي وصية.
ويجوز أن تقيد بشرط صحيح وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفة لمقاصد الشريعة ( المادة 210).
مثال ما فيه مصلحة للموصي: كالوصية بثلث المال على أن يرعى أولاده أو على أن يسدد ما في ذمته.
مثال ما فيه مصلحة للموصی له: كأن يوصي بأرض لفلان على أن تكون نفقات إصلاحها في تركة الموصي.
ومثال ما فيه مصلحة لغيرهما: أن يوصي بداره لفلان على أن يسقي من مائها حديقة جاره.
فإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح وكانت الوصية مستوفية للشروط الأخرى صحت الوصية ولغا الشرط فمن أوصى لفلان بمبلغ من المال على أن لا يتزوج صحت الوصية وله أن يتزوج.
ج. الرد والقبول:
قلنا: إن ركن الوصية هو الإيجاب، أما القبول فهو شرط لزوم، وقد بين القانون أحكام الرد والقبول، وموجزه في الآتي:
. إذا كانت الوصية لغير معين . کالوصية للفقراء . فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد ( المادة 225 ) وإن كانت لشخص معين وردها ترد.
.لا عبرة بالرد قبل موت الموصي. .لا تشترط الفورية بالرد أو القبول، بل على التراخي ( المادة 227 ).
.لا يشترط القبول بلفظ قبلت ؛ بل يكفي عدم الرد.. . قد يتجزأ الرد، كأن يوصي بداره وأرضه لفلان، فقيل الدار ورد الأرض، فالوصية صحيحة بما قبل.
– إذا حصل الرد أو القبول لم تجز العودة من الرد إلى القبول أو العكس إلا إذا أجاز الورثة.( المادة229)
يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان :
. العقل : فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.
. البلوغ: اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.
وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام يافع وهو الذي قارب البلوغ.
وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا؟ وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم،
كما نصت المادة (211) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.
نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حياً لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية،
أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.
أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ( 236) مايلي:
. إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حية لسنة أيضا من حين وجوب العدة.
. إذا كانت الوصية لحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
أي أن لا يكون مجهولا جهالة لا يمكن استدراكها وإزالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له فلا تفيد الوصية.
وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.
ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.
ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى للفقراء.
الوصية لأعمال الخير
الوصية الله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير کالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).
وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية
( كتب عليكم إذا حضر أحدكمم الموت إن ترك ځيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) [ البقرة:180].
قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بأيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،
. اختلف الفقهاء في الحد الفاصل بين ممن يحصون ومن لا يحصون، فقال محمد إن كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون، وبه أخذت المحاكم الشرعية في مصر، وقال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب فهم لا يحصون، وقال الشافعية: هم لا يمكن استيعابهم إلا بمشقة ..
وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.
أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238 ) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.
متى يشترط عدم الإرث ؟
الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.
هل تصح بإجازة الورثة ؟
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )).
وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.
متى تعتبر الإجازة ؟
قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها.
وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.
ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقاتل )) .
وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل وغيره.
وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.
وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).
اتحاد الدين:
ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطة في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).
حكم وصايا غير المسلمين :
إذا أوصی غیر مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:
. أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.
. أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصى مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق أبي حنيفة وصاحبيه.
وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).
د. شرائط الموصى به:
يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون :
– مالاً: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال. – منقوم: أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير.
– قابل للتمليك أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.
– أن لا يكون مستغرقاً بالدين: فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الآيات تقدم
الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية11 ]
فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.
– أن لا تزيد على الثلث: لقوله { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم } . وقوله (( الثلث والثلث كثير )).
هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟
ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.
أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.
تبطل الوصية في الحالات التالية:
– جنون الموصي جنونأ مطبقة متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.
– موت الموصى له قبل موت الموصي.
– هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.
– رد الوصية بعد وفاة الموصي.
– قتل الموصی له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقا.
– رجوع الموصي عن وصيته.
وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدار الحرب.
يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:
2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصی به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.
واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها .. إلخ.
وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد220 – 221 -222.
حكم الوصية بعد البطلان يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.
د. جحود الوصية:
إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوعة، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال،
أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوع حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقا منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئاً عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور.
وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون. الوصية بالثمرة
إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان فإن جاء النص فيها على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت كذلك، وإن نص في الوصية على الثمرة الموجودة له حال وفاة الموصى كان له ما كان موجودة منها عندئذ، فإن لم يوجد شيء فلا شيء له وكذلك لو قام الدليل على أن الموصي أراد ما كان موجودة منها عند وفاته ولو لم ينص على ذلك، وإن جاعت الوصية مطلقة كان للموصى له ما كان موجودة عند الوفاة وما يوجد في المستقل طول حياته، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.
وإلى هذا ذهب الشافعية وبه أخذ القانون (المادة 249 )
أما فقهاء الحنفية فقد قالوا بذلك فيما إذا كانت الوصية بالغلة، وأما إذا كانت الوصية بالثمرة فقالوا: إن له ما كان منها قائمة وقت الوفاة لا ما سيوجد في المستقبل، لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعلوم إلا بدلالة زائد کالتنصيص على الأبد، وأما الغلة فتنتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أخرى عرفة.
نفقات الموصى بها
إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة، وبالرقبة لجهة أخرى، صحت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين وسائر نفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة ( المادة 250 )
بيع الموصى بمنفعته
يجوز للورثة بيع العين الموصی منفعتها أو أن يبيعوا نصيبهم منها وهذا رأي الجمهور ومعه القانون ( 251 ) ف 2، وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إجازة الموصى له.
الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، ولا تجب على الشخص إلا بحق الله أو للعباد.
ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين الايرثون، لحجبهم عن الميراث، أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين وقد أخذ القانون المصري (م 76 .79 ) والسوري (م 257 ) بالرأي الثاني، فأوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكمة كالغرقی.
أوجب القانون المصري هذه الوصية لأولاد الابن مهما نزلوا، وللطبقة الأولى فقط من أولاد البنات، أما القانون السوري فإنه قصر هذه الوصية على أولاد الابن فقط، ذكورا وإناثا، دون أولاد البنت؛ لأن هؤلاء لا يحرمون من الميراث في هذه الحالة لوجود أعمامهم أو عماتهم، وإنما هم من ذوي الأرحام الذين يرثون في رأي الحنفية عند عدم ذوي الفروض والعصبات. والأولى الأخذ بما ذهب إليه القانون المصري تسوية بين فئتين من جنس واحد سواء لطبقة واحدة أم لأكثر .
( تم تعديل القانون السوري في عام 2019 ليشمل أولاد البنت ايضاً)
اشترط القانون المصري والسوري لوجوب هذه الوصية شرطين:
الأول . أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفي: فإن ورث منه، ولو میراثة قليلا لم يستحق هذه الوصية.
الثاني . ألا يكون المتوفي قد أعطاه مايساوي الوصية الواجبة، بغير عوض عن طريق آخر كالهبة أو الوصية.
مقدار الوصية الواجبة.
يستحق الأحفاد حصة أبيهم أو أمهمم المتوفي لو أن أصله مات في حياته، على ألا يزيد النصيب عن الثلث، فإن زاد كان الزائد موقوفا على إجازة الورثة. هذا هو مقدار الوصية الواجبة في القانون.
إذا أوصي بعدة وصايا وزادت في مجموعها عن الثلث ولم تجز الورثة إلا إنفاذ الثلث فقط أو أجاز الورثة انفاذها ولكن التركة لا تكفي فهناك صورتان:
الأولى:
أن تكون كل واحدة من الوصايا لا تزيد على الثلث، کسدس الواحد وثلث لأخر، فيضرب كل سهم في الثلث، أي يأخذ كل واحد من الوصية بنسبة وصيته من الثلث، ولا يقسم الثلث أو التركة في الحالة الثانية بينهم بالسوية اتفاق
الثانية:
أن تكون إحداهما تزيد على الثلث، كثلث لواحد وثلاثين لأخر فعند أبي يوسف ومحمد يقسم بحسب السهم أيضا كما في الصورة الأولى، فإذا أوصى لخالد بثلث ماله ولبكر بثلثي ماله قسم الثالث بينهما أثلاثة، فلخالد واحد ولبكر اثنان.
وعند أبي حنيفة يقسم بينهما مناصفة، فلكل من خالد وبكر في المسألة السابقة نصف الثلث أو نصف التركة.
إذا أوصى بوصايا تزيد عن الثلث وكلها من حقوق الله تعالى، فإما أن تكون متحدة الرتبة، أو متفاوتة الرتبة، أو مختلطة.
فإذا كانت متحدة الرتبة بأن كانت كلها فرائض كالحج والزكاة أو كلها واجبات أو كلها مندوبات: يقدم فيها في رأي أبي حنيفة وصاحبيه ما بدأ به الميت أولا، فإذا أوصى بحج وزكاة، قدم الحج.
وإذا أوصى بكفارة يمين وكفارة ظهار، قدمت الوصية الأولى، فإن فضل شيء من الثلث فللثانية.
وإذا كانت متفاوتة الرتبة: كأن كان بعض الوصايا بالفرائض، وبعضها بالواجبات كصدقة الفطر عند الحنفية. وبعضها بالمندوبات كحج التطوع، قدم الفرض ثم الواجب ثم المندوب.
أما إذا تزاحمت بين حق الله والعباد، كما إذا أوصى للحج والزكاة ولزيد والكفارات، فإنه يقسم الثالث أو التركية على جميعها، وتجعل كل جهة من حقوق الله مفردة بسهم، ولا تجعل كلها سهما واحدة، فللحج ربع الثلث وللزكاة ربع الثلث، ولزيدربع الثالث وللكفارات ربع الثالث. هذه الأحكام التي فصلناها في تزاحم الوصايا قد أجملت أكثرها المادتان (258. 259 ).

القوامة مصطلح قانوني يعني إدارة أموال المجانين والمعتوهين والسفهاء والمغفلين .
والمكلف بذلك هو القيم، وهو في إدارة أموال هؤلاء بمثابة الولي والوصي في إدارة أموال القاصرين من حيث الشروط والصلاحيات والأحكام إلا في بعض الأحكام.
ذكر بعض الفقهاء أنه إذا طرأت بعض عوارض الأهلية التي هي بمثابة أسباب القوامة، وهي: الجنون، والعته، والسفه، والغفلة بعد البلوغ والرشد فإن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه، بينما ذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى أن الولاية تعود للأب أو للجد إذا كان السبب جنونا أو عتها، أما إذا كان السبب سفها أو غفلة فإن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه من جهتهه.
وإذا كان السبب فيه قائمة قبل بلوغه، ثم استمر معه إلى ما بعد البلوغ، فإن الولاية على المال تستمر الأبيه وجده لدى الجمهور مادام السبب جنوناً أو عتها، أما إذا كان السبب سفها أو غفلة فإن الولاية على المال تستمر لأبيه وجده عند الشافعية وبعض الحنفية، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه من جهته.
أما قانون الأحوال الشخصية السوري فذهب إلى أن عوارض الأهلية من الجنون والعته والغفلة والسفه إذا كانت قبل البلوغ واستمرت بعده فإن الوصاية والولاية على المال تستمر للأب والجد، وهو موافق لجمهور الفقهاء. فقد نص القانون على ذلك في الفقرة (4) من المادة ( 163):
“تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهة أو مجنونة فتستمر الولاية عليه من غير حكم”.
وأما إذا طرأت هذه العوارض بعد البلوغ فإن الأمر يعود للقاضي، ولمن يعينه قيمة عليهم. وهذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة( 200):
1- المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما، ويقام على كل منهما قيم بوثيقة.
2- السفيه والمغفل يحجران قضاء، وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة، ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة.
3- السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيرة.
4- المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه، ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته.
يلاحظ أن القانون عد المعتوه كالمجنون في تصرفاته ولم يفرق بين ما إذا كان مميزة أم غير مميز، لذلك فإن جميع أحكام المجنون من حيث الحجر وصحة التصرفات وبطلانها تنطبق على المعتوه.
بينما ذهب بعض الحنفية إلى أن المعتوه إذا غلب على أمره فذهب عقله فإنه يعد مجنونة ويأخذ حينئذ حكم المجانين، والا يأخذ حكم الصبي المميز.
ان السفيه: الذي يبذر أموله ولا يحسن التصرف فيها على مقتضى الشرع والعقل،
والمغفل: الذي لا يعرض مصلحته في أثناء تصرفاته، فيغبين في المعاوضات.
فالسفيه والمغفل عقلهم سليم ولكن ينقصهم حسن التدبير والتصرف. والعته مرض يستر العقل فيمنعه من الإدراك الصحيح، وهو نوع من الجنون يصحبه هدوء، وقد يكون معه تمييز فيأخذ صاحبه حکم الصبي المميز، وقد لا يكون مميزة فيأخذ حكم المجنون
الوكيل القضائي هو النائب الشرعي عن المفقود والغائب لعجزهما عن التصرف بسبب الفقد والغيبة، فيشرف على أموالهما ويحافظ عليها. والفقهاء يحدون من تصرفات الوكيل القضائي ضمن حدود التصرفات الضرورية، لذلك يجيزون له حفظ الأموال وإدارتها دون استثمارها، وهذا بخلاف الولي والوصي .
إن أحكام الوكيل القضائي من حيث شروطه وصلاحياته وتعيينه وعزله…إلخ يسري عليه فيها ما يسري على الوصي والقيم – إلا ما استثني بنص – في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي تناول أحكام الوكالة القضائية عبرالمواد الآتية:
المادة 202): المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.
المادة: 203): يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه، أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه، مدة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غیره.
المادة: 204): إذا ترك المفقود وكيلا عامة تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، والا عينت له وكيلا قضائيا.
المادة: 205). 1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود، أو بموته، أو بالحكم باعتباره ميت عند بلوغه الثمانين من العمر.
2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية، أو الحالات المماثلة المنصوص عليه في القوانين العسكرية النافذة، والتي يغلب عليه فيها الهلاك، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه.
المادة: 206): يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنی بنص صريح.
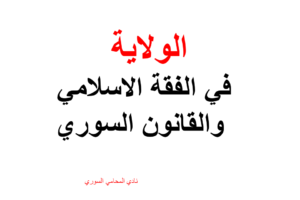

مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم – بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم أعجزتهم عن التصرف فيما يحتاجون إليه- يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم، لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمل دراسة الولاية، والوصاية والقوامة والوكالة القضائية. وسنبحث هذه الموضوعات في هذا الفصل.
وقد جاء في المادة:( 163) من قانون الأحوال الشخصية السوري:
3 – الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.
الولاية في اللغة بفتح الواو وكسرها: النصرة،والسلطة، قال تعالى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 257] أي ناصرهم.
والولاية في اصطلاح الفقهاء، هي:” سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء محل الولاية تصرفا نافذا”.
و بمعنى آخر: الولاية سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات، وتترتب عليها الآثار الشرعية .
أو هي: إنشاء العقود نيابة عن الغير بحكم الشرع.
ويبدو عبر ما ذكرناه سابق عن أهلية الأداء الكاملة وآنفاً عن الولاية أن هناك فرق بينهما:
1- أهلية التصرف (أهلية الأداء الكاملة): هي الولاية القاصرة على ذات الشخص المتصرف»، وهي تثبت للراشد العاقل، وبها يتمكن من إنشاء العقود النافذة غير الموقوفة على إجازة أحد.
أما الولاية: فإن أثرها يتعدى إلى الغير، وهي شرط لنفاذ العقد وترتب آثاره الشرعية عليه. ثم إن الولاية لا تثبت إلا لكامل الأهلية، أما ناقص الأهلية؛ كالمميز والسفيه فلا ولاية له على غيره.
تنقسم الولاية من حيث مصدرها إلى قسمين: ولاية قاصرة أو ولاية ملك، وولاية متعدية.
1- الولاية القاصرة أو ولاية الملك:
وهي ولاية كامل الأهلية البالغ العاقل على نفسه وماله.
وهذه الولاية فرع عن الملك، ومرافقة له ما لم تكن أهلية الملك ناقصة، فإذا كانت كذلك لعارض من العوارض التي ذكرناها، أو كان المالك صغيرة (لم يبلغ بعد الأهلية الكاملة) فإنها تنزع منه هذه الولاية عن ملکه ونفسه كلية أو جزئية بحسب النقص الذي طرأ على أهليته، أو لم تثبت له أصلا كليا أو جزئية إذا كان بعد صغيرة سواء أكان مميزة أم غير مميز.
وإن مصدر ولاية الملك حقيقة هو( الله تعالى) المشرع؛ لأنه استودع الناس واستخلفهم على ما في أيديهم، قال تعالى:
( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد، الآية7].
لذلك أطلق الله يد الإنسان على ما عنده من أموال واستخلفه فيها مادام بالغ عاقلا، وجعله والياً عليها مالم يصب بعارض من عوارض الأهلية، فإذا ما أصيب بذلك فإن الله تعالى يسترد سلطته على ماله ونفسه وحينئذ يفوض الله تعالى هذه السلطة إلى الغير.
2- الولاية المتعدية :
و تعطي صاحبها حق التصرف على غيره، حيث تتعدى المالك إلى غيره، وهي نوعان حسب مصدرها المباشر:
فإذا كان مصدرها المباشر المالك فتسمى وكالة، ومحل دراستها فقه المعاملات.
وإذا كان مصدرها المباشر المشرع تسمی: نيابة شرعية، وهي محل دراستنا.
وتنقسم النيابة الشرعية من حيث سببها إلى قسمين:
سبب هذه الولاية هو القرابة؛ كولاية الأب على أولاده القاصرين ، وولاية الأخ على إخوته القاصرين… إلخ، ويدخل في هذه الولاية ولاية من ولاه القريب؛ كولاية وصي الأب ووصي الجد… إلخ.
ومستند هذه الولاية قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . [البقرة: 282].
2- ولاية السلطة العامة:
وهي للحاكم الذي تثبت ولايته على كل قاصر أو ناقص الأهلية إذا لم يكن هنالك ولي قرابة مستحق للولاية عليه.
وينوب عن الحاكم في هذه الولاية القاضي الذي هو ولي من لا ولي له، فولاية القاضي فرع عن ولاية الحاكم.
وبينت المادة (24) من القانون السوري بمنطوقها :أن “القاضي ولي من لا ولي له”.
ومستند هذه الولاية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : { السلطان ولي من لا ولي له }.
وتنقسم ولاية القرابة وولاية السلطة العامة من حيث موضوعها إلى قسمين :ولاية على النفس وولاية على المال.
سلطة يملكها الولي، وتخوله الحق بتدبير شؤون القاصر المتعلقة بنفسه؛ كتربيته أخلاقية وعقلية ونفسية واجتماعية، ورعايته الصحية، وتعليمه، والإشراف على تزويجه…إلخ.
ترتيب الأولياء على النفس :
تثبت هذه الولاية للأب ثم للجد العصبي ثم لأقربائه من العصبات. فالمقدم هو الأب، ثم الجد العصبي، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم أخو الأب من أبيه، ثم أبناؤهما وهكذا.
وقد أخذ القانون السوري برأي الجمهور فقصر الولاية على النفس على العصبات عبر المادة (21) فقال:” الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرمة”. وجاء ترتيب هؤلاء في (المادة 275) : العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- البنوة، وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.
2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
3- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام جده العصبي إن علاء وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على النفس: (المادة170):
4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سببة لإسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سببا مسقط لحضانتها .
المادة171): إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به عن المحكمة وصية خاصة على هذا المال.
سلطة تمنح الولي التصرف في شؤون القاصر المالية، عبر الإشراف عليها وإدارتها، وحفظها وتنميتها، والإنفاق من أموال القاصرين عليهم بما تقتضيه مصلحتهم وحاجاتهم.
و تصح تصرفات الولي نيابة عن المولى عليه، معاملة ومعاوضة؛ كالبيع أو شراء أو الإجارة أو الوكالة…إلخ مادامت تصرفات الولي في حدود المعتاد وفي مصلحة المولى عليه على تفصيل عند الفقهاء في بعض التصرفات
وقد تجتمع ولاية النفس وولاية المال في بعض الأشخاص، وهم الأب والجد والحاكم.
– ترتيب الأولياء على المال:
يقدم في ولاية المال الأب، ثم الجد، ثم وصي الأب، ثم وصي الجد، ثم القاضي، ثم وصيه.
– وقد يقدم بعض الفقهاء ؛ كالحنفية وصي الأب على الجد ووصي الجد على القاضي – وهذا المعمول به في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي نص في الفقرة الأولى من المادة (170)
على أن ” للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملزمان بالقيام بها”.
وقد أكد ذلك القانون في المادة (172) بأنه للأب والجد الولاية على وضع اليد على مال القاصر على ألا يكون الغيرهما هذا الحق.
غير أن القانون السوري عاد فبين جواز وصاية الأب والجد في الفقرة الأولى من المادة (176) بقوله: يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصية مختارة لولده القاصر أو الحمل وله أن يرجع عن إيصائه”.
وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على المال:
المادة:172):
المادة: 173):
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها.
ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، وبعد سماع أقوال الولي.
المادة 174):
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقودة، أو حجر عليه، أو اعتقل، وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع، ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي أخر.
المادة175):
تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.
شروط الولي على المال:
هناك شروط عدة ذكرها الفقهاء في الولي على المال يمكن بيانها في الجملة في ما يأتي :
1- أن يكون كامل الأهلية، أي: أهلية الأداء الكاملة، ويكون ذلك بالبلوغ والعقل، وناقص الأهلية ليس له ولاية على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيره.
2- الرشد: وهو حسن التصرف بالمال، وأضاف الشافعية: الرشد الديني.
3- العدالة الظاهرة :وهي صفة في النفس تحمل صاحبها على تقوى الله تعالى التي تقتضي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.
فإن زالت عدالة الولي الظاهرة عبر ظهور فسق عزله القاضي، ونزع الولاية منها، وكذا ينعزل القاضي عن الولاية إذا زالت عدالته وإمامته وظهر فسقه.
4- أن لا يكون محجورة عليه لسفه وتبذير؛ لأن المحجور عليه ليس له ولاية على أمور نفسه فلا يلي أمور غيره.
5- أن يكون متحد الدين مع من هو تحت ولايته؛ كالقاصر والسفيه ونحوه، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور ابنه المسلم، لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
6- الحرية: فلا ولاية لعبد.
واجبات الولي و حقوقه:
1- حفظ المال:
جعل العلماء حفظ مال القاصر من واجبات الولي التي يعاقب على التقصير فيها، لذلك أذنوا له بكل الوسائل المشروعة التي من شأنها المحافظة على مال القاصر؛ كوضع ماله في مكان أمين، واستئجار حارس لحفظه عند الحاجة وتكون الأجرة حينئذ من مال القاصر وليس من مال الولي… إلخ.
والولي أمين على هذا المال، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولذا عليه أن يصونه، وقد حذر القرآن من أكل أموال اليتامى إذ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا [النساء: 10].
ويقاس على اليتامى غيرهم ممن يحجر عليهم في التصرفات المالية ويكونون تحت رعاية غيرهم من ولي أو وصي.
2- تنمية المال وتثميره:
تثمير مال القاصر حق للولي وليس واجبة عليه؛ لأن الاستثمار يحتاج إلى خبرة، وقد لا تكون متيسرة في الولي، ثم إن التثمير في حقيقته تعريض المال للخطر لذلك لا يمكن جعله واجبة على الولي، فإذا وجد الولي في نفسه القدرة على الاستثمار، وكان في ذلك مصلحة لمن تحت ولايته فله أن يستثمر هذا المال بالطرق الشرعية؛ كالمشاركة والمضاربة، والإجارة…إلخ.
ومستند جواز التثمير قول النبي : «ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها . أو : لا تستهلكها . الصدقة».
أي تاجروا في أموالهم واطلبوا لهم الربح فيها، حتى تؤدوا الزكاة من الربح، ولا يذهب أصل المال بأدائها.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (172) على ضرورة حفظ الولي مال من هو تحت ولايته وتنميته فقال: “للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً”.
3- أن ينفق على من تحت ولايته من ماله حسب الحاجة، من غير إسراف ولا تقتير، حتى لا يضيع هؤلاء.
قال تعالى : و ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وازقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا [النساء: 5].
التبرع بمال القاصرين و الانتفاع به:
ليس لمن ولي قاصراً أن يتبرع بشيء من ماله ولو لوجوه الخير؛ لأنه تصرف مضر ضررة محضة بالقاصر، وهذا موضع اتفاق لدى جميع الفقهاء. وقد جاء نص القانون متفقا مع رأي الفقهاء في هذا الموضوع.
وأما انتفاع الولي بمال من تحت ولايته لنفسه :
فإن كان أبا أو جداً، وكان مستغنياً بماله، فليس له أن يأخذ شيئا من مال من تحت ولايته، لأن من واجبه أن يرعى مصالحه، عملا بقوله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (19).
فإن كان الأب أو الجد غير مستغن بماله ومحتاجة إلى النفقة جاز له أن يأخذ من مال من تحت ولايته قدر كفايته من غير إسراف ولا تقتير، ويكون ذلك من قبيل نفقة الفروع على الأصول ، الا من قبيل الأجرة على الولاية.
دل على ذلك قوله تعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) [النساء: 6].

س 275 – هل يمكن إجراء التقاص بين مبلغي المطالبة بأجر المثل من خصم قابله الخصم الآخر بادعاء بالتقابل بالمطالبة بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية ؟

ج 275 – نعم ، ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى وبترك الثانية لدعوى
جديدة ) نقض رقم 42 أساس عقاري تاريخ 17 / 3 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 219 () المحامون العددان 11 و 12
السنة 75 لعام 2010 ص 1649 )
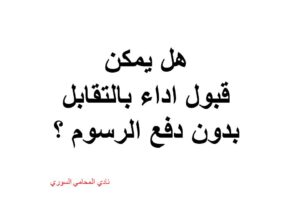
س 277 – قدم المدعى عليه ادعاء متقابل دون أن يسدد رسم هذا الادعاء، فتمت الاستجابة إلى طلبه وحُكم لمصلحته فيما يدعيه .
ما الحكم القانوني لهذا الادعاء المتقابل ؟
ج 277 – لما كان الادعاء المتقابل يُعامل معاملة الادعاء العادي ، فلا يعتبر الطلب ادعاء إلا إذا سُدد الرسم المتوجب والطابع، وإلا يتوجب على المحكمة عدم الأخذ بهذا الادعاء .
( نقض غرفة مدنية 2 أساس 409 قرار 530 تاريخ 20 / 3 / 2006
( المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 108 )