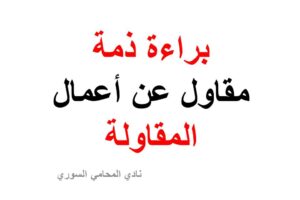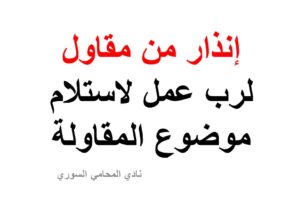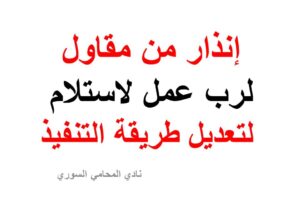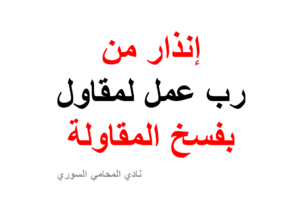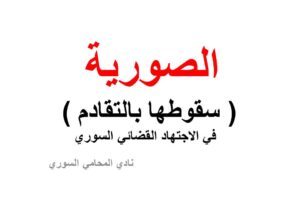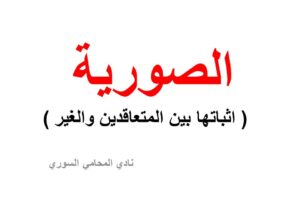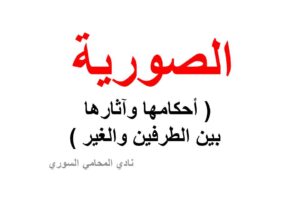إثبات دعوي الصورية
الأصل في العقود والالتزامات أنها حقيقية فالصورية لا تفترض البتة، ومن يدعيها يدعي خلاف الظاهر والأصل وعليه أن يثبتها . وعلى ذلك نصت المادة / ۱۳ / مدني سوري
“ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت مايدعيه “
فالتمسك بأن عقد البيع يستر وصيه هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية، فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه .
وإثبات الصورية يكون طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .
المطلب الأول
إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين
إن إثبات التصرفات القانونية طبقا للقواعد العامة لا يجوز بغير السند المكتوب متی زادت قيمة الالتزام على النصاب القانوني المحدد ؛ الذي فيما دونه يجوز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن القضائية أو إذا كان المراد هو إثبات ما يخالف ما هو ثابت بالدليل المكتوب أيا كانت قيمة الالتزام (المواد 54 – 55 بينات سوري).
ولذا يجب على كل من يبرم تصرفاً صورياً يثبته في محرر أن يحصل على محرر أخر يثبت فيه حقيقة التصرف ويوقع عليه الطرف الآخر، مهما كانت قيمة الالتزام ليستطيع أن يثبت به صورية العقد الظاهر الثابت بالكتابة، ويسمى المحرر الذي يثبت الصورية ورقة الضد .
وإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد هو سبب صوري يستر سببة حقيقية، وهي الصورية النسبية فإنه إذا كان السبب الحقيقي مشروعة وجب على المدين أن يثبته بالكتابة وفقاً للقاعدة المتقدمة.
وهذا سواء كان العقد الظاهر ثابتا بسند رسمي أم بسند عادي، على ذلك نصت المادة (3/ 6 بين مات سوري ) حيث جاء فيها :
“وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها “.
وقد ورد في المذكرة الإيضاحية بخصوص هذا النص ” إن النص الجديد جاء أكثر انطباق على الواقع لأنه يظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن،
فالأفعال المادية حجة على جميع الناس ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير لأنها أمور تثبت منها الموظف العام فتثبت ثبوتاً مطلقاً كما لو بين الموظف العام بسند منظم أن أحد العاقدين دفع مبلغا من النقود إلى أخر بحضوره فيكون الدفع أمراً ثابتاً تجاه الناس فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير .
أما البيانات الصادرة عن ذوي الشأن فتعد صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها، كم ما لو أقر أحدهم بعقد وسجل الموظف العام هذا الإقرار، ففي هذه الحالة يكون وقوع الإقرار أمراً مقرراً لا يجوز إنكاره إلا بطريق الطعن بالتزوير، أما الواقعة المتنازع عليها التي تضمنها الإقرار فيجوز إثبات عکسها من غير حاجة إلى الطعن بالتزوير،
وبما أن الأستاد الرسمية هي في الأصل حجة تجاه جميع الناس فإن كل اتفاق خفي يراد به تعديل الأسناد الرسمية لا يكون له مفعول إلا بين موقعيه .
وقد استنبطت هذه القاعدة من المبادئ العامة للصورية وعلى ذلك لا يكون للعقد الصوري وجود بين المتعاقدين وورثتهم، وإنما يسري في حقهم العقد الحقيقي المحرر في الأوراق السرية، أما الغير فلا يكون للعقد الخفي أثر ضده وإنما يحق له أن يستفيد منه.
على أن هناك أحوالاً استثنائية نصت عليها المادة 56 و 57 يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن القضائية فيما يجب إثباته أساساً بالكتابة .
فإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الصورية، أو وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على ورقة الضد، أو فقدت تلك الورقة بعد الحصول عليها لسبب أجنبي، جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى الشهادة أو القرائن لإثبات صورية العقد الظاهر ولو كان مكتوبة ولو كانت قيمته تجاوز النصاب القانوني.
من ذلك الصورية التي يقصد بها الإضرار بورثة أحد طرفي المعاملة الصورية رغم أنهم ليسوا من الغير كوصية أفرغت في صورة بيع منجز، كما يجوز لهم الالتجاء إلى الشهادة أو القرائن لإثبات انعقاد التصرف في مرض الموت رغم أن التاريخ المكتوب سابق على بدء المرض، إذ يتعذر عليهم في مثل هذه الحالات الحصول على دليل كتابي للكشف عن التحايل . كما يمكن تفسير ذلك بمخالفة التصرف الحقيقي للنظام العام .
على أنه إذا كانت الصورية قد اتخذت وسيلة للتحايل على القانون، بقصد التخلص من اتباع الشرائط الموضوعية اللازمة لصحة التصرف الحقيقي أو نفاذه، جاز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات . ولو كان العقد الصوري ثابتة بالكتابة. من ذلك أنه يجوز للمتعاقد ولخلفه العام أن يلجأ إلى الشهادة والقرائن لإثبات أن حقيقة العقد هبة دفع إليها باعث غير مشروع، أو أن المشتري الحقيقي هو أحد عمال القضاء، أو أن التاريخ الحقيقي للعقد لاحق للتاريخ المكتوب إذا كان المتعاقدان قد قدما التاريخ لجعله سابقا على تاريخ الحجر بغية إظهار العقد صحيحاً غير قابل للإبطال خلافا لما يقضي به القانون في تصرفات المحجور عليهم .
ويبرر بعض الشراح الإثبات بجميع الطرق في مثل هذه الحالات أنها تتضمن مانعا حال دون الحصول على ورقة الضد، ومن ثم فهي تدخل في عموم المادة 57/أ بينات سوري.
إذ إن المتعاقد الذي تم التحايل لمصلحته لن يرتضي أن يقدم للطرف الأخر أو لخلفه العام ورقة مكتوبة لإثبات التحايل ..
ويرتب هؤلاء على هذا التفسير أنه إذا كان التحايل لمصلحة المتعاقدين معا وقصد به الإضرار بالغير ممن ليس طرفاً في التصرف الصوري أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فلا يجوز لأي من الطرفين أو للخلف العام أن يثبت ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
ذلك أنه لم يكن هناك ما يمنع المتعاة دمن الحصول على ورقة ضد .
إذ لا يوجد ما يدعو المتعاقد الأخر إلى أن يمتنع عن إعطائه تلك الورقة فليس هناك ما يخشاه من ذلك مادام التحايل قد قصد به مصلحتهما معاً أو على الأقل مصلحة أحدهما دون أن يكون العقد الحقيقي ضد مصلحة الأخر.
وعلى ذلك إذا طالب البائع أو خلفه العام، المشتري بدفع ثمن أكبر من الثمن المذكور في العقد، بدعوى أن هذا الثمن أقل من الثمن الحقيقي وأن إظهار البيع بثمن أقل كان يقصد به إنقاص رسوم التسجيل، فلا يجوز إثبات حقيقة الأمر إلا بالكتابة، إذ إنه بالنسبة للمتعاقدين لم يكن هناك مانع يحول دون الحصول على ورقة الضد.
ويفسر بعضهم هذا الحكم بقاعدة الغش يفسد كل ما يقوم عليه أو بحماية المصلحة العامة التي تتحقق بتسهيل إثبات التحايل لتبرير إجازة الإثبات بكل الطرق في هذه الحالات .
والتعليل الذي نرجحه هو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من التفريق بين نوعين من التحايل على قاعدة متعلقة بالنظام العام، ويترتب عليه جواز الإثبات بكل الطرق، والتحايل الذي لا يراد به مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام، وهو لا يكفي للخروج على قاعدة وجوب الإنبات بالكتابة .
وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 27 من قانون البينات السوري من أنه يجوز الإثبات بالشهادة مطلقاً في الالتزامات التعاقدية إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب .
وقد عدت محكمة النقض السورية أن إبرام المورث بيعة صورياً مع زوجة وارثه، بغية تأمين منفعة له على حساب باقي الورثة إنما يخالف النظام العام، الذي لا يجيز الوصية للوارث، مما يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، وإن لم تكن الزوجة المتعاقد معها صورياً وارثة للمورث، إذ إنها ليست المستفيدة الفعلية من ذلك التصرف بل زوجها الوارث .
المطلب الثاني
إثبات الصورية بالنسبة للغير
يجوز لغير أطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام أن يثبتوا صورية الالتزام بكل طرق الإثبات دون أن يفرض عليهم الإثبات بالكتابة ولو كان التصرف المطعون بصوريته ثابتاً بالكتابة لأنه من المتعذر والمستحيل على غير أطراف المعاملة الصورية أن يحصل على سند كتابي لإثبات صورية عقد لم يكن طرفاً فيه . (م 245/1 مدني سوري ) . وسواء كان عقد الخلف الخاص سابقاً أم لاحقاً للتصرف الصوري.
على أنه إذا كانت دعوى الصورية مسألة أولية في الدعوى غير المباشرة، كأن يكون الثمن الحقيقي أكبر من الثمن المثبت في العقد الصوري ويريد الدائن أن يطالب باسم مدينه بالثمن الحقيقي . فيجب عليه أن يثبت صورية الثمن، فإذا كان العقد الصوري ثابتا بالكتابة، وجب على الدائن أن يثبت صورية الثمن المسمى بالكتابة إذ هو في هذه الحالة يقوم مقام المدين، فهو ليس من الغير، بل هو نائب عن المدين فتسري عليه قواعد الإثبات التي يخضع لها المدين .