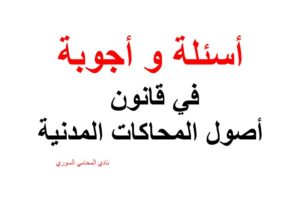س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة
الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟

ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي
الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص
( نقض قرار 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 )
(استانبولي ج 2 ص 1697 )