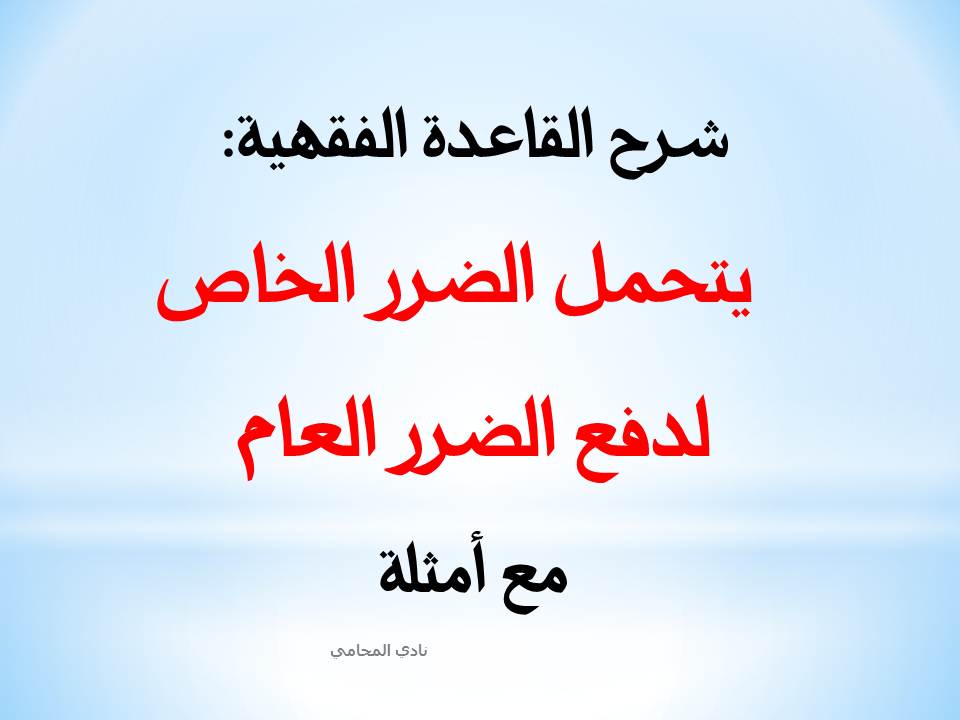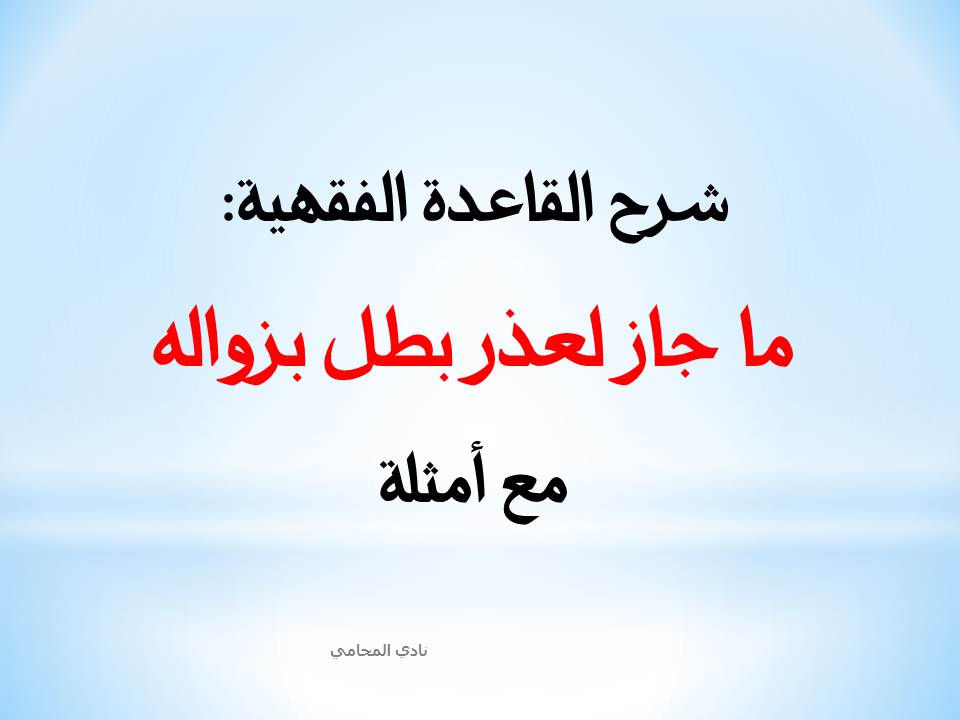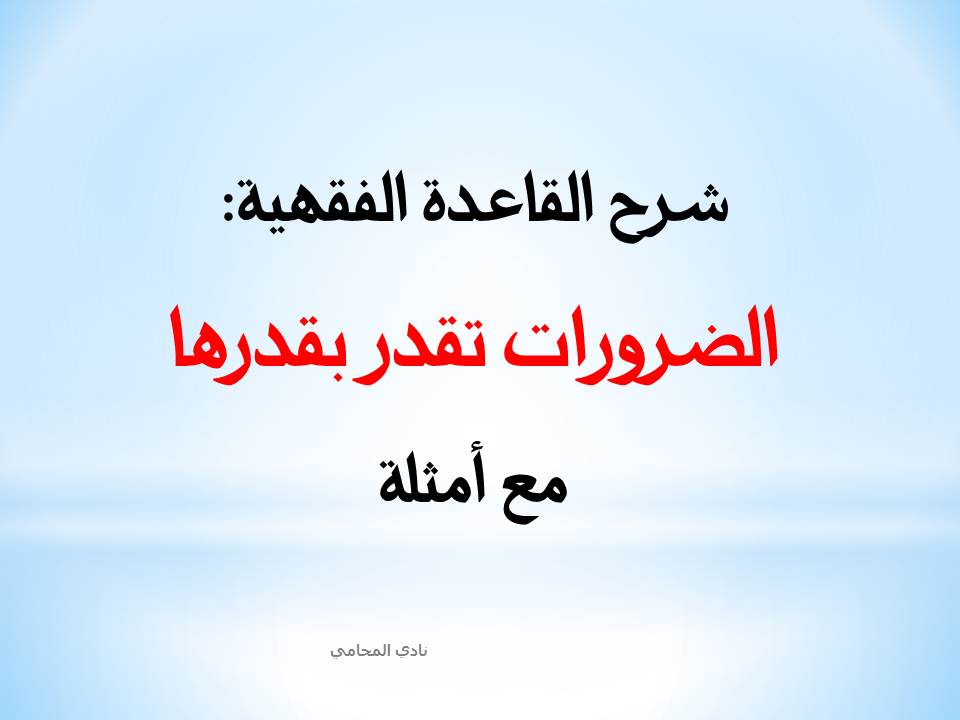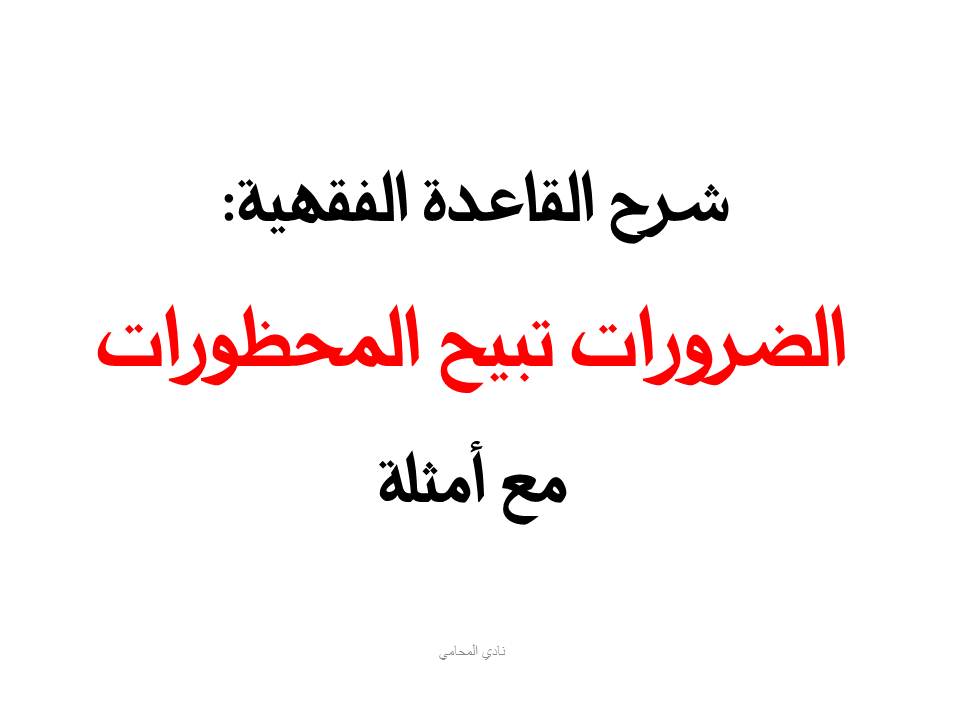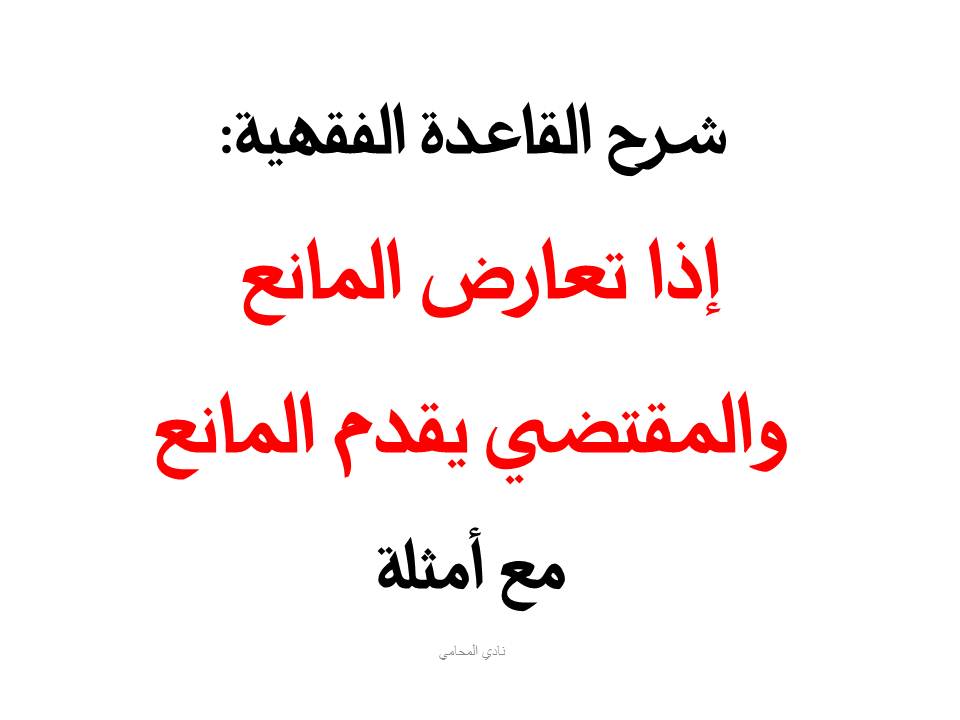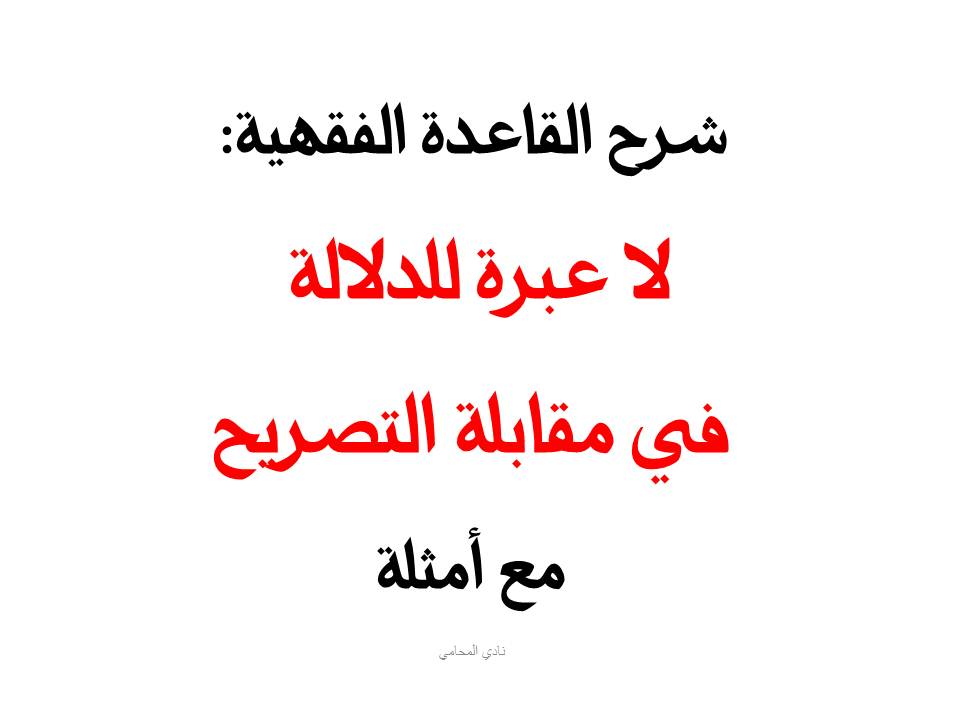إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
يقدم المانع على المقتضي لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» .
ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة هي : (إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام)، وهي لفظ حديث أورده جماعة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال»، قال العراقي: هذا حديث لا أصل له، وضعفه البيهقي وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود، وذكره الزيلعي شارح الكنز في کتاب الصيد مرفوعاً، وقال السيوطي في شرح التقريب: قول المحدثين هذا لا أصل له أي لا سند له.
فإذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة يقدم التحريم احتياطاً، وعلله الأصوليون بتقليل النسخ ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جعل المبيح متأخراً كان المحرم ناسخاً للإباحة الأصلية ثم يصير منسوخاً بالمبيح.
وعلة تقديم التحريم ـ كما يقول العلامة الحموي ـ فقط للاحتياط، وقد روي عن عثمان له لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك يمين قال : (أحلَّتهما آية وحرمتها آية، والتحريم أحب إلينا ) .
وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، ورفع الإباحة ليس نسخاً، إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي فحينئذ يكون تقليل النسخ في تقديم المبيح. .
من هذه القاعدة حديث” لك من الحائض ما فوق الإزار”، وحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح” فإن الأول يقتضي تحريم . ما بين السرة والركبة والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فرجح الشيخان التحريم احتياطاً والترخيص في غير شعار الدم عملاً بالثاني. .
ومنها: بطلان كل القضاء وكل الشهادة إذا بطل بعضهما، كما لو قضى القاضي أو شهد الشاهد لمن تقبل شهادته له ولمن لا تقبل بطل في كليهما . . وكذا اختلاف الشاهدين مانع من قبول الشهادة كأن طابق أحدهما الدعوى والآخر خالفها لغلبة المانع على المقتضي.
ومنها : لو اشتبه وجود مَحْرَمة بين أجنبيات لم يحل الزواج بإحداهن لأن الأصل في الأبضاع التحريم.
ومنها : لو طلق إحدى زوجتيه مبهماً حرم وطء واحدة منهما ديانة قبل التعيين .ولو وطىء واحدة منهما كان تعييناً لطلاق الأخرى؛ لأن الطلاق واقع على أحديهما مبهماً في نفس الأمر، فإذا نوى واحدة معينة منهما وقع عليها وإن لم ينو واحدة منهما عند الطلاق، فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره. .
ومنها : لو أسلم وتحته أختان أو أم وبنت بطل النكاح، وإن رتب فالأخيرة، وخيّره محمد في اختياره إحدى الأختين أو البنت أو أمها.
وكذا لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار وهو قول محمد، وقول الشيخين ببطلان النكاح . وسبب البطلان هو نكاحهن بعقد واحد، وإلا فلحديث غيلان .
لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة فزاد الناظر عليها، فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة , وصرّح بعضهم بالفساد فيما زاد على الثلاثة. .
ومنها : لو أقر شخص لوارثه ولأجنبي معه بمال في مرض موته لايصح . لأن الإقرار للوارث في مرض الموت لا يعتبر فيكون مانعاً ، وهذا مبني على الرأي المشهور في المذهب الحنفي من عدم تجزؤ الإقرار، ولو قيل بالنفاذ في حصة الأجنبي بناءً على نظرية إمكان تجزؤ الإقرار لكان وجيهاً.
تنبيهات :
– أولاً : ينبغي أن يقيد إطلاق القاعدة بما إذا لم يربُ المقتضي على المانع بأن تساويا، أما إذا ربا المانع كما في مسألة الخروج على الإمام الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من جوره فإنه حينئذ يقدم المانع، وإذا ربا المقتضي فالظاهر تقديم المقتضي بدليل ما ذكروه في المضطر إذا لم يجد ما يدفع به الهلاك عن نفسه إلا طعام الغير، فإنه يجوز تناوله جبراً عليه ويضمنه له لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. .
ثانياً : إن محل تقديم المانع على المقتضي إنما يكون إذا وردا على محل واحد، أما إذا لم يردا على محل واحد فإنه يُعطى كل منهما حكمه، فإنه لا تعارض عند انفكاك الأمرين إذ يمكن مراعاة المقتضي بدون أن يلزم المانع.
مثال ذلك: لو جمع بين من تحل له ومن لا تحل في عقد واحد صح في الحلال وبطل في الأخرى، وقد اتفق الإمام وصاحبيه في صحة عقد من تحلّ، واختلفوا في انقسام المسمى من المهر ، فقالا : يلزمه مهر مثل من صح نكاحها. وقال الإمام المسمى كله للتي صح نكاحها، . وكذا لو أوصى لأجنبي ووارث، أو أجنبي وقاتل فللأجنبي نصف الوصية ولا شيء للآخر على تقدير عدم الإجازة من الورثة؛ لأن بطلان التمليك لأحدهما لا يستلزم بطلان التمليك للآخر.
ثالثاً : المراد من تقديم المانع رعايته والعمل به، فهو مقدم في الرتبة والاعتبار لا في الزمن، فلو شهد اثنان أنه مات وهي امرأته وشهد آخران أنه طلقها قبل موته يفتى بأولوية بينة ،الطلاق وكذا بينة الخلع أولى من بينة النكاح، مع أن الطلاق أو الخلع يكونان أبداً بعد النكاح، فيترجح اعتبار الطلاق أو الخلع القائم عند وفاة الزوج وإن كان النكاح المقتضي لثبوت الإرث أسبق زمناً من الطلاق المانع. .
رابعاً : قد يتعارض المانع والمقتضي ولا يُقدم أحدهما على الآخر بل يعمل في كل منهما بما يقتضيه من ذلك لو قال لزوجته : إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنت طالق ثم أراد ألا يطلق امرأته فقالوا في الحيلة من ذلك ما روي عن الإمام أبي حنيفة كما لله أن يقول لها : أنت طالق ثلاثاً على ألف درهم، فتقول له : لا أقبل، فإذا قالت ذلك ومضى اليوم كان الزوج باراً في يمينه ولا يقع الطلاق .وهذا لا يُخرج كلام الزوج من أن تطليقاً قد حصل، فالمقتضي هو إيقاع الزوج للطلاق الثلاث على ألف والمانع هو رد المرأة وعدم قبولها . .
خامساً : قد يطرأ المانع على المقتضي قبل حصول المقصود من المقتضي فيقدم المانع، كما لو شهد لامرأة أجنبية ثم تزوجها قبل القضاء بشهادته بطلت شهادته، وكذا لو شهد لأجنبية ثم صار أجيراً خاصاً عندها تبطل شهادته أيضاً .
– سادساً : العقود التي لا تبطل بالشروط الفاسدة كعقد النكاح يغلب فيها الحلال على الحرام، أما العقود التي تفسدها الشروط الفاسدة فيغلب فيها الحرام على الحلال ، فمن أمهر زوجته على شياه وخنازير صح العقد على الشياه دون الخنازير ومن ابتاع على خل وخمر فسد البيع ووجب فسخه.
– سابعاً : في عقود البيع إذا اجتمع الحلال والحرام في صفقة واحدة، فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الميتة والذكية يسري البطلان إلى الحلال، وإن كان الحرام مالاً كالجمع بين وقف وملك فلا يسري البطلان إلى الحلال، لأن الوقف مال والميتة ليست بمال .
ويخرج عن هذه استثناءات، منها من كان أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي، فإنه يحل نكاحه وذبيحته ويجعل كتابياً.
ومنها : لو اختلط لبن المرأة بماء أو دواء أو بلبن شاة، فالمعتبر الغالب، وإذا استويا تثبت الحرمة احتياطاً، واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى، والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة ومنها لو سمى من المهر ما يحل وما يحرم، كأن تزوجها على دراهم وخمر صح في الدراهم وبطل في الخمر، وبدل الخلع كالمهر، واشتراط هذا المهر بمنزلة الشرط الفاسد والنكاح والخلع لا يبطلان بالشروط الفاسدة. .
ومنها : لو زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان أباً أو جداً صح عليه وإلا فسد النكاح ، وقيل يصح بمهر المثل ومنها : إذا جمع في الشهادة بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز كإن مات بعد أن وقف على فقراء جيرانه فأنكرت الورثة الوقف فشهد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهادتهما عند أبي يوسف، وصحة الشهادة مبنية على قلة الجيران الموقوف عليهم، وعند محمد لم تصح .