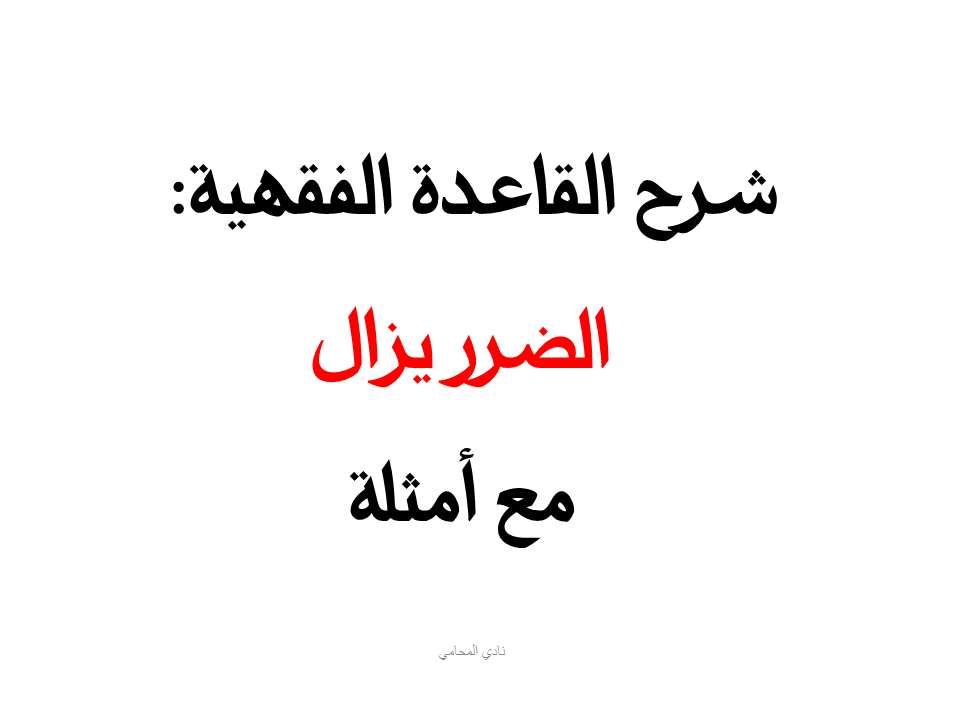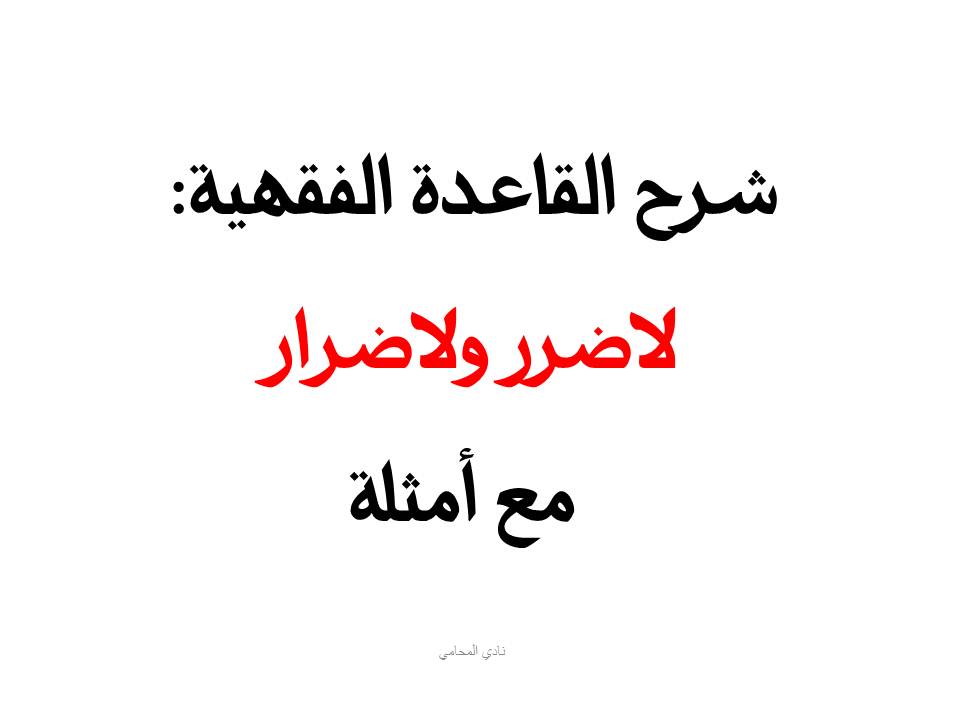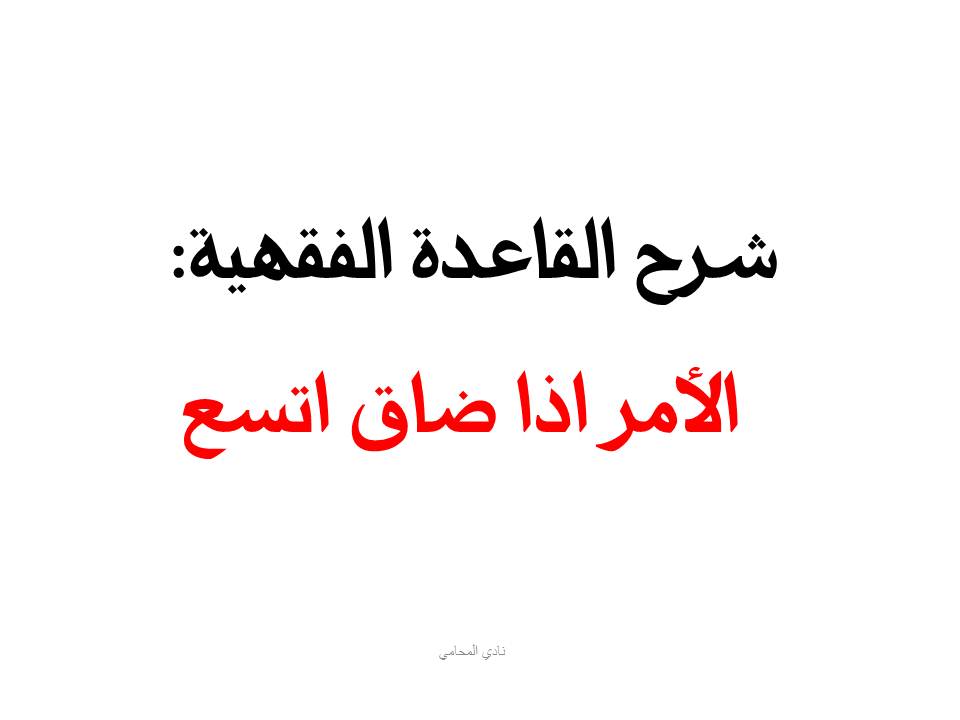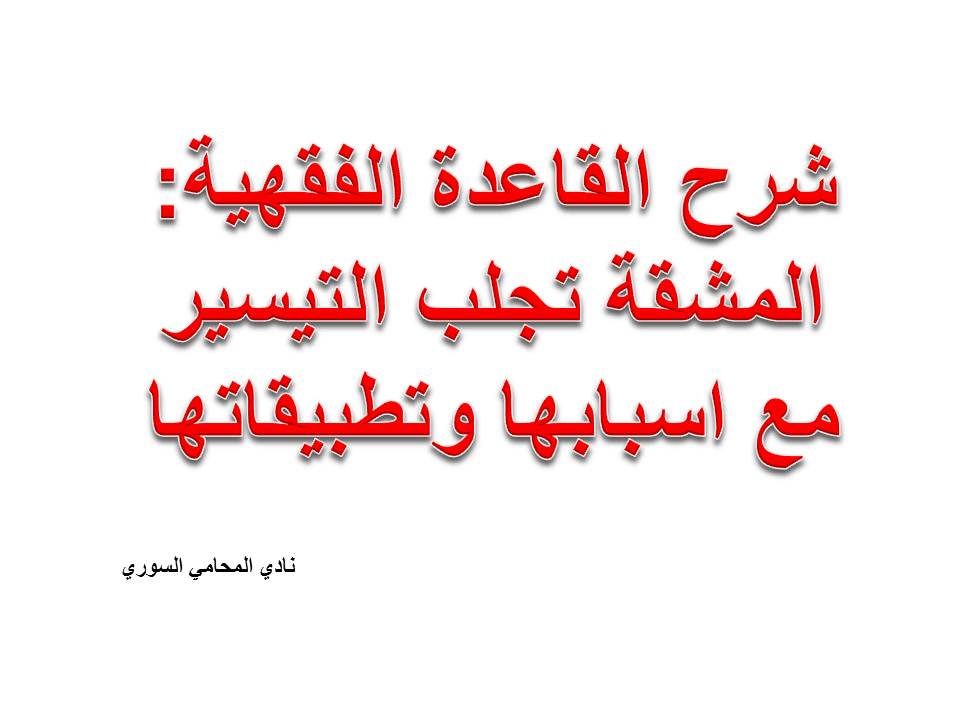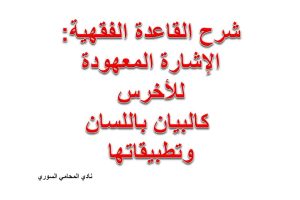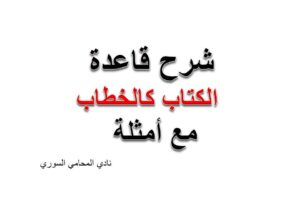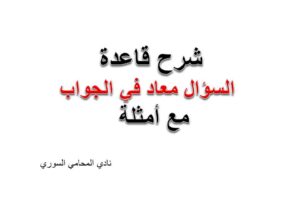المشقه تجلب التيسير
المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ” ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة.
والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية، أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود وقتل الجناة . . . فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف .
واعتبار المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، أما المواضع التي ورد فيها نص خلافهما فإن المشقة لا تجلب التيسير.
إن اعتبار أعراف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة مادام لا يصادم أسس الشريعة، لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس وفي الحقوق المدنية فإن التقادم بمرور الزمن المانع من المطالبة بالحق، يتوقف بالمعاذير كنقص الأهلية والسفر، وإلا كان إحراجاً لأصحاب الحقوق.
المشقة التي تجلب التيسير لها سبعة أسباب :
وهي السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، عموم البلوى، نقص الأهلية.
1- السفر، وتيسيراته كثيرة
منها : جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الخاطب الكفء استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر،
ومنها: جواز كتابة القاضي إلى القاضي في بلد المدعى عليه بشهادة المدعي عنده .
ومنها: جواز بیع الانسان مال رفيقه إذا مات في السفر معه وحفظ ثمنه لورثته بدون وصاية حيث لا قاضي ثمة .
ومنها جواز تحميل شهادة المسافر لغيره،
ومنها: استحباب القرعة بين نساء المسافر وترك القسم . . ..
٢ – المرض، وتيسيراته كذلك كثيرة:
منها : عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزوج أو في الزوجة، ومنها : اذا كان الشاهد مريضاً جاز له أن يستشهد في بيته . . ..
٣ ـ النسيان،
وهو عدم تذكر شيء عند الحاجة إليه، وهو مسقط للعقاب، ولو وقع الناسي فيما يوجب عقوبة كان نسيانه شبهة في إسقاط العقوبة،
ومن تيسيراته : لو حكم القاضي بالقياس ناسياً النص فلم يؤاخذ بنسيانه، ويستثنى من ذلك أنه لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلوعلق على فعل شيء ثم فعله ناسياً التعليق فإنه يقع.
٤ ـ الجهل،
وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم،
ومن تيسيراته: لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل أو جهل المحجور عليه بالحجر، فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك، ولو باع الأب أو الوصي مال اليتيم أو اللطيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش ثم قال : لم أعلم تقبل دعواه.
ولو أجاز الورثة الوصية ولم يعلموا ما أوصى به الميت لا تصح إجازتهم.
ولو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه : إنه ليس ابني ثم قال : هو ابني، يثبت النسب لأن سبب البنوة العلوق منه وهو خفي، والتناقض في الدعوى فيما كان سببه خفياً معفو عنه .
ولو اختلعت المرأة من زوجها على بدل ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع وبرهنت على ذلك فإنها تسترد بدل الخلع ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الخلع ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير والزوج يستبد به بدون علمها فكانت معذورة.
ه ـ نقص الأهلية،
كالصغر والجنون، فيجلبان التخفيف عنهما لعدم تكليفهما أصلاً .
وعند السادة الحنفية تُعتبر الأنوثة نوع من أنواع نقصان الأهلية فلا تكلّف المرأة بكثير مما يكلف به الرجل كالجهاد بالسيف والجمعة والجماعة وتحمل الدية، وقد رخص لها الشارع مما لم يرخصه للرجل كلبس الذهب والحرير ..
٦ – العسر وعموم البلوى:
وله تيسيرات منها : إباحة نظر الشاهد والخاطب للأجنبية ،
ومنها صحة الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع كما صح وقف المشاع الذي يحتمل القسمة ولم يشترط التسليم إلى المتولي،
وجواز استبدال الوقف عند الحاجة إليه بلا شرط ترغيباً في الوقف وتيسيراً على المسلمين،
ومنها: جواز النكاح بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ولم يفسد بالشروط الفاسدة ولم يخصص بلفظ النكاح والتزويج وينعقد بما يفيد ملك العين للحال، ويصح بحضور ابني العاقدين وبحضور ناعسين وسكارى على أن يذكروه بعد الصحو، كل ذلك دفعاً لمشقة الزنا،
ومنها: اعتبار فعل الأمر في عقد النكاح إيجاب بخلاف البيع .
والفرق بينهما أن قوله زوجني توكيل، وقوله : زوجتك، قائم مقام الطرفين كما عرف أن الواحد في النكاح يتولى عبارة الطرفين بخلاف البيع.
وبسبب العسر وعموم البلوى جوّز الحنفية العقود التي على خلاف القياس، ومن ذلك مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرّط فيه حال حياته وفسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعاً لضرر الورثة، حتى أجازوا الوصية بكل المال عند عدم المنازع، وأوقفوها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث، وأبقوا التركة على ملك الميت حكماً حتى تنقضي حوائجه منها رحمة له، وجوزوا الوصية بالمعدوم ولم يبطلوها بالشروط الفاسدة.
۷ ـ الإكراه :
وهو تهديد ممن هو قادر على الأذى بضرب مبرح، أو بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس مديد، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى هذا إكراهاً ملجئاً . أو بما يوجب غماً يعدم الرضا ما كان بغير ذلك، ويسمى إكراهاً غير ملجئ .
تنبيه : إن تأثير الإكراه على أفعال المكلفين على وجوه :
أولاً: العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل كالبيع والإجارة والهبة والإبراء والإقرار . . . مطلق إكراه يؤثر عليها، ويكون المكره بعد زوال الإكراه بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ .
ثانياً : العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل كالطلاق والنكاح والعفو عن دم العمد لا تأثير فيها للإكراه بل هي ماضية على الصحة، ولكن للمكره أن يرجع بالمهر على المكرِه له على الطلاق، إلا الزوجة فلو كانت هي المكرهة سقط المهر عن الزوج.
ثالثاً : المنهيات التي لا تباح عند الضرورة كالجناية على الغير، لا تحل بأي إكراه، ولو فعلها المكره وجب عليه القصاص.
رابعاً : المنهيات التي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير، فإنها تحل بالملجئ وضمان المال على المكره .
خامساً: الردة، فإنه يرخص للمكره أن يجري كلمتها على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويوري وجوباً إن خطر بباله التورية، فإن لم يوّر يكفر وتبين زوجته.