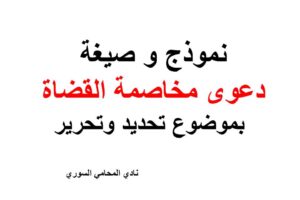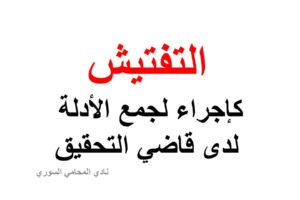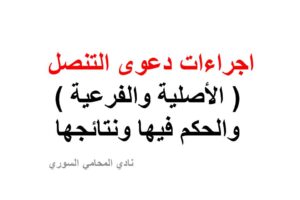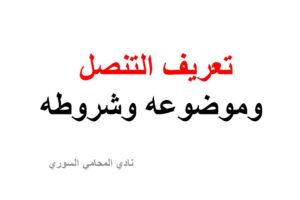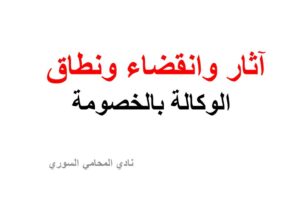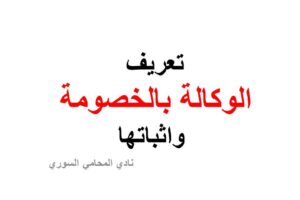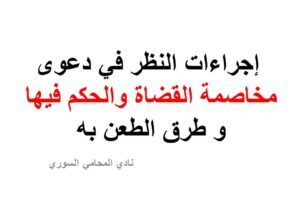محكمة النقض الموقرة
الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة
طالب المخاصمة : السيد …………….. ، يمثله المحامي ……….. ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
الهيئة المخاصمة :
هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :
1) – الرئيس الأستاذ …………….. .
2) – المستشار الأستاذ …………… .
3) – المستشار الأستاذ …………… .
المدعى بمواجهتهم :
1) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. 2) – السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .
موضوع المخاصمة :
القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بريف دمشـق ، في الدعـوى رقـم أساس (000/ب) لعام 2001 والمتضمن :
{ قبول الاستئناف شكلا … رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .
أسباب المخـاصمة : علمت الجهة طالبة المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدمت بطلب المخاصمة هذا تلتمس إبطال القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى الاعتراضية لسقوط الحق موضوعها عملا بأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ، وذلك للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من العلم أو تبلغ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .
وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات.
وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها.
وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .
كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ،
وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .
لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .
ثانيا – في الموضوع
آ ) – في الوقائع :
1- بتاريخ 0/00/1999 تقدم المدعى بمواجهته الأول بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في الزبداني يطلب فيها فسخ تسجيل العقارات رقم /1 و2 و3/ من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 المسجلة ابتدأ باسم طالب المخاصمة نتيجة أعمال التحديد والتحرير التي اختتمت بتاريخ 24/8/1984 ، و إعادة تسجيلها على اسمه في قيود السجل العقاري وذلك بزعم بطلان محاضر التحديد والتحرير و أنها مخالفة للقرار 186 لعام 1926 {ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى وعن إخراج القيد العقاري المبرز فيها وعن محاضر التحديد والتحرير وعن العقد العقاري المتضمن الهبة للقاصر – الوثائق رقم 1و2 و3 و4 و5 و6}.
2- تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدفوعها إلى محكمة البداية في الزبداني موضوع مذكرتها المؤرخة 18/7/1999 المرفق بها بيان من قاضي التحقيق في الزبداني بوجود دعوى التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة واستعمال المزور ومرفق بها صورة عن استدعاء الدعوى الجزائية الذي يبين كيفية وقوع التزوير … ومرفق بها كتاب مديرية المصالح العقارية الذي يشير إلى أن التزوير في الوثائق المقدمة من المدعى بمواجهته إلى محكمة البداية المدنية في الزبداني قد تم بعد صدور تلك الوثائق صحيحة من مديرية السجل العقاري … كما أبرزت صورة طبق الأصل عن الإعلان عن انتهاء أعمال التحديد والتحرير الذي يثبت ، وخلافا لمزاعم المدعى بمواجهته ، أن ختام أعمال التحديد والتحرير تم في 16/2/1984 وليس 23/8/1984 ، وصورة طبق الأصل عن قرار ختام أعمال التحديد والتحرير وعدم وقوع اعتراضات والمنشور في لوحة إعلانات القاضي العقاري بتاريخ 18/3/1984 وطلبت من حيث النتيجة رد الدعوى لمخالفتها أحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 ومخالفتها أحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 واستطرادا اعتبارها مستأجرة لحين البت بالدعوى الجزائية { ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة الجوابية وعن مرفقاتها المذكورة – الوثائق /7 و8 و9 و10 و11/}.
3- كما تقدمت بمذكرة جوابية ثانية مؤرخة 24/10/1999 أوضحت فيها صحة الوكالات المبرزة من قبل المحامي الوكيل عنها وان قرارا صدر عن محكمة النقض يثبت صحة تلك الوكالات {ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة – وثيقة رقم 12}.
4 – بتاريخ 30/10/1999 رفضت محكمة البداية المدنية في الزبداني الوكالات المقدمة من المحامي الوكيل عن طالب المخاصمة وقررت تقصير المهل و إعادة تبليغ الجهة طالبة المخاصمة وتعليق الجلسة إلى يوم 8/11/1999 إلا انه وبقدرة قادرة بدل الموعد إلى 4/11/1999 وجرى التبليغ بطريق الإلصاق … كما أجلت الجلسة إلى 8/11/1999 للإخطار ولدى عرض مذكرة الإخطار على العاملين في منزل الجهة طالبة المخاصمة أفادوا بان الجهة الموكلة لا تقيم في مدينة دمشق وهي مسافرة خارج القطر ، وقد أيد مختار المحلة هذه المشروحات … وتضمنت مذكرة الإخطار شرحا بأنها تعاد لتعذر التبليغ … وإذا بالمحكمة مصدرة القرار المستأنف تعتبر أن الجهة طالبة المخاصمة قد تبلغت الإخطار وقررت تثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي ؟؟؟!!! { ربطا صورة طبق الأصل عن مذكرة الإخطار – وثيقة رقم 13}.
5- وبجلسة 8/11/1999 تقدم وكيل المدعى بمواجهته بطلب عارض على ضبط المحاكمة يتضمن طلبه تسليم العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل … ومثل ذلك الطلب يتوجب قانونا دفع الرسم عنه و إبلاغه إلى الخصم (المادة 157 من قانون أصول المحاكمات ) كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية}.
(قرار محكمة النقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 538 لعام 1978) .
(قرار محكمة النقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3/5/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 378 لعام 1978)
(نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30/6/1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 110 لعام 1964)
إلا أن محكمة البداية المدنية في الزبداني تجاهلت أحكام القانون و أصدرت قرارها ذي الرقم /000 / تاريخ 00/00/1999 بالدعوى رقـم أساس/000/ لعـام 1999 ، والمتضمن من حيث النتيجة :
{ا- إبطال قرارات القاضي العقاري الصادرة عن القاضي العقاري ذوات الأرقام 1 ، 2 و 3 تاريخ 24/4/1984 .
2- إبطال عقد الهبة رقم 655 تاريخ 10/6/1998 الموثق لدى مكتب التوثيق العقاري في الزبداني المعقود بين المدعى عليه الواهب وبين ولده القاصر الموهوب له.
3- إعادة تسجيل العقارات المدعى بها موضوع الدعوى ذوات الأرقام 1و2 و3 زبداني 0/00 على اسم المدعي.
4 – نزع يد الجهة المدعى عليها عن العقارات موضوع الدعوى وتسليم هذه العقارات للجهة المدعية خالية من الشواغل ……. إلى آخر ما جاء في القرار } { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار وعن ضبط الجلسات المثبت فيه الطلب العارض – وثيقتين رقم 14 و15}.
6- بتاريخ 4/12/1999 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة باستدعاء استئناف على القرار البدائي المذكور سابقا أوضحت فيه مدى مخالفته لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 ومدى مخالفته لأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ومدى مخالفته لأحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات و أشارت إلى بطلان الإجراءات نظرا لبطلان تبليغ مذكرة الإخطار {ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف المذكور – وثيقة رقم 16}.
7- كما تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية إلى محكمة الاستئناف أرفقت بها نسخة من الإعلان المنشور في جريدة الرياض العدد 00000 تاريخ 4/10/1999 المتضمن إعلان التعزية بوفاة المرحوم المدعى بمواجهته ….وطلبت الحكم وفق طلباتها في استدعاء الاستئناف وعلى سبيل الاستطراد قطع الخصومة بسبب وفاة المستأنف عليه {ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة وعن إعلان الجريدة – الوثيقتين 17 و18 }.
8- كما أبرزت الجهة طالبة المخاصمة مذكرة جوابية مؤرخة 26/3/2001 طلبت فيها توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه مبينة صيغتها في تلك المذكرة {ربطا صورة طبق الأصل عنها – وثيقة 19 }.
9- تجاهلت محكمة الاستئناف المصدرة للقرار موضوع المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت واقعة وفاة المستأنف عليه و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة ، فكانت هذه الدعوى .
ب) – في القانون :
– لما كان من الثابت أن دعوى المدعى بمواجهته تقوم ابتدأ على الزعم بوجود بطلان في أعمال التحديد والتحرير المتعلقة بالعقارات ذوات الأرقام {1و2و3} من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 وان ذلك الادعاء استند إلى وثائق مزورة أبرزت الجهة طالبة المخاصمة البيانات الرسمية التي تثبت تزويرها وتثبت أن ذلك التزوير موضوع دعوى جزائية تنظر أمام السيد قاضي التحقيق في الزبداني ، وكان يتوجب على المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة أن تقرر وقف الخصومة بقوة القانون عملا بأحكام المادة 50 من قانون البينات التي تنص على:
{ إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية}.
إلا أن المحكمة المذكورة تجاهلت نص القانون رغم انه نص على وجوب وقف الدعوى المدنية وتجاهلت الاجتهاد القضائي المستقر على :
{ـ عند إقامة الدعوى الجزائية بالتزوير، فعلى المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم بالدعوى إلى ما بعد الفصل في الدعوى المذكورة، وليس أمام المحكمة مجال للتقدير في هذا الموضوع.
ـ على المحكمة المدنية أن تتوقف عن النظر في الدعوى إذا أقيمت الدعوى الجزائية، سواء قامت هي بإجراء التطبيق أو لم تقم، وسواء كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها أم لا، نظراً لإطلاق النص. وكل ذلك ما لم تكن المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في الدعوى}.
(قرار محكمة النقض رقم 737 تاريخ 24/4/1966 المنشور في مجلة المحامون صفحة 158 لعام 1966).
يضاف إلى ذلك أن القرار موضوع المخاصمة الذي ، تبنى حيثيات ومناقشة والأدلة التي اعتمدها قرار محكمة الدرجة الأولى ، ذهب إلى اعتماد صورة القيود العقارية المبرزة من المدعى بمواجهته كأساس للنتيجة التي انتهى إليها رغم أن تلك القيود شابها التزوير ورغم إبراز بيان من أمانة السجل العقاري يثبت تزوير تلك القيود ويثبت أن التزوير قد شابها بعد أن منحت إلى المذكور من تلك الأمانة ورغم إبراز بيان من السيد قاضي التحقيق في الزبداني يثبت أنها موضوع دعوى جنائية …. ورغم إبراز القيود العقارية الصحيحة ، وبالتالي فان الأخذ بالقيود المزورة بعد ثبوت تزويرها ورغم إبراز القيود الصحيحة التي تثبت عدم صحة أقوال المدعى بمواجهته وبطلان دعواه ، يشكل مخالفة لوثائق وأدلة رسمية مبرزة في الملف وهذه المخالفة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:
“ – التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.
(قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).
“ – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة .
– ذهاب الحكم للفصل في واقعة النزاع المطروحة في الدعوى على عكس ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المستقر يشكل خطأ مهنيا جسيما .
– إهمال المحكمة وثيقة مبرزة وعدم مناقشتها على الرغم من أنها قد تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم يشكل خطأ مهنيا جسيما “ .
(قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .
كما تجاهل القرار موضوع المخاصمة طلبات الجهة طالبة المخاصمة لجهة وقف الخصومة بالدعوى لوجود دعوى جنائية بالتزوير ، مما يشكل مخالفة للأصول والقانون ترقى إلي مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر على :
{ إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .
(قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).
{- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.
( – قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682).
v- لما كان من الثابت ان دعوى …….. جاءت مخالفة لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 و أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر وذلك على النحو التالي:
◄- نصت المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) على :
{لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي}.
ونصت المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 على :
{ أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوي المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}
وكان من الثابت أن مدة السنتين التي نصت عليها المادتان المذكورتان هي مدة سقوط لا تقبل وقفا أو انقطاعا لأي سبب كان وهذا الأمر من النظام العام وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{انقضاء المهلة المعينة للاعتراض على التحديد والتحرير يسدل ستارا على جميع المزاعم والادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر ويجعلها غير مسموعة}.
( قرار محكمة النقض رقم 8 أساس 78 تاريخ 28/1/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 765).
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{ … سواء أكانت دعوى المدعي بطلب تثبيت بيع العقار المسجل بقرار القاضي العقاري على اسم الغير أم كانت بطلب فسخ التسجيل المذكور فإن موضوع الادعاء ينصب على ذات العين العقارية المحكوم بتسجيلها بقرار القاضي العقاري فتطبق بشأنه أحكام المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر والمؤرخ في 20 / 4 / 1932.
ومن حيث أن المدة المنصوص عليها في هذه المادة هي ميعاد للمداعاة تسقط بانقضائه وتختلف في أحكامها عن أحكام التقادم لأنها من مهل السقوط وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي كما هو موضح في الأسباب الموجبة للقرارات 44 و45 و46 ل.ر المؤرخة في 20 /4/ 1932 التي جاء فيها أن المهلة بموجب المادة 31 المذكورة المعطاة للمتأخرين والغائبين وبصورة إجمالية للمعترضين الذين فضلوا الاستفادة من الأصول الواردة في القانون العام وسلوك جميع طرق المراجعة هي مهلة للإدلاء بمزاعمهم وبعد انتهاءها يسقط حق هؤلاء } .
(قرار محكمة النقض رقم 50 تاريخ 29/1/1961 المنشور في مجلة القانون صفحة 758 لعام 1961) .
{ إن مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام}.
(قرار محكمة النقض رقم /48/ أساس /92/ تاريخ 31/1/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 209 لعام 1970).
{إن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 والمعطاة لمراجعة القضاء لمن لم يعترض أمام القاضي العقاري، مهلة سقوط ولا تخضع للأحكام المتعلقة بوقف التقادم أو انقطاعه}.
(قرار محكمة النقض رقم 403 أساس 228 تاريخ 20/10/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 470 لعام 1965).
{1- إن النزاع الواقع على العقارات من جهة كونها ملكاً أم وقفاً لا يدخل في اختصاص محاكم تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة وإنما يعود للمحاكم العادية.
2- وإن سقوط حق الادعاء بالحقوق العقارية بإهمال استعماله في الأجل المضروب أو بانقضاء هذا الأجل لأي سبب كان إنما يراد منه وضع حد لجميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية من أجل استقرارها وتأمين انتظام قيود السجل العقاري وهو بهذا الاعتبار يختلف في غايته عن التقادم ولا يخضع للأحكام المتعلقة بوقف سريانه أو انقطاعه.
3- وإن مدة السقوط تتعلق بالنظام العام ولا توقفها المعذرة .
4 – وإن المادة 31 من القرار 186 المعدلة بالقرار 44 تقضي بسقوط حق الادعاء بعد مرور سنتين، وإن هذه المدة تبدأ من تاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري، لا من تاريخ اكتسابه القوة القانونية للتسجيل النهائي.
5- وإن طلب التدخل في الدعوى هو بمثابة دعوى يشترط لقبوله ما يشترط لقبول الدعوى}.
(قرار محكمة النقض رقم 378 أساس 60 تاريخ 24 / 10 / 1954 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 634 لعام 1954).
وكان ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة – باعتباره قد تبنى المناقشة وحيثيات القرار البدائي – من اعتبار أن المستأنف عليه يقيم خارج القطر وان الإجراءات تمت في غيابه يشكل ظروفا قاهرة تمنع من سريان المهلة المنصوص عليها قانونا وانه بزوال ذلك المانع يعود له حق الادعاء مجددا … ومن ثم قبول دعواه بعد انقضاء حوالي خمسة عشر عاما على تسجيل قرار القاضي العقاري في قيود السجل العقاري … يشكل مخالفة لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 و لأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ، ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر على أن تلك المهلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين هي مهلة سقوط تتعلق بالنظام العام ولا توقفها المعذرة ولا تنطبق عليها الأسباب المقررة قانونا لانقطاع التقادم ووقفه وبانقضائها يزول الحق بالمداعاة بالحقوق العينية ، وهذه المخالفة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة سواء المشار إليه سابقا أم اجتهادها المستقر على :
{- السير في الدعوى خلافا لنصوص القانون الصريحة والمبادئ الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /58/ أساس /151/ تاريخ 20/11/1989 – سجلات النقض) .
{ – إن المبادئ الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير .
– عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /239/ أساس /1536/ تاريخ 19/3/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 895).
{ – القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /49/ أساس /43/ تاريخ 13/2/1987 – سجلات النقض) .
{ إن تأويل الوقائع على خلاف الثابت إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية وعدم تمحيصها بالقدر الكافي }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 75 أساس 197 تاريخ 15/7/1999 – سجلات النقض) .
◄- لما كان من الثابت أن الزميل الأستاذ الذي حضر بالوكالة عن الجهة طالبة المخاصمة أمام محكمة الدرجة الأولى وابرز سند توكيل موثق أصولا من الكاتب العدل في القرداحة تضمن تفويضه بالمرافعة والمدافعة أمام المحاكم وابرز دفوعا وأدلة تثبت أن جميع الأوراق التي بنيت عليها الدعوى مزورة كما ابرز بيانا يثبت وجود دعوى التزوير الجنائي مقامة أمام السيد قاضي التحقيق في الزبداني موضوعها الوثائق التي حصل عليها المستأنف عليه من أمانة السجل العقاري ثم قام بتزويرها ، وقد أثبتت التحقيقات في تلك الإضبارة أن التزوير قد شابها بعد صدورها من الدوائر العقارية وبفعل المستأنف عليه ، كما ابرز من تلك الدوائر وثائق صحيحة تثبت بطلان جميع مزاعم المستأنف عليه وتؤكد أن جميع ما قدمه من أوراق في هذه الدعوى هو مزور ومخالف لقيود السجل العقاري ، وإذا بالمحكمة مصدرة القرار المستأنف (كي تتفادى إعمال آثار الوثائق الصحيحة المبرزة في الملف وإعمال أحكام المادة 50 من قانون البينات التي توجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية) تصدر قرارا إعداديا بجلسة 30/10/1999 ترفض فيه وكالة الزميل وتعتبرها محصورة بالعقارات التي تملكها الجهة طالبة المخاصمة في اللاذقية ؟؟؟!!! رغم أن سند التوكيل تضمن نصا صريحا بالتفويض بالمرافعة والمدافعة أمام جميع المحاكم حيث جاء في سند التوكيل ما نصه : ((… كما فوضته بالصفة المبينة أعلاه بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى المحاكم كافة … )) وكانت كلمة (كما) تعني انه بالإضافة إلى ما ذكر سابقا فوضته أيضا أي أنها تشكل تفويضا مستقلا عما وكل به سابقا وإضافة إلى ما وكل به سابقا وتجيز له المرافعة والمدافعة ضد أي شخص كان وبأية صفة كانت … أي أن عبارات التوكيل جاءت عامة وليس فيها تخصيص ولو كان المقصود بها العقارات التي يملكها الموكل في اللاذقية لجرى تخصيصها بهذا الصدد ، كما أوضح الزميل في مذكرته المقدمة أمام محكمة البداية المدنية في الزبداني أن تلك الوكالة اعتمدت في دعوى مماثلة بقرار من محكمة النقض وان صدور ذلك القرار باعتبارها صحيحة وتجيز للوكيل المخاصمة في أي دعوى تقام من أو ضد الجهة التي وكلته يجعل مناقشة الأمر مجددا تشكل تعديا على حجية حكم قضائي مبرم .
◄- وتضمن القرار الإعدادي المذكور إعادة تبليغ الجهة طالبة المخاصمة وتعليق الجلسة إلى يوم 8/11/1999 إلا انه وبقدرة قادرة بدل الموعد إلى 4/11/1999 ؟؟؟ وجرى التبليغ بطريق الإلصاق إلى عنوان لا تقيم الجهة طالبة المخاصمة فيه … وأجلت الجلسة إلى 8/11/1999 للإخطار ولدى عرض مذكرة الإخطار على العاملين في منزل بالمزة تعود ملكيته للجهة طالبة المخاصمة أفادوا بان الجهة الموكلة لا تقيم في مدينة دمشق وهي مسافرة خارج القطر ، وقد أيد مختار المحلة هذه المشروحات كما دون المحضر أن المذكرة تعاد دون تبليغ لتعذر ذلك … وإذا بالمحكمة البدائية تعتبر أن الجهة الموكلة قد أبلغت الإخطار وتقرر تثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي ؟؟؟!!! .
◄- وبجلسة 8/11/1999 يقدم المدعى بمواجهته طلبا عارضا يتضمن طلبه تسليم العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل … ومثل ذلك الطلب يتوجب قانونا إبلاغه إلى الخصم (المادة 157 من قانون أصول المحاكمات ) كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية}.
وجاء في حيثيات قرار محكمة النقض ما نصه :
{… وحيث أن جريان المحاكمة بالصورة الغيابية بحق الجهة الطاعنة يحتم تبليغها هذا الطلب العارض الأمر الذي يجعل قبول المحكمة له وحكمها بمقتضاه قبل تبليغه إلى الطاعنين منطويا على مخالفة لأحكام القانون تعرض الحكم للنقض} .
(قرار محكمة النقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 538 لعام 1978) .
(قرار محكمة النقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3 / 5 / 1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 378 لعام 1978).
(نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30 / 6 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 110 لعام 1964) .
◄- يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن طلب التسليم يستوجب إجراء الكشف والخبرة للتحقق من شاغل العقار المطلوب تسليمه وصفته بالاشغال … .
ورغم إثارة تلك الدفوع أمام الهيئة المخاصمة إلا أنها تجاهلت نصوص القانون والاجتهاد المستقر وتجاهلت المشروحات المدونة في مذكرة الإخطار وحجزت القضية للحكم وأجلت المحاكمة لثلاثة أيام فقط ؟؟؟!!! وأصدرت قرارها موضوع المخاصمة المخالف لصراحة نص القانون والنظام العام وتجاهلت أسباب الاستئناف رغم ان البطلان الذي شاب الإجراءات أمام محكمة البداية يرقى إلى مرحلة الانعدام ، الأمر الذي يشكل مخالفة لصراحة نص القانون وللنظام العام وللاجتهاد القضائي وتلك المخالفات ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة المشار إليه سابقا والذي نلتمس الرجوع إليه دفعا للتكرار .
– ذهبت الجهة طالبة المخاصمة في دفوعها إلى انه وصل إلى علمها أن المستأنف عليه قد توفي إلى رحمة الله تعالى ، وان ورثته قد أخفوا هذه الحقيقة تحايلا على القانون ، وأن الوفاة توجب قطع الخصومة بقوة القانون كما وأنها تعتبر مقطوعة حكما بمجرد وقوع الوفاة ، في حين استقر الاجتهاد القضائي على :
(( الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل )).
( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .
وعندما لم تستجب الهيئة المخاصمة لطلب قطع الخصومة ورفضت اعتماد صحيفة مرخصة أصولا تصدر في المملكة العربية السعودية تتضمن نعي ووفاة المستأنف عليه المذكور ، وكلفت الجهة طالبة المخاصمة إبراز بيان وفاة حسب الأصول ، فتقدمت بطلب ملتمسة إحالته إلى القنصلية السعودية بدمشق لتزويد الجهة الموكلة ببيان يثبت واقعة وفاة المذكور ، إلا أن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية رفضت استلام الطلب مع إحالة المحكمة إلا عن طريق وزارة العدل ، فقدمت الجهة الموكلة ذلك الطلب إلى ديوان وزارة العدل حيث سجل لديه برقم (00/0) وتاريخ 6/1/2001 والتي قامت بدورها بإحالته وعن طريق وزارة الخارجية إلى القنصلية السعودية بدمشق لإجابة طلب الجهة الموكلة ولم يرد جواب القنصلية السعودية لذلك التمست تمديد الإمهال لحين ورود جواب القنصلية السعودية إلا أن المحكمة رفضت طلب تمديد الإمهال ورفعت القضية للتدقيق ، فتقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة خلال فترة التدقيق أوضحت فيها :
أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{ لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق لأن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة عملاً بالمادة 134 أصول محاكمات }.
( قرار محكمة النقض رقم 193 أساس 135 لعام 1981 المنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة 559 ) .
{ إن باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم. وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة ورفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة } .
(قرار محكمة النقض رقم 499 أساس 710 تاريخ 27 / 3 / 1990 ، سجلات النقض) .
ومن الثابت أن الجهة الموكلة ، وبناء على تكليف المحكمة الموقرة إثبات واقعة وفاة المستأنف عليه قد تقدمت بطلب ملتمسة إحالته إلى القنصلية السعودية بدمشق لتزود الجهة الموكلة ببيان يثبت واقعة وفاة المذكور ، إلا أن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية رفضت استلام الطلب مع إحالة المحكمة الموقرة إلا عن طريق وزارة العدل ، فقدمت الجهة الموكلة ذلك الطلب إلى ديوان وزارة العدل حيث سجل لديها أصولا والتي قامت بدورها بإحالته إلى القنصلية السعـوديـة لإجابة طلب الجهة الموكلة ولم يرد جواب من القنصلية السعودية حتى الآن .
ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة قد أبرزت في الملف نسخة من الصحف اليومية الصادرة في المملكة العربية السعودية المتضمنة نعي المستأنف عليه من قبل أولاده ، وكان هذا الشهر العلني لواقعة الوفاة كاف لإثبات وقوعها فعلا خاصة وان قانون أصول المحاكمات قد اعتبر الصحف اليومية إحدى وسائل تبليغ الأوراق القضائية المنتجة للآثار القانونية المقررة للتبليغ الجاري إلى المخاطب….. ، إلا انه وأمام تأخر القنصلية السعودية في إجابة طلب الجهة الموكلة فإنها تلتمس إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون البينات وتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز وثيقة حصر ارث المستأنف عليه كونها أضحت وثيقة مشتركة ما بين الطرفين … وفي حال استمرار الجهة المستأنف عليها على إنكار واقعة الوفاة فان الجهة الموكلة تلتمس تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة التالية :
{ والله العظيم إنني لم ادخل إلى أراضى الجمهورية العربية السورية بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير المتعلقة بالعقار موضوع هذه الدعوى وانه كان لدي عذر قاهر يمنعني من دخولها ولا علم لي بوقوع التحديد والتحرير في ذلك العقار إلا عند تقديمي لهذه الدعوى والله} .
إلا أن القرار موضوع المخاصمة لم يناقش هذه الأسباب و الدفوع رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر وامتنع عن إعمال أحكام المادة 20 من قانون البينات كما امتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه خلافا لنصوص القانون وللاجتهاد القضائي المستقر وحرم الجهة الموكلة من وسيلة إثبات نص عليها قانون البينات الأمر الذي يجعله منطويا على خطأ مهني جسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:
{ حرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمة لإثبات دعواه ينطوي على خطأ مهني جسيم } .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /240/ أساس /534/ تاريخ 19/2/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 896) .
{ حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة}.
(قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض).
يضاف إلى ذلك أن وثيقة حصر الإرث للمرحوم …… المرفقة بهذا الادعاء ثابت فيها وفاته بتاريخ 20/6/1420 هجرية أي بتاريخ 30/9/1999 أي في الوقت الذي دفعت فيه الجهة طالبة المخاصمة بوقوع الوفاة و أبرزت عدد الجريدة المتضمن النعي وفي وقت كانت الدعوى أمام الهيئة المخاصمة لا تزال في طور تبادل الدفوع ولم يتقرر حجزها للحكم أو إقفال باب المرافعة فيها ، وكان إخفاء الجهة المدعى بمواجهتها في هذه القضية ورثة المرحوم والوكيل الحاضر عنه واقعة الوفاة وواقعة انتهاء وكالة ذلك الوكيل بسبب وفاة موكله ، إضافة إلى أنها تنطوي على غش وغدر ، إلا أنها في الوقت ذاته تؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي التي تمت بمواجهة ذلك الوكيل بما فيها صدور القرار موضوع المخاصمة كون الوفاة وقعت قبل صدوره بحوالي ثمانية عشر شهرا مما يجعل القرار موضوع المخاصمة باطلا عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة :
{- الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل} .
( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .
من الأسباب السابق ذكرها يتبين للمحكمة الموقرة أن القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطويا على أخطاء مهنية جسيمة توجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:
{إن الخطأ المهني الجسيم إنما هو التجاهل للمبادئ الأساسية في القانون التي يجب أن لا يقع فيها القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فهو في سلم الخطا أعلى درجات فهو الخطأ الفاحش والجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى .
إن الحكم الباطل كما عرفه الفقه إنما هو حكم صحيح من جهة الشكل إلا أنه مبني على إجراء باطل }.
(قرار محكمة النقض رقم 68 أساس 387 لعام 1996 تاريخ 13/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 207 ) .
{ التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم .
إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.
(قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .
{ التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .
(قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .
{ يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .
(قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ 17/3/1993 سجلات النقض) .
{ القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .
(قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .
{ التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .
التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.
(قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ 30/10/1993 سجلات النقض) .
{ التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .
(قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ 14/4/1993 – سجلات النقض ) .
y- لما كان من الثابت أن الجهة المدعى بمواجهتها ورثة المرحوم ……قد نفذت القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في الزبداني وتسلمت العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل ، كما قامت – في عام 2002 أي بعد وقوع الوفاة بثلاث سنوات – بنقل الملكية في قيود السجل العقاري إلى اسم مؤرثها المرحوم …… كما هو ثابت في القيد العقاري المرفق ربطا ، كما وأنها اتبعت إجراءات تنفيذ ذلك القرار بواسطة الوكيل الذي انتهت وكالته بالوفاة ، الأمر الذي يوجب في حال قبول طلب المخاصمة هذا إعادة الحال إلى ما كانت عليه سواء لجهة إعادة تسليم العقارات موضوع الدعوى إلى الجهة الموكلة خالية من الشواغل أم لجهة إعادة تسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري ، كما يوجب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها.
الطلب : لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار ابتدأ بوضع إشارة هذه الدعوى على صحيفة العقارات ذوات الأرقام {1 و2 و3} من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 ، ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :
1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا.
2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا .
3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى ، و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار موضوع المخاصمة بإعادة تسليم العقارات موضوع الدعوى للجهة طالبة المخاصمة و إعادة تسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري أصولا وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
4) – إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .
5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/2004
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل