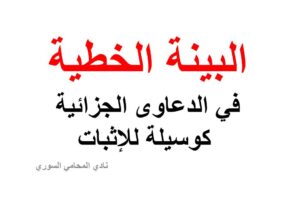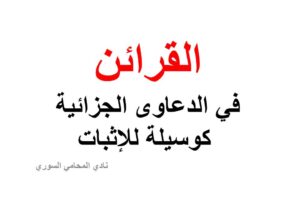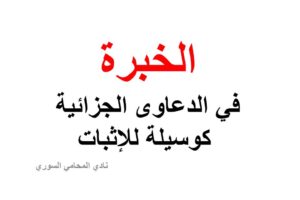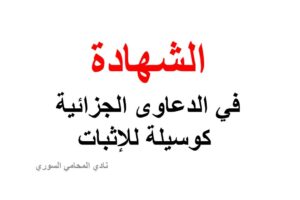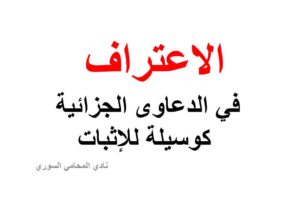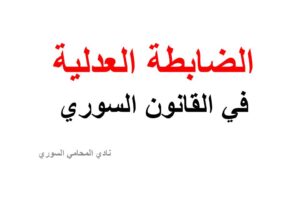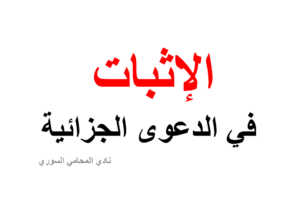مقدمة عن الشهادة
الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بإحدى حواسه الأخرى ، فهي التعبير الصادق عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة التي شاهدها أو سمعها أو أدركها بحاسة من حواسه بطريقة مباشرة والمطابقة الحقيقة الواقعة التي يشهد عليها في مجلس القضاء ممن تقبل شهادتهم بعد أداء اليمين .
وتعد الشهادة من أهم الأدلة التي يستمد منها القاضي قناعته الشخصية، وقد يبني عليها حكمه، على الرغم من أنها كوسيلة إثبات أو نفي تبقى موضع نقد شديد.
فالتجربة دلت على أن صدق الشهادة أمر يتوقف على ضمير الشاهد وأخلاقه وسلوكه ومدی شعوره بمسؤوليته.
أ- موضوع الشهادة
يتناول موضوع الشهادة وقائع الجريمة ساعة تنفيذها، كما قد يتناول إيضاح بعض الحقائق التي سبقت ارتكاب الجريمة أو لحقت بها، وقد يكون مضمون الشهادة متعلقة بوقائع ليس بينها وبين الجريمة صلة مباشرة، ولكن الاطلاع عليها يفيد في استنباط بعض القرائن المتعلقة بركن الجريمة المادي أو المعنوي .
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون موضوع الشهادة ذا أهمية قانونية في الدعوى في وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وأن تنصب على ما رأه الشاهد أو سمعه أو أدركه بحواسه من وقائع، فلا يجوز أن تتناول أراءه الشخصية أو تصوراته أو مدى تقديره لمسؤولية المتهم أو جسامة الواقعة، أي يجب أن ينطق بواقع الحال دون زيادة أو نقصان
ب- أنواع الشهادة
الشهادة إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة:
1- الشهادة المباشرة:
هي الشهادة التي تنجم عن الاتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها سواء كان اتصاله عن طريق البصر كأن يرى بعينه إطلاق النار، أو عن طريق السمع كأن يسمع كلمات الذم، أو عن طريق حاسة الشم كأن يشم رائحة المخدر، أو عن طريق حاسة الذوق كأن يذوق المادة المسكرة، أو عن طريق حاسة اللمس كأن يلمس الدم الحار.
2- الشهادة غير المباشرة:
ويطلق عليها الشهادة السماعية أو شهادة النقل، وهي تلك التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره.
فالشاهد يشهد أنه سمع الواقعة التي يرويها له شاهد يكون هو الذي رأها بعينه أو سمعها بأذنه أو أدركها بحاسة من حواسه.
فالشهادة السماعية هي شهادة على الشهادة.
وهذه الشهادة لا تصلح وحدها دلية في الإثبات، وإنما هي مجرد استدلال لا يصل إلى مرتبة الدليل.
إنما يمكن للمحكمة أن تستند إليها إذا توافرت أدلة أخرى أو قرائن تعززها، فإذا استندت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبة لفساد في الاستدلال، ذلك لأنها مبنية على الظن لا اليقين، لأن الأقوال تتعرض دائما للتحريف والتغيير والشك حين تنتقل من شخص إلى آخر.
ج- أهلية أداء الشهادة
هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى تعد الشهادة دليلا في الإثبات وهي:
1-التمييز:
أن يكون الشاهد قد بلغ الخامسة عشرة من عمره وقت أداء الشهادة، وأن يكون سليم الإدراك وقت حدوث الواقعة المشهود عنها ووقت الادلاء بشهادته.
أي أن يكون واعيا لما يدور حوله، فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله.
كما يجوز سماع شهادة الأيكم الأصم، فإذا كان يعرف الكتابة يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه من المحكمة خطياً.
كما يمكن الاستعانة بمترجم إذا كان لا يعرف الكتابة.
2- اليمين:
أوجب المشرع تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في محضر التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
والهدف من أداء اليمين استرعاء انتباه الشاهد إلى خطورة ما هو مقدم عليه وإيقاظ للقيم الأخلاقية فلا يكذب.
وإذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية فإن شهادته تكون باطلة ولا يمكن الاستناد إليها.
وكل حكم يستند إلى شهادة كهذه يكون مخالفة للأصول وجديرة بالنقض.
وتحليف الشاهد اليمين القانونية قبل أدائه لشهادته هو إجراء يتعلق بالنظام العام ويجب مراعاته ولو رضي الخصوم بغير ذلك .
3- حرية الاختيار:
أي أن يكون الشاهد متمتعاً بإرادة حرة عند الإدلاء بشهادته، بمعنى أن لا تكون أقواله صادرة إثر تهديد أو إكراه، وإنما يشترط أن تكون صادرة عنه اختياراً .
د- القيود الواردة على الشهادة
کي تكون الشهادة تعبيرا صادقا عما أدركه الشاهد، وخوفاً من عدم الحايدة والنزاهة، فإن المشرع لم يقبل بشهادة بعض الأشخاص إما لأن لهم مصلحة في الدعوى، أو لأن الصفة التي يحملونها لا تتفق مع صفة الشاهد.
1- الممنوعون من أداء الشهادة بموجب نص قانوني :
تنص المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :
“لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق. ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة”.
كما نصت المادة 292 على أنه:
1- لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ- أصول المتهم وفروعه.
ب- إخوته وأخواته.
ج – ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.
د – الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.
ه- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار.
واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم، لا تكون باطلة.
أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات”.
يتبين من هاتين المادتين أن عدم قبول شهادة هؤلاء الأشخاص لا يورث بطلاناً مطلقاً بل نسبياً .
فحتى لا تقبل شهادة هؤلاء، يجب أن يعترض عليها من قبل أحد الخصوم (النيابة العامة أو المدعي عليه أو المدعي الشخصي).
فإذا تم الاعتراض قبل سماع الشهادة كانت باطلة، أما الاعتراض الواقع بعد ذلك فإنه لا قيمة له.
كذلك لا يجوز أن يكون المدعى عليه شاهدة في دعواه. والحال نفسه بالنسبة إلى المدعي الشخصي فلا يجوز أن يدلي بأقواله بعد تحليفه اليمين.
لكن محكمة النقض أخذت اتجاها معاكساً عندما لم تستبعد المدعي الشخصي بالذات من الاستماع إلى شهادته بصفته شاهداً في الدعوى العامة فاعتبرت المدعي الشخصي ما هو إلا مدع في دعوى مدنية مضافة إلى دعوى جزائية لاختلاف الدعويين، فيجوز تحليفه اليمين في دعوى مدنية مضافة إلى الدعوى الجزائية التي يعد طرفها الأساسي النيابة العامة لا المدعي الشخصي.
فإذا ما أدى الشهادة بعد حلف اليمين لم يكن على القضاء حينئذ إلا تقدير قيمة هذه الشهادة .
كما يستمع إلى الشاكي الذي لم يتخذ صفة المدعي الشخصي شاهدا في الدعوى العامة، إذا كان لديه معلومات تفيد التحقيق بعد تحليفه اليمين.
وإذا كان المشرع قد استبعد من الشهادة من تربطهم بالمدعى عليه أو المتهم صلة قرابة. فإنه لم يمنع سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته وأخواته.
2- الممنوعون من الشهادة بسبب صفتهم:
هناك بعض الأشخاص الذين تتعارض صفتهم مع الشاهد، ومن هؤلاء القضاة وممثل النيابة العامة الذي يحضر جلسات المحكمة.
فالقاضي لا يجوز أن يكون شاهد في الدعوى التي ينظر فيها، لأنه يكون قد كون رأياً مسبقا في هذه القضية، فلا يجوز أن يكون القاضي شاهداً وحكماً أو شاهداً وخصماً.
ولا يجوز قبول شهادة ممثل النيابة العامة لأنه يعد جزءا متممة في تشكيل المحكمة.
كما لا تجوز سماع شهادة كاتب الجلسة. ولا تجوز شهادة المترجم في الدعوى نفسها لأنه يكون قد تأثر بالأقوال التي ترجمها.
ه – الشهادة على سبيل المعلومات :
إن الشهادة على سبيل المعلومات، كما تدل عليها تسميتها، هي التي لا تصل إلى مرتبة الدليل وإنما تسمع على سبيل الاستئناس، أي لا يمكن الاستناد إليها وحدها في الحكم، وإنما لابد من أن تكون معززة بأدلة أخرى في الدعوى. وهذه الشهادة تسمع دون توجيه اليمين القانونية إلى الشاهد، وتكون في الحالات التالية:
1- ما نصت عليه المادة (292) وهو عدم قبول شهادة بعض الأقرباء. فإذا اعترض
على سماع شهادة هؤلاء الأشخاص كان لرئيس محكمة الجنايات أن يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات.
2- تستمع المحكمة إلى القاصر الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره دون حلف اليمين وعلى سبيل المعلومات .
3- جاء في المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الرئيس محكمة الجنايات أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الإحضار . والأشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات إذا اعترض النائب العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.
وفي جميع الأحوال إن المشرع لم يبين قيمة الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين، لكنه لم يحرم على القاضي الأخذ بشهادة من لا يحلفون اليمين إذا وجد فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب قناعته الشخصية.
ويظهر أن المشرع أراد أن يلفت نظر القاضي إلى ما في هذه الشهادة من ضعف بأن يكون أكثر حيطة في تقديرها، وترك له بعد ذلك الحرية التامة في الأخذ بها من عدمه.
و- واجبات الشهود:
يترتب على الشاهد واجبات أخلاقية وقانونية، فإذا أخل بهذه الواجبات تعرض للمساعلة الجزائية. وهذه الواجبات هي:
1- المثول :
أي أن يلبي الدعوة إلى الحضور فيمثل أمام المرجع المختص الذي دعاه.
فكل شاهد يتخلف عن الحضور من دون عذر مقبول أمام القاضي المحقق أو المحكمة، يعرض نفسه لغرامة يقضي بها المرجع الذي كان قد دعاه للمثول أمامه.
2- أداء اليمين :
على الشاهد أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء شهادته سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
أي أن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان.
ويترتب البطلان على عدم حلف اليمين، وهو بطلان يتصل بالنظام العام، فلا يجوز التنازل عنه.
وكل حكم يستند إلى شهادة غير موثقة باليمين يعد مخالفة للأصول والقانون.
3- قول الصدق :
على الشاهد بعد أن يؤدي اليمين القانونية أن يقول ما يعرفه بصدق وأمانة وموضوعية إحقاق للحق وانتصارا للعدالة، وبما يمليه عليه ضميره.
فإذا امتنع عن أداء الشهادة أو ثبت كذبه، لوحق بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 397 وما يليها من قانون العقوبات.
وللشاهد أن يعتصم بالصمت فلا يجيب إذا كان ما سيقوله يؤدي إلى إفشاء سر مسلكي، مما
يؤدي إلى ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (565) من قانون العقوبات.
لكن هذه الحالة تعد من حالات الضرورة التي يمتنع فيها العقاب.
لكن بما أن عليه واجبا أن يقول الحق أمام القضاء، فإن مبدأ الإعفاء من واجب الإدلاء بالشهادة يجب أن يفسر وأن يطبق في أضيق الحدود.
ز – حقوق الشاهد :
للشاهد حقوق مقابل الواجبات التي فرضها عليه المشرع. وهذه الحقوق هي:
1- يحق للشاهد تقاضي مقابل للمصاريف التي أنفقها وتعويضه عنها وعما أضاعه من وقت في سبيل الحضور والمثول أمام الجهة القضائية التي دعي إلى أداء الشهادة أمامها. والقاضي هو من يقدر المبلغ الواجب أداؤه للشاهد ويدفع من ميزانية الدولة إذا كان الشاهد من شهود الحق العام، أي وجهت الدعوة إليه بناء على طلب النيابة العامة.
أما إذا كان من شهود الدفاع أو دعي بناء على طلب المدعي الشخصي أو المسؤول مدنية، فإن الفريق الطالب هو الذي يؤدي نفقات الشاهد المطلوبة.
2- من حقوق الشاهد الحق في حمايته وحماية شرفه واعتباره، لأنه شخص يؤدي خدمة عامة، ويستهدف تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم كان من الواجب حمايته من أن يتعرض إلى أي اعتداء أو أي إهانة قد تلحق به من جراء أدائه لشهادته.
فالمشرع أضفى على الشاهد حصانة بحيث يمتنع أن تقام عليه أي دعوى عامة أو مدنية من أجل جرائم القدح أو الذم أو غيرها التي قد يرتكبها أثناء قيامه بواجب الادلاء بشهادته.
ح- تقدير قيمة الشهادة:
الشهادة كغيرها من أدلة الإثبات، تخضع لتقدير قاضي الموضوع، فلا تصح مناقشته في قناعته الشخصية.
وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد واحد وتطرح أقوال الشهود الآخرين، لأن العبرة في الاقتناع ليست بعدد الشهود، وإنما بالاطمئنان إلى ما يدلي به الشهود، قل عددهم أو كثر. كما يمكن للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد أدلى بشهادته في التحقيق الابتدائي دون الشهادة التي أدلى بها أمامها.
وللمحكمة أن تجزيء الشهادة الواحدة فتأخذ ببعض ما جاء فيها وتطرح البعض الآخر، شريطة أن تذكر المحكمة في حكمها أنها قصدت هذه التجزئة، وأن تقدم في حكمها المسوغات الكافية التي دفعتها إلى الأخذ بجزء من الشهادة وعدم الأخذ بالجزء الأخر منها.
وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد استمع إليه على سبيل المعلومات، وتطرح شهادة موثقة باليمين، إذا كان بين أدلة الدعوى ما يدعم الشهادة التي أخذت على سبيل المعلومات، لكنها ملزمة ببيان الأسباب التي حملتها على الأخذ بشهادة دون أخرى.
فتقدير الأدلة والشهادات واستنباط الواقع منها يعود إلى قاضي الموضوع الذي يترتب عليه بيان الأسباب التي حدت به إلى الأخذ ببعض الشهادات واهمال البعض الآخر في حال تعارضها.
فمناقشة القاضي حول أخذه بشهادة أو طرحها أو اعتماده على دليل دون أخر هو تدخل في استقلال القاضي ورقابة على قناعته، وهذا لا يستقيم طالما أن تلك القناعة مبنية على أسباب صحيحة. فقاضي الموضوع لا يخضع في تقديره للشهادة لرقابة محكمة النقض طالما كان تقديره لهذه الشهادات يأتلف والمنطق ويسلم به العقل.
لتحميل الموضوع كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا