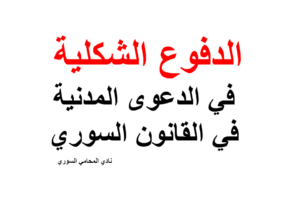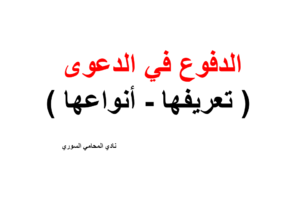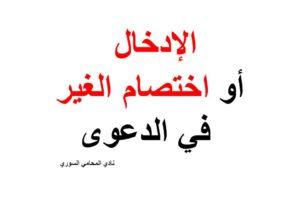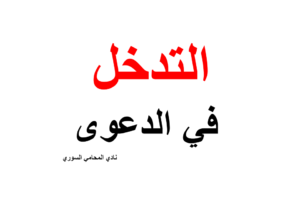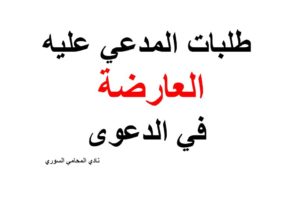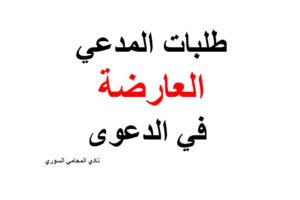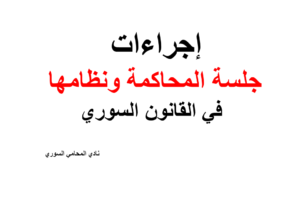تعرف الدفوع الشكلية بأنها تلك المتعلقة بالإجراءات وقواعد الأصول من حيث الإعلانات أو بالاختصاص، ومنها ما يتعلق بصحة الخصومة والتمثيل أو الحضور أمام المحاكم وممارسة حق الدفاع أمامها، أو بإصدار الأحكام، منها ما يتعلق بقواعد رفع الدعوى، أو هي الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الخصوم قبل مناقشة الموضوع أو التعرض له بهدف منع إصدار حكم فيها قبل البت في صحة تلك المسائل.
لذلك، فإن بعض الدفوع الشكلية تتعلق بالقواعد الموضوعة لمصلحة المتقاضين والتي تمكنهم من الوصول إلى اقتضاء حقوقهم أو الدفاع عنها عن طريق عدالة الدولة، وبالتالي على الخصوم أن يتمسكوا بالدفوع التي تنظم هذا الجانب قبل أي دفع أخر وأمام محاكم الأساس، وقبل التعرض الموضوع تحت طائلة سقوط الحق بها،
وتوجد دفوع أخرى تتعلق بالقواعد الموضوعة لتنظيم الجهاز القضائي ولحسن سير العدالة كتلك المتعلقة بالاختصاص الدولي للمحاكم أو بالاختصاص النوعي أو القيمي، أو بطرق الطعن ومهله،
وهذه الدفوع تتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز إثارتها والتمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة النقض، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها دون الحاجة لإثارتها من قبل الخصوم.
لهذا يمكن القول:
يقصد بالدفوع الشكلية الإجرائية بأنها تلك الموجهة إلى الخصومة أو إجراءاتها، ويقضي المبدأ القانوني بضرورة الفصل بها قبل البحث في موضوع وقبل أي دفع موضوعي مال تكن تتعلق بالنظام العام.
وقد نص المشرع اللبناني على:
(( أن الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها)) ،
وهكذا، نميز بالنسبة للدفوع الإجرائية بين دفوع تتعلق بالنظام العام، ودفوع غیر متعلقة بالنظام العام، ويترتب على هذا التمييز أنه يحق للخصوم التمسك بالدفوع المتعلقة بالنظام العام في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم،
أما الدفوع غير المعلقة بالنظام العام، فيجب التمسك بها قبل أي دفاع آخر والا سقط الحق بها، لأنها في الأصل مشرعة لمصلحتهم، ولا يجوز التمسك بها أمام محكمة النقض، مالم يكن قد تم التمسك بها أمام محاكم الأساس، ونبين ما هي الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، والدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام وفق الأتي:
1 – الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام:
توجد مجموعة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لارتباطها بالتنظيم القضائي وبحسن سير العدالة نبينها في الأتي:
أ. الدفع بعدم الاختصاص الولائي :
يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي عندما لا يكون للمحكمة سلطة النظر في الدعوى إما لكونها لا تدخل في اختصاص القضاء العادي لأن المنازعة إدارية وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، أو لأنها غير مختصة وفق قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم، أو لأنها تدخل في اختصاص جهات قضائية أخرى. فهذا الدفع ينكر على المحكمة سلطة النظر في الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص التي قررها القانون.
ب. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
يتم الدفع بعدم الاختصاص النوعي عندما يخرج عن سلطة المحكمة المرفوعة إليها الدعوى كونه يدخل في اختصاص محكمة أخرى بحسب نوع الدعوى وفقا لقواعد توزيع الاختصاص النوعي بين درجات وطبقات المحاكم.
ج. الدفع بعدم الاختصاص القیمي :
إن عدم اختصاص المحكمة عدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن المشرع والاجتهاد خرجا عن هذا المبدأ في معرض تحديد الاختصاص القيمي للعقار حيث أوجب الاعتراض على القيمة قبل الدخول في الموضوع تحت طائلة سقوط الحق بالتمسك به.
د. الدفع بالبطلان المطلق :
يعد الدفع بالبطلان المطلق من النظام العام، ويتم التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لأنه يجعل ما بني عليه بحكم المعدوم، ويقضي المبدأ أن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ومن الأمثلة على الدفع بالبطلان المطلق الآتي:
(1) – عدم حضور كاتب المحكمة مع هيئة المحكمة في الجلسات ليتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي أو رئيس الهيئة.
(2) – بطلان الإجراءات التي تتم خلال انقطاع الخصومة، وقد ميز الاجتهاد القضائي بين حالتين , حالة الإجراءات التي تتم خلال فترة الانقطاع حيث تكون باطلة نسبية، وأن البطلان موضوع لمصلحة الورثة، لذالك لا يجوز التمسك به من غيرهم ولا يحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وحالة الإجراءات التي تتم ابتداء بمواجهة شخص ميت حيث يكون الحكم الصادر بالاستناد إليه معدومة وليس باطلاً.
(3) عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوى أو مباشرته لأي إجراء من إجراءاتها يجعل كل ما يصدرعنه باطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بأصول توزيع العدالة.
(4) – عدم السماح بممارسة حق الدفاع . وهو حق مقدس واجب الاحترام كي تكون المحاكمة عادلة، والإخلال بهذا الحق يعد اعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين، وبالتالي فهو يدخل في دائرة النظام العام التي يستطيع أن يتمسك من خلالها صاحب الحق بحقه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان، إلا أن لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض. .
2- الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام وتطبيقاتها:
هناك مجموعة من الدفوع الموضوعة المصلحة الخصوم التي لا تتعلق بحسن سير العدالة، وبالتالي فهي ليست من النظام العام، وهي تشترك فيما بينها في مجموعة من الأحكام. لذلك سوف نعرض بعض تطبيقاتها، وأحكامها المشتركة وفق الآتي:
أ- تطبيقات الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام:
نص المشرع على مجموعة من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ومنها على سبيل المثال :
(1) – الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو المكاني :
يتعين الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي قبل أي دفع أخر وإلا سقط الحق به، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به قبل الإجابة على موضوع الدعوى أو الدخول في نقاش وسائل الإثبات وصحتها، ويستثنى منها الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة إذ تعد من النظام العام.
(2). الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط :
يمكن أن يلجأ كل من الطرفين إلى إقامة الدعوى ب ذاته أمام دائرتين مختلفتين أو أمام الدائرة ذاتها حيث قد يكون كل منهما دائن ومدينة، ويقيم الدعوى كل منهما للمطالبة بدينه كأن يقيم المشتري الدعوى بتسليم المبيع، ويقيم البائع الدعوى بإلزام المشتري بتسديد الثمن أو ما تبقى منه، أو كأن ترتبط الدعوى بموضوع دعوى أخرى أو بسببها،
ففي هاتين الحالتين يمكن الدفع بإحالة إحدى الدعويين إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأخرى وتوحيدهما معا كي يصدر بهما حكم واحد منعاً من نشوء حالة تعارض الأحكام وتناقضها، ونسمي هذه الحالة بحالة توحيد الدعاوی وليس بضم الدعاوى كما تفيد بعض المحاكم الأن مصطلح الضم يكون في حالة ضم دعوى مفصولة إلى دعوی منظورة للاستفادة من الوثائق أو المستندات الواردة فيها في الدعوى المنظورة، أما التوحيد يكون في الحالتين المشار إليهم.
(3)- الدفوع المتعلقة بالبطلان النسبي :
يكون البطلان نسبياً عندما يتعلق بالإجراءات، وفي الحالات التي ينص القانون على ترتيبه عند عدم القيام به ومنها:
(أ)- تبلیغ مذكرات الدعوة أو التنفيذ عن غير طريق الجهات المحددة في القانون.
(ب)- التبليغ قبل السابعة صباحا أو بعد السادسة مساء أو في أيام العطل الرسمية بغير موافقة
المحكمة.
(ج)- عدم اشتمال التبليغ على البيانات المطلوبة.
(د) – عدم تسليم سند التبليغ إلى الأشخاص الذين يصح تسليمها لهم أو خلافا لما نص عليه
القانون. .
(هـ) – إذا لم يحقق الإجراء الغاية المرجوة منه.
لذا، هناك أحكام مشتركة بين جميع حالات البطلان النسبي والمترتبة على التمسك عدم نوجزها في الآتي:
(1)- إن بطلان استدعاء الدعوى وتبليغها، و بطلان مذكرات الدعوة الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
(2) – لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
(3) – لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه.
(4) – يزول البطلان يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا، أو قام بعمل أو إجراء أخر باعتباره كذلك.
(5) يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء میعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاد مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
(6) – إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحة باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
3- الأحكام المشتركة بين الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العامة :
توجد مجموعة من الأحكام المشتركة بين جميع الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام تتلخص بالأتي:
أ- يجب إبداء الدفوع الشكلية دفعة واحدة قبل التعرض الموضوع الدعوى وقبل أي دفع أخر تحت طائلة سقوطها، وليس من تفاضل أو أولوية بين تلك الدفوع.
ب- إن الحكم بالدفع الشكلي ليس حكماً بالموضوع، ولا يسقط ولاية المحكمة للنظر في الموضوع. فإذا ما تم استئنافه، وقررت محكمة الاستئناف فسخه عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الموضوع، لا أن تفصل في الدعوى حتى لا تحرم المتقاضين درجة من درجات التقاضي.
ج- تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع ويمكن أن ترجئ البت فيه إلى حين البت في الموضوع، وهذا يعني التفات المحكمة عن الدفع المذكور كونه لا يؤثر في نتيجة الدعوى.