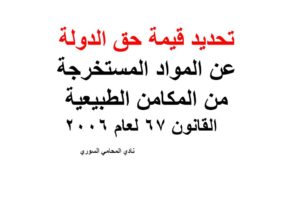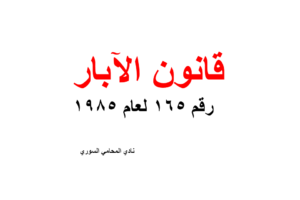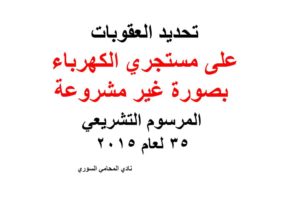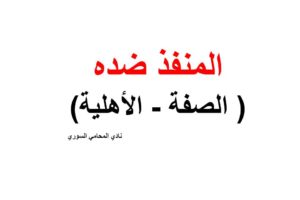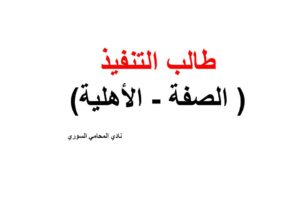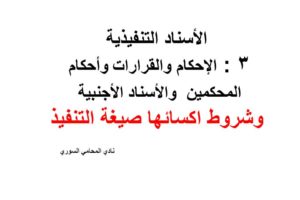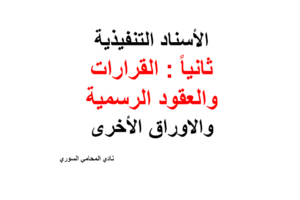تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية
القانون 67 لعام 2006
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8- 12- 1427 هـ الموافق 28- 12- 2006 م .
يصدر مايلى:
المادة 1
تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضى أملاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة في الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والإنشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلي :
أ / خامات مواد البناء والإنشاءات
اسم المادة الوحدة
الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب
قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة
/2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب
قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة
/3/ حجر بازلتي للطحن والاغلوميرات متر مكعب
قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة
/4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانية عشرة ليرة سورية
/5/ الحجر البازلتي للبناء متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
/6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر8/ ثماني ليرات سورية
/7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية
/8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
ب / خامات أولية مستخرجة للصناعة
اسم المادة الوحدة:
/1/ غضار لصناعة السيراميك طن
قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية
/2/ غضار لصناعة القرميد والأجر والاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
/3/ حجر كلسى وكلسي مارلى لصناعة الاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
/4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
/5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن
قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
/6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والأجر والاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
/7/ حجر كلسي ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن
قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية
/8/ الجص طن
قيمة حق الدولة /00ر19/ تسعة عشر ليرة سورية
/9/ الطف البركانى والسكوريا طن
قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية
/10/ تراكيت طن
قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية
/11/ نفيلين سيانيت طن
قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
/12/ تريبوليت طن
قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية
/13/ زيوليت طن
قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية
/14/ الفوسفات طن
قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
/15/ البازلت لصناعة الخيوط والأنابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن
قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
/16/ البنتونايت طن
قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية
المادة 2
تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة
المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون
المادة 3
تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة
المادة 4
/ أ / تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى
/ب/ تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة
/ج/ تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرار بدون ترخيص وتسرى عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون
/د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة
المادة 5
يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها
المادة 6
مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وأحكام قانوني أملاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص
المادة 7
يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة
المادة 8
الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين /6/7/ السابقتين لا تعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة كما لو كان مرخصا
المادة 9
يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق أصولا
المادة 10
يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية :
// اقسم بالله العظيم بان أقوم بعملي بأمانة وإخلاص//
المادة 11
تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول إيرادا للخزينة العامة
المادة 12
/أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز / 2000/ ألفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الأعمال المكلفين بها ولا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة
/ب/ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة
المادة 13
يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار
المادة 14
يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون
المادة 15
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/تاريخ 31-7-1996
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
دمشق 9- 12- 1427 هـ الموافق 29- 12- 2006 م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد