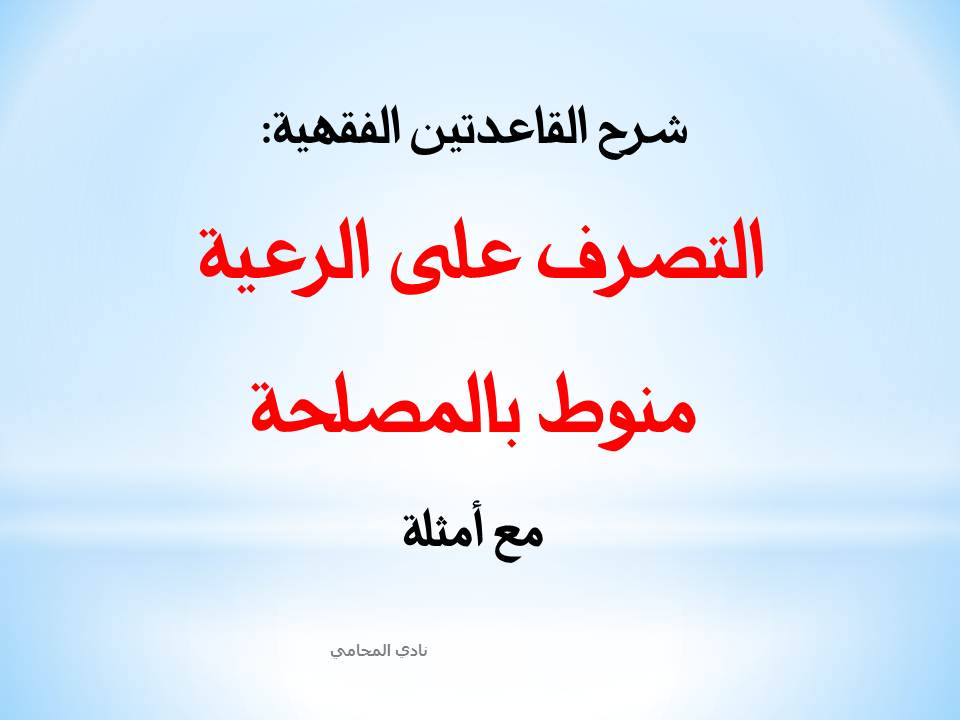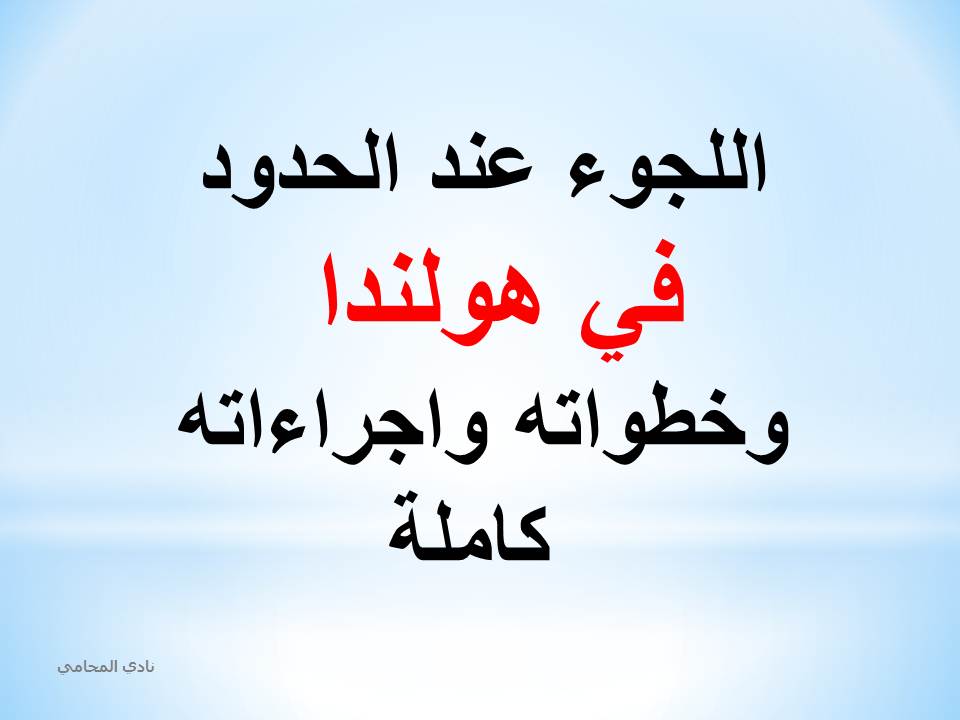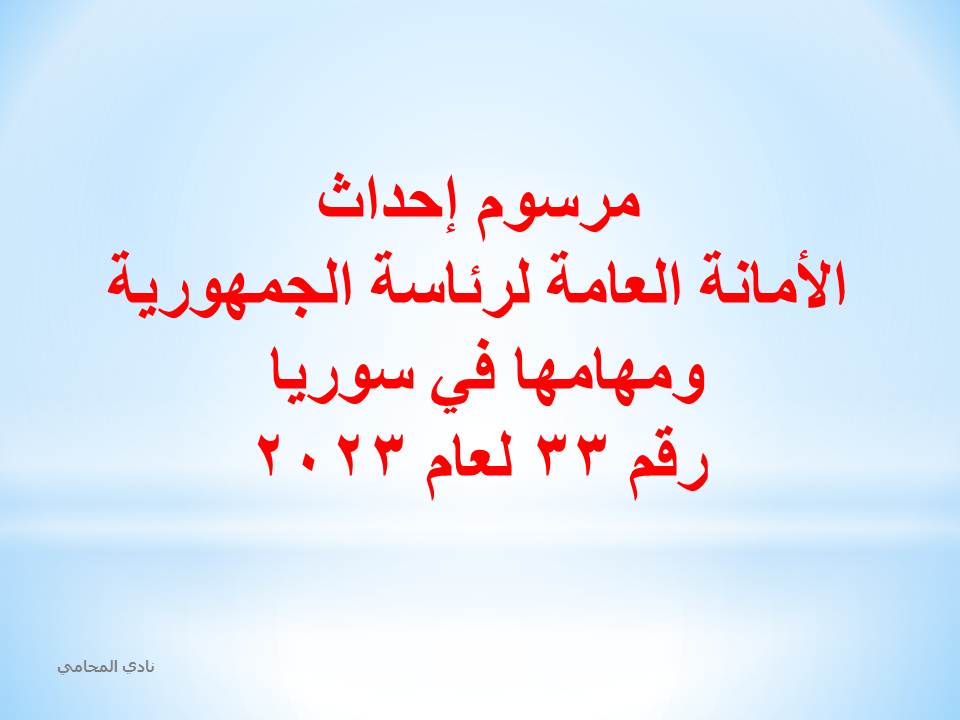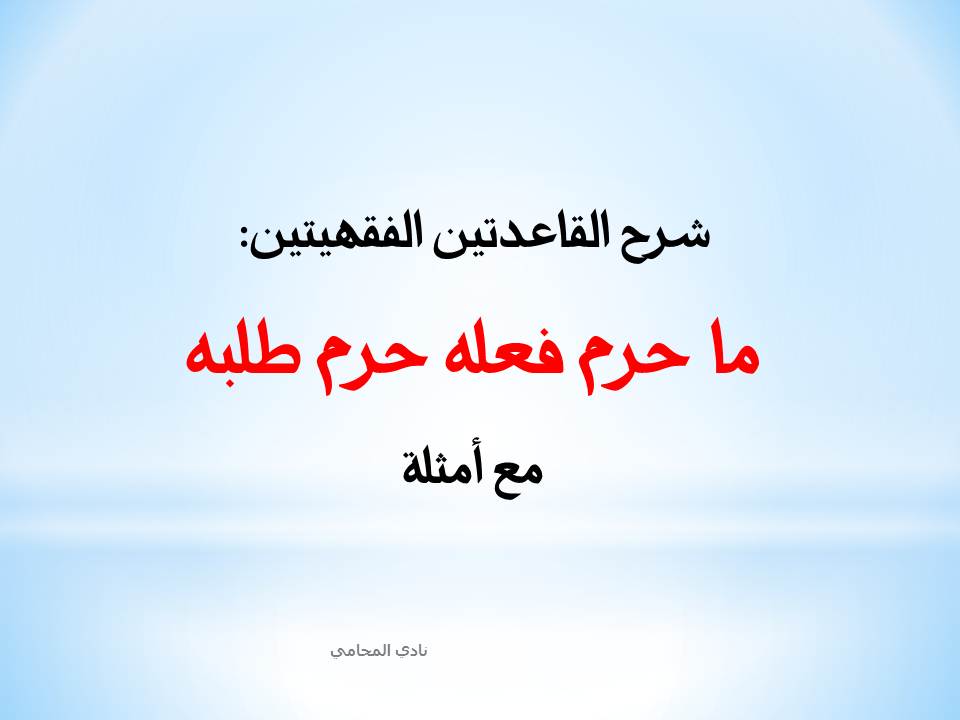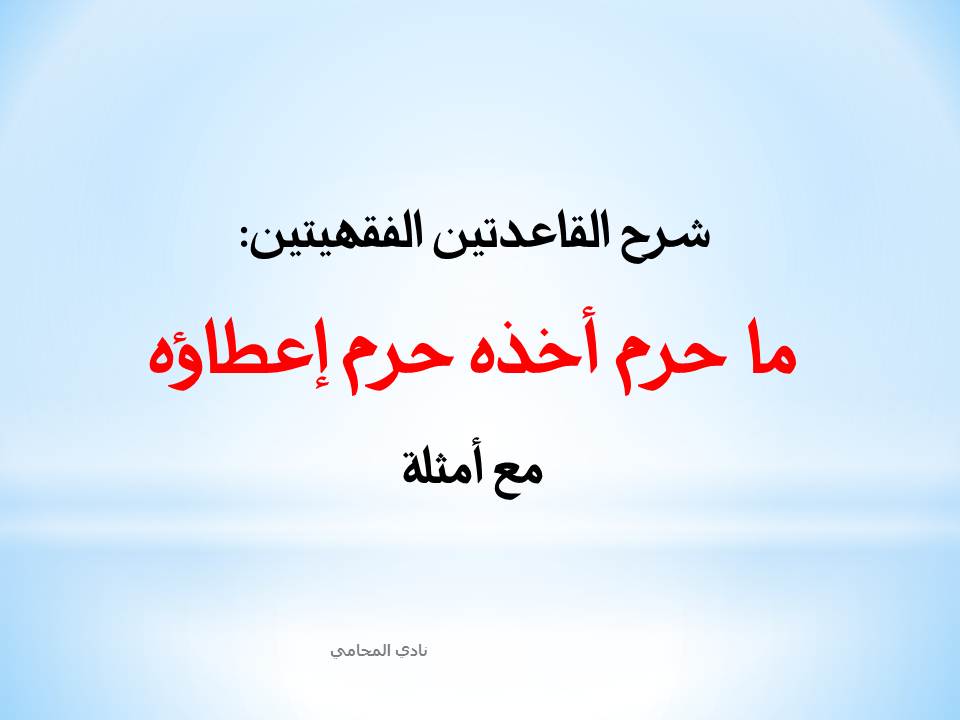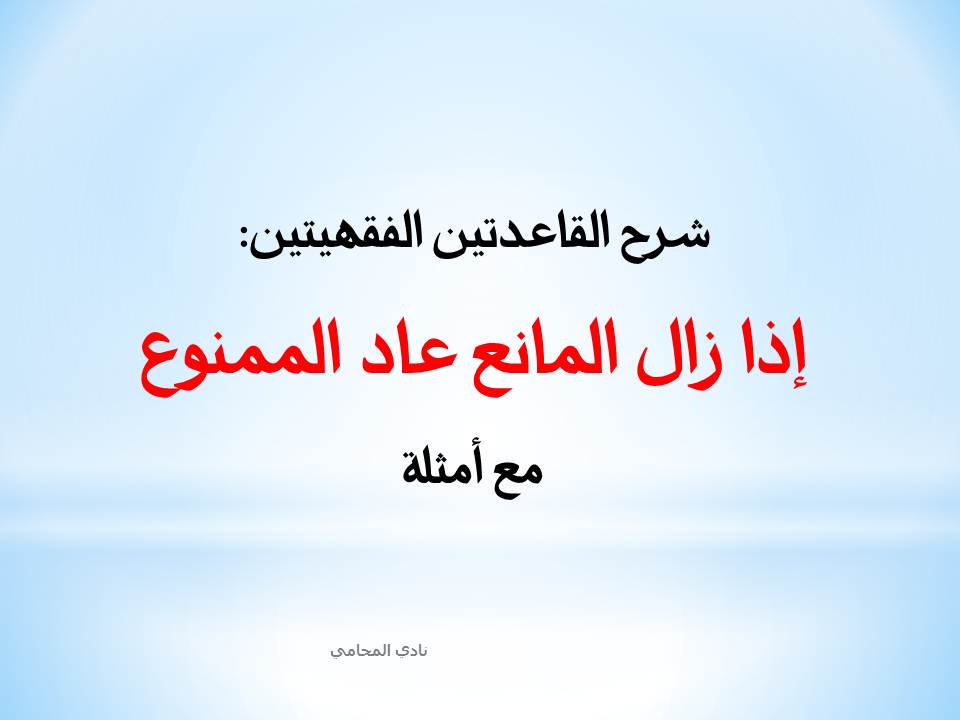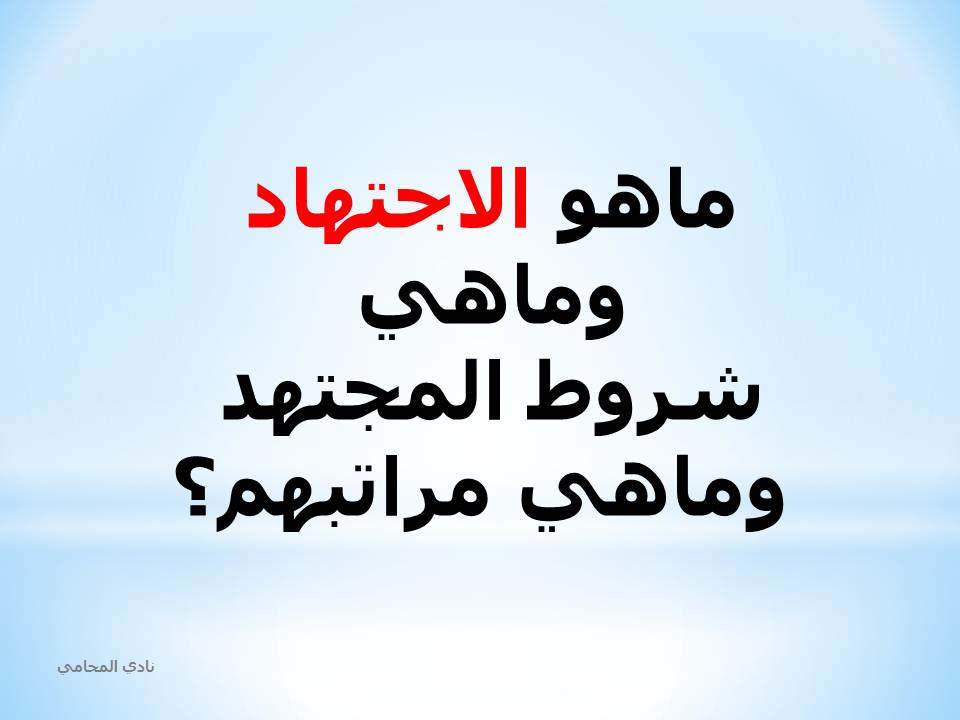1- لم تلقّيْت هذا المنشور؟
دخلت هولندا عبر مطار أو ميناء. تريد الآن أن تتقدم بطلب اللجوء هنا. اللجوء يعني: توفير الحماية في بلد آخر للأشخاص غير الآمنين في بلدهم والذين لا يستطيعون الحصول على الحماية في بلدهم.
إذا قدمت طلب لجوء، تطلب رسميا من الحكومة الهولندية منحك تصريح إقامة. تحتاج إلى هذا التصريح من أجل السكن في هولندا.
تبدأ إجراءات اللجوء بعد طلبك للجوء: وهي إجراءات قانونية تقوم الحكومة الهولندية من خلالها بتقييم إمكانية حصولك على تصريح إقامة.
تتم معالجة طلب لجوئك ضمن إجراءات طلب اللجوء على الحدود. يجب على IND في هذه الإجراءات اتخاذ قرار في طلبك خلال 28 يوماً.
يمكنك أن تقرأ في هذا المنشور ما يحدث أثناء إجراءات طلب اللجوء على الحدود هذه. تقرأ كذلك ما يجب عليك فعله (واجباتك) وما يمكن لك أن تتوقعه من الحكومة الهولندية (حقوقك)
2- متى تحصل على تصريح إقامة اللجوء؟
ينص قانون الأجانب الهولندي على الشروط التي يمكنك بموجبها الحصول على تصريح إقامة اللجوء. يمكنك الحصول على تصريح إقامة إذا انطبقت عليك أحد المواصفات التالية:
- لديك أسباب مبررة للخوف من الملاحقة في بلدك الأصلي بسبب عرقك أو دينك او جنسيتك أو انتمائك السياسي او لأنك تنتمي إلى مجموعة اجتماعية محددة.
- لديك أسباب مبررة للخوف من عقوبة الموت او الإعدام أو التعذيب او التعرض لمعاملة غير إنسانية أو مذلة أخرى في بلدك الأصلي.
- لديك أسباب مبررة بأن تكون ضحية لعنف عشوائي ناتج عن صراع مسلح في بلدك الأصلي.
- حصل زوجك/زوجتك أو شريك حياتك أو والدك أو والدتك أو طفلك القاصر على تصريح إقامة لجوء في هولندا. تقرر مصلحة الهجرة والتجنيس (IND ) ما إذا كنت مستوفياً لشروط الحصول على تصريح إقامة اللجوء.
3- ما الذي يتم توقعه منك؟
من المهم أن تدلي بأقوال تدعم طلب لجوئك أثناء الإجراءات. كما يُتوقع منك أن تقدم ل IND جميع وسائل الإثبات الموجودة بحوزتك أو التي يمكنك الحصول عليها (كالوثائق مثلا أو الرسائل التي تدعم أقوالك).
هل لديك ظروف شخصية يجب على IND أخذها بعين الاعتبار؟ يمكنك الإشارة إلى ذلك. يمكن ل IND في هذه الحالة اتخاذ تدابير أثناء المحادثات(المقابلات) مثلا أو في الإيواء المغلق. تحاول IND دعمك أكبر قدر ممكن.
4- ما هي المؤسسات التي ستتعامل معها؟
مؤسسة مساعدة اللاجئين هولندا( VWN )
هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تم تأسيسها لرعاية مصالح طالبي اللجوء.
تقدم لك VWN معلومات وشرحا حول إجراءات اللجوء وتبلغك وتدعمك شخصيا خلال سير هذه الإجراءات وتلعب دور الوساطة عند حدوث مشاكل مع مؤسسات أخرى. وتتعاون في ذلك بشكل وثيق مع محاميك.
لا تتخذ VWN القرار بشأن طلب لجوئك.
الموع الرسمي: https://www.refugeehelp.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl
مجلس المساعدة القانونية RvR
يحرص مجلس المساعدة القانونية على أن تتلقى مساعدة من محام إن كنت لا تستطيع دفع أتعابه بنفسك. يدفع RvR تعويضا لهذا المحامي مقابل مساعدته لك. لا يعمل المحامي لدى RvR .
المحامي هو مقدم مساعدة قانونية مستقل يؤازرك أثناء إجراءات لجوئك.
الموقع الرسمي: https://www.rvr.org/
مصلحة الهجرة والتجنيس ( IND )
هي جزء من وزارة العدل والأمن الهولندية. يبحث موظفو IND ما إذا كان لك الحق في الحصول على اللجوء في هولندا. لذلك تُجري مقابلات معهم حول هويتك. وسبب طلبك اللجوء في هولندا. يبحثون قصتك الشخصية والوضع في بلدك الأصلي. ثم يقررون ما إذا كان سيُسمح لك بالبقاء (مؤقتا) في هولندا أم لا.
الموقع الرسمي: https://ind.nl/nl
يتم تحديد موعد لك داخل مركز الإيواء مع ممرض(ة) من (ميديفيرست )
يسألك الممرض عن رغبتك في التعاون لإجراء فحص طبي. الهدف من هذا الفحص هو تحديد ما إذا كنت تعاني من مشاكل نفسية و/أو جسدية التي يمكنها التأثير على مقابلاتك مع IND .
المنظمة الدولية للهجرة IOM
هي منظمة مستقلة تدعم المهاجرين في كل أنحاء العالم. يمكن ل IOM مساعدتك إن أردت مغادرة هولندا بنفسك. تمنحك IOM معلومات عملية حول العودة وإعادة الاندماج وتوجهك في ترتيب مغادرتك لهولندا. يمكنك طلب المساعدة في ذلك من موظف مؤسسة مساعدة اللاجئين أو من محاميك.
الموقع الرسمي: https://iom-nederland.nl/en/
مصلحة العودة والمغادرة DT&V
هي جزء من وزارة العدل والأمن الهولندية. إذا تم رفض طلب لجوئك من قبل IND ، يساعدك موظف من DT&V في ترتيب عودتك إلى بلدك الأصلي.
الموقع الرسمي https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
مصلحة المؤسسات العدلية DJI
هي جزء من وزارة العدل والأمن الهولندية.
تقيم في مقر إقامة حدودي مغلق بسبب منعك من دخول هولندا. ويعتبر هذا المبنى موقع إيواء تحت الحراسة. تدير مصلحة المؤسسات العدلية DJI هذا المبنى. يرتدي موظفو DJI زيا موحدا. وهم يقومون برعايتك وتوجيهك أثناء إقامتك في مقر الإقامة الحدودي.
الموقع الرسمي : https://www.dji.nl/
خطوات واجراءات اللجوء عند وصولك الى الحدود الهولندية
الخطوة 1 : الإبلاغ بالوصول والتسجيل
تبلغ بوصولك لدى حرس الحدود الهولندية. وهم في الغالب الشرطة العسكرية الملكية الهولندية ( KMar )يتحقق موظفو من هويتك. تسجل بياناتك الشخصية مثل اسمك وتاريخ ميلادك وجنسيتك.
كما تفتش ملابسك وحقائبك وتلتقط صورا لك وتأخذ بصماتك. تلقيت منشورا مع شرح لأسباب أخذ بصماتك. كما أنك تقوم لدى il بالتوقيع على طلب لجوئك. إضافة إلى ذلك يمكن أن تطرح KMarK أسئلة عليك حول:
- طريق سفرك؛
- أو إذا سبق لك أن طلبت اللجوء هنا او في مكان آخر في أوروبا؛ و
- إذا كان لك أفراد عائلة هنا او في مكان آخر في أوروبا.
انتبه! لن تبلغ الحكومة الهولندية سلطات بلدك الأصلي أبدا بأنك قد طلبت اللجوء في هولندا.
الإيواء المغلق
يتم اصطحابك بعد بضعة ساعات من الإبلاغ بوصولك وتسجيلك إلى موقع إيواء مغلق بالقرب من مطار سخيبهول. يدعى هذا الموقع المجمع العدلي سخيبهول (JCS(JCS Schiphol Schiphol Complex ComplexComplex Justitieel Justitieel Justitieel Justitieel (. الإيواء في JCS مغلق لأنك لا تملك موافقة (بعد) على دخول هولندا. تبقى هنا طوال مدة الإجراءات. لا يُسمح لك بمغادرة هذا الموقع لوحدك. هناك مكتب ل IND في JCS .
الخطوة 2 : المقابلة الأولية
تسمى أول محادثة مع IND بالمقابلة الأولية. تطرح IND خلالها أسئلة عليك. أهم أهداف المقابلة الأولية هي:
- الحصول على معلومات حول:
- من أنت )هويتك(؛
- أصلك؛ و
- كيف سافرت إلى هولندا.
- معاينة الوثائق التي بحوزتك.
- التحقق مما إذا كان هناك بلد أوربي آخر سيتخذ قرارا بشأن طلب لجوئك )إجراءات دبلن(.
تطرح عليك أثناء المقابلة الأولية أسئلة حول:
- هويتك وجنسيتك وأصلك ومكان سكنك؛
- العائلة؛
- الوثائق؛
- الدراسة المهنية؛
- العمل والخدمة العسكرية؛
- السكن في بلدان أخرى؛
- سفرك إلى هولندا؛ و
- سبب طلبك للجوء.
يمكنك منح جواب مختصر على السؤال حول سبب طلبك للجوء. تستخدم IND هذه البيانات من أجل إجراءات لجوء سريعة.
أثناء المقابلة المفصلة، تحصل على متسع من الوقت لكي تحكي بشكل مفصل عن أسباب طلب لجوئك.
تقوم IND بإعداد تقرير عن هذه المقابلة. تحصل على نسخة من تقرير IND عن طريق محاميك.
انتبه! امنح دائما بياناتك الحقيقية وليس بيانات وثيقة (سفر)مزورة. أعْلمْ أيضا ما إذا كنت قد استخدمت لقبا (=اسم تمويه). قدّمت معلومات خاطئة أو بيانات مزورة ل IND I ؟ يمكن أن يكون لذلك عواقب بالنسبة لإجراءات لجوئك.
الوثائق
تعتبر الوثائق ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتقييم طلب لجوئك. هل لديك وثائق يمكن أن تثبت هويتك كجواز السفر مثلا أو بطاقة التعريف الشخصية أو شهادة ميلاد أو رخصة قيادة؟ أو هل لديك وثائق يمكن ان تدعم طريق سفرك او قصة لجوئك كتذاكر الطيران مثلا أو بطاقة ركوب الطائرة أو شهادات دراسية أو حكم قضائي او مقالات صحيفة؟ سلّم هذه الوثائق عندئذ بأسرع وقت ممكن أثناء التسجيل او أثناء المقابلة الأولية مع IND . يمكنك بعد ذلك، مثلا أثناء المقابلة المفصلة، تسليم وثائق إضافية. يمكن لمحاميك أو موظف من مؤسسة مساعدة اللاجئين ( VWN VWN ) في موقع الإيواء المغلق مساعدتك في ذلك. يتم فحص وثائقك من قبل خبراء للتأكد من صحتها. تستخدم IND هذه الوثائق في تقييم طلب لجوئك.
انتبه! تعتبر بياناتك الشخصية ووثائقك مهمة بالنسبة لتقييم طلب لجوئك. لتكن معلوماتك كاملة وتأكد ان يتم تسجيل بياناتك بشكل كامل وصحيح. لا تتخلص أبدا من الوثائق الشخصية.
المترجم الشفهي
هناك مترجم شفهي موجود أثناء المقابلات مع IND . يطرح موظف IND الأسئلة باللغة الهولندية. يترجم المترجم الشفهي هذه الأسئلة إلى لغة مفهومة بالنسبة لك. يترجم المترجم الشفهي إجاباتك إلى اللغة الهولندية. لا يعمل المترجم الشفهي لدى IND وليس لديه تأثير على القرار بخصوص طلب لجوئك. أبلغ مباشرة إن كنت أنت والمترجم لا تستطيعان فهم بعضكما بشكل جيد. تحاول IND عندئذ ترتيب مترجم شفهي آخر. من المهم ألا تحدث حالات سوء فهم نتيجة عدم فهمك للأسئلة.
الخطوة 3 : فترة الاستراحة والتحضير
تُمنح بعد المقابلة الأولية فترة 6 أيام للاستراحة والتحضير ( RVTRVT ). يمكنك اثناء فترة الاستراحة والتحضير أخذ قسط من الراحة ومواصلة تحضير نفسك لإجراءات اللجوء. يمكنك بالتشاور مع محاميك أن تطلب من IND تقصير فترة الاستراحة والتحضير. يمكن ل IND أحيانا أن تقرر ألا تحصل على RVT . يمكن أن تحدث ذلك مثلا إذا قدمْت من بلد آمن. أو إذا كنت تملك حماية في بلد آخر عضو في الاتحاد الأوربي أو النرويج أو ايسلندا أو ليشنشتاين أو سويسرا.
تلقي المعلومات من قبل مؤسسة مساعدة اللاجئين VWN
يقدم لك موظف تابع ل VWN معلومات وشرحا حول إجراءات اللجوء العامة والنصيحة الطبية. يقدم لك موظفو مؤسسة مساعدة اللاجئين المعلومات والدعم أثناء إجراءات اللجوء. خدمات VWN مجانية. يتم التعامل مع معلوماتك بسرية.
النصيحة الطبية
سوف يقوم ممرض(ة) من MediFirst بطرح أسئلة عليك أثناء إجراء فحص غير موسع. يكتب الممرض نصيحة طبية. يرسلك الممرض إن كان ذلك ضروريا إلى طبيب لإجراء فحص مفصل. يبلغ الممرض أو الطبيب IND بنتيجة الفحص. ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقتك.
تأخذ IND المعلومات المتعلقة بوضعك الصحي بعين الاعتبار أثناء إجراءات اللجوء.
من المهم أن تكون صادقا حول مشاكلك العقلية والجسدية إن وجدت. تحدث حول هذه المشاكل مع الممرض أو الطبيب. هل لديك ندب(أثر جروح)؟ أبلغ بذلك أيضا للممرض أو الطبيب. يتصف تقرير النصيحة الطبية بالسرية. لا يعتبر إجراء فحص طبي إجراءا إلزاميا. لست مضطرا للدفع مقابل الفحص الطبي.
إذا لم ترغب في التعاون على إجراء فحص طبي، يمكنك إبلاغ الممرض بذلك. في هذه الحالة لا تستيطع IND أخذ وضعك الصحي بعين الاعتبار بشكل تام.
فحص السل الرئوي
السل الرئوي هو مرض شائع في العالم. وربما يكون كذلك في بلدك الأصلي. يمكن للأشخاص المصابين بالسل المعدي نقل العدوى إلى أشخاص آخرين عن طريق السعال أو العطاس.
سوف يطرح عليك موظف من الوحدة الصحية لموقع الإيواء المغلق أسئلة حول ذلك. يحدث ذلك من حيث المبدأ أثناء فترة الاستراحة والتحضير ) RVT (. لكن يمكن كذلك أن يحدث قبل RVT . إذا كانت هناك شكوك بأنك مصاب بالسل الرئوي، يجرى لك فحص سل رئوي شامل. ولهذا الغرض يتم أخذك إلى المستشفى. إذا كنت مصابا بالسل الرئوي، تتلقى علاجا بالأدوية في هولندا. في هذه الحالة يتم الشروع في إجراءات اللجوء بعد العلاج الطبي.
مساعدة المحامي
تحصل أثناء إجراءات لجوئك على مساعدة من محام. يتم تعيين محام لك في اللحظة التي تقدم فيها طلب اللجوء. لا يعمل هذا المحامي لدى الحكومة الهولندية. أثناء اجتماع مع محاميك، يساعدك هذا الأخير على التحضير لإجراءات اللجوء. يتم اجتماع التحضير هذا مع محاميك في
المبنى الذي تقيم فيه. لست مضطرا لدفع أي تكاليف مقابل مساعدة المحامي لك. يتم التعامل مع معلوماتك بسرية.
الخطوة 4 : إجراءات اللجوء يوما بعد يوم
تبدأ بعد فترة الاستراحة والتحضير RVT إجراءات اللجوء العامة ) AA ( تستغرق AA ستة أيام وتتم في المبنى الذي تقيم فيه. هناك أيضا إجراءات اللجوء العامة AA + تتستغرق 9 أيام غالبا. إن إجراءات اللجوء العامة AA + مخصصة لطلبات اللجوء التي يجب على IND
إجراء المزيد من البحث حولها. وكذلك لطالبي اللجوء الذين يحتاجون لاهتمام أكثر نتيجة مشاكل عقلية أو جسدية. تقرأ أدناه كيفية سير إجراءات لجوئك يوما بعد يوم.
إجراءات اللجوء العامة AA الى هولندا
اليوم 1 : المقابلة المفصلة
المقابلة المفصلة هي مقابلة مع موظف من IND . يمكنك خلال هذه المقابلة أن تحكي أسباب طلبك للجوء بشكل مفصل. سيطرح موظف
IND أسئلة عليك أيضا أثناء المقابلة. يكون هناك مترجم شفهي موجود أثناء المقابلة. يمكنك أن تطلب من مؤسسة مساعدة اللاجئين VWN حضور المقابلة المفصلة معك إن أردت ذلك.
هل قدمت أنت وشريك حياتك (زوجك) طلب اللجوء سوية؟ في هذه الحالة، يتم إجراء مقابلة مع كل واحد منكما على حدة من قبل موظف
IND . هل لديك أطفال بسن 15 سنة أو أكبر؟ سيتم عندئذ إجراء مقابلة خاصة بهم.
من المهم أن تقول كل شيء يتضح منه أنك تحتاج إلى الحماية. كن صادقا وليكن كلامك كاملا وواضحا حول ما تعرضت له وحول الأسباب التي لا يمكنك بسببها طلب الحماية في بلدك الأصلي. إذا لم تستطع تذكر أحداث محددة بشكل دقيق، أخبر موظف IND بذلك.
موظف IND على علم بالوضع العام في بلدك. من المهم أن تحكي عن وضعك الشخصي: لماذا تحتاج شخصيا إلى الحماية؟ اذكر أكبر كمية ممكنة من التفاصيل المهمة. هل لديك ندب(أثر جروح9 أو شكاوى جسدية أو عقلية لها علاقة بأسباب طلبك للجوء. من المهم عندئذ أن تخبر IND بذلك.
يمكن أن تقرر IND أن تعرض عليك إجراء فحص طبي إن ارتأت أن ذلك مفيد لتقييم طلب لجوئك. يمكنك كذلك أن تُجري مثل هذا الفحص على نفقتك الخاصة.
اليوم 2 : مناقشة المقابلة المفصلة
يناقش محاميك تقرير المقابلة المفصلة معك. وخلال هذه المحادثة أيضا، يساعدك مترجم شفهي على ترجمة كل ما تقوله أنت والمحامي. إذا كان هناك شيء ناقص أو غير مكتوب بشكل صحيح في التقرير، يقوم محاميك بإبلاغ IND بذلك بواسطة رسالة.
اليوم 3 : القرار الأول
تقيم IND ما إذا كنت مستوفيا لشروط الحصول على تصريح إقامة اللجوء. نتيجة هذا التقييم هي التي ستحدد الكيفية التي ستستمر بها إجراءات اللجوء الخاصة بك. هناك 4 احتمالات:
1 . تكون مستوفيا لشروط الحصول على تصريح إقامة اللجوء. تصلك (عن طريق محاميك) رسالة من IND مفادها أن إجراءات اللجوء على الحدود قد انتهت وأنه سُمح لك بدخول هولندا. ستتم الموافقة على طلب لجوئك بأسرع وقت ممكن بالتشاور مع محاميك. يُسمح لك بالسكن (مؤقتا) في هولندا. سيشرح لك محاميك عواقب ذلك بالنسبة لك.
2 . تحتاج IND إلى المزيد من الوقت لإجراء البحث ولا تستطيع اتخاذ قرار خلال 28 يوما حول طلب لجوئك. تواصل IND معالجة طلب لجوئك ضمن إجراءات اللجوء الممددة ( VA ). تتم هذه الإجراءات في مركز إيواء (مفتوح). يصدر القرار حول طلب لجوئك
لاحقا. تتلقى عندئذ منشورا آخر يحتوي على معلومات حول إجراءات اللجوء الممددة هذه.
3 . تقرر IND بإنك على الأرجح غير مستوف لشروط الحصول على تصريح إقامة اللجوء لكن لا توجد اسباب لإبقائك في مركز مغلق.
يستمر طلب لجوئك ضمن إجراءات اللجوء العامة AA لكن خارج إجراءات اللجوء على الحدود. تتوقف إجراءات اللجوء العامة AA
وغالبا ما تتم مواصلتها بعد أسبوع في مركز إيواء (مفتوح9.
4 . تقرر IND بأنك غير مستوف لشروط الحصول على تصريح إقامة اللجوء. تصلك (عن طريق محاميك9 رسالة من IND مفادها أن IND تنوي رفض طلب لجوئك. تسمى هذه الرسالة بالقرار المُعتزم اتخاذه. تحتوي هذه الرسالة كذلك على أسباب هذا الرفض وعواقب
ذلك بالنسبة لك. يناقش محاميك هذه الرسالة معك.
اليوم 4 : الرد على القرار: الرد الرسمي(وجهة نظرك)
إذا كانت IND تنوي رفض طلب لجوئك، تناقش القرار المعتزم اتخاذه مع محاميك. يمكن لمحاميك بعد ذلك إرسال رد رسمي خطي إلى
IND . وهي رسالة يرد فيها رسميا على القرار المعتزم اتخاذه من قبل IND . يمكنك في هذه الرسالة شرح سبب عدم موافقتك على القرار المعتزم اتخاذه.
اليوم 5 و 6 : القرار
تقيم IND بعد قراءة ردك الرسمي(وجهة نظرك) ما إذا كان يجب تعديل القرار المعتزم اتخاذه. تحدد نتيجة هذا التقييم الكيفية التي ستستمر بها إجراءات اللجوء الخاصة بك. تصلك 0عن طريق محاميك) رسالة من IND تخبرك فيها بنتيجة هذا التقييم. سوف يشرح لك محاميك عواقب ذلك بالنسبة لك. هناك 4 احتمالات:
1 . تكون مستوفيا لشروط الحصول على تصريح إقامة اللجوء. تصلك (عن طريق محاميك) رسالة من IND مفادها أن إجراءات اللجوء على الحدود قد انتهت وأنه سُمح لك بدخول هولندا. ستتم الموافقة على طلب لجوئك بأسرع وقت ممكن بالتشاور مع محاميك. يُسمح لك (مؤقتا) بالبقاء في هولندا. سيشرح لك محاميك عواقب ذلك بالنسبة لك.
2 . تحتاج IND إلى المزيد من الوقت لإجراء البحث ولا تستطيع اتخاذ قرار خلال 28 يوما حول طلب لجوئك. تواصل IND معالجة طلب لجوئك ضمن إجراءات اللجوء الممددة ( VA 9. تتم هذه الإجراءات في مركز إيواء )مفتوح(. يصدر القرار حول طلب لجوئك لاحقا. تتلقى عندئذ منشورا آخر يحتوي على معلومات حول إجراءات اللجوء الممددة.
3 . تقرر IND بإنك على الأرجح غير مستوف لشروط الحصول على تصريح إقامة اللجوء لكن لا توجد اسباب لإبقائك في مركز مغلق.
يستمر طلب لجوئك ضمن إجراءات اللجوء العامة AA ، لكن خارج إجراءات اللجوء على الحدود. تتوقف إجراءات اللجوء العامة AA وغالبا ما يتم استئنافها بعد ذلك بإسبوع في مركز إيواء (مفتوح).
4 . تُصر IND على رأيها بأنك لست مستوفيا لشروط الحصول على تصريح إقامة اللجوء. تصلك (عن طريق محاميك) رسالة من IND (=قرار) مفادها أن IND قد رفضن طلب لجوئك وأنك يجب أن تعود إلى بلدك الأصلي. كما تحتوي هذه الرسالة على أسباب القرار وعواقبه. وما يمكنك القيام به في حالة عدم موافقتك على قرار الرفض. وما هي الإمكانيات المتاحة للعودة إلى بلدك. يناقش محاميك القرار معك.
إجراءات اللجوء العامة 9 أيام AA الى هولندا
تعالجُ IND طلب لجوئك ضمن إجراءات اللجوء العامة ل 9 أيام ( AA +)؟ تستغرق إجراءات لجوئك عندئذ 9 أيام في الغالب:
- اليوم 1 و 2 : المقابلة المفصلة؛
- اليوم 3 و 4 : مناقشة المقابلة المفصلة مع المحامي؛
- اليوم 5 : القرار الأول؛
- اليوم 6 و 7 : الرد على القرار (الرد الرسمي) من قبل المحامي؛
- اليوم 8 و 9 : القرار الثاني.
إجراءات اللجوء على الحدود 28 يوما كحد أقصى الى هولندا
تم أعلاه شرح أن إجراءت اللجوء العامة AA تستغرق 6 أيام وأن إجرءات اللجوء العامة AA + تستغرق 9 أيام. يمكن أن تقرر IND في حالات محددة تمديد إجراءات اللجوء على الحدود لمدة 28 يوما. تعتبر أيام السبت والأحد أيام عمل أيضا في إجراءات اللجوء على الحدود.
تحاول IND اختزال فترة إجراءات اللجوء على الحدود أكبر قدر ممكن لكي لا تقيم في مركز إيواء مغلق بدون ضرورة. حالما يتضح أنه لا يمكن الاستمرار في معالجة طلب لجوئك ضمن إجراءات اللجوء على الحدود، تتوقف هذه الإجراءات. يتم بعد ذلك، مثلما قرأت سابقا،
معالجة طلب لجوئك ضمن إجراءات اللجوء العامة AA خارج إجراءات اللجوء على الحدود أو ضمن إجراءات اللجوء الممددة VA . تقيم في كلا الحالتين في مركز إيواء مفتوح
إجراءات اللجوء المبسطة
هل أتيت من بلد آمن؟ في هذه الحالة هناك نسبة كبيرة بأنك لن تحصل على حق اللجوء. تُعالج IND طلبك ضمن إجراءات اللجوء المسرعة. تجري أثناء هذه الإجراءات مقابلة واحدة فقط مع IND . ينطبق ذلك أيضا إن كنت تملك تصريح إقامة لجوء في هولندا او بلد آخر عضو في الاتحاد الأوربي أو النرويج أو ايسلندا أو ليشنشتاين أو سويسرا.
انتبه! هناك منشور منفصل حول إجراءات اللجوء المبسطة.
الجنسيات التي لا يحق اللجوء في هولندا (لائحة بالدول الآمنة)
ألبانيا، الجزائر، أندورا، أستراليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، غانا، اليونان، المجر، ايرلندا، الهند، ايطاليا، جامايكا، اليابان، كوسوفو، كرواتيا، لاتفيا، ليشتنشتاين ، لتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، المغرب، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلاندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، أوكرانيا، النمسا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، السنغال، صربيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، إسبانيا، ترينداد وتوباغو، التشيك، تونس، الفاتيكان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ايسلندا، السويد، سويسرا.
يمكن لهذه اللائحة أن تتغير يمكن إضافة بلدان إليها أو حذف بلدان منها وذلك راجع إلى الأمان السائد في بلد ما آخر نسخة من لائحة البلدان الآمنة موجودة على موقع الحكومة المركزية www.rijksoverheid.
سحب طلب لجوئك
يُسمح لك بسحب الطلب في أي لحظة تريد. يوصى في تلك الحالة بالاتصال بمحام أو ب IND مباشرة. هل سحبت طلبك لدى IND ؟ إذن لم يعد مسموحا لك بالبقاء في هولندا. إلا إذا سُمح لك بالبقاء هنا لسبب آخر. يمكن أيضا أن يصدر قرار بمنعك دخول البلاد. نتيجة لذلك، لا يسمح لك بالسفر إلى هولندا وإلى أغلب البلدان الأوروبية أو التواجد بهما. يسمح لك بتقديم طلب لجوء من جديد بعد سحبك لطلب لجوئك. حتى وإن أًصدر بحقك قرار المنع من دخول البلاد.
ما بعد إجراءات اللجوء
إذا رفضت IND طلب لجوئك يمكنك عندئذ بالتشاور مع محاميك تقديم استئناف ضد هذا القرار لدى قاض هولندي. يعني ذلك أنك تبلغ القاضي رسميا بأنك لست موافقا على قرار IND . يمكنك أيضا أن تطلب من القاضي السماح لك بالبقاء في هولندا أثناء إجراءات الاستئناف.
يساعدك محاميك في ذلك. يبحث القاضي بعد ذلك ما إذا كانت IND قد طبقت القانون الهولندي بشكل صحيح عند اتخاذ القرار بشأن طلب لجوئك. يُسمح لك في كثير من الحالات انتظار قرار القاضي في هولندا. تقيم في مركز إيواء مغلق حتى يتخذ القاضي القرار. يفرض عليك في الغالب منع دخول أغلب الدول في أوروبا.
في حالة رفض طلبك، يفرض عليك في الغالب منع دخول البلاد. بعد صدور قرار الرفض، يٌسمح لك بتقديم طلب اللجوء من جديد. حتى وإن فرض عليك قرار منع دخول البلاد.
العودة
أنت مسؤول بنفسك عن العودة إلى بلدك الأصلي. لكن تساعدك مصلحة العودة والمغادرة ) DT&V ( للتحضير لمغادرتك. تتصل DT&V بك بعد رفض طلب لجوئك. إذا لم تغادر بنفسك خلال الفترة المشار إليها، يتم إرجاعك قسريا إلى بلدك الأصلي. تبقى في الإيواء المغلق أثناء إجراءات العودة.
إذا كنت تريد الحديث قبل ذلك مع DT&V حول العودة، يمكن لمحاميك او موظف من VWN توصيلك ب DT&V . يمكنك كذلك الاتصال بنفسك ب DT&V عن طريق استمارة خاصة تجدها على موقع DT&V :
معالجة البيانات الشخصية
البيانات الشخصية هي كل أنواع المعلومات الخاصة بك. أسماء المؤسسات المُشاركة في هذا المنشور مكتوبة أدناه. تعالج هذه المؤسسات البيانات الشخصية أثناء النظر في طلبك او بلاغك أو التماسك. وهم يطلبون منك بياناتك ويطلبونها أيضا من مؤسسات أخرى وأشخاص آخرين إذا كان ذلك ضروريا. تستخدم هذه المؤسسات بياناتك وتحتفظ بها وتمنحها لمؤسسات أخرى إذا استلزم الأمر ذلك قانونا. يتضمن قانون الخصوصية التزامات المؤسسات التي تعالج بياناتك. حيث يتعين عليها مثلا التعامل بحرص وأمان مع بياناتك. يتضمن قانون الخصوصية كذلك حقوقك مثل:
- الاطلاع على بياناتك لدى المؤسسات؛
- معرفة ما تفعله المؤسسات ببياناتك ولماذا؛
- معرفة المؤسسات التي تم منح بياناتك لها.
هل تريد معرفة المزيد حول كيفية معالجة بياناتك الشخصية وحقوقك؟ راجع إذن المواقع الالكترونية الخاصة بهذه المؤسسات.
الأسئلة الشائعة حول اللجوء الى هولندا
متى أجري مقابلة واحدة فقط مع IND ؟
تجري أول مقابلة مع IND بعد تسجيلك كطالب للجوء. وتسمى بمقابلة التسجيل الأولية. غالبا ما تُمنح بعد ذلك 6 أيام من الوقت للاستراحة وللتحضير لإجراءات اللجوء يسمى ذلك بفترة الاستراحة والتحضير RTV . هل تريد اختزال فترة الاستراحة والتحضير؟ يمكنك عندئذ مناقشة ذلك مع محاميك وإبلاغ IND بذلك.
كم يستغرق الرد على طلب اللجوء في هولندا؟
ما الذي يحدث إن لم تستطع IND اتخاذ قرار في إجراءات اللجوء على الحدود في غضون 6 أو 9 أو 28 يوما؟
في هذه الحالة، يمكن ل IND أن تقرر معالجة طلب لجوئك ضمن إجراءات اللجوء الممدة VA . و يستغرق الأمر في تلك الحالة 6 أشهر كحد أقصى منذ توقيعك لطلب اللجوء حتى اتخاذ IND لقرار في طلب لجوئك. تقيم عندئذ في مركز إيواء مفتوح. تتلقى عندئذ منشوراً آخر يحتوي على معلومات حول إجراءات اللجوء الممددة.
عندما لا تستطيع IND اتخاذ قرار في غضون 6 أشهر، تتلقى رسالة منها تخبرك بذلك. إن لم ترسل IND قرارا إليك بعد 6 أشهر من تقديمك لطلب اللجوء ولم تتلق أي رسالة منها يمكنك عندئذ أن ترسل رسالة إلى IND تطلب فيها اتخاذ قرار بسرعة بشأن طلب لجوئك.
يمكن لمحاميك مساعدتك في ذلك.
أفضل أن أروي قصة لجوئي لامرأة. هل ذلك ممكن؟
نعم، يمكنك الإشارة إلى ذلك أثناء المقابلة الأولية )= المقابلة الأولى مع IND (. تحاول IND عندئذ ترتيب موظفة (أنثى) تابعة لها ومترجمة شفهية (أنثى) في المقابلة المفصلة. هل تفضل رواية قصتك لرجل؟ يمكنك الإشارة إلى ذلك أيضا أثناء مقابلة التسجيل الأولية.
تحاول IND في تلك الحالة ترتيب موظف (ذكر) تابع لها ومترجم شفهي (ذكر) للمقابلة المفصلة.
ما الذي يجب علي فعله إذا كنت مريضاً أوحاملاً؟
إذا كنت مريضا أوحامل، أخبر المصلحة الصحية في المطار بذلك. و الممرض(ة)أثناء الفحص المتعلق بالنصيحة الطبية (سبق التطرق لهذا الموضوع في هذا المنشور). يعتبر ذلك مهما أكثر إذا كنت مصابا بمرض مع د أو كنت تعتقد أنك مصاب بأمراض مثل: السل الرئوي أو الجرب أو التهاب الكبد B . يتم التعامل مع كل ما تقوله للممرض() بشكل سري. لا يقدم الممرض(ة) أبدا معلومات حول صحتك للآخرين بدون موافقتك.
إذا مرضت أثناء إجراءات اللجوء، أخبر عندئذ موظف IND أو VWN بذلك. يمكنهم مساعدتك لتلقي المساعدة (الطبية) المناسبة. هل أصبحت مريضا في يوم المقابلة مع IND أو مع محاميك؟
اطلب عندئذ من أحد حراس الأمن أو موظف تابع لمؤسسة مساعدة اللاجئين إبلاغ المحامي أو IND بذلك.
هل ما تزال لديك أي أسئلة بعد قراءة هذا المنشور؟
يمكنك طرح هذه الأسئلة على محاميك او على أحد موظفي IND أو VWN .
هل لديك شكوى؟
تعمل جميع المؤسسات المعنية بإجراءات اللجوء بشكل احترافي ودقيق. هل تجد على الرغم من ذلك أنه قد تمت معاملتك بشكل غير جيد من
قبل مؤسسة ما؟ يمكنك عندئذ تقديم شكوى. يمكن لمحاميك أو موظف من VWN مساعدتك في ذلك.
هذه المعلومات منقولة من المنشور الأصلي و لتحميل المنشور كاملاً بصيغة pdf كما نشر من مصدره يرجى الضغط هنا