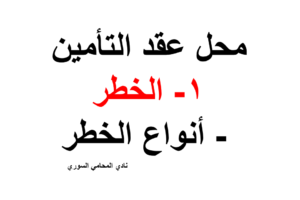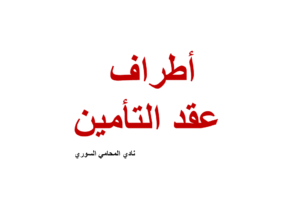كثيرة هي الحوادث التي تحصل ويكون فيها المسبب مجهولاً, وخاصة على الطرق العامة أو السريعة أو المهجورة, لذلك فقد استحدث في عام 2007 صندوق يتبع لهيئة الاشراف على التأمين أسمه ( صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب ) وننقل لكم كل التعليمات المذكورة في موقه الهيئة بالحرف بخصوص هذه الحوادث . December 26, 2018 188
آلية عمل صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التعويض:
أحدث عام 2007 ويتبع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، يتولى الصندوق تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط (دون المادية) الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق.
التعويضات التي يمنحها الصندوق بعد التعديل بتاريخ 2018 –
في حالة الوفاة : 500ألف ليرة سورية.
– العجز الدائم الكلي : 500ألف ليرة سورية.
– العجز الدائم الجزئي : 500ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي.
– العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 15000 عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر.
– النفقات الطبية: وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 250ألف ليرة سورية.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تعويض إلى صندوق حوادث السير مجهولة المسبب:
في حالة الأضرار الجسدية:
1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.
2- صورة مصدقة عن تقرير الطبيب الشرعي بحيث يوضح نسبة العجز إن وجدت.
3- صورة هوية المتضرر.
4- الفواتير الطبية الأصلية (فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المشفى).
يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد.
- يجب تقديم الطلب من المتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حصراً.
- يجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث.
في حالة الوفاة:
1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.
2- بيان وفاة أصلي.
3- كشف الجثة.
4- حصر إرث شرعي (لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر).
5- صورة هوية مقدم الطلب الذي يجب أن يكون أحد الورثة أو قرابة من الدرجة الأولى.
6- الفواتير الطبية الأصلية (في حال تكبد مصاريف طبية قبل الوفاة): فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المستشفى.
7- في حال موافقة اللجنة على صرف التعويض، وبعد إبلاغ الورثة بذلك، يتم تقديم صور هوية لجميع الورثة (في حال رغبة كل وريث بقبض حصته بنفسه)، أما في حال الرغبة بتوكيل أحد الورثة لقبض التعويض عن البقية، يتم تقديم وكالة خاصة لأحد الورثة لقبض التعويض المستحق له ولبقية الورثة، بحيث يتم تنظيم وكالة خاصة من قبل الكاتب بالعدل، لتوكيل هذا الوريث أمام هيئة الإشراف على التأمين (لقبض مستحقات واستلام شيكات وتعهد وإبراء وإسقاط حق) وذلك عن بقية الورثة الموكلين له.
يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد، ويجب أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الحادث، ومن قبل أحد ورثة المتوفى حصراً. بعد مضي أكثر من شهر على تاريخ تقديم طلب التعويض، يجب إحضار مصير ضبط الشرطة من الجهة التي حُفظت ضبوط الشرطة لديها (النيابة العامة) بحيث يقدم طلب إلى تلك الجهة وفق النموذج التالي:
نموذج طلب بيان مصير ضبط شرطة
إلى النيابة العامة في ……..
مقدمه: …………….
أرجو إعطائي بياناً بمصير ضبط الشرطة رقم ……. تاريخ………. المنظم من قبل مخفر ……… وضبط الشرطة رقم……. تاريخ……….المنظم من قبل مخفر ………..، بحيث يوضح هذا البيان إذا كانت السيارة الصادمة للسيد …………. ما زالت مجهولة حتى تاريخه، وهل يوجد إدعاء في الحادث، وذلك لتقديمه إلى هيئة الإشراف على التأمين (صندوق التعويض عن حوادث السير مجهولة المسبب).
مع الشكر
مقدم الطلب: …………..
التوقيع: ………..
تاريخ………..
للمراجعة والاستفسار هيئة الإشراف على التأمين هاتف رباعي 3061 فاكس 2226224 دمشق – شارع 29 أيار – ساحة الشهيد يوسف العظمة (دوار المحافظة) – بناء التأمين ط5