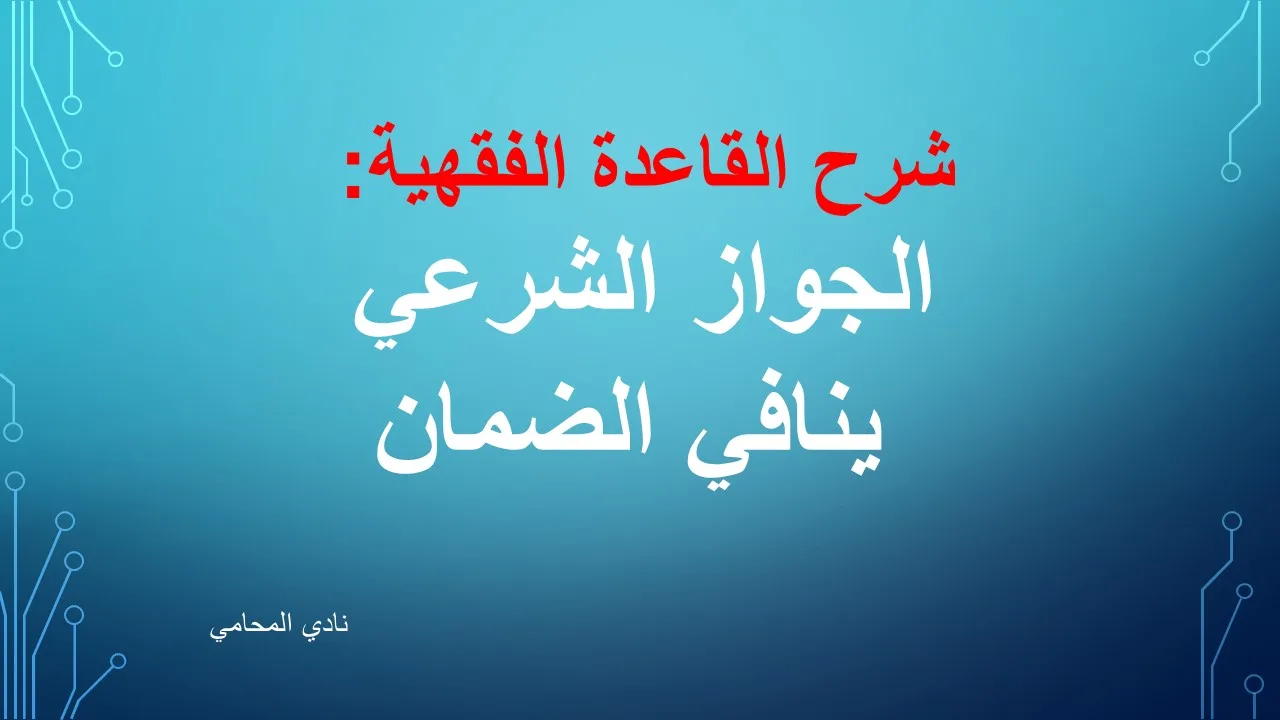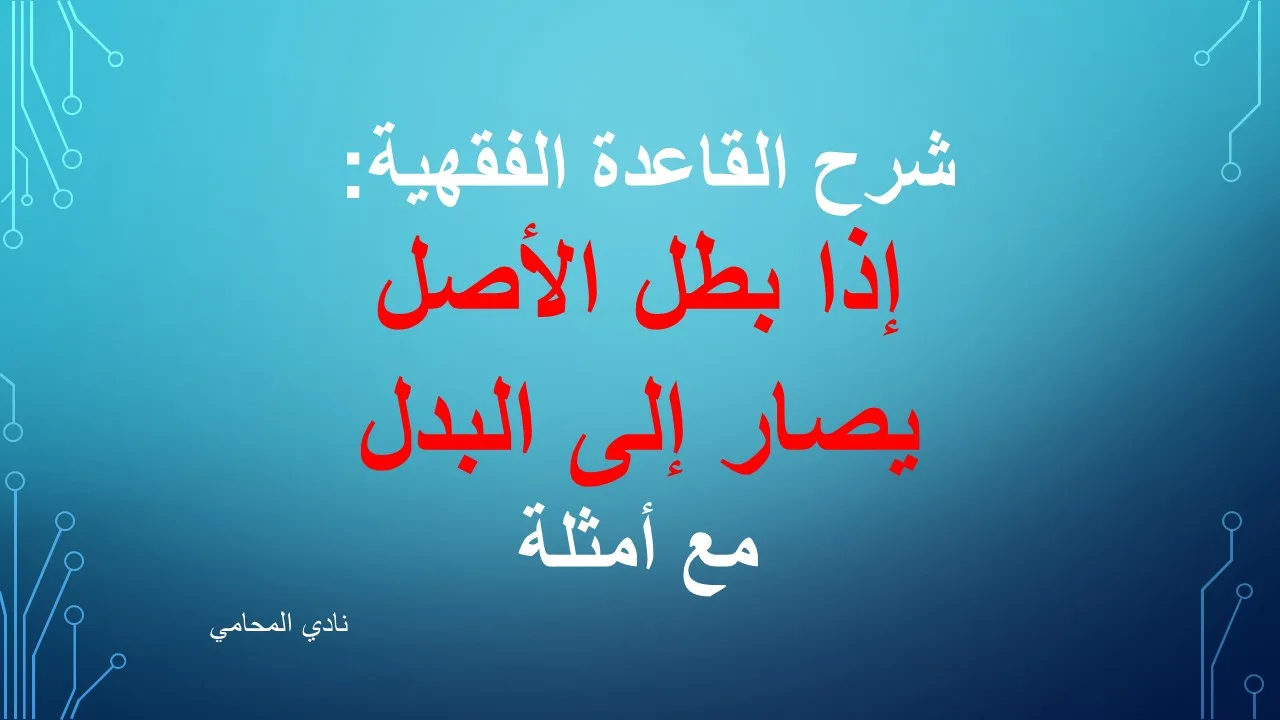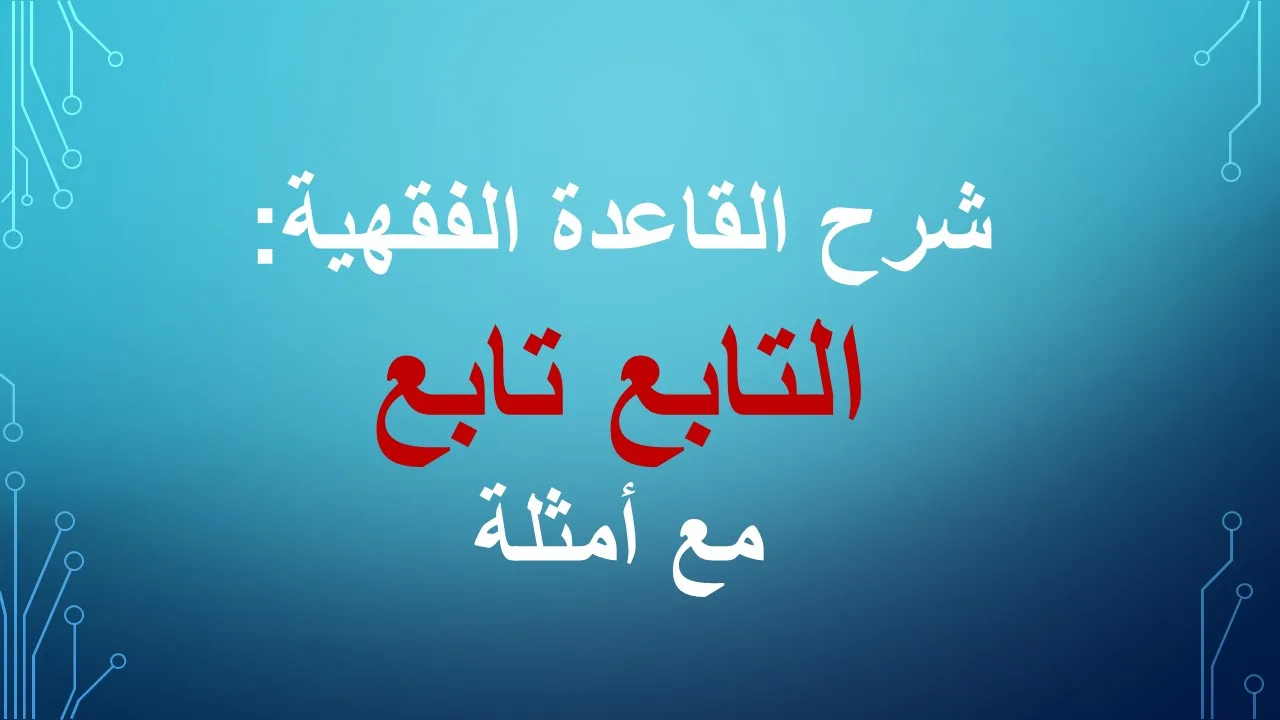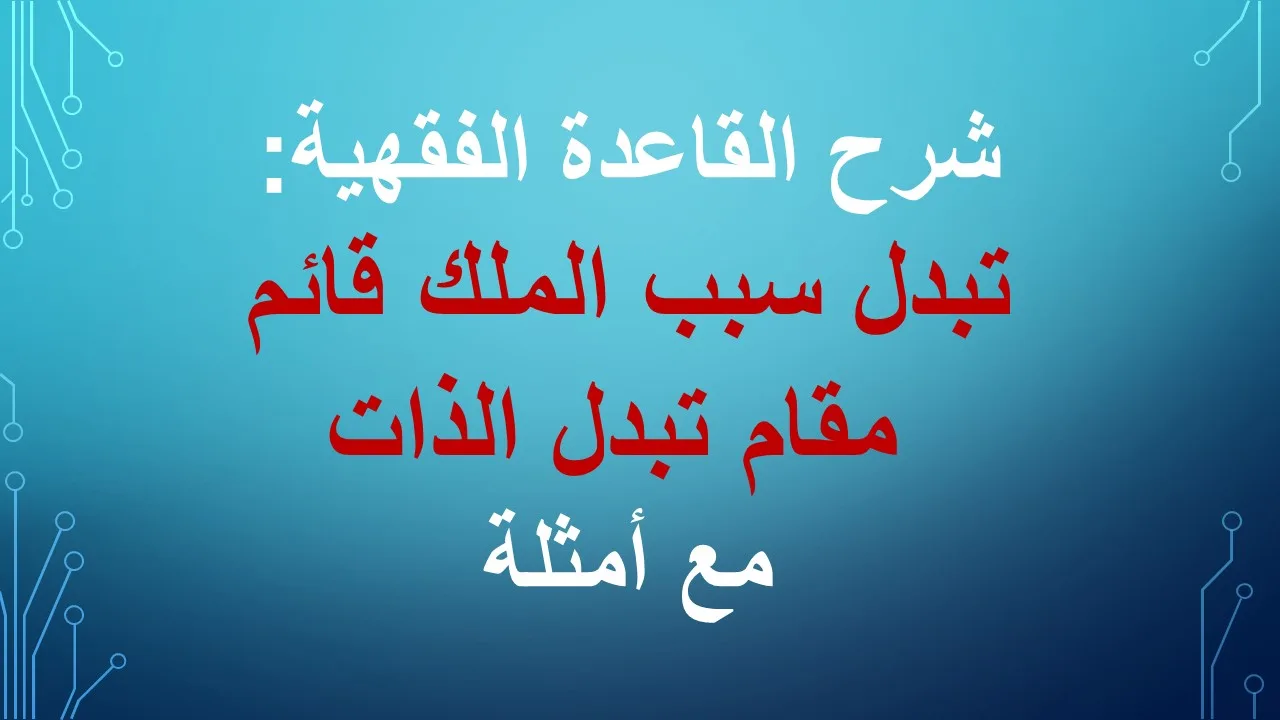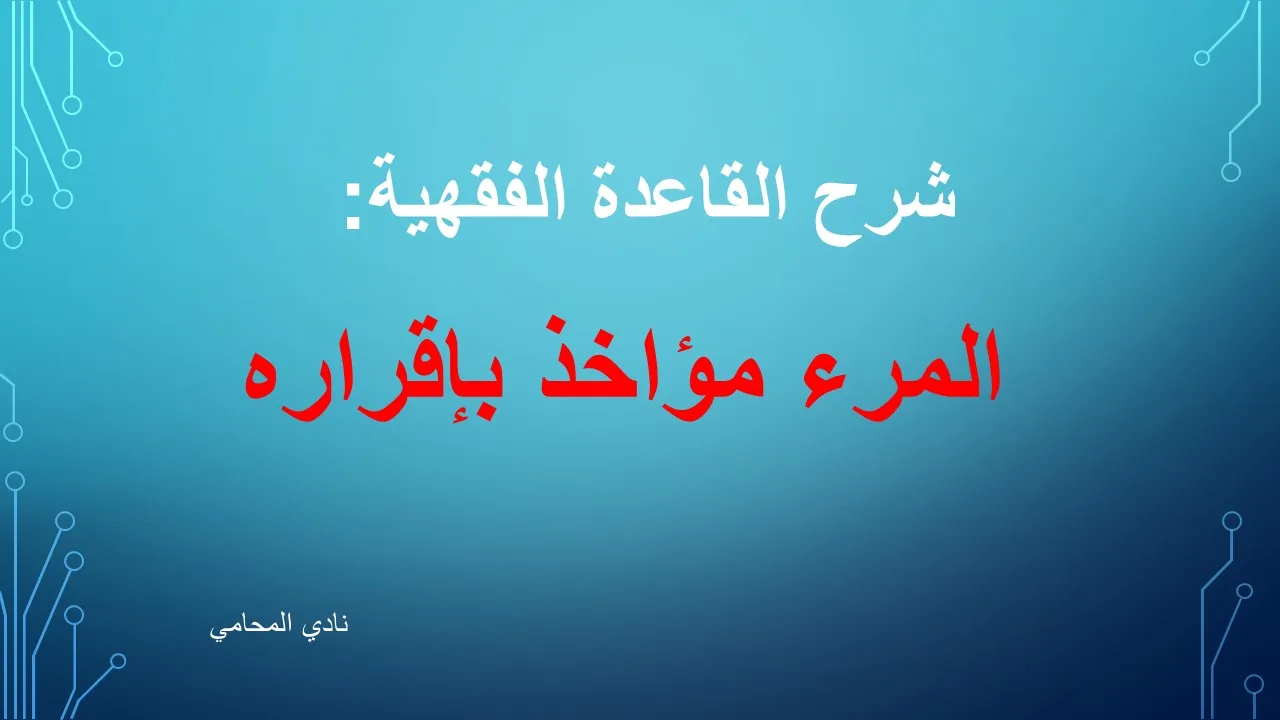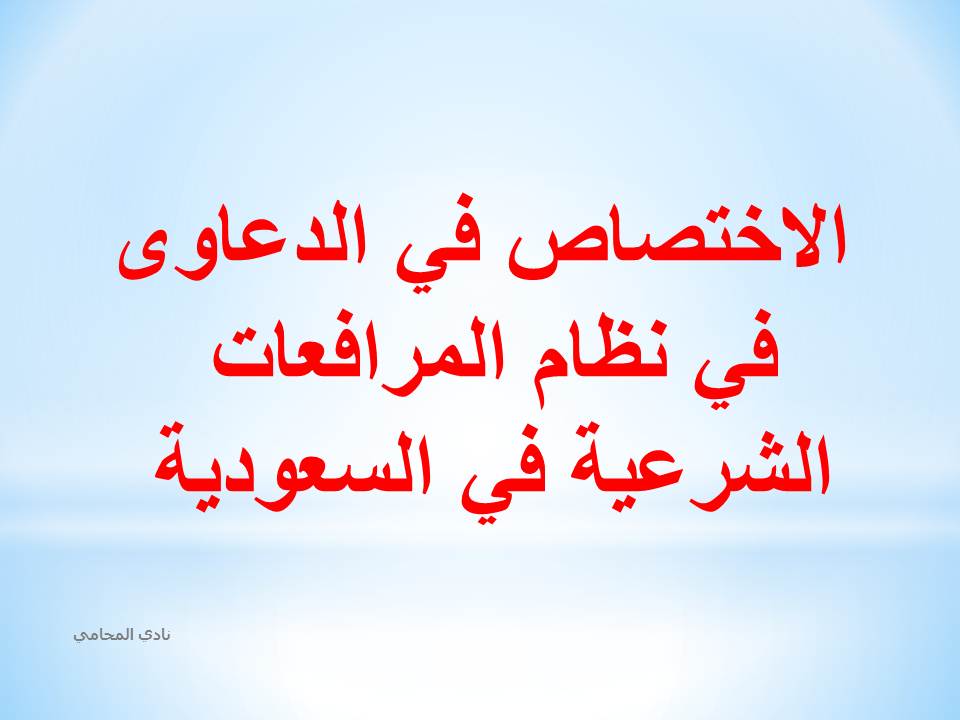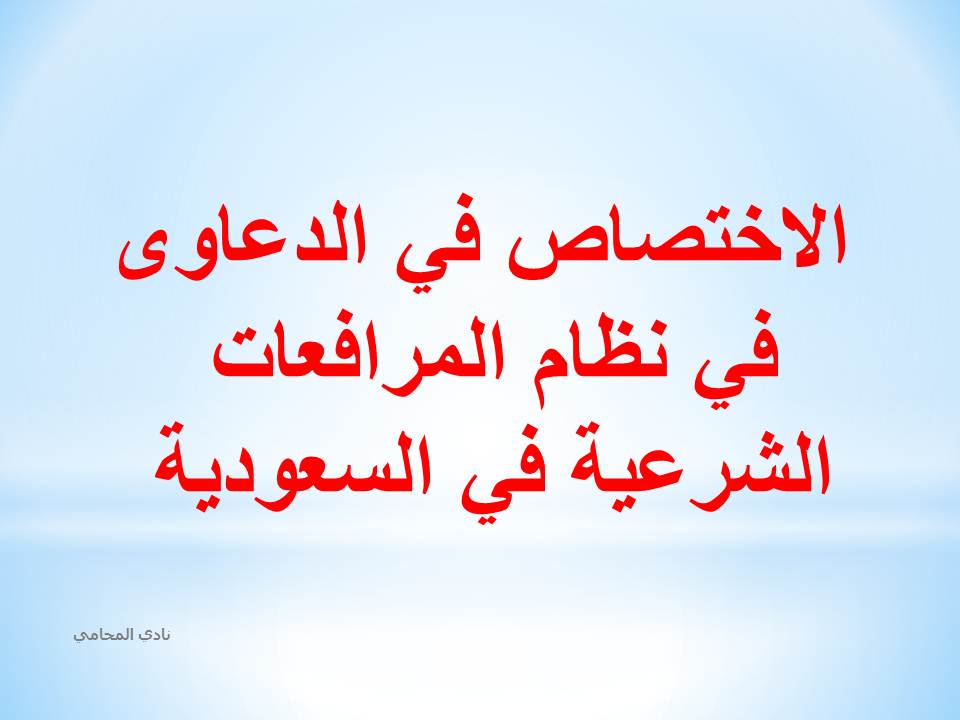الاختصاص في الدعاوى
س – بين المقصود بأنواع الاختصاص الآتية : الدولي، الولائي، النوعي، القيمي، المكاني.
|
نوع الاختصاص
|
المقصود به
|
|
الدولي
|
ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا، سواء أكان ذلك العنصر: المتنازع فيه، أو أحد الخصمين، أو كليهما، أو محل نشوء الالتزام، أو محل تنفيذه.
|
|
الولائي
|
قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة.
وجهات التقاضي: القضاء العام (العادي) ، القضاء الإداري، اللجان شبه القضائية.
|
|
النوعي
|
قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية. مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر قضايا الأحوال الشخصية دون غيرها
|
|
القيمي
|
. قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال
مثاله: اختصاص القاضي في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال
|
|
المكاني
|
قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من الدولة لا يتجاوزه.
مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر الدعاوى في مدينة مكة المكرمة دون غيرها.
|
س – بين الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً.
ج/ الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً:
۱/ المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة: وهي كل ما صدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، كالقرارات المتعلقة بسيادة الدولة خارجيا، كإعلان الحرب وسحب السفراء.
الدعاوى المرفوعة على أشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية الدولية: كرؤساء الدول والممثلين
الدبلوماسيين، فيطلب منهم مغادرتهم لأراضي المملكة.
س – متى تكون الدعوى مرفوعة على شخص سعودي الجنسية، لكنها تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة؟
ج/ كل الدعاوى المرفوعة على السعوديين تختص بها محاكم المملكة، ولو كانوا مقيمين خارج المملكة، باستثناء: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة( عرفت المادة (٢/٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بأنها: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك : قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه) كأن تتعلق الدعوى بإثبات تملك العقار، أو طلب إخلائه، أو طلب تجزئة العقار أو نحو ذلك من الدعاوى التي تتعلق بعين العقار، فهذه الدعاوى لا تختص بها محاكم المملكة إذا كان العقار خارج المملكة، ولو كان المدعى عليه سعودياً.
س – متى تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى المرفوعة على غير السعودي؟
ج / تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي في أحوال، منها:
١. إذا كان له محل إقامة في المملكة.
٢. إذا رفعت الدعوى على أكثر من شخص، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
. إذا رفعت الدعوى على شخص أو أكثر ولم يكن لهم محل إقامة في المملكة، لكن تعلقت الدعوى بأحد الأمور الآتية:
أ) إذا تعلقت بمال موجود في المملكة.
ب) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه (أي : أبرم الالتزام داخل المملكة).
ج) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان تنفيذه (أي: اتفق على تنفيذ الالتزام داخل المملكة).
د) إذا تعلقت الدعوى بإفلاس أُشهر في المملكة.
ه) دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.
س – مما سبق : لخص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة.
ج/ يمكن تلخيص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بالآتي:
1. الدعاوى المتعلقة بعين عقار خارج المملكة، سواء كان الخصوم سعوديين أو غير سعوديين.
٢. الدعاوى المرفوعة ضد شخص غير سعودي وليس له مكان إقامة في المملكة، ولم تكن الدعوى متعلقة بمال أو التزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه، ولم تكن كذلك من دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.
س – إذا كانت الدعوى خارجة عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، وحضر الخصمان إلى محاكم المملكة للمرافعة ، فهل للمحكمة نظر الدعوى؟
ج/ نعم، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى الخارجة عن اختصاصها الدولي إذا قبل المتداعيان ولايتها.
ويستثنى من ذلك: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، فلا تنظر في محاكم المملكة مطلقاً.
س – ما الفرق بين الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي؟ ومتى يحكم بأي منهما؟
ج / سبق أن:
الاختصاص الولائي: قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة. والاختصاص النوعي: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية.
وفي المملكة ثلاث جهات قضائية:
الأولى: المجلس الأعلى للقضاء ويتبعه المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، ومحاكم التنفيذ.
الثانية: ديوان المظالم، ويتبعه المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم الإدارية.
الثالثة: اللجان القضائية، ولكل لجنة ولاية قضائية مستقلة.
متى يحكم بعدم الاختصاص الولائي؟
يحكم بعدم الاختصاص الولائي إذا رُفعت دعوى إلى جهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى.
مثاله: إذا رفعت دعوى أمام محاكم ديوان المظالم، وهي من اختصاص محاكم القضاء العام.
متى يحكم بعدم الاختصاص النوعي؟
يحكم بعدم الاختصاص النوعي إذا رفعت دعوى إلى محكمة تابعة لجهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص محكمة أخرى تابعة للجهة القضائية نفسها، لكنها محكمة ذات نوع مختلف عن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.
مثاله : إذا رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية، وهي من اختصاص المحكمة العامة.
الاختصاص النوعي في الفقه:
قال النووي رحمه الله : (ولو نصب قاضيين في بلد وخَصَّ كُلاً بمكان أو زمان أو نوع: جاز).
س – ما المقصود بالاختصاص القيمي ؟ مبيناً أمثلته في المملكة.
ج/ الاختصاص القيمي: قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال.
فائدة: الاختصاص القيمي في أنظمة المملكة داخل في الاختصاص النوعي.
من أمثلته في المملكة:
اختصاص بعض الدوائر الحقوقية في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا يزيد مبلغ المطالبة فيها عن عشرين ألف ريال، ويكون نظر ما زاد عن ذلك المبلغ من اختصاص دوائر أخرى في المحكمة.
اختصاص الدوائر الفرعية في المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال.
اختصاص دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بنظر دعاوى قسمة التركات التي تزيد عن مئة مليون ريال، واختصاص دائرة ثلاثية في المحكمة العامة بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئة مليون ريال.
الاختصاص القيمي في الفقه:
قال ابن قدامة رحم الله : ( ويجوز أن يجعل حكمه في قدرٍ من المال، نحو أن يقول: احكم في المئة فما دونها،
فلا ينفذ حكمه في أكثر منها).
الغاية من الاختصاص القيمي:
يفرد المنظم بعض الدوائر بالاختصاص في قضايا تقل أو تزيد عن مبالغ معينة لغايات، منها:
اعتبار الدعاوى التي تقل عن مبلغ معين دعاوى يسيرة، يقتضي التخفيف في إجراءاتها، والتعجيل بالحكم فيها، ويكون حكم القاضي فيها حكما قطعياً غير قابل للاستئناف، مما يعجل التنفيذ، ويخفف الضغط عن محاكم الاستئناف.
تخصيص دوائر معينة بنظر الدعاوى التي تزيد عن مبالغ معينة؛ ليكون لدى الدائرة مزيد من التحقق والتدقيق في نظرها مقارنة بغيرها.
س – ما المقصود بالاختصاص المكاني؟ ممثلاً له بمثال.
ج/ الاختصاص المكاني: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من
الدولة لا يتجاوزه، ويسمى أيضاً: الاختصاص المحلي.
مثاله : اختصاص قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة في نظر الدعاوى المقامة على من يقيم في
المدينة، دون من يقيم في المناطق المجاورة كينبع وبدر – مثلاً-.
س – ما المقصود بمصطلح ( مكان الإقامة ) الوارد في نظام المرافعات الشرعية ؟
ج/ يقصد بمكان الإقامة في نظام المرافعات الشرعية : المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.
س – ما ضابط المحكمة التي تختص مكاناً بنظر الدعوى؟
ج بينت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ضابط الاختصاص المكاني بالآتي:
١ – يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
۲- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في أي محكمة من محاكم المملكة التي تختص نوعا بنظر الدعوى.
٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحد المدعى عليهم.
– استثناء: يستثنى مما سبق مسائل :
الدعوى التي تقيمها امرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فلها الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو في بلد المدعى عليه.
الدعوى التي يقيمها إنسان يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالنفقة عليه، فله الخيار في إقامة الدعوى في بلده أو في بلد المدعى عليه.
الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، فللمدعي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه أو في بلد وقوع الحادث.
دعاوى استخراج حجة استحكام على عقار ، فتقام في البلد الذي يوجد فيه العقار.
الدعاوى الجزائية، فيتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فيتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
تنبيهات
-الاختصاص المكاني يختلف عن بقية أنواع الاختصاص في أنه حق للمدعى عليه، أما الأنواع الأخرى فالاختصاص فيها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وعليه: فيجوز نظر الدعوى في غير بلد المدعى عليه إذا رضي المدعى عليه بذلك، كما أن القاضي لا يحكم بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بذلك.
-إذا رفعت الدعوى في غير بلد المدعى عليه، وأراد المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني فيلزمه الدفع بذلك قبل أي إجابة، فإن أجاب على الدعوى قبل الدفع بالاختصاص المكاني: سقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولا يحق له الدفع به بعد ذلك.
-إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى أولاً.
-إذا اختلف البلد الذي يسكن فيه المدعى عليه عن بلد مقر عمله، فالعبرة ببلد سكنه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.
-إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد.
-إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.
-إذا كانت الدعوى مقامة على شركة أو جمعية أو مؤسسة، فيكون الاختصاص المكاني بحسب البلد الذي يقع فيه مركزها الرئيس، أو البلد الذي يقع فيه فرع الشركة الذي تتعلق به الدعوى.
س – من الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة ؟
ج/ الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم التابعة للقضاء العام : المجلس الأعلى للقضاء. والذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية : مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم.
س – إذا حصل نزاع بين محكمتين أو دائرتين قضائيتين في الاختصاص، فمن يفصل بينهما ؟
ج/ يختلف ذلك بحسب نوع الاختصاص المختلف فيه، ويمكن بيان أحوال ذلك في الجدول الآتي:
|
الجهتان المختلفتان
|
نوع الاختصاص محل الاختلاف
|
الجهة التي تفصل بينهما
|
|
محكمة تابعة للقضاء العام، ومحكمة تابعة لديوان المظالم
|
الاختصاص الولائي
|
لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء
|
|
محكمة تابعة للقضاء العام، ولجنة قضائية
|
الاختصاص الولائي
|
لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء
|
|
محكمة تابعة لديوان المظالم، ولجنة قضائية
|
الاختصاص الولائي
|
لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في ديوان المظالم
|
|
محکمتان تابعتان للقضاء العام
|
الاختصاص النوعي أو المكاني
|
المحكمة العليا
|
|
المحكمة وكتابة العدل
|
الاختصاص الولائي
|
المحكمة العليا
|
|
محکمتان تابعتان لديوان المظالم
|
الاختصاص النوعي أو المكاني
|
المحكمة الإدارية العليا
|
|
دائرتان في المحكمة نفسها
|
الاختصاص النوعي، أو بسبب تعلق القضية الجديدة بقضية سابقة
|
رئيس المحكمة
|