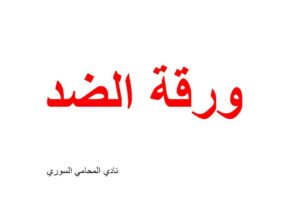1- تعريف ورقة الضد
ورقة أو عقد الضد هو العقد أو الاتفاق الحقيقي الذي يحرص المتعاقدان على ستره وإخفائه ، وذلك عن طريق تنظيم عقد ظاهر يحجب حقيقة التراضي عن الأنظار ، وقد ورد في معظم المؤلفات التعريف التالي لعقد الضد وللصورية :
عقد الضد هو العقد المستتر الذي يبطل أو يعدل مفاعيل العقد الظاهر .
والعقد المستتر يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ، في حين أن العقد الظاهر يعبر عن إرادةوهمية .
ثانياً- شرائط ورقة الضد
مما سبق نستنتج أن ثمة شروطاً يجب توافرها في عقد أو ورقة الضد :
1- يجب أن يكون العقد الظاهر مجرد ستار كاذب يخفي العقد الحقيقي .ومن شروط الصورية أن يكون العقد الظاهر وهمياً ، لأن غرض المتعاقدين الوحيد من عمله ، هو أن يكون ستاراً للعقد الحقيقي وقناعاً يحجبه عن الأعين .
2- يجب أن يكون العقد الحقيقي معاصراً للعقد الظاهر. ويكفي وجود معاصرة ذهنية بين العقد الحقيقي والعقد الظاهر أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، فهذه المعاصرة الذهنية هي الشرط الواجب في ورقة الضد ولا يشترط أن تكون المعاصرة مادية إذ لا شيء يحول دون كتابة العقد المستتر قبل أو بعد كتابة العقد الظاهر بمدة قد تطول أو تقصر ، وتبعاً لما سبق فإن اتحاد التاريخ بين العقدين المستتر والظاهر يعتبر قرينة بسيطة على الصورية في العقد ولكن اختلاف التاريخ ليس دليلاً قاطعاً على جديته.
3- يجب أن لا يتضمن العقد الظاهر الإشارة إلى عقد آخر تواطأ الطرفان على إخفائه لأن أي إشارة في العقد الظاهر للعقد الخفي تلغي الغرض المنشود من هذا العقد الخفي أو الحقيقي المراد إبقاءه خفياً عن الغير.
ثالثاً: خصائص ورقة الضد
1- وجود عقدين اتحد فيهما الطرفان والموضوع :
إن ذاتية المتعاقدين في العقدين السري والظاهر، وذات موضوع التعاقد فيهما تقتضيه طبيعة عقد الضد ذاته من حيث كونه عقداً يلغي أو يعدل عقداً ظاهراً بصورة كلية أو جزئية ، إذ من المعروف بداهة إن إلغاء عقد أو تعديله يعود مبدئياً لطرفيه أو لأطرافه أنفسهم .
ولكن لا يشترط اتحاد المتعاقدين في العقدين شخصياً بل يكفي اتحادهما اتحاداً قانونياً .
2- تناقض العقد السري مع العقد الظاهر :
أي أن ورقة الضد تستلزم وجود اتفاقين متعارضين الاتفاق الثاني يلغي الاتفاق الأول الظاهر أويعدله فهما ضدان لايجتمعان أي استحالة تنفيذهما معاً وهذا الشرط هو العلامة المميزة لورقة الضد وعلى ذلك إذا أمكن تنفيذ العقدين فلا يعتبر العقد السري ورقة ضد .
3- صورية العقد الظاهر :
بمعنى أن يكون العقد الظاهر وهمياً لأن الغرض الوحيد من عمله مع العقد الحقيقي المستتر هو أن يكون له ستاراً يخفيان به عن الغير حقيقة ما تعاقدا عليه ، فالعقد الظاهر معدوم لا أثر له قانوناً لأن المتعاقدين لم يقصداه وليس هناك لا ايجاب ولا قبول ولم يقصدا منه إلا أن يكون قناعاً للعقد المستتر الحقيقي ليخفيا الحقيقة عن الغير .
فالعقدان الظاهر والمستتر إذاً هما عقدان متعاصران يصدران معاً في وقت واحد ولا تشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة الذهنية.
4- العقد الحقيقي المستتر قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر كلياً أو جزئياً :
إذا ارتضى الفريقان تنظيم العقد الظاهر بالشكل الذي برز فيه – وهو أبعد ما يكون عن التعبير عن حقيقة مرادهما – فما ذلك إلا لعلمهما بأن العقد المستتر الذي تضمن إرادتهما الحقيقية قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر بصورة كلية أو جزئية ، أي بالقدر الذي يغاير فيه الحقيقة.
رابعاُ: شكل ورقة الضد
لا يوجد في القانون المصري والفرنسي والسوري الذي استمد معظم مواده من القانونين السابقين نص يحدد ورقة الضد .
وقد ترك المشرع شكل ورقة الضد للقواعد العامة ولحرية المتعاقدين يحررونها بالشكل الذي يرونه مناسباً وذلك مع مراعاة القاعدة الفقهية ” أن الأصل في الأشياء الإباحة.”
فقلما يهم الشكل الذي يرتديه العقد المستتر أو العقد الظاهر ويكفي توفر الشروط والخصائص المكونة لعقد الضد حتى تنطبق أحكام الصورية .
مع التذكير أو ورقة الضد تمثل تصرفاً قانونياً ثنائياً باعتبارها عقد مستور بين متعاقدين اجتمعت ارادتهما لتحقيق آثار ونتائج هذا العقد.
والتصرف القانوني هو إرادة تتجه الى إحداث أثر قانوني كالعقد .
أما الواقعة القانونية فهي حادث مادي يرتب عليه القانون أثراً سواء أكانت الإرادة اتجهت الى إحداث هذا الأثر أم لا .
وتجدر الإشارة الى أن العقد المستتر و العقد الظاهر يمكن أن ينظما بشكل سند عادي أو بشكل سند رسمي ويمكن أن ينظم أحدهما بشكل سند عادي وينظم الآخر بشكل سند رسمي.
وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 577/435 تاريخ 3/6/1976 نشرت في المحامون عام 1976 ص /679/ على :
إن اسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري لا يحصنه ضد قبول إثبات وجود العقد الحقيقي بالبينة الشخصية متى كان من الجائز اعتمادها كدليل لأن العقد الصوري لا وجود له قانوناً فتسجيله وعدمه سيان .”
لكن يبقى السؤال عما إذا كان يمكن أن يكون كل من العقد الظاهر والعقد المستتر شفهياً ؟
والرأي أنه لا شيء يحول دون أن يكون عقد الضد شفهياً وكذلك العقد الظاهر فليس ثمة ما يوجب تنظيم سند خطي للقول بوجود الصورية .
خامساً : آثار ورقة الضد
1- ورقة الضد والصورية :
كما ذكرنا فورقة الضد أو عقد الضد هو عقد يكتب سراً بين متعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كلياً أو جزئياً ، كما إذا أراد مدين تهريب شيء له من دائنه فيبيعه بيعاً صورياً لآخر ويأخذ عليه ورقة ضد تفيد الصورية وأن الشيء لازال ملكه .
فالعقود الصورية إذاً تحوي غشاً أو تغييراً للحقيقة يساعد على الغش ولذلك منعتها القوانين الفرنسية القديمة بل وكانت تعاقب على الصورية وتحرير ورقة الضد في بعض الأحوال بغرامة كبيرة وقد أجاز القانون المدني السوري الصورية بالمادتين /245/ و/246/ كما سنرى فيما يلي:
تنص المادة /245/ قانون المدني السوري على ما يلي :
” إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأوليين. “
ونصت المادة /246/ على مايلي :
” إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . “
ومن هذه النصوص يتبين لنا أثر الصورية ” ورقة الضد ” بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام والغير والخلف الخاص .
2- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام :
لا بد لنا من تعريف الخلف العام ، وذلك لتوضيح ما قصد به المشرع بنص المادة /246/ من القانون المدني السوري وهو :
” من يخلف سلفه في ذمته المالية كلها ( كالوارث الوحيد ) أو في جزء شائع منها ( كالوارث مع غيره أو الموصى له بحصة من التركة ) “
وعليه فإن أثر ورقة الضد بين المتعاقدين والخلف العام تؤدي إلى ما يلي :
– العقد الظاهر لا وجود له : بدلالة المادة /246/ من القانون المدني السوري فلا يعمل به وهذا ما يقتضيه سلطان الإرادة ذلك أن المتعاقدين إنما أرادا العقد المستتر لا العقد الظاهر فوجب أن يلتزما بما أراداه لا بما لم يريداه .
فإذا باع شخصاً عيناً من آخر بيعاً صورياً واحتفظ بورقة الضد ففيما بين البائع والمشتري لا وجود للبيع ويبقى البائع مالكاً للعين وله حق التصرف فيها ويستطيع أن يبيعها جدياً بعد ذلك إلى مشترٍ ثانٍ والمشتري الثاني هو الذي تنتقل إليه الملكية وليس للمشتري الصوري الأول أن يحتج بعقد البيع الصوري على المشتري الثاني ولو سجل البيع الصوري قبل تسجيل البيع الجدي .
كذلك ، إذا مات البائع فالعين الباقية في ملكه تنتقل بالميراث إلى وارثه الخلف العام إذ العبرة بالنسبة إلى الخلف العام بالعقد الحقيقي أيضاً لا بالعقد الصوري، فالبائع الصوري يبقى مالكاً للعين وتنتقل منه الملكية إلى وارثه والمشتري الصوري لا تنتقل إليه ملكية العين ، ومن ثم لا تنتقل منه هذه الملكية الى وارثه .
وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :
” إن أثر ثبوت صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي الى الغاء التسجيل الذي تم بالاستناد اليه .” ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1963 مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963 )
ولما كانت الصورية كثيراً ما تستعمل لخديعة الغير والتحايل على القانون فقد اقتصر القانون على منع تحقيق أغراضها غير المشروعة دون أن يجاوزه إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده المتعاقدان وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من قانون البينات السوري بقولها :
” وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها .”
وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :
” إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام ، أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر ، أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي .”
( نقض سوري /1123/ ت 13/5/1965 – مجلة القانون ص /639/ لعام 1965 )
وجوب إثبات العقد الحقيقي والشروط الواجب توافرها فيه :
فأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وفقاً لقواعد الإثبات العامة ، أما إذا لم يستطع أن يثبت أن هناك عقداً مستتراً فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً لا صورياً ، فإذا ما ثبت وجود العقد المستتر وجب أن تتوافر في هذا العقد حتى يسري فيما بين المتعاقدين جميع الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون وأن يكون العقد المستتر مباحاً .
فعقد الهبة المستتر في صورة بيع مثلاً يجب أن يصدر من ذي أهلية للهبة وأن تتوافر فيه أركان الهبة الموضوعية وشروط صحتها.
فإذا توافر كل ذلك سرى على العقد أحكام الهبة لا أحكام البيع.
أما من حيث الشكل فإن العقد المستتر يخضع الى الشرائط ذاتها المفروضة على العقد الظاهر وعلى ذلك فإن الهبة المبرمة تحت ستار عقد بيع يمكن أن تجري في سند عادي من حيث المبدأ شأنها في ذلك شأن عقد البيع ، مع أن الهبة لا تتم في الأصل الا بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر .
وقد قررت محكمة النقض السورية :
على أن عقد الهبة هو عقد رسمي لا يتم إلا بالتسجيل وبالتالي فإن تسجيل هذا العقد يكون انصياعاً لحكم القانون واستكمالاً لاجراءات حددها المشرع ويمكن اثبات العقد بوثيقة خطية دون أن تماثل العقد الظاهر في قوتها الثبوتية وعلى هذا فإنه يحق لمن يدعي صورية عقد هبة رسمي مسجل أن يثبت مدعاه بطرق الاثبات المقبولة قانوناً إذ ليس في القانون ما يلزم أن تتحقق الرسمية في ورقة الضد وأن تسجيل عقد هبة بين أقارب لا يهدر المانع الأدبي الا إذا كانوا قد اعتادوا التعامل فيما بينهم بالبينة الخطية . “
( قرار /351/ أساس /408/ تاريخ 30/3/1977 – محامون ص /337/ لعام 1977 )
3- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والغير :
لا بد لنا من تحديد من هو الغير في الصورية .بحسب المادة /245/ من القانون السوري الغير هو : ” كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن اليه معتقداً بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله .”
والعدالة تقتضي في هذه الحالة أن يعتبر العقد الصوري بالنسبة له عقداً قائماً ينتج أثره إذا كانت له مصلحة في ذلك ، أما إذا كان عالماً وقت تعامله بصورية العقد فالعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقه شأنه في ذلك شأن المتعاقدين.
ويترتب على ذلك أنه يدخل في الغير كل من :
1- كل من كسب حقاً عينياً : من أحد المتعاقدين على الشيء محل التصرف الصوري سواء كان هذا الحق سابقاً للتصرف الصوري أو تالياً له.
فلو باع شخص داراً من آخر بيعاً صورياً فكل من كسب حقاً عينياً على هذه الدار قبل التصرف الصوري أو بعده من البائع أو المشتري يعتبر من الغير في البيع الصوري الذي تم كدائن مرتهن أو مشتر.
2- الدائنون الشخصيون للمتعاقدين : فدائن المشتري في البيع الصوري يعتبر من الغير إذ أنه قد إطمأن الى الشيء محل التصرف الصوري أنه قد انتقل الى المشتري فدخل في ضمانه العام وله في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الصوري.
وكذلك دائن البائع في البيع الصوري يعتبر من الغير ولكن لسبب آخر هو أن الشيء محل التصرف لم يخرج من الضمان العام للدائن ، فللدائن في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الحقيقي ، حيث يجب حمايته من غش المدين.
والدائن الشخصي يعتبر من الغير في الصورية سواء كان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء وسواء كان سابقاً على التصرف الصوري أو تالياً لهذا التصرف. إذ أن تصرف المدين الصوري يبقى صورياً حتى بالنسبة الى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف .
وما قلناه في الدائن الشخصي للبائع نقوله في الدائن الشخصي للمشتري فهو من الغير وفي الحالتين دخل الشيء ظاهراً في الضمان العام للدائنين .
” لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة .
والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون . “
( نقض مدني سوري /610/ أساس /389/ تاريخ 9/12/1962 مجموعة القواعد القانونية – ص 220 )
3- كل شخص لم يكن طرفاً في العقد الصوري : وقد انخدع به يمكن أن يعتبر من الغير ويحق له التمسك به أو طلب إعلان صوريته حسب مصلحته حتى ولو كان هذا الشخص قد باع في الأصل العين موضوع النـزاع بيعاً صورياً ، فمثلاً إذا باع زيد لعمر منـزله بيعاً صورياً ثم مات عمر فباع وارثه المنـزل لآخر بيعاً صورياً أيضاً يعتبر زيد من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من وارث عمر ويترتب على ذلك أنه يجوز له اثبات صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات .
” إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء .”
( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1993 مجلة المحامون ص 65 لعام 1963 )
4- الدائن يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات الضارة به والصادرة عن المؤرث والمتعلقة بحقوق تبلغونها مباشرة من القانون كحقوقهم الارثية مثلاً وفي حالة التصرف لوارث الذي يتضمن هبة أو وصية.
” إذا قصد المؤرث ستر الوصية تحت ستار عقد بيع بقصد الاضرار بالورثة فيعتبر هؤلاء الورثة من الغير ، وللشخص الثالث أو الغير إثبات عكس البيانات التي تضمنها صك كاتب عدل وذلك بالبينة الشخصية إذا توفرت الحالات المشار اليها في المادتين 56 و 57 بينات / نقض سوري /.
( نقض سوري /170/ أساس /2036/ تاريخ 4/2/1982 / سجلات محكمة النقض 1982 – ص 345 )
4- حق الغير أن يتمسك بالعقد المستتر :
قد رأينا أن المادة /245/ من القانون المدني السوري حددت الغير بأنهم دائنوا المتعاقدين والخلف الخاص ولهؤلاء التمسك بالعقد المستتر لأن الأصل أن العقد المستتر هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان هو الذي يسري حتى بالنسبة إلى الغير حتى لو كان هذا الأخير لا يعلم بوجود هذا العقد في بادئ الأمر واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدي ويترتب على ذلك أن لدائني البائع إذا كان البيع صورياً أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع .
وكذلك للخلف الخاص إذا كسب حقه بعد صدور البيع الصوري أو قبل صدور هذا البيع فله أن يتمسك بالعقد المستتر ويطعن في العقد الظاهر بالصورية كأن يبيع المالك العين مرة ثانية بيعاً صورياً بعد أن يكون قد باعها بيعاً جدياً ويسجل المشتري الثاني عقده الصوري قبل أن يسجل المشتري الأول عقده الحقيقي أو الجدي فهذا الأخير له أن يتمسك بالعقد المستتر ( الجدي )
” إن من يتمسك من الطرفين بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر في دعوى الصورية ، عليه إثبات وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. وفي حال عدم وجود العقد المستتر فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً .
” ( نقض أساس /791/ قرار /1021/84 تاريخ 20/6/1984 ص 125 محامون العدد الأول لعام 1984 )
5- حق الغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك :
قضت المادة /245/ من القانون المدني السوري بأن للغير ( أي للخلف الخاص ودائني المتعاقدين ) أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، ومن هنا فتمسك الغير بالعقد المستتر ( الحقيقي ) هو تطبيق للقواعد العامة وهو الذي يسري كما سبق لنا القول .
أما أن يتمسك الغير بالعقد الظاهر الذي لا وجود له قانوناً فهذا هو الاستثناء ويصبح للغير أن يختار بين العقد المستتر أو العقد الظاهر حسب مصلحته.
وهو إذا تمسك بالعقد المستتر فلأنه العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدين فيأخذهما بما أرادا .
وإذا تمسك بالعقد الظاهر فلأن هذا العقد قد خلق مظهراً انخدع به واطمأن اليه وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما بالغير .
فالعقد المستتر يقتضيه مبدأ سلطان الارادة والعقد الظاهر يقتضيه مبدأ استقرار التعامل فللغير إذاً أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا تحققت له مصلحة في ذلك ، ولكن يجب لتمسكه هذا أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري.
“ إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام. أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر . أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي .”
( نقض سوري /1123/ تاريخ 13/5/1965 – مجلة القانون – ص 639- لعام 1965 )
فلا بد إذاً من أن يكون الغير جاهلاً بصورية العقد الظاهر حتى يستطيع التمسك به ويكفي أن يجهل الصورية وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك.
كما لو انتقل اليه حق عيني من المشتري بعد صدور التصرف الصوري فيجب وقت انتقال الحق العيني إليه أن يكون معتقداً جدية التصرف الصوري .
والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية فانه يجوز اثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن .
6- التعارض بين غير يتمسك بالعقد الظاهر وغير يتمسك بالعقد المستتر :
لما كان الغير له أن يتمسك بالعقد المستتر وفقاً لمصلحته ، فإنه يقع كثيراً أن يقوم تنازع فيما بين الأغيار لتعارض المصلحة ويكفي في بيع صوري أن نفرض أن يكون للبائع دائن وللمشتري دائن.
فدائن البائع مصلحته أن يتمسك بالعقد المستتر ، ودائن المشتري مصلحته أن يتمسك بالعقد الظاهر ، ولا يمكن أن نأخذ بالعقدين معاً . فلا بد إذا من تغليب إحدى المصلحتين .
فإما أن نحرص على احترام الارادة الحقيقية للمتعاقدين فنغلب مصلحة دائن البائع أو من كسب حقاً عينياً من البائع ونأخذ بالعقد المستتر .
وإما أن نعنى بثبات التعامل واستقراره فنغلب مصلحة دائن المشتري أو من كسب حقاً عينياً من المشتري ونأخذ بالعقد الظاهر .
وقد حسم القانون السوري هذا الخلاف : فنصت الفقرة الثانية من المادة /245/ على أنه :
” إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأوليين . “
ويترتب على ذلك أن دائن المشتري في البيع الصوري يفضل على دائن البائع، فيقوم هو دون دائن البائع بالتنفيذ على العين المبيعة صورياً ، متمسكاً بالعقد الظاهر إذ هو في مصلحته ، ويمتنع على دائن البائع أن ينفذ على هذه العين وأن يتمسك بالعقد المستتر .
سادساً : كيف أكتب ورقم أو سند الضد:
لايوجد نص خاص لورقة الضد ويمكن لكم الاسترشاد بهذا النموذج ( اضغط هنا)