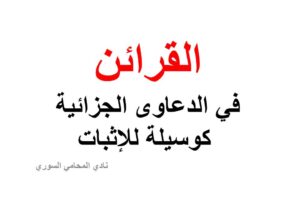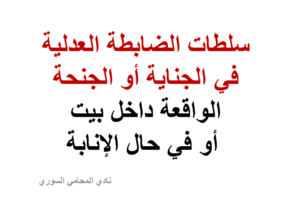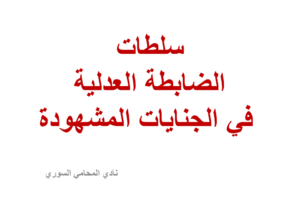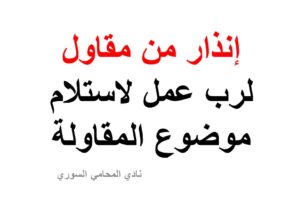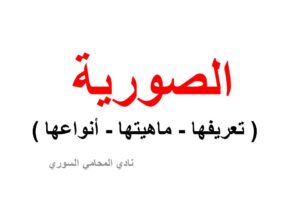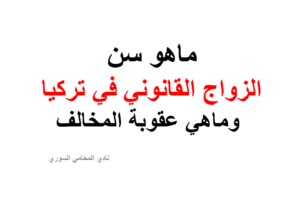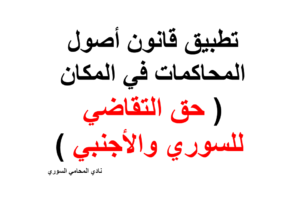مقدمة حول القرائن
القرينة هي وسيلة إثبات غير مباشرة، وهي تختلف عن سائر وسائل الإثبات التي درسناها کالاعتراف والشهادة والخبرة والبينة الخطية، فهذه كلها وسائل إثبات مباشرة لأنها تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، في حين أن القرينة هي دليل غير مباشر لأنها لا تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تتصل بها وتفيد في الدلالة عليها.
لذلك يمكن القول إن الإثبات بالقرائن في الدعوى العامة عبارة عن استنتاج يستخلص من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، بحيث تقوم بين الواقعتين صلة تؤدي إلى معرفة مرتكب الجريمة ونسبتها إليه.
وكلما قويت الصلة بين الواقعة التي دلت عليها القرينة مباشرة، أي الواقعة المعلومة، وبين الواقعة الأصلية المراد إثباتها وهي الواقعة المجهولة، كانت القرينة صالحة لاعتبارها دليلاً على هذه الواقعة.
وتأتي أهمية القرائن في الدعوى العامة من أن بعض الوقائع يستحيل أن يرد عليها إثبات مباشر، ومن ثم يمكن عن طريق القرائن التوصل إلى إثبات هذه الوقائع لصلتها بوقائع أخرى ذات صلة منطقية.
فالقرائن، بوصفها وسيلة من وسائل الإثبات، هي الشواهد التي إذا أضيفت إلى بعضها البعض، يمكن للمحكمة أن تستخلص منها دليلاً مقبولاً تقتنع به.
مثال على ذلك أنه إذا كان من الثابت أن المدعى عليه استدرج المجني عليه إلى منزله ودعاه إلى العشاء، وبعد تناول المجني عليه للعشاء بنصف ساعة، بدأت تظهر عليه أعراض التسمم، وحين تم تفتيش غرفة المدعى عليه، شوهدت آثار المادة السامة في الأواني.
فاستدراج المدعى عليه للمجني عليه ودعوته إلى العشاء، وظهور أعراض التسمم عليه، ثم وجود آثار المادة السامة، كلها قرائن تؤدي إلى استنتاج منطقي بأن المدعى عليه هو الذي دس السم للمجني عليه، وإن لم يشهد أحد بأنه هو الذي دسه إليه.
وكما أن القرينة يمكن أن تكون ضد المتهم، فيمكن بالقرينة أيضا التوصل إلى تبرئة المتهم،
فوجوده في مكان بعيد جداً عن مكان الجريمة وقت وقوعها قرينة على عدم ارتكابه لهذه الجريمة، لأنه يستحيل عقلاً ومنطقاَ أن يقوم بارتكاب جريمة سرقة مثلاً بينما ثبت أن المتهم كان في تلك اللحظة مسافرة ويبعد آلاف الأميال عن مكان وقوع الجريمة.
وبما أن الإثبات بالقرينة يقوم على الاستنتاج المنطقي، فقلما تكفي قرينة واحدة لإثبات الواقعة
التي يجري التحقيق في شأنها. وإنما يلزم تضافر قرائن عدة تقوى كل قرينة منها بغيرها فتسندها .
والقرائن على نوعين: إما قرائن قانونية أو قضائية.
أ- القرائن القانونية
وردت في القانون على سبيل الحصر، لذلك لا يجوز للقاضي أن يضيف إليها أو يقيس عليها.
وهذه القرائن تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، أي تعفي من عبء الإثبات. فالإثبات في بعض الأحيان مسألة صعبة جدا قد لا يستطيع أحد الأطراف تحمل عبئه.
وهي على نوعين: قرائن قانونية قاطعة، وقرائن قانونية بسيطة.
أما القرائن القانونية القاطعة فهي القرائن التي لا تقبل إثبات عكسها، كقرينة انعدام التمييز لدي الصغير الذي لم يتم العاشرة من عمره، وقرينة صحة الأحكام المبرمة التي هي عنوان الحقيقة، وقرينة العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، فلا يجوز الدفع بالجهل به.
أما القرائن القانونية البسيطة، فهي التي تقبل إثبات العكس، وتظل قائمة إلى أن يقوم الدليل على عكسها، ومنها مشاهدة الجاني حاملا أسلحة أو تبدو عليه آثار معينة تعد قرينة على أنه مساهم في الجريمة، لكنها قرينة بسيطة يستطيع الجاني إثبات عكسها.
ب – القرائن القضائية
القرينة القضائية هي التي يستنتجها القاضي باجتهاده من خلال وقائع الدعوى المعروضة عن طريق إعماله الممكنات العقلية، وهذه القرائن كثيرة ولا يمكن حصرها، وقد ثرك تقديرها للقاضي يستنبطها من ظروف الوقائع المعروضة أمامه بعد التحليل والربط فيما بينها بما يقتضيه المنطق والتعليق العلمي،
وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها مادام الرأي الذي يستخلصه منها سائغة، ولكنها ليست ملزمة للقاضي.
مثال ذلك وجود الدماء على ملابس المتهم، وقد ثبت أن هذه الدماء هي نفس فصيلة دم المجني عليه.
ومن أمثلتها أيضا ضبط ورقة مع المتهم فيها رائحة الأفيون بوصفها قرينة على ارتكابه جريمة حيازة مخدر، أو مشاهدة عدة أشخاص يسيرون في الطريق مع من يحمل المسروقات ودخولهم معه في منزل واختفاؤهم فيه كقرينة على تدخلهم في السرقة، ووجود بصمة إصبع المدعى عليه أو أثار قدميه في مكان الجريمة كقرينة على مساهمته فيها.
لذلك يمكن القول إن القرينة القضائية هي كل استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، بحيث يكون الاستنتاج ضروريا بحكم استخدام العقل والمنطق.
ولا يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض في تقديره للواقعة التي جعلها قرينة من حيث ثبوتها أو انتفاؤها، فذلك من صلاحيات محكمة الموضوع.
وليس في القانون ما يمنع من بناء الحكم على القرائن وحدها، لكن القاضي يخضع لرقابة محكمة النقض فيما يستخلصه من الوقائع الثابتة من دلالات، وما يترتب عليها من أثر في إثبات الواقعة التي يبني عليها حكمه، إذ يجب على القاضي أن يبني حكمه على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
فالقرائن القضائية تصلح دليلاً كاملاً للإثبات، فيجوز للقاضي أن يستمد من القرائن قناعته الشخصية التي يعتمد عليها في الحكم.
فالقناعة الشخصية يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.
لكن يجب عند الأخذ بالقرينة أن يتم ذلك بحذر شديد مع بيان الأسلوب المنطقي الذي توصلت إليه المحكمة في اعتمادها القرينة، لأن القرينة، وإن كانت تصلح لأن تكون دليلاً، إلا أنها تعد من أدنى البينات.