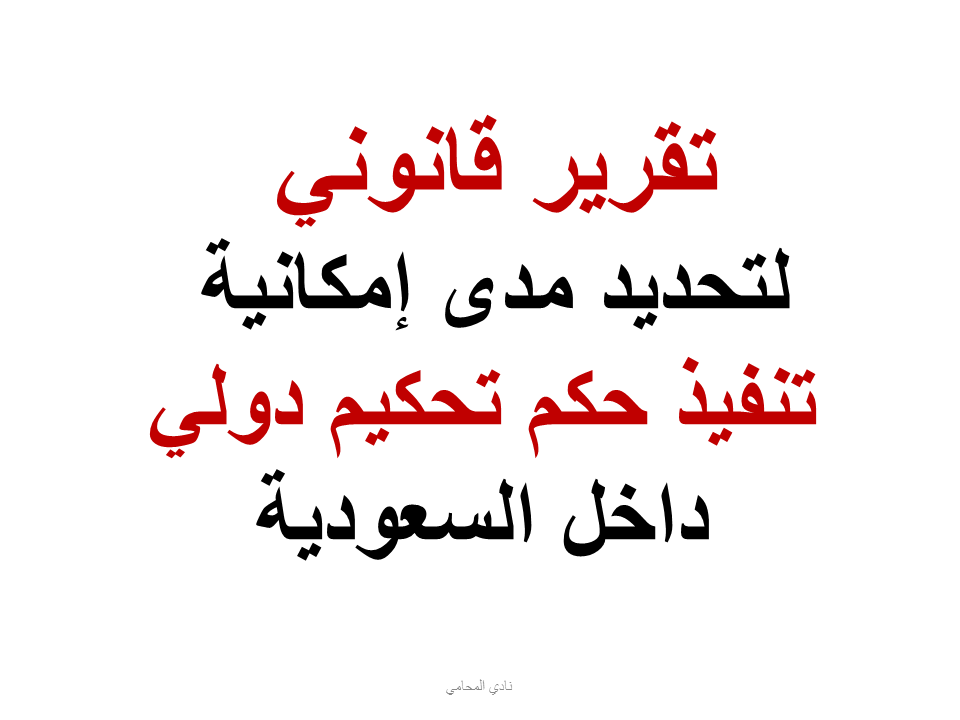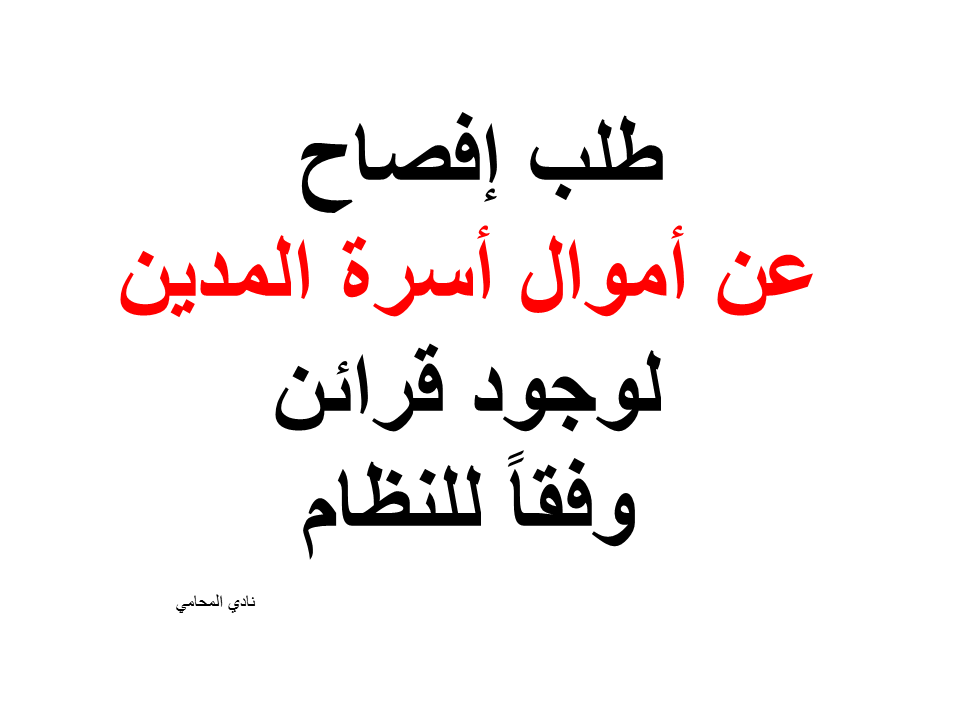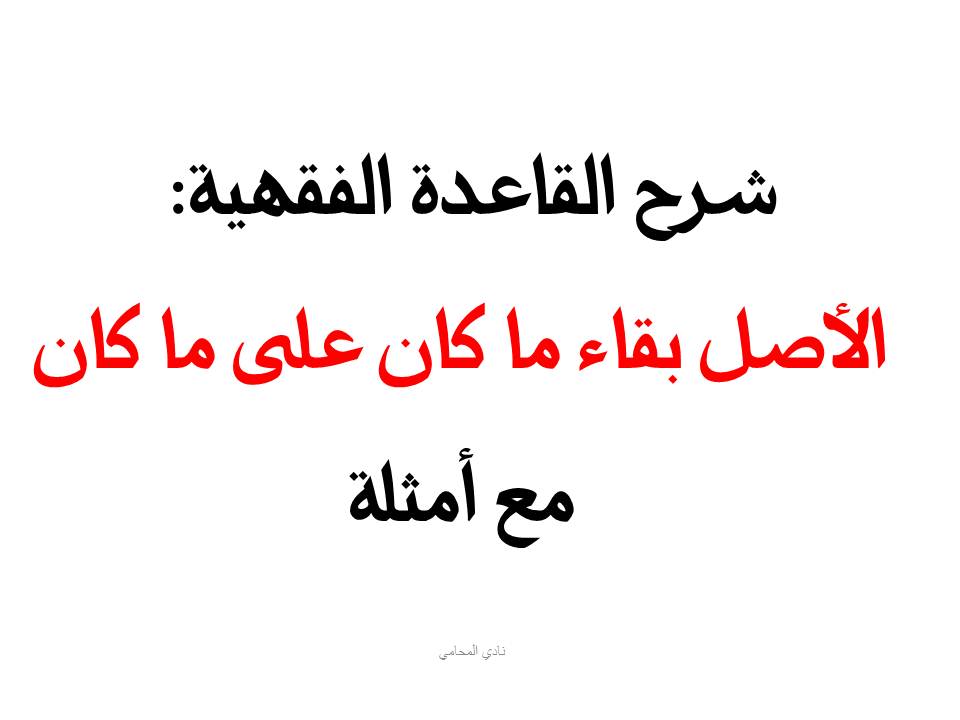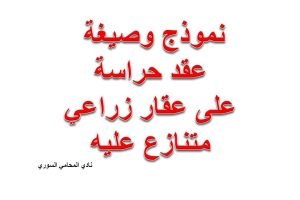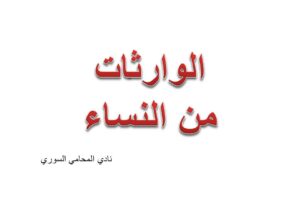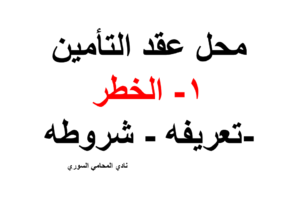تعريف الخطر
لم تبرز محاولات الفقه – في تعريف الخطر وفي تقسيماته للأخطار وفي تعيينها الحد الفاصل بين الخطر كمحل رئيس لعقد التأمين، وبينه كأساس لتحديد أداءات كل من المتعاقدين.
وظهرت فكرة الخطر في عقد التأمين غير محددة المعالم، اختلط فيها كيف الخطر بكمه، رغم تباين المعنى والوظيفة التي يؤديها كل من الأمرين.
فكيف الخطر إنما يعني محل العقد ويتعين أن يؤدي هذه الوظيفة بالتلاقي الإرادي عليها، بينما كم الخطر يعني نطاق التزام شركة التأمين، ويتعين أن يؤدي الوظيفة الضابطة للبدل الذي يمثل المؤمن.
وبما أن الخطر أساس التأمين وعماد الالتزامات التي تنشأ عنه ، فان السعي قد جد منذ نشأة التأمين إلى محاولة الإحاطة به كخطوة أولية في سبيل الوقوف على التزام المؤمن باعلان الخطر.
هذا الالتزام الذي حمله المؤمن أو طالب التأمين منذ قيام عقد التأمين والى اليوم. وقد حاول الفقه، في هذا المجال، تعريف الخطر تعريفاً شاملاً يميزه عما سواه.
فقد ذهب هيمار في تعريف الخطر إلى أن :
” الخطر هو احتمال غير ملائم يولد الحاجة “
أما العميد ريبير فقد ذهب في تعريف الخطر إلى أنه:
” احتمال حدث يلزم شركة التأمين، في حال تحققه، أن تقدم عطاءها أو أداءها، وهذا الحدث قد يكون سعيداً (زواج أو بقاء) ، وقد يكون غير سعيد (حريق، سرقة،…)
وذهب الفقييان بيكار وبيسون في تعريف الخطر إلى أن:
” الخطر هو حدث غير محقق وغير متعلق بمحض إرادة المتعاقدين، خاصة بالنسبة لإرادة المؤمن”
ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن فكرة الخطر في التأمين هي أوسع بكثير من فكرة تحمل المخاطر المدنية التي تصور الخطر بأنه ىلاك الشيء بقوة قاهرة يتحمل تبعتها أحد المتعاقدين في العقود اللمزمة للجانبين، فيقال إن المشتري يتحمل مخاطر الهلاك بعد التسليم الحقيقي أو الاعتباري .
أما في التأمين فان فكرة التأمين تبدو أوسع من ذلك بكثير لأنها لا تشمل الهلاك بقوة قاهرة فحسب، بل تمتد في التأمين على الأشياء إلى هلاك الشيء بأي سبب كان.
وبذلك فان لفكرة الخطر معنى خاصاً أصيلاً في مجال علم التأمين، يختلف كثيراً عن المفهوم الذي يعطى لفكرة الخطر في مجال القانون المدني أو اللغة التجارية.
أما أندرية كاستاني فقد عرف الخطر بأنه:
” كل حادث احتمالي يصيب الشخص في ذمته المالية أو في تركيبه الفيزيولوجي العضوي “.
ويمكننا تعرف الخطر على أنه:
“ حادث مشروع ومحتمل الوقوع في المستقبل، يصيب المؤمن في ماله أو في جسمه، ولا يتوقف تحققه على محض إ رادة أحد المتعاقدين”.
هذا التعريف بسيط في مفهومه ويشمل تحديد عناصر الخطر وشروطه ويمكن أن نعتمد عليه في مجال دراسة الخطر بأنواعه بعد أن نحدد الشروط الواجب توافرها في الخطر.
كما يؤكد هذا التعريف أن ظاهرة عدم التأكد أو الشك بصفة عامة تمثل ركناً أساسياً من أركان الخطر. فهو إنعدم الشك فلوعرف الفرد مقدماً النتائج ، لما كان للخطر من وجود، ويجب أن يكون مبدئياً مستقبلاً ومن الممكن قياسه موضوعياً باستخدام نظرية الاحتمالات.
ومن الممكن أن تكون نتائج تحقق الخطر خسارة مادية أو جسدية يمكن تقويمها بوحدات النقود المستخدمة.
على أن هذا الخطر المستقبلي يجب أن يكون مشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة، من جهة ولا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد طرفي عقد التأمين ولا سيما شركة التأمين.
شروط الخطر
كل محاولة لتعريف الخطر كانت ترتبط بضرورة توافر شروط ثلاثة، ودونها لا يكون للحادث معنى الخطر في التأمين. إذ لابد من الناحية القانونية من أن تتوافر في الخطر المؤمن شروط ثلاثة : أن يكون غير محقق الوقوع في المستقبل، وأن يكون غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد، وأن يكون مشروعاً.
الشرط الأول – يجب أن يكون الخطر غير محقق الوقوع:
فالخطر حادث غير مؤكد ومحتمل الوقوع في المستقبل، ذلك لأن التأمين يستند إلى وقائع محددة تتصف بالاحتمال وعدم التأكد من وقوعها. وغالباً ما يكون الحادث غير مؤكد ويبحث المؤمن عن تعويضه من النتائج الضارة لهذا الحادث، كالسرقة والحريق مثلاً.
وعدم التأكد من وقوع الحادث وبالتالي تحقق الخطر، يعني أن هذا الخطر هو حادث وقوعه غير محتم، فقد يقع وقد لا يقع، تلك حالة أغلب أنواع التأمين، ولاسيما التأمين من الأضرار، (كالتأمين من الحريق أو السرقة أو المسؤولية، أو الحوادث…إلخ).
وقد يكون وقوع الخطر محتماً إلا أن احتمال وقوعه ينصرف إلى وقت تحقق الحادث الذي سيقع حتماً. فهو خطر محقق إلا أنه مضاف إلى أجل غير محقق.
فالخطر، إذن هو حادث مقدر وحتمي، وسيتحقق عاجلاً أو جلاً، في وقت غير مؤكد.
وخير مثال على ذلك التأمين على الحياة لحالة الوفاة، أو التأمين من الموت، فالموت أمر محقق ولكن وقت وقوعه غير محقق.
أما التأمين على الحياة لحالة البقاء، فهو تأمين بموجبه تدفع شركة التأمين مبلغ التأمين إلى المؤمن إذا بقي هذا الأخير حياً بعد مدة معينة، يكون هذا التأمين من خطر غير محقق الوقوع، إذ أن بقاء المؤمن حياً بعد مدة معينة أمر غير محقق الوقوع. وفي هذا يختلف الخطر عن الشرط كوصف للالتزام التعاقدي .
فالشرط حادثة مستقبلية غير محققة الوقوع، أي أن الاحتمال ينصب على وقوعها فاذا كانت محققة الوقوع، وتعلق الشك بتاريخ وقوعها، خرجت الحادثة عن نطاق الشرط لتصبح من قبيل الأجل غير المحدد.
أما الخطر في التأمين فهو أوسع من فكرة الشرط، إذ يدخل فيه ما يعد من الحوادث من قبيل الشرط ، والحوادث مؤكدة الوقوع متى كان الاحتمال منصباً على تاريخ وقوعها.
فالاحتمال في الخطر المؤمن، إذن، قد ينصب على وقوع الحادث في ذاته (كالتأمين من الحريق والسرقة)، وقد ينصب على تاريخ وقوعه (كالتأمين على الحياة) فالموت، في هذا النوع من التأمين، خطر و وان كان محقق الوقوع في ذاته .
وبناءً على ذلك إذا كان الخطر مستحيل الوقوع، كان محل التأمين مستحيلاً وبالتالي كان العقد باطلاً ، فاذا أمن شخص على منزله من الحريق ثم اتضح أن المنزل كان قد أنهدم، قبل إبرام العقد، كان عقد التأمين باطلاً لانعدام المحل، إذ أن هلاك الشيء المؤمن قبل إبرام العقد يجعل تحقق الخطر مستحيلاً فينعدم محل التأمين.
ويترتب على بطلان العقد أن ترد شركة التأمين للمؤمن ما قبضته من بدل، وتب أ ر ذمة المؤمن من الأقساط الباقية.
وبناءً على ما تقدم فان الخطر لا يكون غير محقق الوقوع إذا كان، وقت إبرام عقد التأمين، قد تحقق أو زال. وفي الحالتين لا يكون الخطر محتملاً، إذ هو في الحالة الأولى قد تحقق وقوعه، وهو في الحالة الثانية قد أصبح وقوعه مستحيلاً.
فاذا أمن شخص على بضاعته من السرقة وكانت البضاعة وقت ابرام العقد قد سرقت، فان الخطر المؤمن منه يكون محقق الوقوع وقت إبرام العقد ذلك لأنه قد تحقق فعلاً.
ومن ثم يكون العقد باطلاً ولا تدفع شركة التأمين للمؤمن، ولكنها ترد له الأقساط التي قبضتها منه.
وكذلك قد يكون الخطر مستحيل الوقوع، ويصبح محل التأمين مستحيلاً، وبالتالي يكون العقد باطلاً، فالاحتمال يتنافى مع الاستحالة.
والاستحالة قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية وفي الحالتين تكون مانعة من التأمين.
والاستحالة المطلقة تتعلق باستحالة تحقق الخطر بحكم الطبيعة كالتأمين من احتمال سقوط كوكب مثلاً .
أما الاستحالة النسبية فيقصد بها تلك الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها الخطر وفقاً لقوانين الطبيعة ووفقاً للتجارب والمشاهدات السابقة، ولكن يستحيل تحقيق الخطر في حالة معينة برغم إمكان تحققه في حالة أخرى.
كأن يؤمن شخص على أشياء يملكها، من السرقة، ثم تحترق تلك الأشياء، فالخطر في مثل هذه الحالة يصبح مستحيلاً في المستقبل بالنسبة للشيء المؤمن عليه وبالتالي ينتهي التأمين لانعدام محله وهو الخطر.
ويعد هذا التأمين من قبيل التأمين من الخطر الظني، ويقصد بالخطر الظني ذلك الخطر الذي يكون قد تحقق بالفعل وقت إبرام العقد ولكن على غير علم المتعاقدين، فهل يصح التأمين من هذا الخطر الظني؟
في التأمين البري لا يجوز التأمين من الخطر الظني وهذا ما يتفق مع القواعد العامة، فاذا أمن شخص على حياة شخص خر، وكان هذا الشخص الاخر قد مات وقت إبرام عقد التأمين دون علم من طرفي العقد، فان العقد يكون باطلاً، وما دام لا يوجد خطر محتمل فليس هناك عقد تأمين لانعدام المحل.
أما في التأمين البحري فان التأمين من الخطر الظني جائز كما في التأمين على السفينة إذا كانت قد غرقت قبل إبرام العقد دون أن يعلم أحد الطرفين بذلك، يكون عقد التأمين صحيحاً.
ويرجع ذلك إلى أن أخطار البحر تبقى مجهولة مدة طويلة حتى بعد وصول السفينة، فأجيز التأمين منها طالما بقيت مجيولة .
وهذا الاستثناء الوارد في نصوص قانون التجارة البحرية لا يجوز القياس عليه في التأمين حيث يستطيع الأفراد دائماً التبين من حالة الخطر المؤمن وقت التعاقد، وبالتالي يجب استبعاد التأمين على الخطر الظني في مجال التأمين البري ، لأنه يفتح الباب واسعاً للغش والتدليس، وهو على الأقل يثير صعوبات من حيث إثبات علم المؤمن أو عدم علمه بتحقق الحادث وقت التعاقد.
الشرط الثاني – يجب أن يكون الخطر أمراً مستقبلاً:
يجب أن يتم التأمين على خطر يحتمل وقوعه في المستقبل وهذا هو ما تقوم معه فكرة الاحتمال , فكل تأمين يفترض وجود خطر، أي يفترض احتمالاً من شأنه أن يتحقق، فاذا كان الخطر قد وقع فعلاً عند إبرام العقد أو كان قد زال فان عنصر الاحتمال يختلف، وبالتالي لا يقوم عقد التأمين.
فلا يكفي أن يعتقد المؤمن أو شركة التأمين أنهما يتعاقدان على خطر المستقبل، وانما يلزم أن يكون هذا الخطر مستقبلاً بالفعل، من حيث الواقع ، ولم يتحقق من قبل، أو لم يزل. ولكن احتمال بحدوثه لا زال قائماً.
وهذا ما أدى إلى استبعاد التأمين من الخطر الظني أو الوهمي كما سبق أن ذكرنا في الفقرة السابقة.
الشرط الثالث – يجب أن يكون الخطر مستقلاً عن الإرادة المحضة لطرفي العقد ولاسيما المؤمن:
قدمنا أن الخطر يجب أن يكون مستقبلاً غير محقق الوقع، لأنه يعتمد على عنصر الاحتمال.
كذلك إذا تعلق الخطر بإرادة أحد طرفي العقد، ولاسيما المؤمن، انتفى عنصر الاحتمال، وأصبح وقوع الحادث رهناً بمشيئة هذا الطرف، ولم يعد للخطر وجود وستصبح الحادثة مؤكدة بالنسبة للطرف الذي قد ينفذ الخطر.
فاذا كان هذا الطرف شركة التأمين، وهذا لا يتم في الواقع العملي، كان في استطاعتها أن تمنع تحقق الحادث المؤمن، فهي إذن لا تتحمل خطراً ما يكون محلاً للتأمين.
واذا كان الطرف المتعلق بارادته تحقق الحادث المؤمن، وهذا ما يقع عملياً، لم يعد هناك معنى للتأمين، إذ هو يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته ، وما عليه إلا أن يحققه حتى يتقاضى مبلغ التأمين في أي وقت أراد.
لذلك إذا تعلق الخطر بمحض إرادة المؤمن فان التأمين يعد باطلاً. وذلك لانعدام الخطر بانتفاء الاحتمال، وكذلك لأنه لا يمكن أن يتكون الخطر من غش المؤمن. بأن يتدخل في تحقق الخطر بشكل متعمد.
وهذا البطلان ليس تطبيقاً للقاعدة التي تقضي ببطلان العقد المعلق على شرط إرادي محض، ففي هذه القاعدة يجب أن يكون الالتزام معلقاً على محض إرادة المدين، أما فيما يتعلق بالتأمين فالالتزام متعلق بمحض إرادة الدائن.
ويعد خطراً الحادث الذي يتحقق دون تدخل الإرادة المحضة للمؤمن، ولابد من تدخل عامل المصادفة والطبيعة أو عامل إرادة الغير. فيجوز للشخص أن يؤمن نفسه من عواقب الفيضان والحريق،
كما يجوز أن يؤمن نفسه من السرقة والتبديد والإصابات التي تلحقه من الغير، أو من مسؤوليته عن الإصابات التي يلحقها، بدون عمد، بالغير نتيجة حوادث السير.
ولكن لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطأه العمد ، لأن الخطأ العمد الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادته.
فاذا أمن شخص على حياته، فانه لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر، لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن وهو الموت، وهذا ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 722 من القانون المدني التي تنص على أن:
” إذا اشتلمت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار إدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد”.
وكذلك إذا أمن شخص على حياة غيره لمصلحته ، ثم تسبب عمداً في وفاة ذلك الغير، فانه يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن، ومن ثم لا يستطيع الرجوع على شركة التأمين بمبلغ التعويض.
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 723 من القانون المدني.
” إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير مؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه…”.
ونضيف أنه إذا أمن شخص على متجره من الحريق، ثم تعمد إحراق هذا المتجر، لم يعد من حقه الرجوع على شركة التأمين للمطالبة بمبلغ التأمين لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن.
وهذا ما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة 734 من القانون المدني، التي تقول في هذا الصدد:
” أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن (شركة التأمين) مسؤولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك”.
وينسحب أثر عدم مسؤولية شركة التأمين لارتكاب المؤمن خطأ عمدياً في تحقيق الخطر المؤمن، على سائر أنواع التأمين، ولاسيما التأمين من الحوادث. فاذا أمن شخص نفسه من المسؤولية عن الحوادث، ثم تعمد إلحاق الضرر بالغير، فان شركة التأمين لا تكون مسؤولة، لأن المؤمن هو الذي تعمد تحقيق الخطر المؤمن.
ففي عقد التأمين الإلزامي للمركبات الآلية من الأضرار الجسدية والمادية جاءت وثيقة التأمين، الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، في المادة السابعة من الشروط العامة على ما يلي:
” للمؤسسة الحق بالرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر
وبموجب هذا العقد في الحالات التالي:
7 – إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصداً من قبل سائق المركبة”. –
كما نصت وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين على عدم شمول التأمين لسائر الحوادث الناشئة عن الغش أو الخطأ المقصود أو الخطأ الجسيم الصادر عن المتعاقد أو المستخدمين أو الأشخاص الذين يسأل عنهم.
نلاحظ أن سائر النصوص القانونية والاتفاقية قد استبعدت من التأمين الخطأ العمد والجسيم.
ذلك لأنه لا يمكن أن يكون هنالك تأمين بالنسبة للحوادث الناتجة عن فعل عمد ، لأنه إذا كان تحقق الكارثة معلقاً على الفعل أو الخطأ العمد للمؤمن، فان هذه الكارثة تستبعد شرط عدم تحقق الخطر، وينتفي عنصر الاحتمال والمصادفة.
إلا أنه ومع تطور صناعة التأمين، وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع حجم الأخطار التي تقوم شركات التأمين بتغطيتها فانه من الجائز التأمين من الخطأ العمد في حالتين:
1 – إذا كان الخطأ العمد صادراً من الغير، إذ الممنهع تأمينه هو الخطأ العمد الصادر من المؤمن نفسه، ويقصد بالمؤمن هنا هو المستفيد من التأمين .
فاذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمد أجنبياً عن المؤمن، وتعدى عمداً على المؤمن كأن سرق ماله، أو ألحق به أذى ، فان هذا الخطأ العمد يجوز التأمين منه، لأن الخطر المؤمن لا يتعمق أصلاً بارادة المؤمن، بل وقع ضد إرادته.
و واذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمد غير أجنبي عن المؤمن، كما لو كان تابعاً أو مسؤولاً عنه، فخطأ التابع العمد يجوز هو أيضاً التأمين منه، لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن، وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن نفسه.
2 – إذا كان الخطأ العمد صادراً من المؤمن نفسه، ولكن كان هناك ما يبرر هذا الخطأ.
وما يبرر الخطأ العمد ، فيجعل التأمين منه جائزاً ً، أن يكون قد ارتكب أداء لواجب أو حماية للمصلحة العامة، كما لو عرّض المؤمن على حياته نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعلاً.
وكذلك في التأمين من الحريق يجوز للمؤمن، بل يجب عليه، أن يتلف عمداً بعض المنقولات المؤمنة لمنع امتداد الحريق، وذلك لمصلحة شركة التأمين حيث تنحصر مسؤولياتها في أضيق الحدود الممكنة.
إلا أنه ومع تطور التشريعات المنظمة لأعمال التأمين فقد اقتصر استبعاد الخطأ العمد من التأمين، وأجازت التأمين من باقي الأخطاء حتى من الخطأ الجسيم. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 13- 172 من قانون التأمين الفرنسي الجديد الصادر عام 1984 على أن:
” لا تعوض شركة التأمين عن أخطاء المؤمن العمدية أو غير المبررة “.
قبل صدور هذا القانون كان كل من الخطأ العمد والخطأ الجسيم مستبعد من التأمين.
إلا أنه لكي ينسجم القانون الفرنسي مع قوانين دول أخرى فقد استبدل المشرع الفرنسي الخطأ الجسيم بالخطأ غير المبرر.
ويقصد بالخطأ العمدي :
الخطأ الذي يرتكبه المؤمن وهو مدرك تماماً لما يقوم به ويرغب بتحقيق الحادث الذي سينتج عنه الضرر المؤمن.
أما الخطأ غير المبرر:
فقد ذهب الفقو الفرنسي إلى أنه يجب تحديد معنى الخطأ غير المبرر بمقارنته بالخطأ الجسيم . فالمؤمن في الخطأ الجسيم قصد اتيان الفعل الذي حقق الخطر، ولكن لم يقصد تحقيق الخطر ذاته، وقد تدخلت عوامل أخرى غير محض إرادته في تحقيق هذا الخطر.
أما الخطأ غير المبرر فهو الذ يرتكبه المؤمن ويمكن أن يثبت، بطرائق الإثبات كافة، بأنه مدرك لفعلته ومدرك للضرر الذي قد ينجم عنه.
فالمؤمن في الخطأ الجسيم أتى الفعل ولكنه لم يقصد تحقيق الخطر وبالتالي الضرر وانما حصل ذلك بسبب إهماله أو عدم كفايته في تنفيذ التزاماته أو عدم عنايته اللازمة في منع وقوع الحادث.
كما ذهب القانون اللبناني في هذا الاتجاه حيث نص على أن شركة التأمين تكون مسؤولة عن الهلاك أو الضرر اللذين… ينجمان عن خطأ المؤمن المادة 966 من قانون الموجبات اللبناني.
فخطأ المؤمن أيا كان، حتى ولو كان جسيماً لا يمنع من مسؤولية شركة التأمين، طالما أن الخطأ لم يحدث من المؤمن قصداً (انظر المادة 966/2 من قانون الموجبات اللبناني ) ذلك لأنه حتى في حالة الخطأ الجسيم فيظل عنصر الاحتمال قائماً لو في بعض الحدود، وبهذا يصح معه التأمين.
وبذلك فاذا تعلق الخطر بالإرادة المحضة للمؤمن، فان صفة الاحتمال تنتفي عن الخطر وبالتالي يستبعد التأمين لعدم وجود الخطر.
الشرط الرابع – يجب أن يكون الخطر مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة:
يجب أن يكون الخطر المؤمن متولداً عن نشاط للمؤمن غير مخالف للنظام والاداب العامة. وذلك لأنه حتى لو توافر الشرطان السابقان المتعلقان بالخطر بأن يكون غير محقق ومستقلاً عن الإرادة المحضة لطرفي العقد، فان ذلك لا يعني بأنه قابل للتأمين. ذلك لأنه أخطار مختلفة يمنع القانون والاجتياد القضائي تأمينها.
فقد اشترط المشرع صراحة بأن تكون المصلحة المؤمنة مصلحة اقتصادية مشروعة.
إذ نصت المادة 715 من القانون المدني على أن:
” يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين”.
من هذا النص نستنتج بأن الخطر كمحل رئيس للتأمين يجب أن تكون الغاية من تأمينه مشروعة وأن يكون بذاته مشروعاً غير مخالف للنظام العام والاداب العامة.
وقد سبق أن بحثنا فيما تقدم أنه لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطئه العمد ، ذلك لأن الخطر المؤمن متعلق في تحققه على محض إرادة المؤمن. وقد عد المشرع التأمين من الخطأ العمد باطلاً، ولو اتفق على خلاف ذلك، لأنو مخالف للنظام العام .
ويقوم هذا المنع على أساس أنه عندما يؤمن شخص عن مسؤوليته عن خطأه العمد ، أي من مسؤوليته عن أن يتعمد الإضرار بالناس، فإذا أضر بهم متعمداً دفعت شركة التأمين التعويض عنه، فيكون هذا التأمين حتماً مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، لأن من شأنه أن يشجع المؤمن على الإضرار بالناس مادامت العاقبة مأمونة.
كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائياً فلا يجوز التأمين عن الأعمال الجرمية التي يأتيها الشخص.
والواقع أن عدم جواز التأمين من الغرامة والمصادرة، يرتبط بفكرة أساسية هي فكرة شخصية العقوبة مراعاة للنظام العام.
ولا شك أن مما يتعارض مع النظام العام أن يلقى على الغير بآثار أفعال الشخص التي يعاقب عيها القانون، وتبعاً لذلك لا يجوز أن تتحمل شركة التأمين الغرامات الجنائية التي تقع من المؤمن، إذ بذلك يتخلص المؤمن من نتائج ما يرتكب من أفعال تعد مخالفات للقانون .
وتطبيقاً لذلك فلا يجوز التأمين من الغرامات الضريبية وما يشابهها من الحالات التي يكون لها طابع جزائي، وكذلك لا يجوز التأمين بالنسبة لعلميات التهريب.
إذ يبطل التأمين إذا قصد من ورائه تغطية المخاطر التي تتعرض لها السمع والأموال المهربة خلافاً لما تقضي به القوانين. ويطبق هذا الحكم، سواء أكان التهريب مخالفاً للنظام العام الدولي، أم كان قانون البلد الذ وقع التهريب منه أو إليه هو وحده الذي يحرم التهريب .
كذلك لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في المخدرات. كما لا يجوز التأمين إذا تم بقصد إقامة أو إدارة أو استغلال بيوت الدعارة، أو المقامرة خاصة إذا كان الغرض من التأمين هو التمكين من هذه الأعمال بأن كان من شأنه أن يساعد على إنشاء أو إقامة منزل لهذا الغرض .
ويعد مخالفاً للآداب العامة، كذلك، التأمين على الحياة لمصلحة خليلة، إذا كان الغرض من التأمين دفعها إلى قبول قيام هذه العلاقة غير المشروعة أو بالاستمرار فيها أو بالعودة إليها بعد أن انقطعت. على أنه إذا كان الغرض من التأمين هو تعويض الخليلة عما لحقها من ضرر بسبب العلاقة غير المشروعة، فقد عد الاجتياد القضائي الفرنسي التأمين في هذه الحالة مشروعاً وبالتالي جائزاً.
كما ذهب الاجتياد القضائي الفرنسي إلى عد التأمين مخالفاً للنظام العام، إذا كانت سبب وفاة المؤمن على حياته هو تنفيذ عقوبة الإعدام وبخاصة إذا كانت الجريمة المحكوم فيها بتلك العقوبة هي جريمة الخيانة العظمى.
على أية حال، فان الحالات التي لا يجوز فيها التأمين لمخالفته النظام العام أو الاداب العامة لا يمكن حصرها، فهي تختلف بحسب ظروف الزمان والمكان، ولذلك يترك تقديرها في ضوء المبادئ التي يقررىا القضاء.
وبذلك فاننا نكون قد بحثنا مختلف الشروط القانونية الواجب توافرها في الخطر، ولكن إلى جانب هذه الشروط توجد شروط أخرى فنية يلزم توافرها في الخطر كي يكون قابلاً للتأمين.
وهي أن يكون الخطر متواتراً قابلاً للتحقق بدرجة كافية تسمح لقوانين الإحصاء بأن تصل إلى تحديد درجة احتمالية.
وأن يكون موزعاً أ منتشراً على نطاق واسع حتى لا يؤدي تحققه إلى كارثة.
وهذا يعني ألا يكون الخطر مركًزاً يصيب في الوقت نفسه عدداً كبيراً من الأشخاص أو الأشياء. وكذلك يجب أن يكون الخطر متجانساً، من طبيعة واحدة حيث لا يمكن إجراء المقاصة بين مخاطر تختلف في طبيعتها.
وأخيراً يجب أن يكون من الممكن تحديد الخسارة، فلكي يكون الخطر مؤمناً لابد من أن يكون ناتج تحقق هذا الخطر محدداً أو قابلاً للتحديد بصورة دقيقة، فلا يمكن التأمين مثلاً على شيء له قيمة عاطفية فقط. كما تستبعد أحياناً شركات التأمين الأشياء الثمينة والأوراق النقدية من التغطية عند التأمين من الحريق بسبب عدم إمكان التحقق بشأنها .