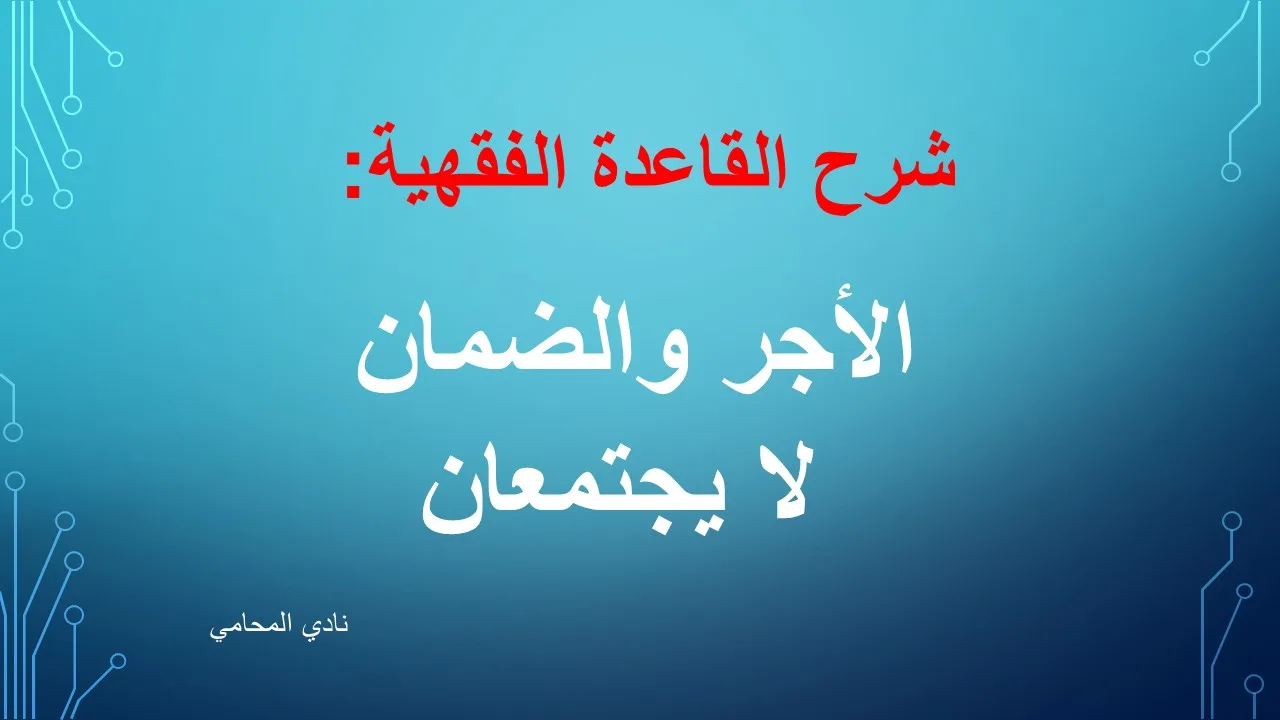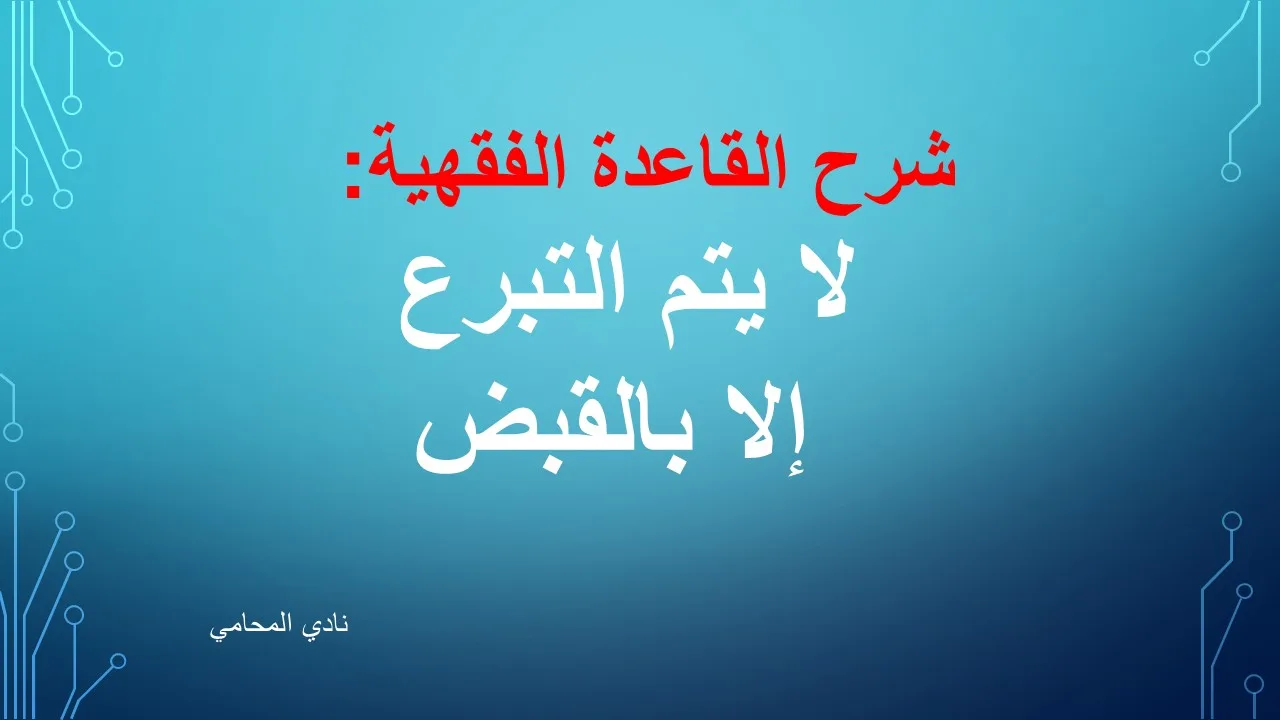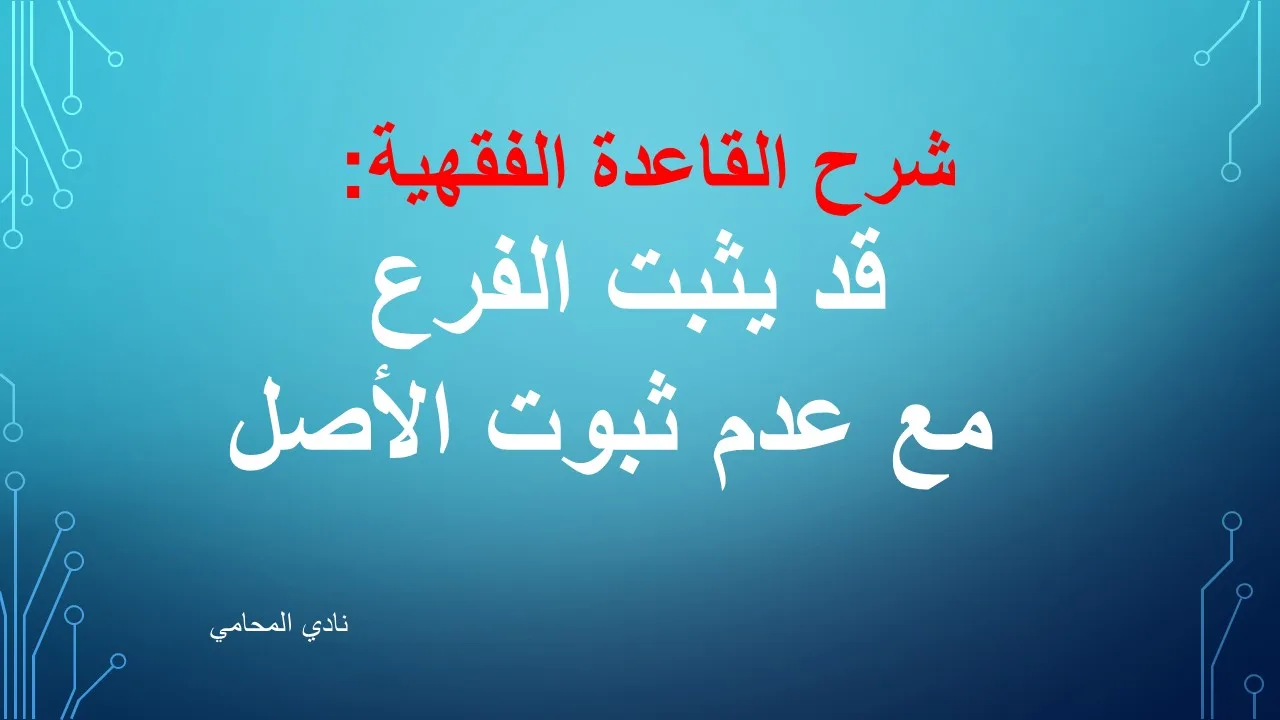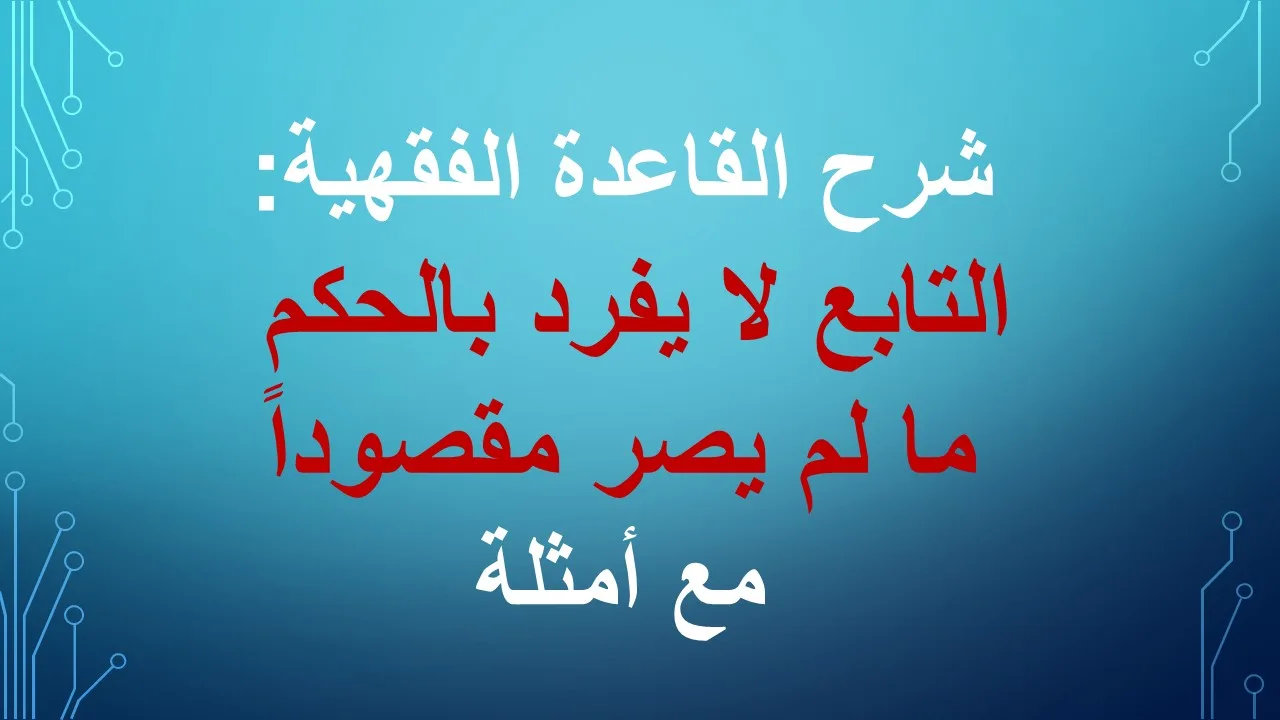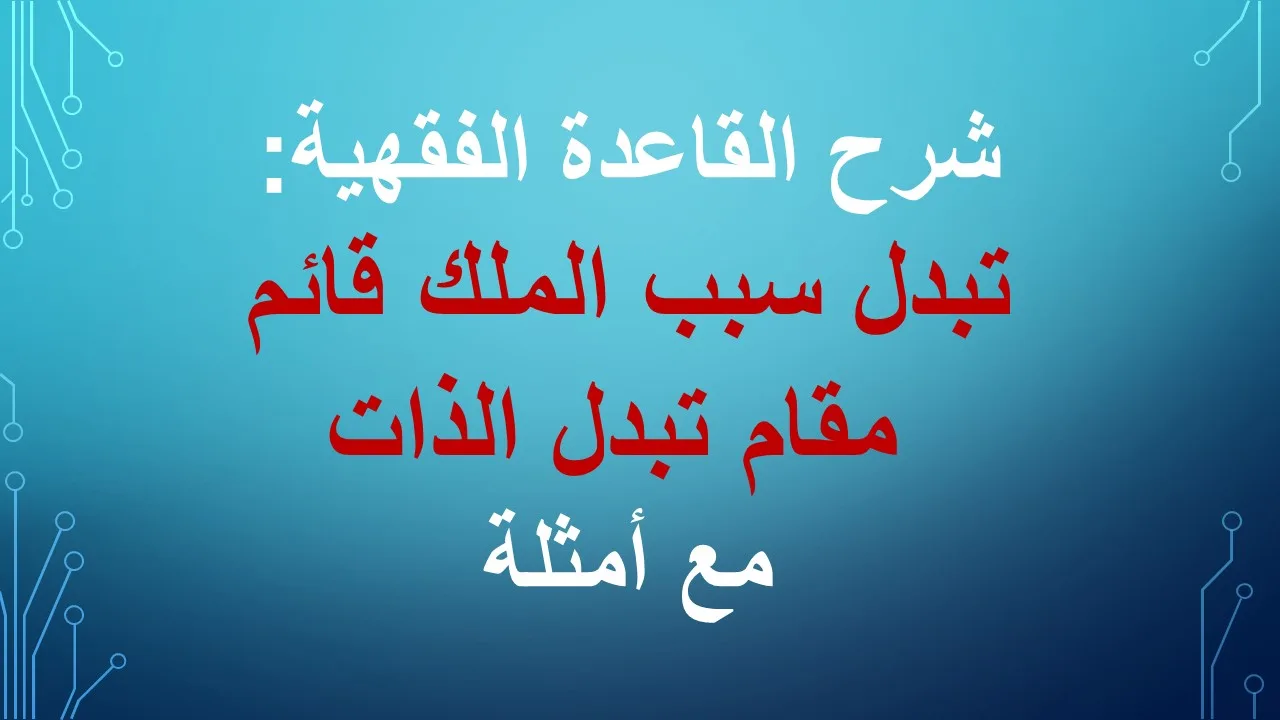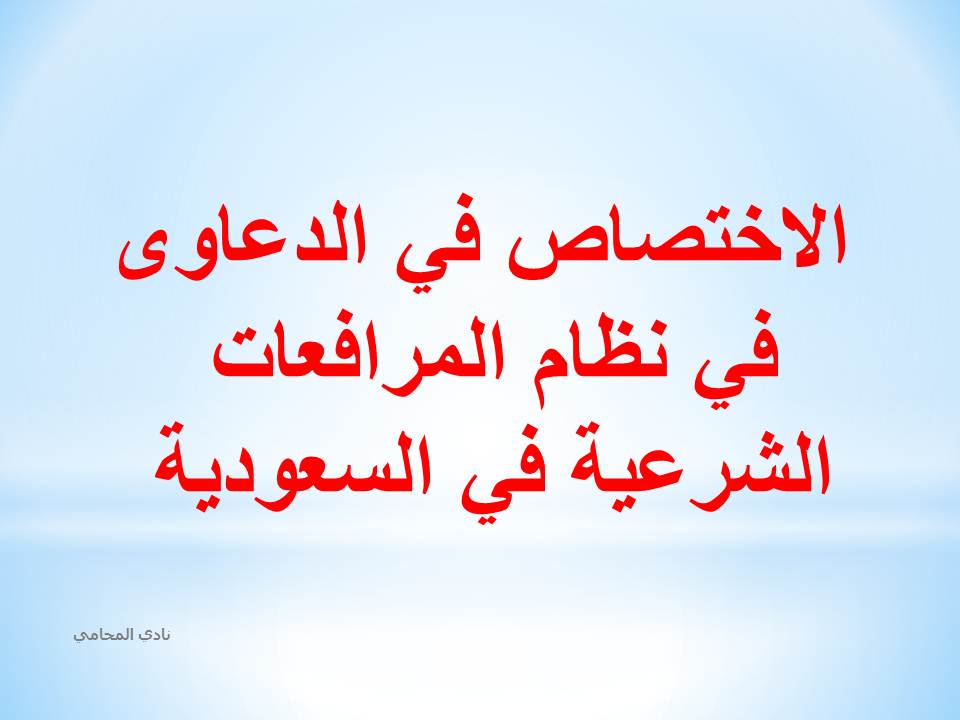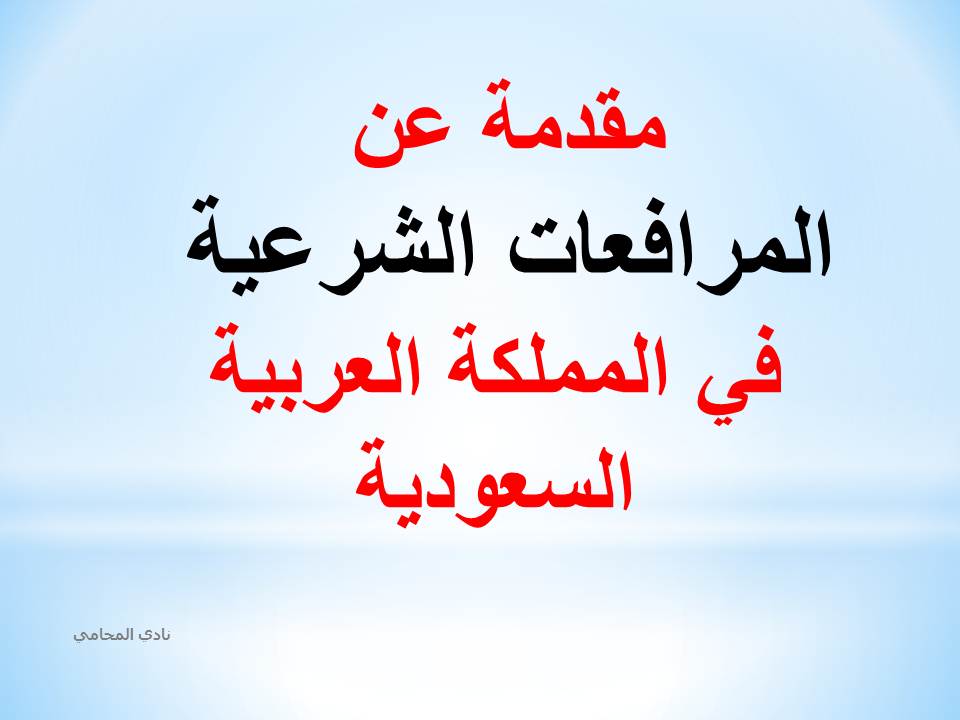س – ما المقصود بالمرافعات الشرعية؟
ج/ تعريف المرافعات:
المرافعات في اللغة: جمع مُرافَعةٍ، وهي (مُفاعلة) من الفعل رَفَع، والمفاعلة في اللغة تقتضي فعلاً من جانبين أو أكثر.
قال ابن فارس: (الراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خلاف الوضع……. ومن الباب: الرفع: تقريب الشيء…… ومن ذلك قوله رفعته للسلطان ………… والرفع إذاعة الشيء وإظهاره)
– وفي الاصطلاح : الأحكام والقواعد التي تنظم سير الدعوى وما يتعلق بها منذ بدايتها حتى الفصل فيها .
– ونسبتها إلى الشريعة؛ للدلالة على أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية.
س – ما موضوع المرافعات الشرعية ؟ وما مسائله ؟
ج/ موضوع علم المرافعات الشرعية :الإجراءات القضائية لتنظيم سير الدعوى وما يتعلق به من أحكام حتى الفصل فيها.
ومسائله كثيرة، فمنها:
إجراءات رفع الدعوى.
صفة الخصوم في الدعوى.
إجراءات سير الدعوى.
شروط الدعوى.
طرق الإثبات، وإجراءاتها.
إجراءات الفصل في الدعوى.
س- ما غاية تعلم المرافعات الشرعية ؟ وما ثمرته ؟
ج/ يفرق بعض الأصوليين بين الغاية والثمرة، فيجعل الغاية الباعث على الفعل الداعي إليه، والثمرة: النتائج الحاصلة بعد الفعل، ولاشك أن الغاية ثمرة من الثمرات، بل هي أعظم الثمرات، وعليه يقال:
إن غاية تعلم المرافعات الشرعية : إتقان إدارة الدعوى من حين رفعها إلى الفصل فيها.
ومن ثمرات تعلم المرافعات الشرعية:
۱. ضبط إجراءات إدارة الدعوى، وتوحيدها يساهم في الحد القضاة، مما بین من اختلاف الإجراءات وتعارضها، وحفظ عرض القضاء، ومنع التهمة عن القاضي.
٢. تعريف المتداعين بطرق رفع الدعوى وإجراءات سيرها، مما يثمر اختصار أمد التقاضي.
3- تعريف القضاة المبتدئين والمرشحين لتولي القضاء بإجراءات التقاضي، وكيفية التعامل مع ما يجري في مجلس الحكم.
س – ما منزلة علم المرافعات الشرعية ومكانته بين العلوم ؟
ج/ علم المرافعات الشرعية أحد أبواب القضاء، ومسائله مما يبحثه الفقهاء في كتاب القضاء من كتب الفقه، حيث يفرد الفقهاء في العادة بابا له كباب الدعاوى، وباب طريق الحكم وصفته، ونحوها من الأبواب، ومنه يتبين أن علم المرافعات الشرعية يستمد مكانته من جانبين:
۱ / منزلة علم الفقه بین العلوم.
٢/ منزلة القضاء في الإسلام؛ إذ تعلم المرافعات يوصل إلى تحقيق العدل بين الخصوم وتنظيم النظر الموصل إلى الحق.
س – مم يستمد علم المرافعات الشرعية؟
ج / يُستمد علم المرافعات الشرعية من أمور، من أهمها:
١) الكتاب والسنة، وما ورد فيهما من نصوص تبين طريقة النظر والفصل بين الخصوم، ومن ذلك ما جاء
عن علي (رضي الله عنه) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، تُرسلني وأنا حديث السِّنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: «إِنَّ الله عزّ وجلّ سيهدى قلبكَ ويُثبت لسانك، فإذا جَلَسَ بين يديكَ الخصمان، فلا تقضِيَنَ حَتى تَسْمَعَ مِن الآخَر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يَتَبيَّن لك القضاء». قال علي : فما زلتُ قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.
ومعنى قول علي : (ولا علم لي بالقضاء)، أي: نفي التجربة بسماع المرافعة بين الخصوم، وإدارة الحديث بينهما، وتمييز الماكر منهما، ويدل له جواب النبي ، ولم يُرد علي صحة نفي العلم مطلقاً؛ فإنه كان من علماء الصحابة .
فمن الكتاب والسنة تستمد جملة من مسائل المرافعات الشرعية، ومنها على سبيل المثال:
التروي في القضاء بالسماع من الخصمين قبل الحكم في الدعوى، وذلك مستفاد من قصة داود الواردة في سورة ص .
إلزام المدعي بالبينة، والاكتفاء باليمين من المدعى عليه، وذلك مستفاد من أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس لما ادعى بئراً في أرض ابن عمه ” شاهداك أو يمينه” متفق عليه.
٢) الفقه؛ لما سبق من عقد الفقهاء بابا لطريق الحكم وصفته، ضمن أبواب كتاب القضاء، ونصوص الفقهاء هي أكثر ما يستمد منه علم المرافعات الشرعية.
٣) التجارب النافعة والخبرات السابقة لمن ولي القضاء من المسلمين، وعلى رأسهم: الخلفاء الراشدون ، والقاضي شريح رحم الله ، ومن ولي القضاء في المذاهب.
وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود : ( مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)).
كما يمكن الإفادة أيضا من تجارب غير المسلمين التي لا تخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن هذا الباب مبناه على المصالح المرسلة.
. وإن من أوائل ما كُتب في المرافعات الشرعية: رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى أبي الأشعري
موسی ففيها من بديع اللفظ وحسن السبك وبليغ الوصايا ما يلزم كل دارس لهذا العلم أن يحفظها، ونصها:
(أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلَّمْ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ آسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِك وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفَك، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلا صُدْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيْنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيَّنَهُ أَعْطَيْنَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْت عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ، وَلَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ قَضَيْت فِيهِ الْيَوْمَ فَرَاجَعْت فِيهِ رَأْتِكَ فَهُدِيت فِيهِ لِرُشْدِك أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقِّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٌ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنْ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنِ وَلا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَابِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرَفْ الأَمْثَالَ، ثُمَّ اعْمِدُ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَههَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلِقَ وَالضَّجِرَ وَالتَّأَنِّي بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُرَ عِنْدَ الْخُصُومَةِ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللهُ بِهِ الآخِرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذَّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ عِنْدَ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ).
س – ما حكم تعلم المرافعات الشرعية ؟
ج/ يختلف حكم تعلم المرافعات الشرعية بحسب المسائل المراد تعلمها:
– فيجب في أحوال:
١) ما كان تعلمه لازماً لتحقيق العدل ؛ فإن تعلمه واجب على القضاة وفرض كفاية على الأمة؛ لأن العدل
واجب، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، والوسيلة إلى الواجب واجبة.
2)إذا ألزم ولي الأمر بإجراءات معينة؛ فإنها تعلمها واجب على القضاة؛ لأنها من طاعة أولي الأمر.
3) إذا توكل إنسان عن غيره في المرافعة أمام المحكمة؛ فيجب عليه تعلم المرافعات الشرعية المتعلقة بقضيته؛ لأن جهله بها تفريط فيما وُكِّل فيه.
وأما مسائل المرافعات التي غرضها التحسين والتكميل؛ فإن تعلمها دائر بين الإباحة والاستحباب.
وأما من لا يلابس القضاء ؛ فيباح له تعلم المرافعات؛ لأنه من جملة العلم النافع.
س- اذكر كتابين في المرافعات الشرعية في كل مذهب من المذاهب الأربعة.
ج- لقد كتب فقهاء المذاهب الأربعة في علم القضاء والمرافعات وطرق الحكم، فمن ذلك:
في المذهب الحنفي:
– أدب القاضي؛ للخصاف (ت٢٦١)، وعليه شروح كثيرة، كشرح الجصاص (ت٣٧٠)، وشرح الصدر الشهيد (ت٥٣٦).
موجبات الأحكام وواقعات الأيام؛ لابن قطلوبغا (ت۸۷۹).
مجلة الأحكام العدلية، خصوصاً ما جاء في الكتاب السادس عشر منها (كتاب القضاء).
في المذهب المالكي:
فصول الأحكام؛ للباجي (ت ٤٧٤).
– تبصرة الحكام؛ لابن فرحون (ت۷۹۹).
في المذهب الشافعي
أدب القاضي؛ لابن القاص (ت٣٣٥).
أدب القضاء؛ لشرف الدين الغُزي (ت۷۹۹).
في المذهب الحنبلي:
إعلام الموقعين؛ لابن القيم (ت٧٥١).
رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام؛ لعلي بن أبي بكر بن مفلح (ت۸۸۲).
الفتح الجلي؛ لمحمد جميل الشطي (ت۱۳۷۹).
س – ما مقاصد وضع أنظمة المرافعات؟
ج / حين توضع أنظمة المرافعات، ويُلزم بها القضاة والخصوم؛ فإن لذلك مقاصد متعددة، منها:
1) الوصول إلى العدل، بضبط إجراءات واضحة تمنع ميل القاضي إلى أحد الخصمين.
ومن أمثلته: إدخال طرف ثالث في الدعوى يكون له علاقة بها، أو يحصل بالحكم فيها ضرر عليه؛ حفظاً لحقه في سماع المرافعة والإجابة عما يرد فيها، واستجلاء للحق.
٢) ضبط إجراءات التقاضي، ومنع اختلاف القضاة فيها، وإيجاد مرجع يفصل بينهم عند الاختلاف.
ومن أمثلته: إلزام القضاة بضبط ما يجري في الجلسة ضبطاً مكتوبا يوقع عليه الطرفان، وضبط الاختصاص القضائي لكل محكمة، وتحديد الإجراءات المتبعة عند تنازع الاختصاص.
نشاط: برجوعك إلى نظام المرافعات الشرعية هات إجراء نص عليه النظام يُعد مثالاً لهذا المقصد.
٣) التعجيل بالفصل في القضية بعد اتضاحها.
ومن أمثلته : تحديد مدة الاعتراض على الحكم بثلاثين يوماً، يكتسب الحكم بعدها الصفة القطعية إذا لم يعترض أحد الخصمين عليه في أثناء تلك المدة.
٤) قطع الخصومات.
ومن أمثلته : منع القاضي من النظر في قضية سبق الفصل فيها.
ه) التيسير ورفع الحرج.
ومن أمثلته: استخلاف محكمة أخرى لسماع الشهادة إذا كان الشاهد يقيم في مدينة أخرى.
٦) منع اللدد والمماطلة.
ومن أمثلته: من ادعى بينة؛ فإنه يمهل لإحضارها مدة كافية، فإن أحضرها وإلا أمهله القاضي مدة ثانية، فإن لم يحضرها بعد المرة الثالثة فإن القاضي يعده عاجزاً وله الحكم في القضية بناءً على ما توفر فيها من بينات.
۷) منع اتهام القاضي، وذلك بتوضيح إجراءات عمله، ونشرها للناس؛ ليعلموا أن ما يجريه القاضي بناءً على النظام وليس تطويلاً أو مماطلة أو ميلاً لأحد الخصمين.
س – ما المرجع في تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية؟
ج – يرجع في تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة إلى:
١. نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ.
٢. ثم إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة من وزير العدل بالقرار رقم (۳۹۹۳۳)
و تاريخ ١٩/ ٥ / ١٤٣٥هـ، وما يتبعهما من تعديلات، والرجوع إلى اللائحة إنما يكون في الآتي:
أ) تفسير الألفاظ المجملة والمُشكلة من نظام المرافعات الشرعية.
ب) بيان الضوابط والاشتراطات والمتطلبات التي أحال فيها نظام المرافعات الشرعية إلى اللائحة.
ولا يجوز أن تزيد اللائحة شروطاً أو قيوداً مخالفة للنظام.
- ثم إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء وتعميماته.
ولا يجوز أن تخالف التعاميم النظام أو اللائحة.
٤. كما يُرجع إلى المبادئ الصادرة عن المحكمة العليا في الجوانب الموضوعية.
س- تحدث عن تاريخ تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية.
ج/ يمكن تلخيص تاريخ تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية في الآتي:
صدر أول نظام للمرافعات في المملكة في عام ١٣٤٦هـ، وكان اسمه: (أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها)، كما صدر في العام نفسه أمر ملكي يلزم القضاة بالتقيد بالمذهب الحنبلي في أحكامهم،
وفي حال الخروج عن المذهب فيذكر مستند ذلك ودليله.
في عام ١٣٥٠ صدر (نظام . سیر المحاكمات الشرعية)، في ٣٦ مادة.
وفي عام ١٣٥٥ هـ صدر (نظام المرافعات)، في ١٤٢ مادة.
وفي عام ١٣٧٢هـ صدر تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية في ٩٢ مادة، كما صدر معه السنة نفسها (نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي)، واستمر العمل عليهما نحواً من ٤٩ عاماً.
وفي عام ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية)، في ٢٦٦ مادة، وألغى في المادة ٢٦٥ منه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وجملة من مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
وفي ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية)، في ٢٤٢ مادة ، وأصله نظام المرافعات الشرعية السابق مع تعديلات عليه وإضافة بعض المواد وحذف بعضها، وقد نص النظام في المادة ٢٤١ على أن: (يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام)، كما نص في المادة ٢٤٠ منه على أن: (تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام).
وفي ١٩/ ٥ / ١٤٣٥ هـ أصدر وزير العدل (اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).
وهذا النظام – الصادر عام ١٤٣٥هـ- ولائحته التنفيذية هو المعمول به حتى هذا اليوم، وتجرى عليهما التعديلات بين الحين والآخر.
وفي جانب آخر ففي سبيل تنظيم إجراءات الترافع أمام محاكم ديوان المظالم صدرت (قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم)، وذلك بتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ.
وبتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ صدر (نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، المنظم لإجراءات الترافع أمام المحاكم الإدارية، وقد نصت المادة ٦٢ منه على إلغاء قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة عام ١٤٠٩ ، كما نصت المادة ٦٠ منه على أن ما لم يرد فيه حكم في النظام فإنه يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.