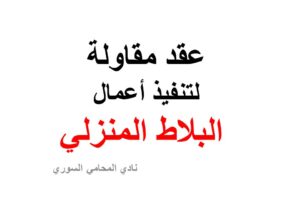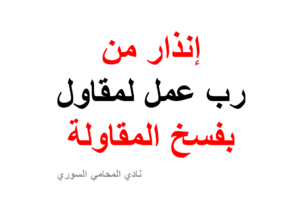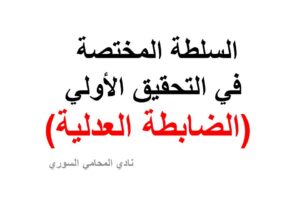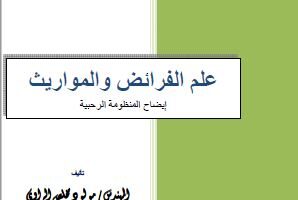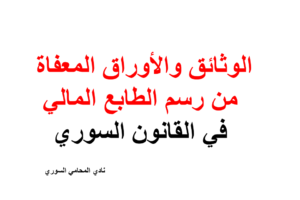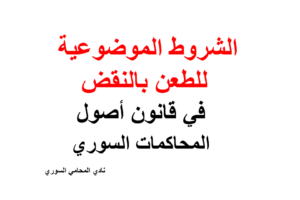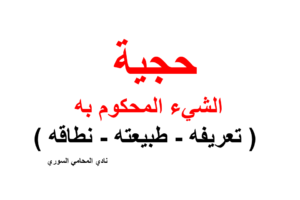عندما تقع جريمة، ينشأ للدولة الحق في معاقبة مرتكب هذه الجريمة، ولكن حتى لا يزج بشخص في السجن من دون أدلة كافية على ارتكابه الجريمة، لابد من البدء بتحقيق أولي لجمع المعلومات والأدلة والكشف عن الفاعلين وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تحيلهم بدورها إلى المرجع القضائي المختص. وتسمى هذه المرحلة ب (مرحلة التحقيق الأولي)، وتبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أن تقام الدعوى العامة. ولا تعد هذه الإجراءات من إجراءات الدعوى العامة لأنها سابقة عليها ولا تؤدي إلى إقامتها فهي إجراءات ليست ذات طبيعة قضائية وإنما هي شبه إدارية.
وقد عهد المشرع للقيام بهذه المهمة إلى مجموعة من الأشخاص الذين أعطاهم القانون صفة الضابطة العدلية)، ويقوم هؤلاء بتزويد السلطات المختصة بالمعلومات اللازمة في حدود الاختصاص المقرر لهم قانونا. فهم الأقدر من غيرهم على القيام بتلك المهمة لما يتوافر لديهم من خبرة ودراية وتخصص.
وتتميز الإجراءات التي يقومون بها بأنها يمكن أن تسبق ظهور الجريمة لأن هدفها الكشف عن الجريمة ، كما يمكن أن تكون لاحقة لظهور الجريمة ولكن قبل اتجاه الاتهامات أو الشبهات إلى متهم بالذات، فالهدف منها هو الوصول إلى تحديد شخص المتهم.
لذلك يمكن القول إن التحقيق الأولي هو مجموعة الإجراءات التي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية عقب علمهم بجريمة ما.
وتنتهي هذه المرحلة بإعداد محضر يسمى محضر التحقيق الأولي، ليضع بين يدي النيابة العامة المعلومات التي تحيط بالجريمة ومرتكبها حتى تستطيع أن تتخذ قرارها إما بإقامة الدعوى العامة في مواجهة المتهم واحالته إلى الجهة القضائية المختصة حسب نوع الجريمة، أو بإصدار قرار بحفظ الأوراق في حال رأت أن ما يتضمنه المحضر من معلومات وأدلة ليس جديا بما فيه الكفاية، فالنيابة العامة ليست ملزمة بالأخذ بما جاء في المحضر، بل لها أن تهمل بعضه أو تهمله كلهه.
فمرحلة التحقيق الأولي لا تدخل ضمن المراحل الحقيقية للدعوى العامة، وإنما هي مرحلة سابقة على إقامة تلك الدعوى واجراءاتها، لذلك فإن إجراءات التحقيق الأولي لا تحرك الدعوى العامة.
وعلى الرغم من الأهمية العملية لهذه المرحلة، فإنها لا تعد مرحلة قضائية، فهي مرحلة تبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أن تقيم النيابة العامة الدعوى العامة.
لذلك لابد من تقسيم دراستنا إلى:
– السلطة المختصة في التحقيق الأولى (الضابطة العدلية).
– سلطات الضابطة العدلية.
السلطة المختصة في التحقيق الأولي – الضابطة العدلية
السلطة التي تتولى القيام بإجراءات التحقيق الأولي تسمى الضابطة العدلية، ومن أجل معرفة ما
هو المفهوم الحقيقي للضابطة العدلية لابد من التمييز بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للضابطة العدلية.
أولا- المفهوم الواسع للضابطة العدلية
يعني مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين ويشمل كل ما تقوم به العدالة الجزائية منذ جمع الأدلة الأولى حتى اللحظة التي تتسلم فيها محكمة الموضوع القضية بما فيها أعمال قاضي التحقيق.
ثانيا – المفهوم الضيق للضابطة العدلية
ينحصر في نطاق القانون الإداري، أي السلطة المكلفة بالحفاظ على الهدوء والأمن والصحة
العامة، بحيث لا يشمل إلا الأعمال المؤقتة التي تسبق إقامة الدعوى العامة وهدفها تنوير النيابة العامة
من أجل إقامة الدعوى العامة أو عدم إقامتها، لهذا لابد من التمييز بين نوعين من الضابطة، الضابطة الإدارية والضابطة العدلية.
1- الضابطة الإدارية
تسبق مهمتها وقوع الجريمة وتتمثل في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع وقوع الجرائم ومراقبة الأشخاص المشتبه بهم، وتنفيذ ما تأمر به القوانين التي تمنع حمل السلاح والمتاجرة بالمواد السامة والمحافظة على الأملاك والقيام بالدوريات في الليل والنهار و بث العيون لتقصي آثار المجرمين، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها حفظ النظام في المجتمع.
فوظيفتها هي الوقاية من الجريمة ومنع وقوعها عن طريق حفظ النظام العام بعناصره الثلاثة المعروفة وهي: الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة. ويقوم بهذه المهمة الشرطة أو قوى الأمن الداخلي ورئيسها المحافظ في المحافظة.
2- الضابطة العدلية
عندما تخفق الضابطة الإدارية في المحافظة على الأمن والنظام وتفشل في منع وقوع الجريمة،
وتقع الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة)، يبدأ دور الضابطة العالية التي تقوم بجمع المعلومات وإجراء الاستقصاءات اللازمة عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها. فعمل الضابطة العدلية محصور في الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى العامة والتي تهدف إلى مساعدة النيابة العامة من أجل أن تقيم الدعوى أو لا تقيمها.
وقد عرف البعض عمل الضابطة العدلية بأنه: “الكشف عن وقوع الجريمة وجمع الاستدلالات
اللازمة لمعرفة مرتكبها، وتقديمها إلى النيابة العامة، وعلى ضوئها يتم تحريك الدعوى الجنائية سواء بالتحقيق أو برفعها”.
كما عرفها البعض الآخر بأنها: مجموعة الإجراءات التي تباشر خارج إطار الدعوى العامة وقبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والعناصر اللازمة التحقيق”.
التمييز بين الضابطتين:
وقد سكت قانون أصول المحاكمات الجزائية عن التمييز بين هاتين الضابطتين، ويقول الفقيه
الفرنسي غارو في هذا الصدد: أن الضابطة الإدارية والضابطة العدلية تتلامسان بشكل يصبح معه أمر التفريق بينهما عسيرا فلا يعرف أين تنتهي الأولى ولا أين تبدأ الثانية، فإذا كان هذا التفريق يبدو سه من الناحية النظرية، إلا أنه ليس كذلك من الناحية العملية. لذلك لا يجب التوسع كثيرة في التفريق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية.
والسبب أن بعض أعضاء الضابطة الإدارية يعدون في الوقت نفسه من أعضاء الضابطة العدلية، أي يجمعون الصفتين القضائية والإدارية معا.
فمثلا الشرطي الذي ينظم حركة مرور السيارات وسيرها، ويعمل على منع ارتكاب المخالفات ووقوع جرائم عدم الحيطة والاحتراز ، يقوم بعمله كضابطة إدارية ولكنه يصبح من الضابطة العدلية عندما يضبط الجريمة التي وقعت على مقربة منه ويستقصي عنها ويكشف فاعلها
وقد بين المشرع على سبيل الحصر في المواد 7 و 8 و 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من تكون لهم صفة الضابطة العدلية، نظرا إلى خطورة العمل الذي يقومون به والذي يتطلب أحياناً المساس بالحريات الشخصية للمواطنين، فكان لابد من تحديد من يملك تلك الصفة بمقتضى القانون، لأنه لا يجوز تخويل تلك الصفة لأحد إلا بقانون.
ويقسم أعضاء الضابطة العدلية إلى فئتين، الفئة الأولى: هم أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام، والفئة الثانية هم أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص.
أعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص العام
أ- الطائفة الأولى : الضباط القضاة
حسب ما جاء في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: “يقوم بوظائف الضابطة العدلية:
1- النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه.
2- قضاة التحقيق.
3- قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في
القانون”.
ويستمد هؤلاء سلطتهم من طبيعة وظائفهم القضائية. فالنائب العام ومعاونوه يقيمون
الدعوى العامة ويترافعون فيها وينفذون الأحكام الصادرة فيها. وقاضي التحقيق الذي يمثل سلطة التحقيق الابتدائي، بيده أمر التوقيف والظن بالمدعى عليهم المحالين عليه.
كما أن قاضي الصلح يعد مرجعا قضائيا له سلطة الادعاء والفصل في القضايا التي تدخل في اختصاصه لا تختلط الوظيفة القضائية لكل من هؤلاء بوظيفته كضابط عدلي، أي تلقي الإخبارات والشكاوي التي ترد إليهم من المواطنين.
فالنائب العام: يتلقى الإخبارات والشكاوى التي ترده من الأفراد، ويتلقى المحاضر والتقارير
والإخبارات التي ينظمها الضباط العدليون المساعدون.
وقاضي التحقيق: يتلقى أيضاً الإخبارات والشكاوي ويرسلها إلى النائب العام، وينظم محاضر بما شاهد من جرائم، و يمارس أعمال النائب العام في الجناية المشهودة.
وقاضي الصلح: يتلقى الإخبارات والشكاوى الخاصة بالجرائم المرتكبة في نطاق مكان اختصاصه، كما يحرر محاضر بالمخالفات التي يعود إليه أمر النظر فيها ويقوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ب- الطائفة الثانية، الضباط المساعدون:
وهم من غير القضاة، فهم موظفون إداريون وقد نصت عليهم المادة (8) من قانون أصول
المحاكمات الجزائية، يساعدون النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية وهم: المحافظون، القائم مقامون، مديرو النواحي والمدير العام للشرطة، ومديرو الشرطة، ومدير الأمن العام، ورئيس القسم العدلي، ورئيس دائرة الأدلة القضائية، وضباط الشرطة والأمن العام، ونقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب، ورؤساء الدوائر في الأمن العام، ومراقبو الأمن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب، ومختارو القري وأعضاء مجالسها، ورؤساء المراكب البحرية والجوية.
وعلى هؤلاء إيداع النائب العام الإخبارات والشكاوى التي تصل إليهم ومحاضر الضبوط والتقارير التي ينظمونها، ويستقصون عن أي جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أو مخالفة تقع في دائرة اختصاصهم المكاني، والمحدد أصلا بالمادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما أنهم مكلفون بتنفيذ أوامر النائب العام أو وكلائه لأنهم موضوعون تحت إمرتهم، إلا في حالة الجناية المشهودة، فلهم أن يقوموا بالتحقيقات حالا دون أمر من أحد
أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص
يقوم هؤلاء بضبط جرائم معينة ترتبط بالوظائف التي يقومون بها عادة، وولايتهم لا
يجوز أن تتعدى تلك الجرائم التي كلفوا باستقصائها.
وقد نصت المادة /8/ الفقرة /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.”
وقد ذكرتهم هذه المادة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن عددهم في ازدياد مستمر.
وتنحصر مهمتهم في التثبت من جرائم خاصة موضوعة تحت إشراف وزاراتهم، وتنظيم محاضر بها. من هؤلاء على سبيل المثال : موظفو الجمارك مفتشو العمل والآثار، والصحة، أمين السجل المدني، شرطة السير المكلفة بضبط مخالفات السير، مدققو الأوزان والمكاييل … الخ
فجميع هؤلاء ليس لهم ممارسة سلطاتهم إلا فيما يتعلق بجرائم معينة ترتبط بوظيفتهم وكل إجراء يقع منهم في غير الجرائم المرتبطة بوظيفتهم يكون إجراء باطلا لتجاوزه حدود الاختصاص النوعي.
فليس الموظف الجمارك على سبيل المثال أن يقوم بمباشرة اختصاص الضابطة العدلية بشأن جريمة إيذاء أو سرقة، حتى لو كانت هذه الجريمة وقعت داخل الدائرة الجمركي.
كما نصت المادة /9/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسة المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.
أي إن الضبوط التي ينظمونها لا ترسل إلى النيابة العامة، وإنما ترسل مباشرة إلى المحكمة.
نصل إلى نتيجة أنه حتى تكون إجراءات عضو الضابطة العدلية التي يقوم بها صحيحة، فإن
عليه أن لا يتجاوز نطاق اختصاصه النوعي الذي خوله إياه القانون.
فتجاوزه حدود هذا النطاق يرتب بطلان ما يقوم به، لأن هذه القواعد من النظام العام.
الاختصاص المكاني لأعضاء الضابطة العدلية
القاعدة أنه إذا حدد المشرع لعضو الضابطة العدلية اختصاصية مكانية محددة، فيلزم لصحة
الإجراءات التي تصدر منه أن تكون قد بوشرت في دائرة هذا الاختصاص، فإذا خرج عضو الضابطة عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وانما يعد فرداً عادياً.
أ- تعيين الاختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية:
ويتعين الاختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية بإعمال أحد المعايير الثلاثة التالية:
1- إما مكان وقوع الجريمة
2- إما موطن المدعى عليه
3- إما مكان إلقاء القبض عليه
هذه المعايير الثلاثة متساوية، وليس هناك أولوية لمعيار على أخر.
فالمحافظ يقوم بوظيفته ضمن الحدود الإدارية لمحافظته، وضابط الشرطة ضمن الحدود الإدارية للقسم الذي يتبع له، فإذا تجاوزوا حدود اختصاصهم المكاني، يصبح أي واحد منهم كأنه فرد عادي وتكون إجراءاته باطلة، فليس لهم أن يباشروا إجراءاتهم خارج النطاق المكاني للجهة التي هم معينون لها.
ب- امتداد الاختصاص المكاني:
لكن القانون خول بعض الضباط العدلين الحق في القيام بأعمال الضابطة العدلية في جميع
أنحاء الجمهورية بموجب نصوص خاصة، كالنائب العام في الجمهورية وقائد قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة الأمن السياسي ورئيس شعبة الأمن الجنائي.
وعلى الرغم من وجوب احترام قواعد الاختصاص المكاني لرجال الضابطة العدلية، يصبح هذا الاختصاص قابلاً للامتداد في حالة الضرورة، أي متى كان الإجراء الذي يباشره في غير دائرة اختصاصه المكاني متعلق بجريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني، أو كان المتهم يقيم في دائرة هذا الاختصاص، أو كان ضبطه قد تم فيها.
عندئذ يقع عمل الضابط العدلي صحيح رغم تجاوزه حدود اختصاصه المكاني.
فحالة الضرورة تسوغ امتداد الاختصاص المكاني، وإلا ترتب على ذلك بطلان الإجراءات، ولابد من الإشارة إلى حالة الضرورة في المحضر، كما لو ندب ضابط عدلي لتفتيش أحد الأشخاص لحيازته مواد مخدرة، فهرب الشخص إلى خارج الاختصاص المكاني للضابط فاضطر إلى ملاحقته وضبطه وتفتيشه، فيكون عمله صحيحة على الرغم من خروجه عن دائرة اختصاصه المكاني.
كذلك الأمر في حالة ما إذا صادف الضابط العدلي شاهدة على وشك أن يموت قبل أن يؤدي
شهادته، فيستمع إليه ويحرر محضر بشهادته.
والأمر نفسه حين يتعلق بمطاردة محكوم عليه هارب من تنفيذ حكم واجب النفاذ ويستمر الضابط العدلي في مطاردته ولو اقتضى الأمر تجاوز حدود اختصاصه.
أي إن امتداد الاختصاص لعضو الضابطة العدلية خارج حدود اختصاصه المكاني يقع صحيحة في حالة الضرورة المبررة، أما في حال عدم وجود ضرورة، فالأصل أنه ليس لأعضاء الضابطة العدلية مباشرة إجراءاتهم خارج النطاق المكاني للجهة المعينين فيها، وتعد الإجراءات التي يقومون بها باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها.
كما أن الدفع ببطلان التحريات التجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني، لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الدفع يقتضي تحقيق موضوعية يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع لا محكمة النقض.
ج- تبعية أعضاء الضابطة العدلية لإشراف النائب العام:
ينتمي معظم أعضاء الضابطة العدلية إلى جهاز الشرطة الذي يتبع وزارة الداخلية التي تشرف
عليه إشرافة تنظيمية وإداريا.
أما عندما يقومون بوظائف الضابطة العدلية فإنهم يخضعون لرقابة واشراف النيابة العامة.
وقد نصت المادة (14) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:
“1 – النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بمن فيهم قضاة التحقيق.
2 – أما مساعدو النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8و9 فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .
كما نصت المادة /16/ من القانون ذاته على أنه: “إذا توانی موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيها وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية”.
ومن مظاهر تبعية أعضاء الضابطة العدلية للنيابة العامة ما يلي :
1 – التزام أعضاء الضابطة العدلية بإخبار النائب العام عن الجرائم التي تصل إلى علمهم.
2- إيداعه الإخبارات ومحاضر الضبوط التي ينظمونها بالجرائم التي تصل إلى علمهم.
3- متابعة عضو الضابطة العدلية للتحقيق الذي بدأه قبل حضور النائب العام، إذا أمره النائب العام بإتمامه.
4- تنفيذ الإنابة التي تصدر عن النيابة العامة.