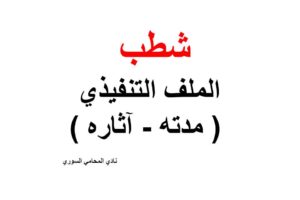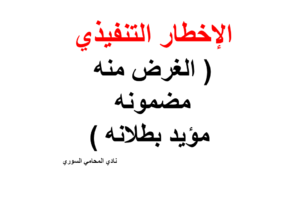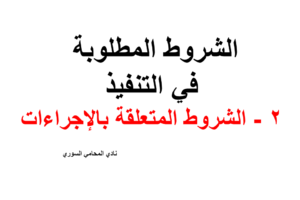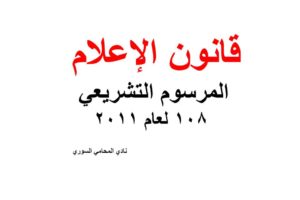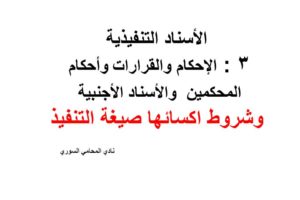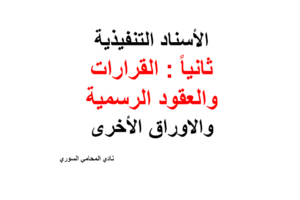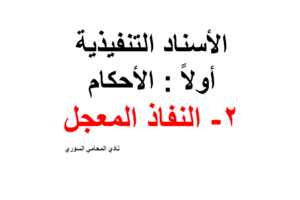قانون الإعلام
المرسوم التشريعي 108 لعام 2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة الأولى
تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ويلغى أيضاً:
1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.
2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.
3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.
المادة الثالثة
تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
قانون الإعلام
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
المجلس: المجلس الوطني للإعلام.
الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للجهاز التنفيذي.
المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد.
المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.
التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل الالكترونية او الكهرطيسية او الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.
الشبكة: منظومة للتواصل الالكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل او مجموعة من المستقبلين وفق اجراءات محددة ومن أمثلتها الانترنت او الشبكة النقالة او ما يشابهها.
الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية او حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.
الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.
النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسيلة او تقنية كانت.
الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت او غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية الإلكترونية.
المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي ورقياً كان أو رقمياً أو ما يشابهه وتصدر باسم معين.
المطبوعة الدورية: مطبوعة ذات منهج اعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.
الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.
وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الاذاعية او التلفزية او ما يشابهها.
الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلاميا بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.
الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.
وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى اعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً “المضيف”.
الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف او اعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.
وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة.
شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.
صاحب الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة اعلامية ويحوز على الترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز ان يكون صاحب الوسيلة الاعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.
رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة اعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.
صاحب الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى او مادة او معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة او تعليقا في وسيلة اعلامية سواء أكان اعلاميا ام لا.
وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة التي تتمتع بالصفة الاحترافية أو مؤسسة الخدمات الإعلامية.
سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية .. قاعدة بيانات ينشئها المجلس وتتضمن بيانات عن المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة.
بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها على وسيلة اعلامية إلكترونية وتشير بوجه خاص الى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول اليها ومدة الاتصال.
الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.
الفصل الثاني
المبادىء الأساسية
المادة 2
الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
المادة 3
تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية..
1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية.
2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.
3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.
المادة 4
يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية..
1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.
2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.
4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.
6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
المادة 5
تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.
الفصل الثالث
الحقوق والواجبات
المادة 6
مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.
المادة 7
أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون.
ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.
المادة 8
تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.
المادة 9
أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.
ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.
ج- للإعلامي الحق في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الاصلية.
د- يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.
ه- على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.
و- يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.
المادة 10
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً.
ب- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.
المادة 11
يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.
المادة 12
يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..
1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.
4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.
5-كل ما يمس برموز الدولة.
المادة 13
يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
المادة 14
يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.
المادة 15
يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.
المادة 16
أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة.
ج- يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.
المادة 17
أ- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس.
ب- تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.
المادة 18
أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ.
ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش المالي والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول.
الفصل الرابع
المجلس الوطني للإعلام
المادة 19
يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى “المجلس الوطني للإعلام “يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 20
أ- يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
ب- يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية ..
1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
2- أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
3- ألا يكون مالكاً لأي وسيلة إعلامية أو مشاركاً في ملكيتها.
4- أن يكون مشهوداً له بالمصداقية والنزاهة.
5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.
ج- يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.
د- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان عين بديل له وفقاً لأحكام هذه المادة.
ه- يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.
و- يعين المجلس أميناً للسر يتولى إعداد جدول الأعمال وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ المهام الموكلة إليه من المجلس.
المادة 21
لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية..
1- وفاته.
2- انقضاء مدة عضويته.
3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية.
4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
5- إخلاله بشرط من شروط العضوية.
6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.
7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.
المادة 22
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية..
1- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.
2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.
3- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ.
4- وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.
5- دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.
6- تحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.
7- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية.
8- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة. 9- السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.
10- المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.
11- إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.
12- الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.
13- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون.
14- الإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك.
15- وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
ب- على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.
ج- تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها في مجلس الوزراء.
المادة 23
أ-يجتمع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.
ب- لا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
د- للمجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد الاستماع إلى رأيه في القضايا المبحوثة دون أن يكون له حق التصويت.
ه- للمجلس الاستعانة بخبراء ومستشارين لتقديم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
و- للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 24
أ- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملاكه العددي بمرسوم.
ب- يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
ج- يصدر نظام الاستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا التي يتقاضونها.
د- يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد التنسيق مع وزير المالية.
هـ- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويمثل المجلس أمام القضاء.
المادة 25
أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها الأمين العام ويقرها المجلس.
ب- يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والاستثمارية للمجلس والجهاز التنفيذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.
ج- إذا وقع عجز في ميزانية المجلس لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لسد العجز تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.
د- تخضع حسابات المجلس بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
هـ- يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس ومركزه المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
و- يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.
المادة 26
تتألف موارد المجلس مما يلي..
1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس.
3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 27
أ- يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلامية طيلة مدة عضويته في المجلس.
ب- يحظر على الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي من مرتبة مدير أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.
ج- يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحاً خطياً يبين فيه عدم وجود مصلحة بينه أو بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وبين أي من الوسائل الإعلامية وتعهداً بالإفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك.
د- على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة وعليه في هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه ويدون ما أفصح عنه العضو بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس.
هـ- يحظر على عضو المجلس أو الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي الإفصاح للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها ويحدد المجلس المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها.
و- يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين من تاريخ انتهائها اتخاذ أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو سبق له البت فيها.
الفصل الخامس
حق الرد والتصحيح
المادة 28
تلتزم الوسائل الإعلامية بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من محتوى يتعلق به دون نقص أو تحريف.
ويجب أن يتم هذا النشر ضمن المهل والشروط الآتية..
أ- في المطبوعات الدورية ينشر الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر بعد استلام الطلب بذلك وفي حال كانت المطبوعة يومية ينشر الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
ب- في وسائل التواصل السمعي والبصري التي تبث على الهواء مباشرة ينشر الرد أو التصحيح فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً وإلا ينشر على النحو الآتي..
1- في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج.
2- إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية فينشر الرد أو التصحيح في مقدمة النشرة التالية المماثلة وإذا ورد في موجز للأخبار فينشر في الموجز أو النشرة التالية.
3- إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأي وسيلة إعلامية فينشر الرد أو التصحيح في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.
ج- في وسائل التواصل على الشبكة ينشر الرد أو التصحيح فور وروده.
المادة 29
أ- يكون نشر الرد أو التصحيح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنية مجاناً أو على النحو الذي يضمن توضيح وجهة نظر صاحبه.
ب- إذا تجاوز الرد أو التصحيح الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو التصحيح قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.
المادة 30
أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحيح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم.
ب- للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه.
المادة 31
يرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون أو ما يقوم مقامه مرفقاً به المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت.
المادة 32
يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية..
1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح.
2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات.
3- إذا لم يكن مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.
4- إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 33
أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحيح يحق للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب التسعيرة العادية فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالوسيلة الإعلامية.
ب- ينشر الحكم الصادر في الوسيلة الإعلامية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التسعيرة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.
المادة 34
أ- في حال مخالفة أحكام المادة 28 والمادة 29 من هذا القانون يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح.
ب- ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أي نفقة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
الفصل السادس
الترخيص والاعتماد وإجراءاته
المادة (35):
لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
أولاً: المطبوعات
المادة (36)
يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العام ويقدم الإخطار عند كل إصدار.
المادة (37)
أ- يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار المطبوعات الدورية.
ب- تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وذلك وفق الإجراءات الآتية..
1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون وعلى المجلس إبلاغ طالب الترخيص بقراره خلال عشرة أيام.
2- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.
3- يجوز في حالة رفض الترخيص تقديم طلب جديد إلى المجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام البندين 1 و 2 من هذه الفقرة.
ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.
د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.
المادة (38)
يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً..
1- اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها.
2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي.
3- رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة يجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.
4- المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.
5- ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في أول ثلاث سنين.
المادة (39)
أ- إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي يجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد له اعتباره قانوناً.
3- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.
4- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.
ب- في حال كان الترخيص باسم شركة يجب تقديم صورة مصدقة عن نظام الشركة الأساسي وسجلها التجاري ويجب أن تتوفر في طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..
1- أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لأحكام قانون الشركات.
2- أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سورية.
3- أن تكون جنسية جميع الشركاء سورية.
4- أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد على 50 بالمئة مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد على 49 بالمئة.
المادة (40)
أ- يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العلاقة.
ب- يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام المادة 39 من هذا القانون.
ج- يجوز نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام المادة(39) من هذا القانون.
المادة (41)
بعد صدور الترخيص يعلم صاحب المطبوعة المجلس باسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفية الشروط الآتية..
أ- للمدير المسؤول ..
1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من المادة 39 من هذا القانون.
2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو حاملاً شهادة خبرة إعلامية يعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات.
3- ألا يكون مديراً مسؤولاً في أكثر من مطبوعة دورية واحدة إلا إذا كان صاحب المطبوعة يملك أكثر من وسيلة إعلامية فله في هذه الحالة تعيين مدير مسؤول واحد لجميع تلك الوسائل.
ب- لرئيس التحرير..
1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من المادة 39 من هذا القانون.
2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل أو يكون رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نفاذ هذا القانون.
3- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.
ج- يحق لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون مديراً مسؤولاً أو رئيساً للتحرير فيها في الوقت نفسه على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- يجوز في المطبوعة الدورية الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
ه- يجب على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام عمل في حال حصول أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير مرفقاً بما يثبت تحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال حدوث طارئ يتعلق بهما يجب إخطار المجلس خلال ثلاثة أيام من حدوثه.
المادة (42)
أ- على صاحب المطبوعة الدورية أن يبدأ بإصدار المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.
ب- على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس فوراً إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة أو بصورة نهائية أو أعاد نشرها بعد التوقف.
المادة (43)
تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية..
1- اسم صاحب المطبوعة.
2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.
3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
5- تاريخ صدور المطبوعة.
6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع.
7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.
ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري
المادة (44)
يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة..
1- طيف الترددات الراديوية.
2- المنظومات الساتلية.
3- شبكات الكبال.
المادة (45)
أ- يقصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة على أن يكون أكثرية الشركاء فيها حائزين شهادة جامعية على الأقل.
ب- يجب أن لا تزيد ملكية أي شريك وزوجه وأفراد أسرته من الأصول والفروع على..
1- 20 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة منها بالأخبار والبرامج السياسية و 25 بالمئة في باقي وسائل الخدمة التلفزية على ألا يكون مالكاً لأي نسبة في وسيلة خدمة تلفزية وطنية أخرى يكون لها نفس منهج المحتوى.
2- 25 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الإذاعية.
المادة (46)
يجب أن يتضمن طلب الترخيص..
1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.
2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية.
3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث.
4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
المادة (47)
يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي..
1- الإمكانات والمواصفات التقنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصصة.
2- شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.
3- قدرة الوسيلة الإعلامية على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية.
4- مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية شريطة أن تكون جميعها وطنية.
المادة (48)
تقوم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 بتخصيص الترددات اللازمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي وتعلم الهيئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات.
المادة (49)
أ: يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بالقانون رقم 18 لعام 2010.
ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.
ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.
د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.
المادة (50)
تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الإذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
المادة (51)
يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير وتنطبق عليهما أحكام المادة (41) من هذا القانون ويجوز أن يحل محل رئيس التحرير في وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الإعلامي المتخصص غير السياسي مدير للبرامج ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض أحكام هذا القانون.
المادة (52)
أ- لا يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.
ب- على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلال البث التلفزي وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
ج- على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة الخدمة الإذاعية والمرئي في حالة الخدمة التلفزية لما يتم بثه من برامج لمدة يحددها المجلس.
المادة (53)
يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس.
المادة (54)
أ- على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.
ب- يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة.
المادة (55)
تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث تقنيات البث فيها على النحو الآتي..
1- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.
2- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهورية العربية السورية على ألا تقل التغطية عن ثلاث محافظات.
3- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية ويتجاوز نطاق تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية.
4 وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية أو فضائية تستخدم تقنيات التشفير ولا تتيح برامجها إلا للمشتركين فيها.
المادة (56)
تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على النحو الآتي..
1- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الأخبار والبرامج السياسية.
2- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي لا تخرج عنه.
المادة (57)
أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس.
ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل.
ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة
المادة (58)
أ- يمكن التقدم بطلب إلى المجلس للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تتمتع بالصفة الاحترافية.
ب- يقدم طلب الاعتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة على أن يتضمن..
1- عنوان الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة وإثبات عائدية هذا الموقع إلى مقدم طلب الاعتماد.
2- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.
3- اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده على أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة (41) من هذا القانون.
4- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ويحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها فيهما.
5- منهج وسيلة التواصل على الشبكة.
ج- يجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استلام المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصدر المجلس وثيقة الاعتماد خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.
د- على صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة إبلاغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على احد البيانات الواردة في الطلب خلال مدة عشرة أيام.
ه-يجوز أن يكون صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئيس تحرير أو مديراً مسؤولاً لها.
و- يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط التي يحددها المجلس.
المادة (59)
يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية..
1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك.
2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة.
3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.
المادة (60)
أ- تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل على الشبكة المعتمدة أو غير المعتمدة سواء أكان محرراً من أي من العاملين في وسيلة التواصل على الشبكة أم من أي صاحب كلام.
ب- تعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عما يرد فيها من محتوى أو التعليقات عليه.
المادة (61)
تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ينشر فيها على اختلاف أشكاله وبحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة يحددها المجلس وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة على إنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب ذلك.
المادة (62)
أ- يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها.
ب- تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالتزوير.
المادة (63)
تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات الآتية:
1- اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.
2- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
3- عنوان مركز التحرير إن وجد.
4- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.
المادة (64)
أ- تعد وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات وأي جهة أخرى مرخصة أصولاً معتمدة حكماً.
ب- تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعلام المجلس عن إنشائها وتقديم البيانات التي يحددها المجلس.
ج- يكون لكل من وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يمثلها أمام الجهات الإدارية والقضائية على أن تتوفر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.
د- إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عد الاعتماد ملغى حكماً.
المادة (65)
أ- يجوز للوسائل الإعلامية المرخص لها نشر محتواها إلكترونياً في وسيلة تواصل على الشبكة باستخدام الاسم نفسه ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وذلك بعد إعلام المجلس بالبيانات المطلوبة.
ب- يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية أن يتقدم بطلب اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تختلف في محتواها عن وسيلته الإعلامية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسها للإشارة إلى تلك الوسيلة.
رابعاً: وكالات الأنباء
المادة (66)
أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على ألا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30 بالمئة من رأس مال الشركة.
ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.
ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية على الأقل.
المادة (67)
أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء المتخصصة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة.
ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.
ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية.
المادة (68)
يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة:
1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها.
2- بالموارد البشرية.
3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.
المادة (69)
أ- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً شروطه.
ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.
ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.
د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.
المادة (70)
يكون لوكالة الأنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير وتطبق عليهما أحكام المادة 41 من هذا القانون.
المادة (71)
أ- لا يجوز لوكالة الأنباء إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.
ب- على وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الإعلامي الإخباري الذي تقدمه لمشتركيها لمدة يحددها المجلس.
ج- يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة الأنباء لمصلحة أي جهة أخرى كما لا يجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس ويعد أي تصرف بهذا الشأن باطلاً.
المادة (72)
على وكالة الأنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.
المادة (73)
تعد وكالة الأنباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها.
خامساً: شركات الخدمات الإعلامية
المادة (74)
أ- يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات ويحدد المجلس أنواع هذه الأنشطة.
ب- للوسائل الإعلامية حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من المجلس.
المادة (75)
أ- يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.
ب- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية:
1- اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.
2- بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية.
ج- إذا صدر قرار المجلس برفض الاعتماد فيجب أن يكون مسبباً.
د- يحق لمن رفض طلبه بالاعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض.
المادة (76)
أ- تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات الأجنبية وعن الأعمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل البدء بتنفيذها.
ب- يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه فإذا انتهت هذه المدة دون رد عد قراراً بالموافقة الضمنية.
المادة (77)
تعامل شركات الخدمات الإعلامية معاملة الوسائل الإعلامية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الأعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقديم محتوى إعلامي للجمهور.
الفصل السابع
العقوبات وأصول المحاكمات
المادة (78)
أ- رئيس التحرير والإعلامي وصاحب الكلام في الوسائل الإعلامية مسؤولون عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في هذا القانون والقوانين النافذة ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهم الجرمية.
ب- صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.
المادة (79)
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.
المادة (80)
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام المادة (13) من هذا القانون.
المادة (81)
يعاقب بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (14) والمادة (16) من هذا القانون.
وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.
المادة (82)
يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (15) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.
المادة (83)
يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل ثلاثة أمثال ثمن تسعيرة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.
المادة (84)
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (85)
يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية عضو المجلس أو الأمين العام أو الموظف في الجهاز التنفيذي الذي يخالف أحكام الفقرات /أ/ و/ب/و/هـ /من المادة (27) من هذا القانون.
المادة (86)
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (28) والمادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
المادة (87)
أ- يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منحه الرخصة وبإيقاف أعمال النشر أو البث.
ب- تضاعَف الغرامة في الفقرة (أ) من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون.
المادة (88)
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من المادة (58) من هذا القانون.
المادة (89)
يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.
المادة (90)
يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المادة (43) والفقرة (ب) من المادة (52) والمادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.
المادة (91)
يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (45) والفقرة (أ) من المادة (66) والفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القانون.
المادة (92)
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (52) والفقرة (أ) من المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال التكرار.
المادة (93)
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (52) والمادة (61) والفقرة (ب) من المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.
المادة (94)
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من المادة (71) من هذا القانون.
المادة (95)
يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم خطأ على نشر أخبار غير صحيحة أو أوراق مختلقة أو مزورة.
المادة (96)
يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر المصدر المنقول عنه دون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
المادة (97)
يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية على أن تكون الغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
المادة (98)
أ- تتولى محكمة بداية الجزاء في مركز كل محافظة النظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للاستئناف ويصدر حكم الاستئناف مبرماً.
ب- تنظر محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف على وجه السرعة في القضايا المعروضة أمامها المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
ج- للمدعى عليه أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن ينيب عنه محاميا لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة.
المادة (99)
كل جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين النافذة.
المادة (100)
في جميع الحالات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.
المادة (101)
في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
المادة (102)
أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية.
ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة (103)
تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلامية لها في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطاً اقتصادياً أساسياً راهناً وذلك بصرف النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلامية إلكترونية.
المادة (104)
أ- لا يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد لهذه الوسائل.
ب- يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد وسائل التواصل على الشبكة التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات.
المادة (105)
تستثنى الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.
المادة (106)
أ- على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه.
ب- تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.
دمشق في 28-9-1432 هجري الموافق 28-8-2011 ميلادي.