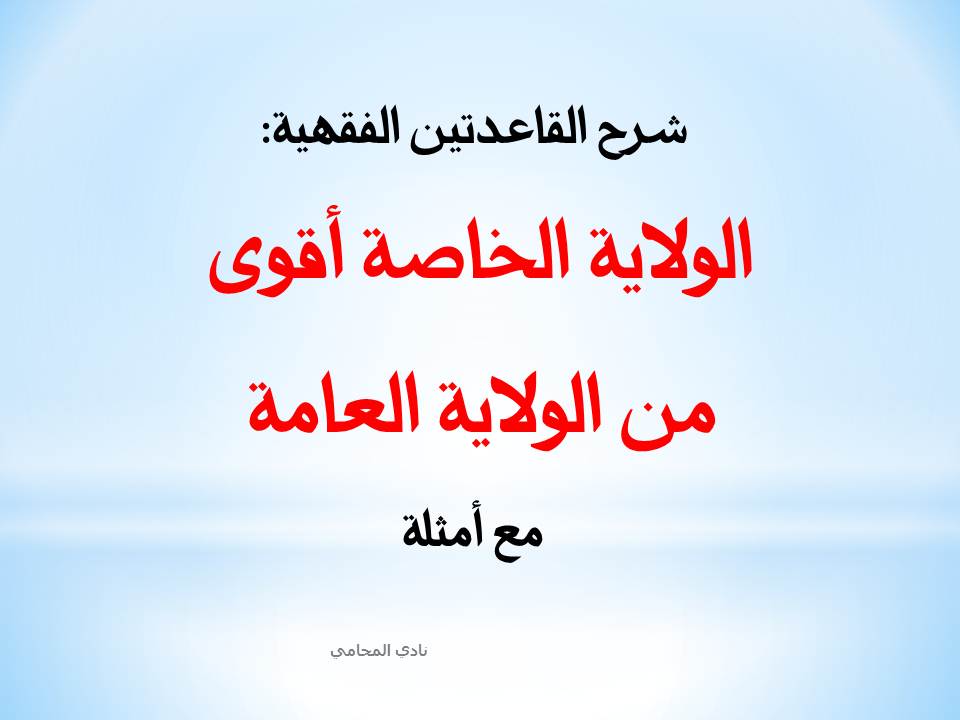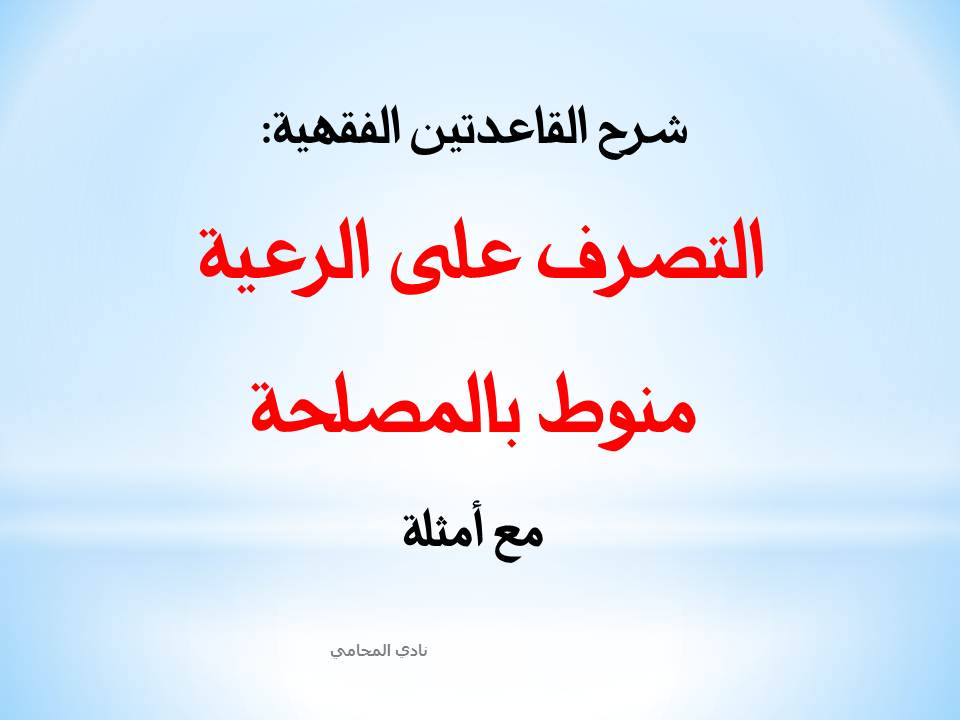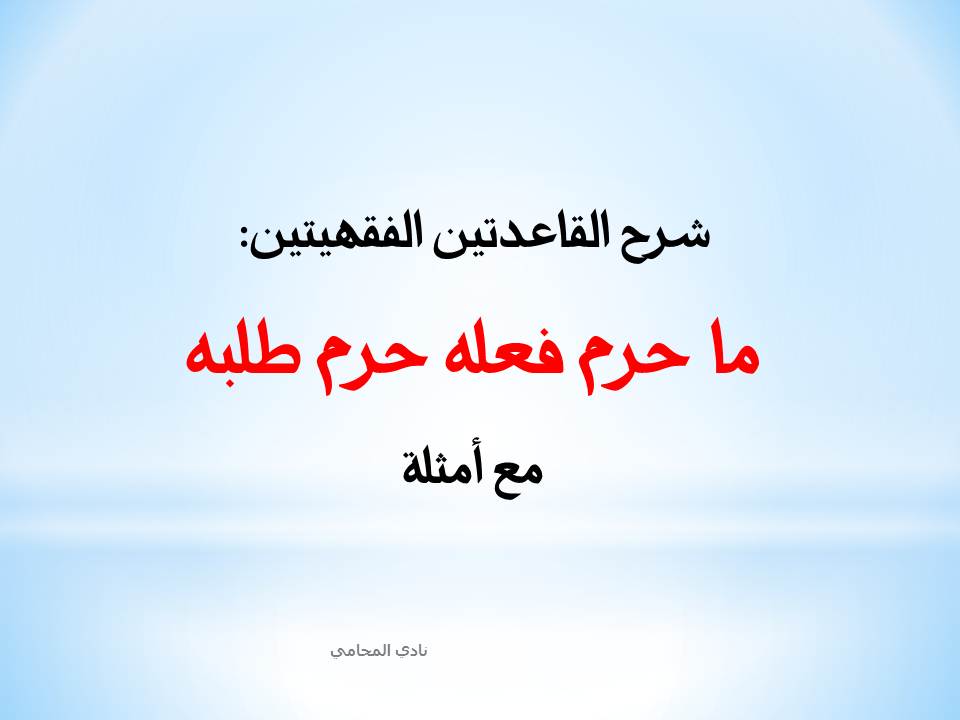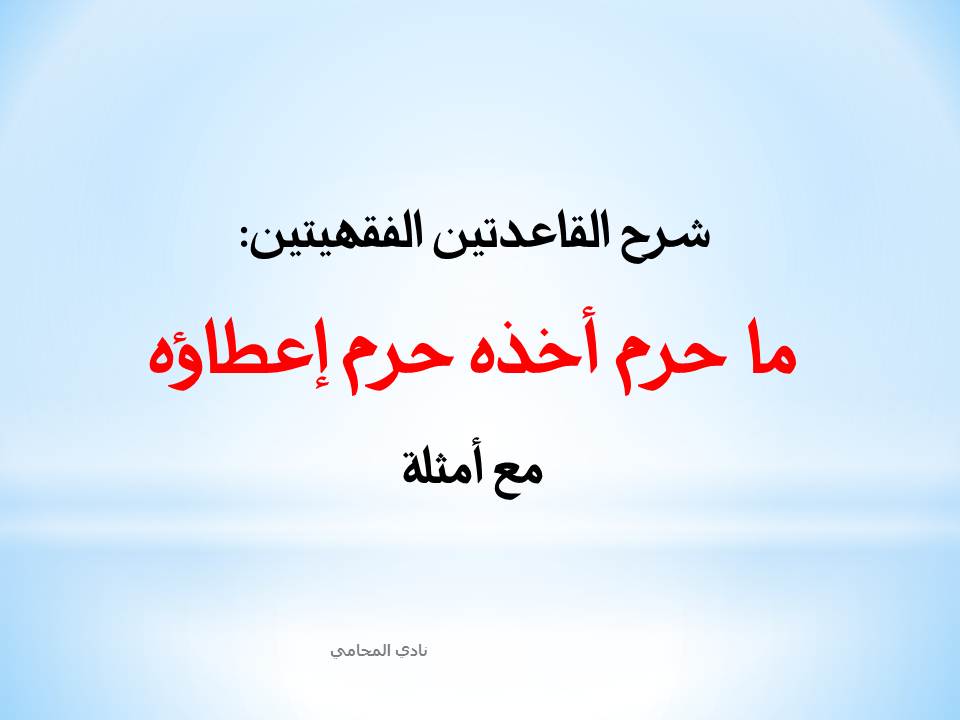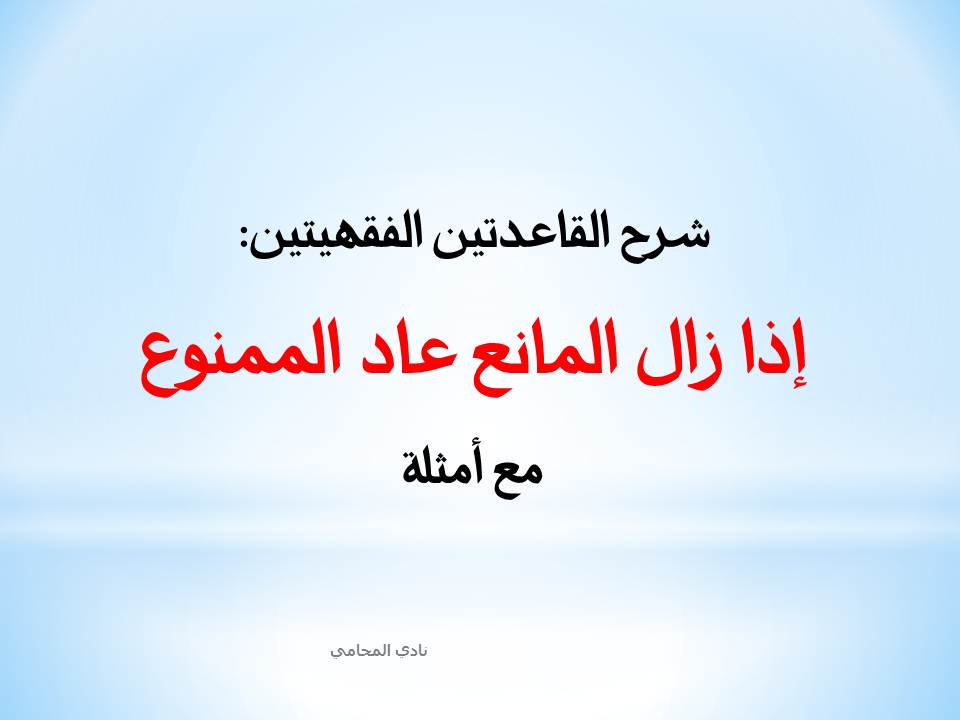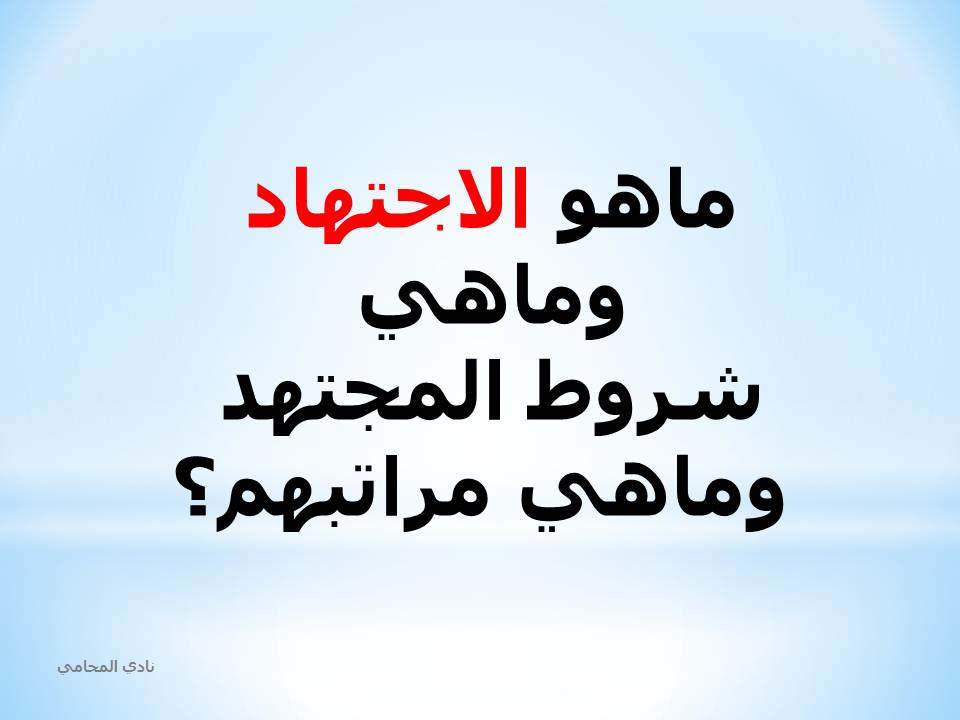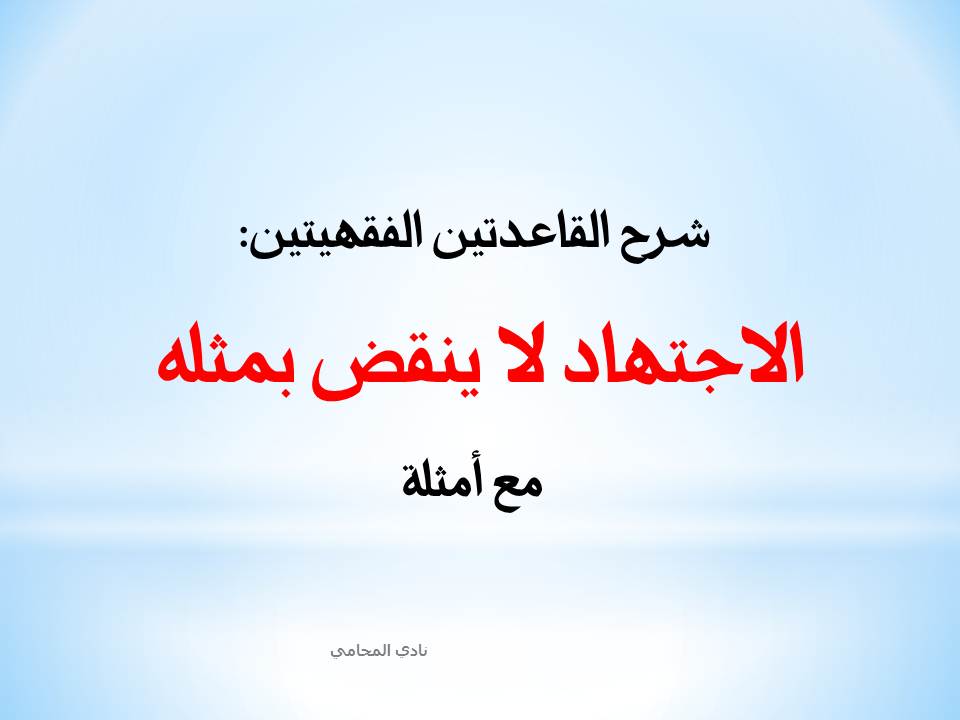الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
الولاية العامة تكون في الدين والنفس والمال وهي ولاية الإمام ونوابه، والولاية الخاصة تكون في النفس والمال فقط، وقولهم الولاية الخاصة أقوى . . لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وتمكيناً ، ومعنى أن الولاية الخاصة أقوى أي بقوة نفاذ التصرف على الغير شاء أم أبى.
من تطبيقات هذه القاعدة أن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم وجود ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرم أو أماً .
ومنها: إذا أجر القاضي حانوت الوقف من زيد وأجره المتولي من بكر، فإن إجارة المتولي هي المعتبرة.
ومنها : أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولّ ولو من قبله، حتى لو تصرف فيه ببيع أو شراء أو إجارة أو جباية لا ينفذ تصرفه؛ إذ لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف . .
ومنها : أن القاضي لا يملك التصرف بمال الصغير مع وجود وصي الأب أو الجد أو وصي القاضي نفسه، ولا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله .
ومنها : لو زوج القاضي المرأة لغيبة الولي وزوجها وليها الغائب من آخر في وقت واحد وثبت ذلك بالبينة اعتبر تزويج الولي لا غير.
تنبيهات :
- الأول : ظاهر كلام المشايخ أن الولاية مراتب :
١ – ولاية الأب والجد، وهي وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا .
۲ ـ ولاية الوكيل وهي غير لازمة للموكل عزله وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله .
3- ولاية الوصي وهي بينهما، ولم يجز أن يعزل نفسه .
٤ – ولاية ناظر الوقف، يجوز للواقف عزله بلا اشتراط، وهو المعتمد في الأوقاف والقضاء، أما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية،
وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه .
الثاني: الأب والجد ولايتهما في المال والنكاح، والعصبات والأم وذوو الأرحام ولايتهم في النكاح فقط، والوصي ولايته في المال فقط. . .
الثالث : الولاية الخاصة على خمسة أضرب :
1 – ولاية قوية في النفس والمال، وهي ولاية الأب والجد لأب وإن علا بشرط الحرية والتكليف والاتحاد في الدين، وغير الإسلام من الأديان بمنزلة دين واحد .
٢ – ولاية ضعيفة في النفس والمال وهي ولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب أو من الأقارب، وكان هناك أقرب منه فيملك تأديبه ويحفظ له ماله .
3- ولاية قوية في النفس ضعيفة في المال وهي ولاية العصبات من غير الأب والجد أو ذوي الأرحام فيزوجون الصغيرة بالكفء وبمهر المثل والصغير بما فيه مصلحة له ولا يتصرفون في أموالهما .
٤ ـ ولاية قوية في المال ضعيفة في النفس، وهي ولاية وصي الأب أو الجد أو القاضي، فإنهم يتصرفون في أموال الصغار ولا يزوجوهم.
ه ـ ولاية قوية في المال فقط، وهي ولاية متولي الوقف في مال الوقف وولاية الوصي في مال الكبير الغائب، فإن الواحد منهما يلي بيع غير العقار من التركة لدين أو وصية لا وفاء لهما إلا ببيعه. .
. الرابع: الولاية على النفس هي أولاً للعصبات الأصول، ثم للفروع، ثم للحواشي، ثم للأم، ثم للشقيقات، ثم للأخوات لأب، ثم للأخوات لأم، ثم لذوي الأرحام. .
ولهذه القاعدة مستثنيات منها : يجوز للقاضي تأجير عقار الوقف من المتولي ممن لا تقبل شهادته للمتولي أو من أصوله وفروعه، ولو لم يكن في ذلك خيرية .
ومنها : أن المتولي لا يملك العزل والنصب لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف له ذلك ويملكه القاضي بدون شرط الواقف .
ومنها : أن القاضي يملك إقراض مال الصغير دون الأب أو الوصي؛ لأن القاضي قادر على تحصيل الدين لشوكته وليس للوصي ذلك .
ومنها : أن القاضي يملك الاستقراض للوقف واستبداله بشروط وتأجيره مدة طويلة عند مسيس الحاجة إلى تعميره ولا يملك المتولي ذلك.
ومنها: للقاضي أن يحاسب المتولين والأوصياء ويعزل الخائن منهم وإن شرط الواقف والموصي عدم مداخلته؛ لأن صيانة مال الأوقاف والأيتام هي من الحق العام فتجاوز الحدود المسموحة للأولياء والأوصياء والقوام يعود إلى تقدير الولاية العامة . .