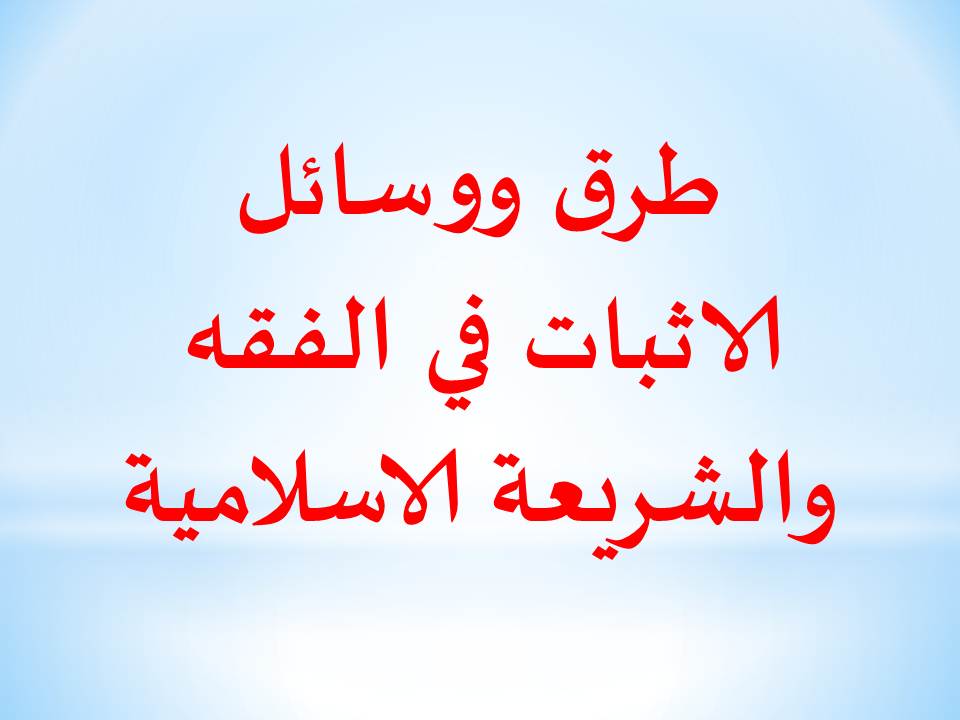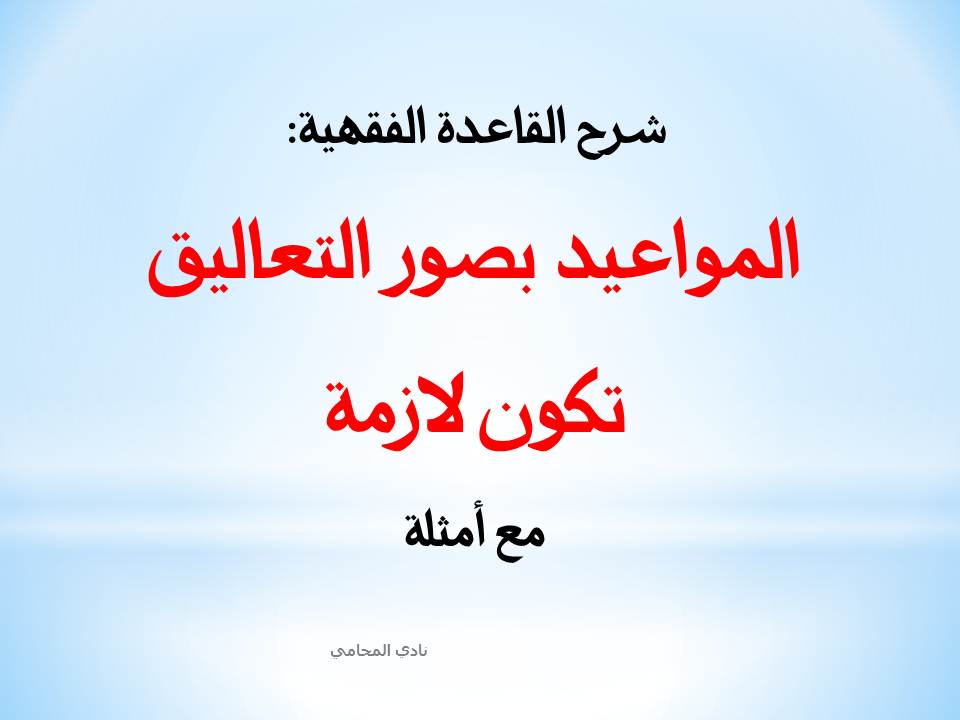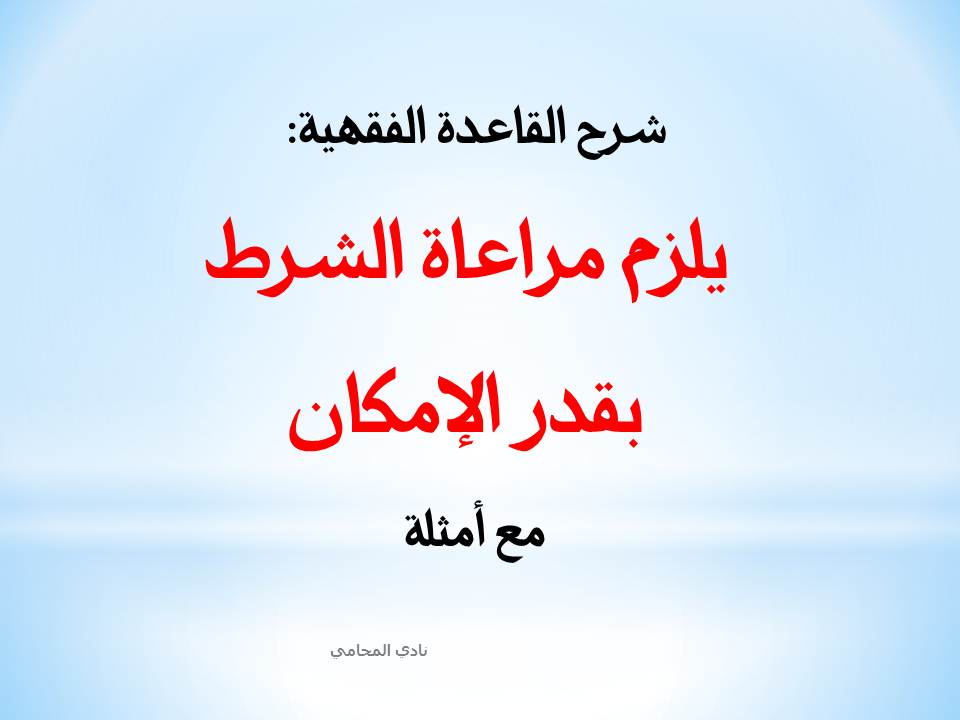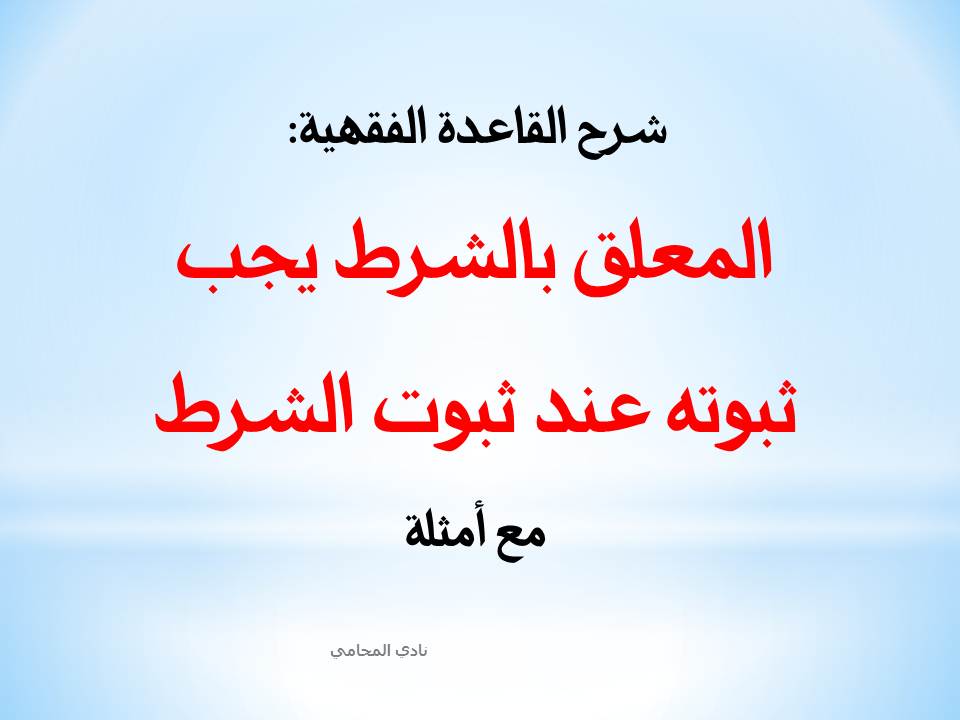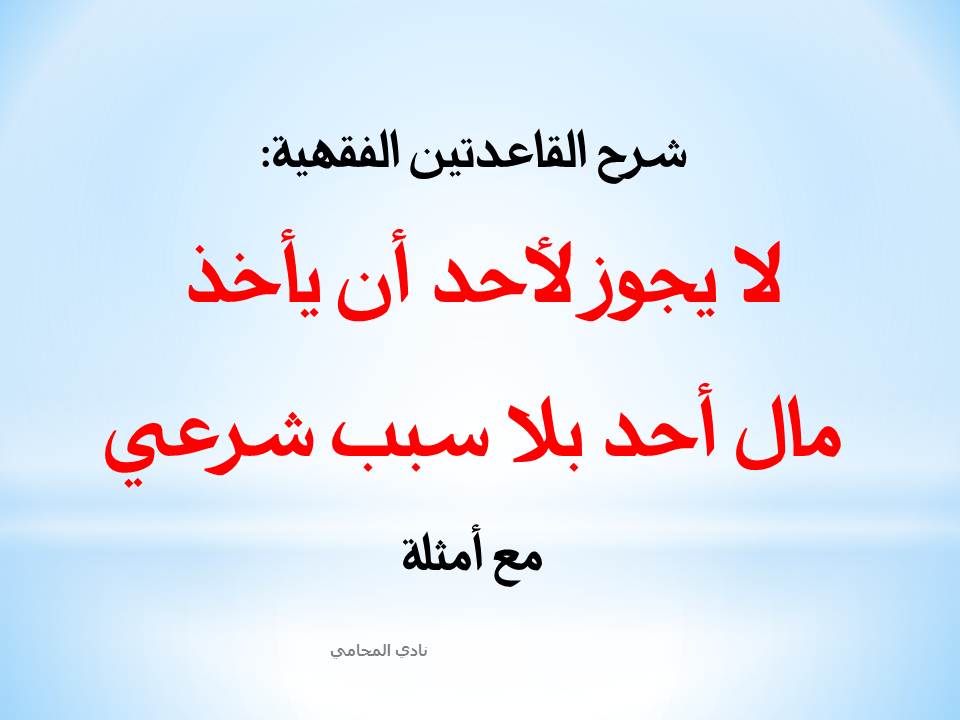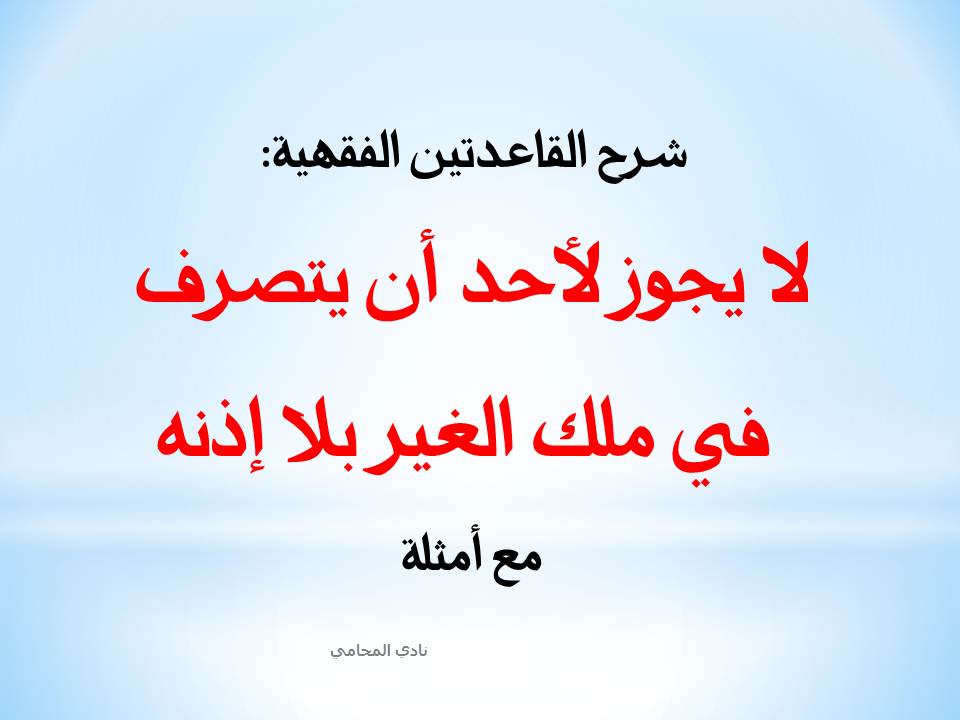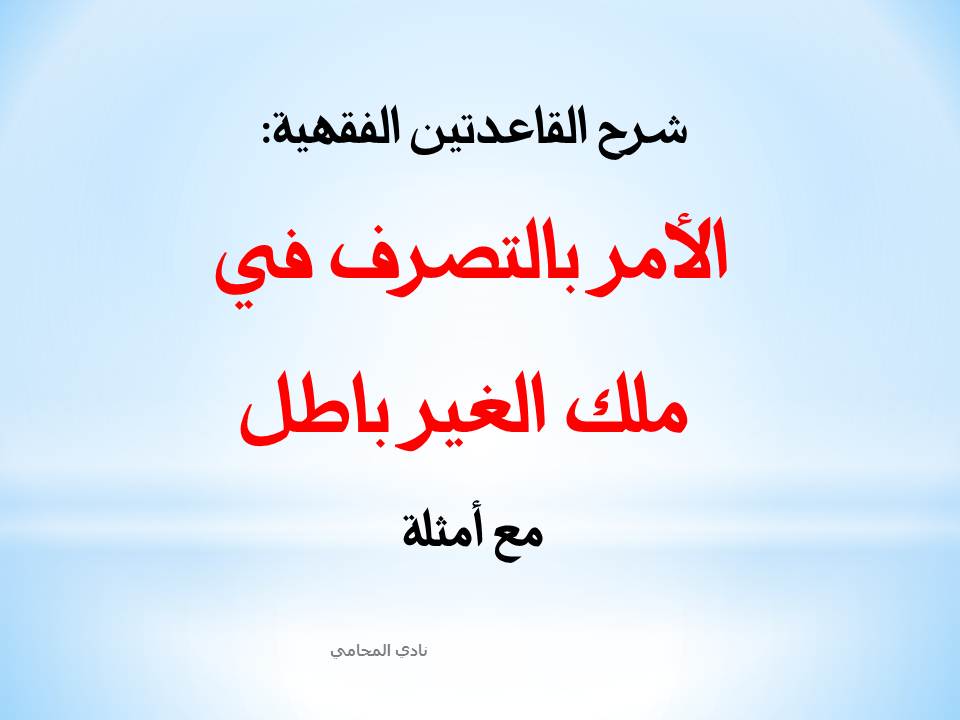وسائل الإثبات التي أقرها الفقه الإسلامي ثمانية وسائل وهي
١ – الشهادة :
وهي إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد وبصيغة المضارع؛ لأنها تتضمن المشاهدة الحقيقية في الماضي والإخبار جزماً في الحاضر،
ويشترط لها شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي: إسلامه ورشده وحريته وبصره ونطقه وعلمه بالمشهود به وعدالته وعدم إقامة الحد عليه بقذف، وعدم وجود تهمة بقرابة أو خصومة أو عداوة أو شراكة)،
ويوجد شروط مختلف بها كإكمال الشهادة بيمين المدعي عند الشافعية، وهذا ثابت بحديث موقوف عندهم رواه أبو داود والترمذي منسوخ عند الحنفية.
ونصاب الشهادة عند الحنفية أربعة من الرجال على الزنا،
أما باقي الحدود والقصاص وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء.
وتجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة . ولا تجوز الشهادة بالتسامع من غير أن يراها الشاهد أو يقف عليها إلا في النسب والموت والولادة والنكاح وولاية القاضي وأصل الوقف.
۲ ـ الإقرار :
وهو إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر، ويشترط فيه الإسلام والرشد وأهلية التملك وعدم الإكراه أو الهزل ، وأن يكون قبل الدخول في مرض الموت. وكل شيء جازت المطالبة به ويجوز الانتفاع به وتقع عليه الحيازة ويملك المقر إنشاءه جاز الإقرار به .
3– اليمين :
ولا تنعقد إلا بالقسم بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» [رواه الستة ما عدا النسائي]،
وقوله صلى الله عليه وسلم : «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وفي رواية: «فقد كفر» [أبو داود والترمذي].
وهي على أنواع مختلفة:
أ – – يمين المدعى عليه
التي يوجبها القاضي بناء على طلب المدعي وتسمى اليمين الدافعة، لأنها تدفع ادعاء المدعي، وتسمى الرافعة لأنها ترفع النزاع وتسقط الدعوى، وتسمى الحاسمة لأنها تحسم النزاع، وتسمى الواجبة لوجوبها بنص الحديث : “اليمين على من أنكر،” وتسمى الأصلية لأنها المقصودة عند الإطلاق للنص المذكور .
ب ـ اليمين الجالبة
وهي التي يؤديها المدعي في إثبات حقه لعدة أسباب، إما لكونها يمين القسامة في القتل والجراح، أو لكونها من أيمان اللعان، وتسمى اليمين المردودة عند الأئمة الثلاثة لأنها تكون عند نكول المدعى عليه عن اليمين الأصلية، ويقابلها الحكم بالنكول عند الحنفية .
ج – يمين الاستظهار،
وتسمَّى يمين الاستيثاق ويمين الاستحقاق، ويسميها المالكية يمين القضاء ويمين الاستبراء، وهي التي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والريبة في الادعاء، وذلك من حالات استثنائية وظروف خاصة كالدعوى على الميت والغائب.
4- الكتابة:
لم يفرد الفقهاء الإثبات بالكتابة بفصل مستقل وإنما وضعوه تحت ألفاظ مختلفة وهي الصك والحجة والمحضر والسجل والوثيقة وكتاب القاضي إلى القاضي وديوان القضاء … و
الكتابة من أقدم الوسائل في حفظ العلوم والحقوق كما ورد في تدوين الكتب الدينية والقوانين عند الشعوب الغابرة .
5 ـ القرينة :
وهي في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من العلم بها الظن بوجود شيء آخر،
وهذه القرينة قد تكون بمثابة دليل قوي مستقل لا يحتاج إلى دليل آخر كالخلوة في استحقاق المهر عند الحنفية،
ووطء المرأة التي زفت إلى منزل زوجها، ونسبة الولد إلى الزوج بوجود الفراش وإذن البكر في زواجها بصمتها، و
براءة الرحم وخلوه من الحمل بوجود دم الحيض. وقد تكون بمثابة الدليل المرجح لما معها ومقوية له، كأن يتنازع الزوجان في متاع البيت الزوجي بأن يدعي كل منهما ملكيته ولم يستطع إحضار البينة، فما كان للرجال يُعطى للزوج وما كان يصلح للنساء يُعطى للزوجة، حيث إن العادة صلاحية كل نوع لصاحبه ولا عبرة لليد الحسية وهذا ما يعرف بالقرائن الحسية.
٦ – علم القاضي :
وهو العلم بحقيقة الواقعة وتفاصيل القضية، وقد اتفق الفقهاء على العمل بعلم القاضي في ثلاث حالات :
أ ـ ألا يقضي بخلاف علمه ولو مع البينة، فإذا علم بطلاق بائن مثلاً ولم تقم البينة على ذلك فلا يجوز له القضاء بنفقة زوجية قطعاً لأنه متيقن بطلان حكمه والحكم بالباطل حرام فيجب عليه أن يعتزل النظر بالدعوى أو يفوض غيره فيها ويكون شاهداً .
ب ـ إذا علم القاضي حالة الشهود عدالة أو فساداً، فيقبل العدل ويسمع شهادته ولا يطلب تزكيته ولا يقبل شهادة الفاسق ولا يسمع تعديله .
ج – فيما يحدث في مجلس المحاكمة فيستند القاضي في حكمه على ما ولا يحتاج إلى بينة، كأن يستمع القاضي الطلاق البائن من الزوج ثم سمع يدعي الزوجية فيمنعه القاضي من الاتصال بزوجته كما يمنعها من المطالبة بالنفقة.
7– معاينة القاضي :
وهي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة نائبه محل النزاع لمعرفة حقيقة الأمر فيه، فهي دليل مباشر ويكون علمه الذي حصل من المعاينة كالعلم من البينة ومن الحلف والإقرار وهذا ليس قضاء بعلم القاضي، وذلك كما إذا رأى البنت التي لم تبلغ أن جسمها يتحمل الزواج فيأذن بتزويجها .
8– تقرير أهل الخبرة :
وهو الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي الموجه إلى أهل الاختصاص، ولا يشترط في أهل الخبرة عدد ولا ذكورة ولا عدالة .
إن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي تمتزج بالعقيدة ومبادئ السلوك، وهي نسيج بذاته لا أن تخلط بغيرها رجاء الحصول على مقاصدها، وأن يصح الاقتباس من بعض أحكامها كالأخذ بالشهادة دون البحث في شروطها الشرعية يطمس محاسنها ويضيع ثمراتها . [وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي (بتصرف)].