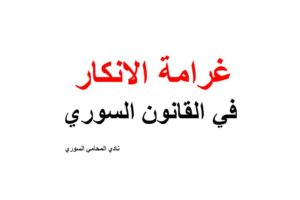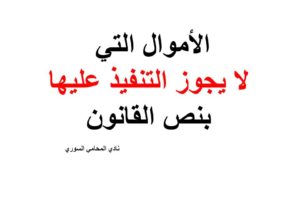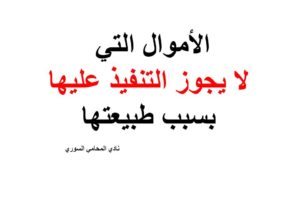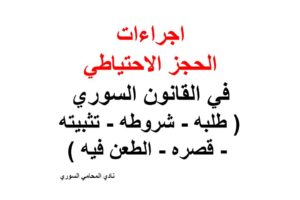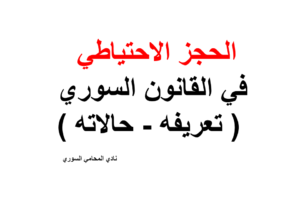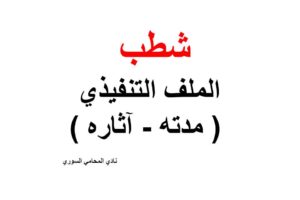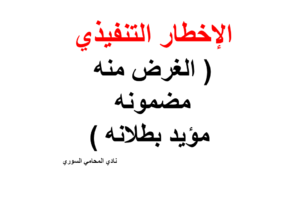إجراءات الحجز الاحتياطي
لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بناءً على طلب مقدم من طالب الحجز إلى مرجع قضائي في إجراءات معينة.
وعلى طالب الحجز أن يقدم كفالة نص عليها القانون، ومن حق المحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي .
كما أن لطالب الحجز أن يطعن بقرار رد طلبه في إلقاء الحجز.
وتعتبر الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات واجبة التطبيق فيما يتعلق بطلب الحجز ومعاملات و وشروطه ما لم يوجد نص آخر في قانون خاص.
1 – طلب الحجز وشروطه
أولاً – طلب الحجز الاحتياطي:
يقدم طلب الحجز الاحتياطي بإحدى طريقتين نصت عليهما المالدتان 315 و 316 من قانون الأصول، إما بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو من قبل المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع.
آ- بقرار من قاضي الأمور المستعجلة:
يوقع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة بناءً على استدعاء تتوافر فيه شروط الدعوى ( المادة 315 أصول )،
وتقتصر مهمة القاضي في ذلك على التدقيق في موضوع الحجز من حيث مصلحة المدعي و خصومة المدعى عليه و التحقق من وجود حالة من الحالات التي نص عليها القانون لإلقاء الحجز وتقديم الكفالة .
ب- بقرار من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع:
وهنا يقدم طلب الحجز الاحتياطي بصورة تبعية، حيث يجوز إلقاؤه بقرار من المحكمة المختصة أصلاً للنظر في أصل النزاع بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.
وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بِأصل الحق، ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة فعندها يقدم طلب الحجز باستدعاء مستقل إلى هذه المحكمة (المادة 316 أصول ).
أما بالنسبة لللاختصاص المكاني، فإن إلقاء الحجز يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراءات في دائرتها .
أي التي يوجد في منطقتها المال المراد حجزه ( المادة 91 أصول ).
فإذا كان موجوداً في منطقة عدة محاكم كانت كل محكمة مختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي ( المادة 82 أصول ).
وينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق، في طلب الحجز الاحتياطي ويصدر الحكم بشأنه بتوقيع الحجز أو رد طلب الحجز في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم.
وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء أكان يتعلق بمال منقول أم عقار ( المادة 318 أصول ).
ثأنياً – شروط الحجز الاحتياطي:
إذا قدم طلب الحجز الاحتياطي إلى قاضي الأمور المستعجلة فإن الطلب يسجل في ديوان المحكمة في سجل خاص بالدعاوى المستعجلة.
كما تنفيذ الحكم وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ بعد ورودهما إلى ملف دعوى الحجز ويحفظ.
ويحق للحاجز بعد ذلك أن يطلب من المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بِأصل الحق،
كما يحق له أن يبرز صورة مصدقة عن الحجز وضبط الحجز في ملف هذه الدعوى
ويحق لأصاحاب العلاقة الحصول على صورة مصدقة عن الإوراق والوثائق المحفوظة في ملف الدعوى المستعجلة التي ألقي الحجز بموجبها.
وبعد أن يحصل طالب الحجز على قرار به من قاضي الأمور المستعجلة يتوجب عليه أن يقدم الدعوى بِأصل الحق، أمام المحكمة المختصة، خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي، تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن، الإ إذا كان طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قاب للتنفيذ ( م 2/317 أصول ).
وفي جميع الإحوال، على طالب الحجز أن أن يودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعاد 3 % من المبلغ المحجوز من أجله، أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه، إذ تبين أن الحاجز كان غير محل في حجزه، من كل عطل وضرر يتمثل في الخسارة التي قد تنشأ عن حرمان المحجوز عليه من الإنتفاع بالأشياء المحجوزة طيلة مدة الحجز،
كما ويدخل في العطل والضرر نفقات حفظ الأشياء ومصاريف المحكمة ونقصان قيمة الأشياء المحجوزة أو تعيبها (م 1/317 أصول المعدلة بالقانون رقم 1 لعام 2010 ) .
ويعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ أو كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً ( مادة 3/317 أصول ).
2- تثبيت الحجز الاحتياطي وحصر نطاقه ( قصر الحجز )
أولاً – تثبيت الحجز
إذا تبين للمحكمة المختصة بِأصل الحق أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز، يتوجب عليها عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز، أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المحكوم عليه وبتثبيته وذلك تمهيداً لتنفيذه ( المادة 320 ) .
ثانياً- حصر نطاقق الحجز ( قصر الحجز ):
يجوز للمحكمة أن تحصر نطاقق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة،
وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تنص عليها المادة 235 من القانون المدني، التي تقضي بأن جميع أموال المدين تعتبر ضمانة للوفاء.
وبناءً على ذلك ، فإن للمحجوز عليه الحق بطلب حصر نطاق الحجز من المحكمة على ما يكفيي من الأموال للوفاء طيلة مدة الدعوى .
وللمحكمة أن تقصر نطاق الحجز قبل الفصل بالموضوع طالما أن الفصل بطلب القصر خاضع لتقدير المحكمة التي تمارس حقها بالسلطة عليه قبل الفصل فيه بالدعوى).
ولا يجوز قصر نطاق الحجز الإ بقضاء الخصومة، لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة، ولا يطب على رفع الحجز أو تبديله .
واذا استؤنف قرار قصر الحجز فإن استئنافه يوقف تنفيذه ( استئناف دمش رقم 180/180 تاريخ 1970/12/24 ) .
3- الطعن بالحجز الاحتياطي:
نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:
“1 – للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3 – إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن “.
وبموجب هذا النص فإن هناك ثلاث حالات يمكن الطعن بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع طلب الحجز الاحتياطي:
الحالة الأولى : الطعن في الحكم الصادر برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي:
إذا صدر الحكم برد طلب الحجز الاحتياطي عن قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن فيه يكون أمام محكمة الاستئناف. واذا كان صادراً عن محكمة الإساس يكون الطعن فيه من اختصاص المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن الوارد بِأصل الحق،
وفي هذه الحالة يخضع الطعن للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بِأصل الحق.
وعليه تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف، ومحكمة النقض المختصة للنظر بالطعن بالنسبة للأحكام الاستئنافية.
الحالة الثانية: الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي:
للمحجوز عليه أن يعترض على الحكم المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الإساس بدعوى مستقلة أصلية، يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الإساس التي أصدرته خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة الحكم المذكور، سواء أنفذ هذا الحكم أم لم ينفذ، ويمكن تبليغ المحجوز عليه الحكم أثناء تنفيذ الحكم.
ونرى، أنه يجوز تقديم الإعتراض أمام محكمة الإساس حتى ولو كان قرار الحجز صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الدعوى بِأصل الحق قد أقيمت قبل تقديم الإعتراض نظرًا لصلاحية محكمة الإساس للبت في الدعاوى المستعجلة.
ويخضع الطعن لأصول استثنائية، فإذا تبين للمحكمة، سواء قاضي الأمور المستعجلة أم محكمة الإساس، بنتيجة هذه الدعوى المستقلة، أن الحاجز كان غير محق في طلب الحجز أو عدم توفر إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي قانوناً، أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه، قضت المحكمة برفع الحجز، واذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة قضت برد الطعن . ونشير إلى أنه لا يجوز توحيد دعوى الإعتراض على الحجز مع دعوى أصل الحق، وترى الدعوى بشكل مستق .
الحالة الثالثة: الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي:
إذا صدر قرار برفع الحجز الإحيتاطي عن قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن فيه يكون أمام محكمة الاستئناف.
أما إذا صدر الحكم برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال من قبل محكمة الإساس بنتيجة الدعوى المستقلة، فإن الطعن يكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر بالطعن في أصل الحق، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام التي تكون قابلة للاستئناف ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً (م 322 أصول ).