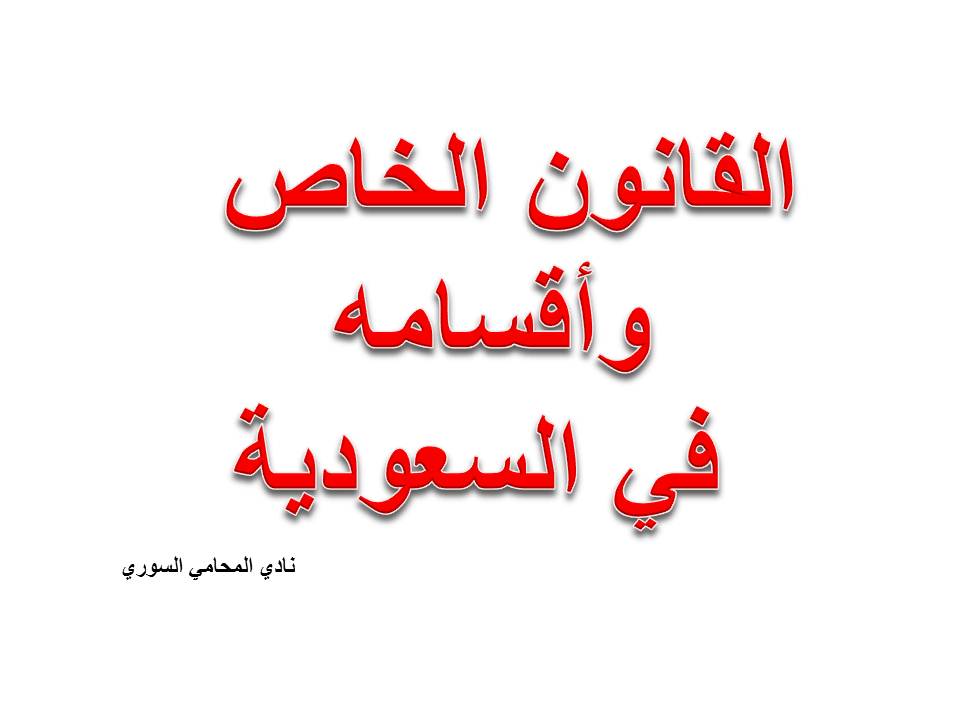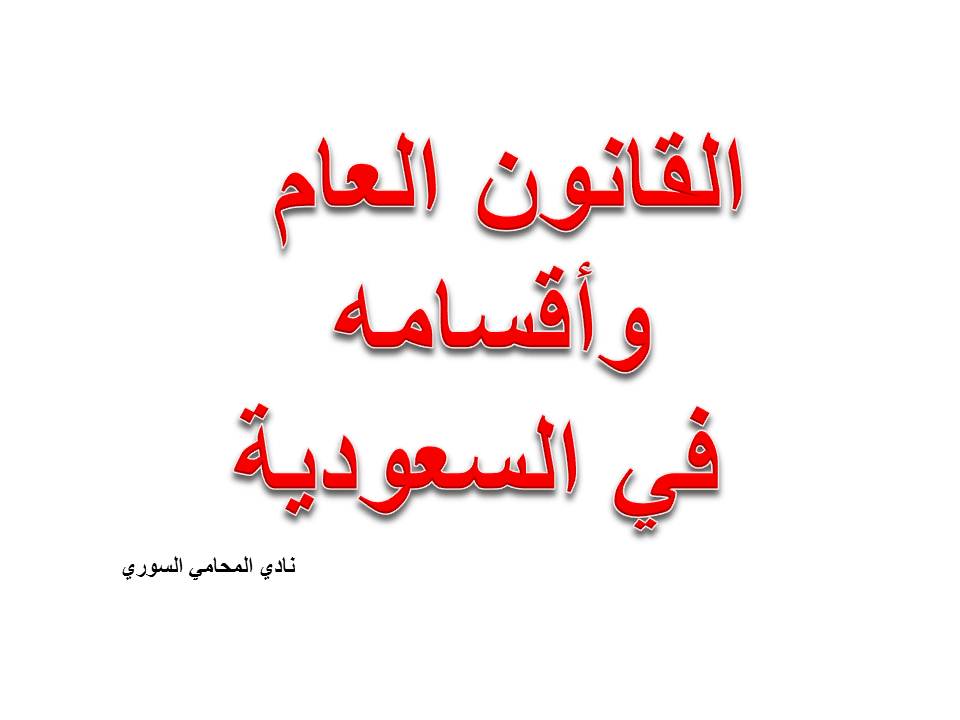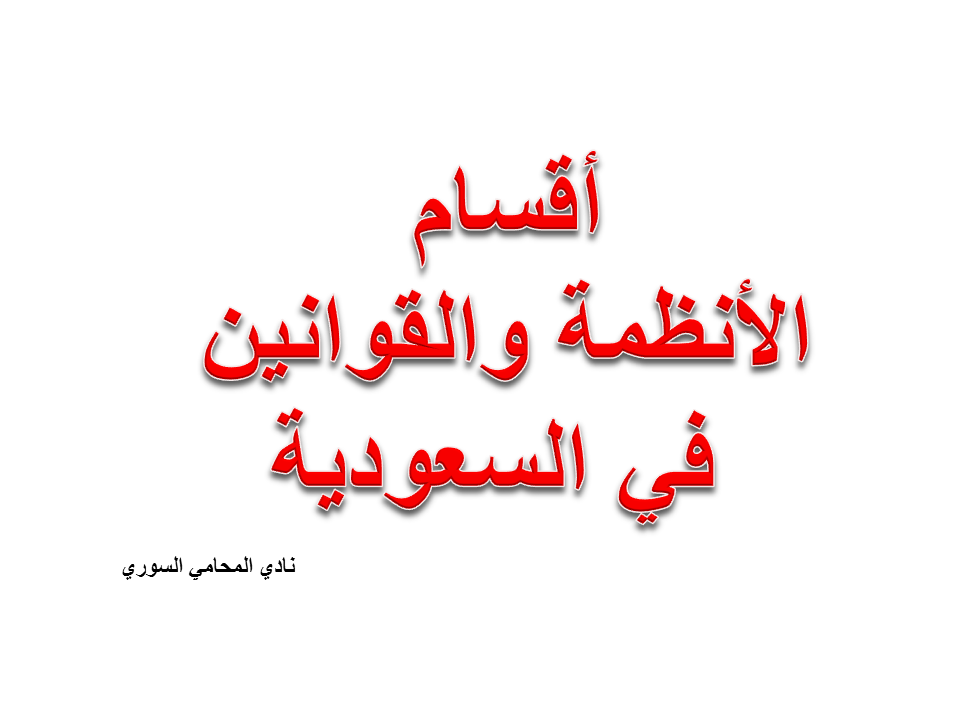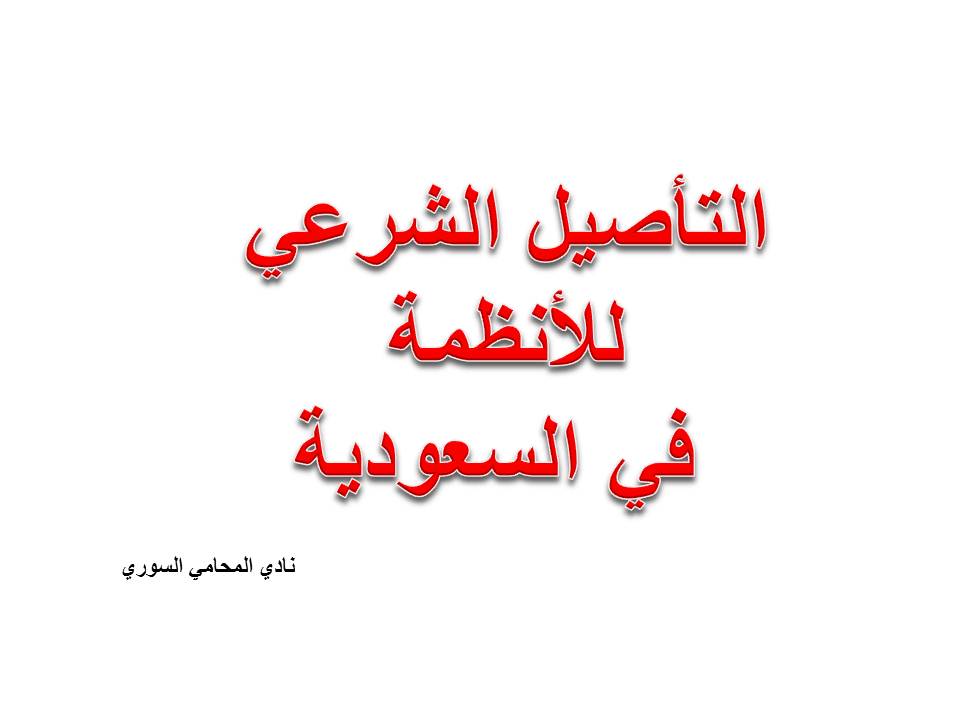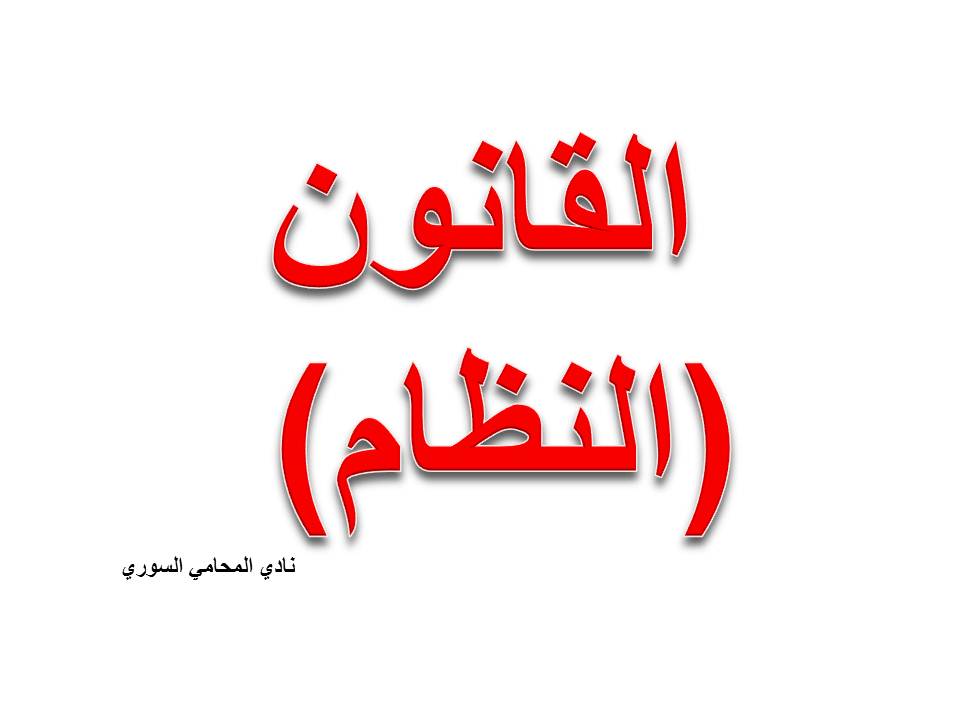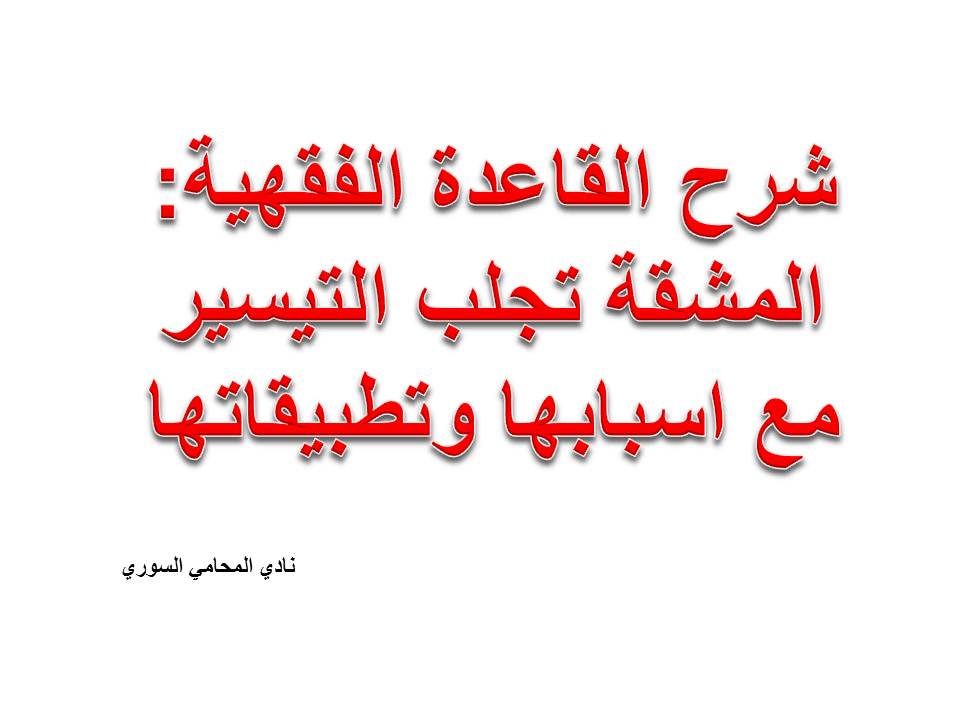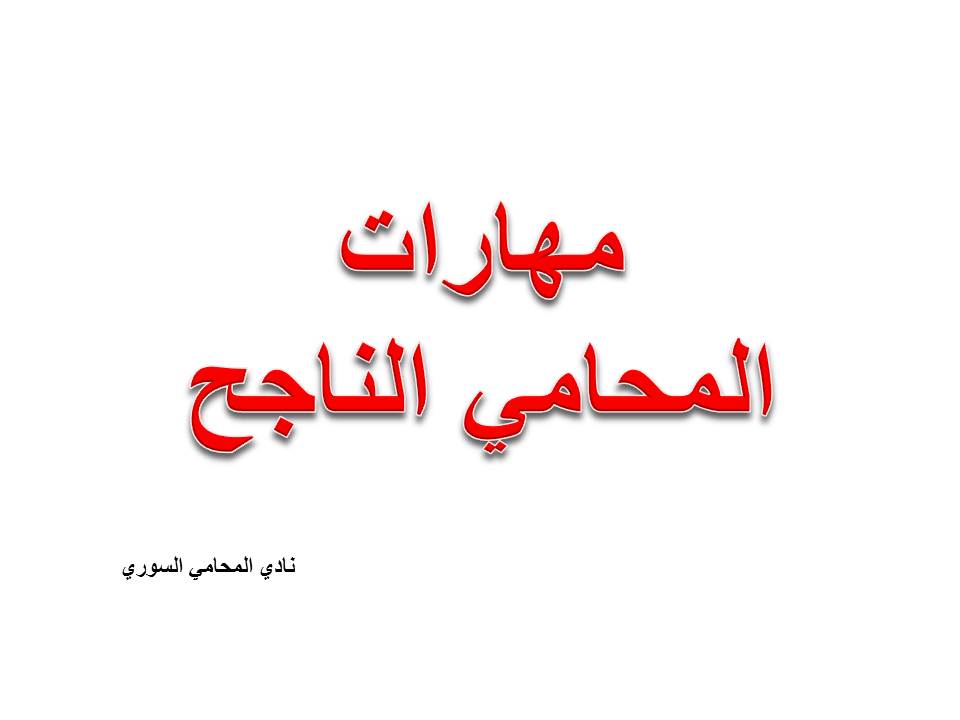مُقَدِمة:
هذه المذكرة ماهي إلا مقدمة متواضعة لمهارات المحامي الناجح ، أذكر فيها بعض النقاط التي ترسم الخطوات الأولى لرحلة المحامي الناجح جسدتها من واقع خبرة وتطبيق ، داعية الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد.
لابد أولاً من معرفة ماهي مهام المحامي ؟
1 – الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية بداية من مرحلة التحقيق وحتى المحاكم.
٢ – تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات.
3- دراسة القضايا
٤- صياغة وكتابة الصحائف واللوائح والمذكرات والعقود. ه- دراسة الأنظمة ومراجعتها وصياغتها.
المهارات اللازمة لتصبح محامي ناجح:
1- مهارة تقديم الاستشارة القانونية
والاستشارة القانونية تنقسم قسمين :
استشارة شفهية
استشارة مكتوبة وتستغرق وقت وجهد وتكون أغلى سعرا.
– ولتقديم استشارة قانونية مناسبة للعميل لابد أن تتمتع بمهارة الانصات أولا ، لتستمع لوقائع الأحداث وتحللها بعقلك وتبدأ بعدها بطرح الأسئلة المناسبة والمتصلة بالوقائع على العميل مثل ( منذ متى لا ينفق عليك زوجك، متى تركت المنزل، ما تاريخ توقف المنشأة عن إعطائك رواتبك) لتحصل على كافة المعلومات اللازمة التي قد يغفل عنها العميل أو لا يعلم مدى أهميتها).
– ولابد من التنويه على العميل على أهمية ذكر الحقائق كما هي دون إغفال أو إخفاء ليحصل على استشارة مفيدة لأنه سيكون المتضرر الأكبر إذا أخفى حقيقة ما.
ا – مهارة تقديم الاستشارة القانونية
الاستشارة لا بد أن تتضمن عدة أمور مهمة مثل:
– توضيح موقف العميل القانوني ( ماله وما عليه)
– تصنيف قضيته اذا وجدت وبأي محكمة
– أهمية وجود اثباتات على الوقائع وماهي طرق الاثبات .
– الحلول وجميع الاحتمالات التي قد تواجهه.
– مخاطر أو اثار عدم تنفيذ التزاماته أو تنازله عن حقوقه.
قيمة الاستشارة:
تحدد قيمة الاستشارة حسب أسعار السوق أولا وحسب خبرة المحامي وتقديره وأيضا قد تحدد حسب نوع القضية وتكون مبلغ ثابت يطلب من العميل عند طلبه موعد للاستشارة وابلاغه بالقيمة.
٢ – مهارة دراسة القضية :
وهي تأتي بعد الاستشارة وقبل الترافع إذا كانت كامل القضية بيد المحامي، وتأخذ الدراسة من المحامي وقت أطول من الاستشارة المكتوبة لأنها دراسة كاملة متكاملة لجميع جوانب القضية من حيث الوقائع والمستندات وهي تختلف عن المذكرة حيث أن الدراسة تعطى للعميل ليعرف موقفه القانوني ويعلم ماهي الحلول التي تفيد موقفه القانوني، أما المذكرة فهي تقدم للقاضي وتحتوي على وقائع ودفوع وطلبات.
لدراسة القضية لابد من المرور بعدة مراحل:
1- الانصات للعميل لأخذ كافة ملابسات الوقائع ولمعرفة ماحدث من الطرف الآخر ويتم ذكر الوقائع في الدراسة كما هي ولكن بأسلوب قانوني ولغة عربية صحيحة.
٢- الخطوة التالية وهي كتابة تمهيد لموضوع الدراسة وتوضيح بعض الألفاظ المستخدمة ومعانيها فمثلا لو كانت الدراسة عن قضية يوجد بها خطأ طبي فلا بد في التمهيد تعريف الأخطاء الطبية وتوضيح ماهي وهكذا.
لابد من استخدام منهجية البحث في الدراسة كالمنهج التحليلي.
٤- الخطوة التالية والأهم هي كتابة الرأي القانوني بشكل مفصل (رأيك كمحامي في القضية ) بتوضيح الحقوق والواجبات والخطوات التي يجب على العميل اتباعها كنوع القضية وأين يجب أن ترفع بأي منطقة وأي محكمة.
ه – كتابة الأسانيد الداعمة للرأي القانوني من القرآن والسنة والقوانين وآراء الفقهاء.
٦- الأحكام السابقة: دعم القضية بحكم سابق لقضية مماثلة .(موجودة الأحكام بمجلد الأحكام القضائية).
٧- الدراسة لا يحبذ بها التطويل الممل ولا الاختصار المخل وأفضل أسلوب هو ( ما قل ودل).
أهمية الدراسة :
تعتبر الدراسة القانونية كخارطة الطريق للعميل والمحامي توضح معالم القضية وتوضح الحلول المقترحة وتسهل على المحامي كتابة المذكرات والردود فيما بعد ومع الممارسة في كتابة الدراسات يصبح المحامي ملم بالعديد من المهارات كالكتابة واستنباط الأسانيد . فهي مهمة على الصعيد العام بالنسبة للمحامي وعلى الصعيد الخاص بالنسبة للقضية والعميل .
أهمية الصياغة بالنسبة للدراسات والمذكرات:
الصياغة هي أداة التعبير عن فكرة لتصبح حقيقة يتم التعامل معها. الصياغة التشريعية: هي كل ما يصدر من قواعد قانونية مكتوبة عن سلطة مختصة في الدولة.
الصياغة القانونية :
هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والتدريب والقراءة.
أهمية الصياغة القانونية:
فهم إرادة الكاتب سواء المشرع أو المحامي وتفسيرها.
معرفة المتطلبات من الموضوع كالوقائع والأحداث .
علاج للقضية بالدفوع والإسنادات.
صياغة الحلول بشكل واضح للاستفادة منها.
عناصر الصياغة القانونية:
– لابد من الإحاطة بكامل المعلومات
– احترام قواعد الكتابة الصحيح باللغة العربية
– استعمال علامات الترقيم على الوجه الصحيح والابتعاد عن الاستعارات والسجع وأسلوب الاستعطاف.
(ملاحظة) اللجوء لأسلوب الاستعطاف يضعف موقف عميلك في القضية وقد يظن القاضي أنه لاحجة لك وتحاول أخذ حق لمـوكـلـك لـيـس مـن حـقـه.
– احترام القوانين والعدالة وصياغتها بشكلها الصحيح مع ذكر القانون المستعان به وأي مادة وأي فصل .
– استخدام المصطلحات القانونية الواضحة والابتعاد عن المصطلحات الأعجمية أو التي تحتوي على أكثر من معنى.
– عدم الإطناب والحشو في الكلام. – مراعاة عند طباعة الدراسة نوع الخط ووضوحه والألوان والـمـسـافـات المستخدمة والهوامش.
٣- مهارة الترافع أمام الجهات القضائية:
الترافع عن النفس حق شرعي لكل نفس إلا إذا وجد مانع شرعي أو رغب الشخص في توكيل غيره للترافع بدلا عنه لفصاحة المحامي مثلا ولمعرفته بالقانون نظرا لأن هذا هو عمله ولذلك قال موسى عليه السلام ({وَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذبون} (٣٤) سورة القصص )
وقد تم وصف المرافعه من أكثر من محامي خبير :
“أن المرافعة تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر في الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة”
“المرافعة هي شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة”
من أقوال الفقيه الروماني كانثليلتس :
– “يجب أن تكون المرافعة صحيحة، واضحة، وممتعة”
“المرافعة الجيدة هي أحد الأسباب المهمة لنجاح القضية لذا لابد أن ييتحضر لها المحامي ويجتهد لأن دور المحامي هو بذل جهد من وقت وعلم”
دور المحامي قبل المرافعة :
ا – دراسة المستندات .
٢ – مناقشة الموكل .
3- إعداد المرافعة .
٤ – نصائح قبل إعداد المرافعة .
ه – تدوين بعض النقاط
٦ – خطة الدفاع
دراسة المستندات :
١- قراءة المستندات .
٢ – استخلاص الحجج .
٣- كتابة المستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .
إعداد المرافعة :
1- الإلمام بموضوع الدعوى والتحضير له .
٢ – النقطة الضعيفة التي يدخل من ثغرتها الخصم.
3- إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة وتقديم الأدلة والاثباتات.
مواصفات المرافعة الجيدة :
1 – الوضوح
٢ – الإعداد الجيد ( التنظيم – الترابط – الإيجاز )
خاتمة المرافعة :
1 – تلخيص سريع – للنقاط الهامة في الدعوى.
٢ – إبراز الأدلة الحاسمة .
٣ – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .
٤ – الطلبــات.
نصائح أثناء المرافعة
1 – السهولة.
٢- الدقة.
٣- الثقة.
٤ – الإقناع .
ه – المظهر.
6- اللغة القانونية
المهارات العامة لمهنة المحاماة:
١- العلاقة الطيبة بين زملاء المهنة:
لا بد أن يحرص المحامي على إنشاء علاقات حسنة مع زملاء مهنته ولا يراهم منافسين أو أعداء بأي حال من الأحوال، ولا ينسى دوما بأن محامي الخصم زميل مهنة وليس خصم، فيحرص على حضور مجتمعاتهم ومنتدياتهم ودوراتهم ويتعلم منهم وقد يتعاون معهم مستقبلا ويتعاونوا معه فالمهنة تحتاج تعاون وتعاضد لا تحارب وتعادي.
٢ – إدارة المكتب:
أول نصيحة أقدمها للمحامين والمحاميات هي عدم الاستعجال في فتح مكتب بعد الرخصة إذ لابد أن يحرص المحامي على اكتساب خبرة واسعة في المحاماة ليستطيع إدارة مكتبه وقضاياه ولا بد أن يحرص على تكوين قاعدة عملاء إذ من الصعب فتح مكتب في وقت لم ينتشر فيه اسمك بعد ولا تملك عميل . إن من أهم أمور إدارة المكتب هي إدارة أموره المكتبيه كتنظيم جدول مواعيد الاستشارات وجدول الجلسات
فإذا كنت في أول مشوارك المهني ولا تملك سكرتارية فلا بد أن تتحمل وحدك مهامك الإدارية والتنظيمية من تدوين المواعيد وتحضير الملفات قبل الجلسة والإطلاع على البريد الإلكتروني والرد عليه وإرسال إشعارات العملاء بمستجدات القضية.
لابد من عمل آرشيف في المكتب لملفات القضايا وترتيب ملف القضية بشكل واضح كأن يحتوي على ( هوية العميل بياناته الأسـاسـيـة والـوكـالـة وورقة موعد القضية والمستندات المتعلقة بالقضية وبيانات الخصم).
ولا بد أن تكون الملفات مرتبة بالأرقام والتواريخ والارشيف لابد أن يكون ورقي والكتروني لابد أن يمتلك المحامي خزانة داخلية ليحفظ بها أصول الأوراق الهامة كالكمبيالات والعقود
ولابد أن يمتلك المحامي أجندة مواعيد سواء كانت ورقية أو رقمية وهناك العديد من البرامج بالهاتف التي تنظم المواعيد كالتذكيرات أو (سكاجول مانجر) أو ( ديسكتوب ريمايندر)
الحرص على نظافة المكتب وعدم المبالغة في ضيافة العملاء فالوسطية مهمة
3- مظهر المحامي والمحامية:
بالنسبة للمحامي/ لابد ان يحرص على نظافة ملبسه وطيب الرائحة ويبتعد عن الروائح الكريهة ( كالتدخين) ويبتعد عن المبالغة في المظهر والمبالغة في التطيب ويبتعد عن المفاخرة أمام العميل بما يملك من أمور ثمينة، (كخواتم الألماس) ، والعكس أيضا صحيح لابد الترتيب بالمظهر والابتعاد عن الملابس الرديئة أو الغير متناسقة والأفضل الالتزام باللبس الرسمي (الثوب والشماغ)
بالنسبة للمحاميات الالتزام بالحجاب الساتر والابتعاد عن الزينة والمكياج المبالغ فيه وتركيب الأظافر والرموش والزينة المبالغ فيها من المجوهرات ويتسم مظهرها بالرسمية.
٤- القراءة:
مهمة جدا للمحامي فعي عامود المعرفة ومن المهم جدا قراءة أمهات الكتب في القانون كتب السنهوري وكمجلدات الأحكام وفتاوى ابن تيمية وابن عثيمين ويقرأ القوانين الموجود بموقع هيئة الخبراء والتعاميم التي تصدرها وزارة العدل ليبقى على اطلاع بالمستجدات
ه- مواكبة التطور:
ومايخص وسائل التواصل مع المجتمع حتى يعلم المجتمع نوع الخدمات التي يقدمها مكتبك مثل( إنشاء حساب بجميع مواقع التواصل باسم المكتب كحساب للمكتب بـتـويتر وانستجرام ولينكيد إن ليتعرف المجتمع على منشأتك وعملك واحرص أن تكون حساباتك مهنية تحتوي على فائدة قانونية بعيد عن الفن والشعر والسياسة حتى لا يختلط على الجمهور من أنت وما تخصصك بالضبط .
6- ابتعد عن العلاقات الشخصية:
مع العملاء أثناء سير القضية حتى لا تتشتت وتؤثر عاطفتك على عملك أما بعد انتهاء القضية فلا مانع من الحفاظ على العلاقة الطيبة والمودة.
حسابات قانونية مفيدة بتويتر :
1- @ Mashat عبد الرحمن مشاط
2 – @ Hekmah1 طارق حمود آل إبراهيم
3- @hassanlawyer حسان السيف
4- @fisalam فيصل المشوح
5- @LAWKARIM1 عبد الكريم الشمري
6 – @_smaghrabi سامي مغربي
7- @K_Suraihi خالد السريحي
8 – kholoudlawyer خلود ناصر الغامدي
9 – Mlatafm محمد المشيقيح .
10 – @Afnanaldkheel أفنان الدخيل
بعض الكتب القانونية المفيدة من اختيارنا :
الوسيط في شرح القانون المدني – عبد الرازق السنهوري منصور اليهوتي
موسوعة كشاف القناع – منصور البهوتي – اضغط هنا
الروض المربع – منصور البهوتي
الوجيز في العقود الإدارية – د/ عمر الخولي – لشراء الكتاب من مكتبة جرير اضغط هنا
الفقه على المذاهب الأربعة – عبد الحمن الجزيري – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا
منهاج العارفين في تدريب المحامين – د/ سامي مغربي – لشراء الكتاب من مكتبة جرير اضغط هنا
قضايا الطلاق والحضانة والنفقة – علي بن يحي بابكر – لشراء الكتاب من مكتبة جرير اضغط هنا
مهارات التأهيل المني في مهنة المحاماة – بيان زهران – لشراء الكتاب من مكتبة جرير اضغط هنا
القانون التجاري – د/ عبد الهادي الغامدي – لشراء الكتاب من مكتبة جرير اضغط هنا
أساسيات القانون التجاري الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية الواقية – د/ عبد الرحمن قرمان – لشراء الكتاب اضغط هنا
الوسيط في نظام التنفيذ السعودي – د/ محمود عمر محمود – لشراء الكتاب من مكتبة جرير اضغط هنا
التشريع الجنائي الإسلامي – عبد القادر عودة – لتحميل أجزاء الكتاب الثلاثة بصيغة pdf يرجى الضغط هنا
أنظمة العدالة الجنائية لدى الشرطة والنيابة العامة – د/ محمد عبد الغفور العماوي – لشراء الكتاب اضغط هنا
جريمة الابتزاز – عبد الرحمن عبد الله السند –
مبادئ الضبط الجنائي – د/ ناصر البقمي – لشراء الكتاب اضغط هنا
المغني – ابن قدامة – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا
الشرح الممتع – ابن عثيمين – لتحميل الكتاب اضغط هنا
الملكية الصناعية – سميحة القليوبي – لشراء الكتاب اضغط هنا
تم بحمد الله وتوفيقه
المحامية خلود الغامدي 1442هـ