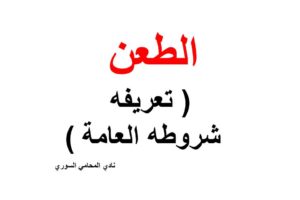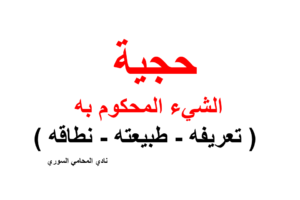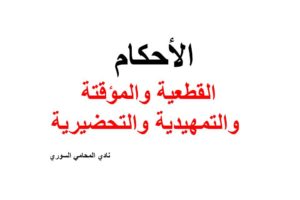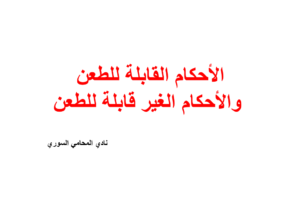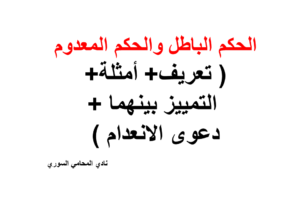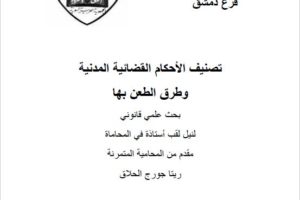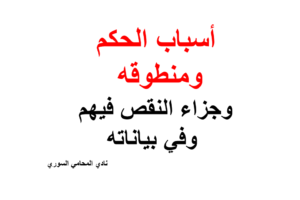أولاً: تعريف الطعن وتصنيف طرقه:
الطعن في الأحكام هي وسيلة حددها القانون على سبيل الحصر، بمقتضاه يتظلم الخصوم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما تضمنته من قضاء،
وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر طرق الطعن بالأحكام وهي : الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة واعتراض الغير والاعتراض على الحجز الاحتياطي، وهي طرق حصرية تتعلق بالنظام العام،
والمشرع السوري في قانون أصول المحاكمات لم ينص على دعوى الإبطال بالنسبة للأحكام القضائية، ومعنى ذلك أنه متى استنفذت طرق الطعن بالأحكام فإنها عندئذ تنبرم وتصير عنوان الحقيقة، وإن الإبرام يغطي البطلان، كما يغطي ما قد يشوب الحكم من عيوب لا تصل إلى درجة الأنعدام، وإن قوة القضية المقضية تعلو على اعتبارات النظام العام، فلا يقبل إذن الطعن
في الأحكام بدعوى مبتدئة بالبطلان ولا بدفع بالبطلان يقدم في دعوى قائمة، مثلما يطعن في العقود، وإنما يجب الوصول إلى بطلانها باتباع طرق الطعن المقررة في القانون، على أنه لا يعد القرار الصادر برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة مانعة من إقامة دعوى جديدة.
ثانياً : الشروط العامة للطعن
أ- شرط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة :
يشترط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن يمثله، فلا يقبل الطعن بأي طريق من طرقه ممن أخرجته المحكمة من الخصومة، أو ضده قبل صدور الحكم فيها لانتفاء صلته بالنزاع، فلم يعد طرفا فيها بشخصه أو بمن يمثله، وحسبه أن ينكر حجية هذا الحكم بوصفه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها، خلا الطعن بطريق اعتراض الغير.
والقاعدة – كما مر – أن المتدخل تدخلاً انضمامياً أو اختصامياً، والمختصم بناء على طلب أحد الخصوم، أو بأمر من المحكمة يعد خصمة أصلية وطرفاً في الخصومة التي تدخل أو اختصم فيها، متى قبلت المحكمة تدخله أو إدخاله.
أما إذا رفضت طلب التدخل – أيا كان نوعه – أو رفضت إدخال أو اختصام الغير، كما إذا أبدى طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، فإن المتدخل أو المختصم لا يعد طرفاً في الخصومة التي يصدر فيها الحكم ولا يملك الطعن فيه بالصفة المتقدمة، وإن كان كل منهما يملك الطعن في الحكم الصادر برفض تدخله أو بعدم قبوله، فالحكم الصادر برفض طلب التدخل في الدعوي قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي .
كما أن الخصم الذي تبلغ حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه مع باقي المحكوم عليهم، ليس له أن يطعن في الحكم الصادر في الاستئناف ولو كان الآخرون قد اختصموه فيه.
ب. شرط الصفة في الطعن
من الشروط الواجب توافرها في الطاعن، أن يرفع طعنه بالصفة نفسها التي اتصف بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم، فلا يكفي أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، والا أضحى خصماً أخر فلا يقبل طعنه،
فإذا كان الاستئناف – مثلا – قد تم بصفة مخالفة للصفة التي تم فيها الادعاء وصدور الحكم البدائي على أساسه، فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مقدما على أشخاص لا صفة لهم بالدعوى مما يتعين رده شك، فمن رفع الدعوى أو رفعت عليه بصفته الشخصية، فلا يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها بصفته نائبا عن صاحب الحق أو وصية أو ولية عليه.
وتتصدى محكمة الطعن من تلقاء ذاتها للتحقق من شرط الصفة في الطعن، كشرط الصفة في الدعوى تماماً.
ج. شرط المصلحة في الطعن
لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه بشيء، فإذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلاً أو أن الدعوى ردت عن شخص، فإن هذا لا يجوز له الطعن فالمصلحة مناط كل طعن ودعوى ودفع، وان تخلف هذه المصلحة يجعل الطعن غير مقبول قانوناً.
ويستوي أن تكون مصلحة الطاعن مادية أم أدبية، فإذا تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه وعرض أداء المصاريف كافة لخصمه ونصفه من نفسه، انعدمت مصلحة الطاعن المادية.
فالنزول عن الحكم أو عن شق منه ينشئ دفعاً بعدم قبول الطعن في هذا أو ذاك، كما ينشئ دفع بعدم قبول الدعوى المبتدئة التي ترفع في الموضوع ذاته الذي صدر فيه الحكم وكلاهما من النظام العام.
وحسب المادة (174 أصول) فإن التنازل عن الحكم يترتب عليه التنازل عن الحق الثابت فيه، ومن ثم يمتنع على المحكوم له تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه، أي بأصل الحق الذي رفعت به الدعوى لأن الحكم – كما مر – كقاعدة عامة من شأنه أن يكشف عن حقوق الخصوم التي كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها، ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق.
وقد حكم بأنه “لا تصلح المصلحة النظرية البحتة أساسية للطعن بالنقض، متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها”، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن، بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه.
وحكم بأن “الطعن على الحكم بأنه قد قضى برفض الاستئناف بدلا من الحكم برده شکلاً لرفعه بعد الميعاد لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن “.
د. إيداع الرسوم والتأمينات
إن قبول الطعن منوط – فضلاً عن تقديم استدعاء الطعن وتسجيله ضمن المدة المحددة للطعن – بإيداع التأمينات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية خلال ميعاد الطعن، وإن تقديم الطعن من دون تسديد التأمين المشار إليه، أو سداد مبلغ أقل من المبلغ المحدد قانون لا يحفظ مدة الطعن، مما يوجب رفض الطعن شكلاً.
والمشرع في المادة (۲۳۳/ج أصول محاكمات) عد الرسم شرطة لحفظ المهل القانونية، وقد أوكل أمر حساب هذه الرسوم إلى مساعد مختص، لذا فإن قيام المكلف بدفع الرسوم التي يكلفه بها المساعد يكفي لحفظ هذه المهل وان كانت الرسوم المؤداة تقل عن الرسم القانوني، بحسبان أنه غير مسؤول عن خطأ هذا الحساب، بخلاف ما هو عليه تأمين الاستئناف الذي حدده القانون بمبلغ محدد من الليرات السورية وأوجب استيفاءه سلفاً عند طلب استئناف الدعوى عملاً بالمادة (۸۷) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وبمقتضى ذلك يغدو إيداع الطاعن تأميناً استئنافية بمبلغ أقل ولو ليرة سورية لا يحفظ له مدة الاستئناف، الأمر الذي يجعل فوات مدة الاستئناف مدعاة لرفض الاستئناف شكلا.
هـ – إيداع نسخ عن لائحة الطعن
إيداع نسخ عن لائحة الطعن مرفقة بصور مصدقة عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم إلا أنه إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفي بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن (۲۲۳/و). ويعد هذا الحكم الذي أورده قانون أصول المحاكمات الجديد، نتيجة منطقية لنص المادة 479/أ منه والتي أثبتت ولاية الوكيل بالخصومة في سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية، بمحض إصدار التوكيل.
و – عدم القبول بالحكم
قضت المادة (۲۲۱ أصول محاكمات) بأنه لا يقبل الطعن بالأحكام لمن رضخ للحكم، فالقبول بالحكم هو الرضا به صراحة أو ضمناً، بحيث يمتنع على من رضي به، الطعن فيه بعدئذ بأي طريق في مواجهة من صدر الحكم والقبول لمصلحته.
وحتى ينتج القبول بالحكم أثره في عدم قبول الطعن فيه، ينبغي أن يكون هذا القبول صريحاً، أو ضمني إنما بإجراءات أو عبارات تؤدي في مدلولها إلى التيقن من حصول الرضاء بالحكم، بأن يكون القبول واضحأ قاطعاً في دلالته على الرضاء بالحكم، ولا يجوز للمحكمة أن تستشفه وتقضي به إلا إذا كان ثابتة على وجه اليقين دلالة لا تحتمل الشك، وعلى هذا تنص المادة ۲۲۱ أصول محاکمات “.. لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم”.
ويعد قبول الحكم كقاعدة عامة إسقاطاً ينتج أثره بمجرد حصوله صراحة أو ضمنية، ولو قبل موافقة الطرف الآخر، فالنزول عن الحق في الطعن تتحقق آثاره بمجرد حصوله من دون الحاجة إلى قبول الخصم الأخر.
تستثنى من ذلك الحالات التي قررها المشرع والتي بمقتضاها يجوز لمن رضي بالحكم أن يعدل عن رضائه، كحالات الحكم الصادر في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وكحالة عدم قبول الخصم الأخر بالحكم وقيامه بالطعن به، بحسبان أن الخصم الذي قبل بالحكم ما قبل به إلا لظنه رضاء خصمه بالحكم، وقد نصت المادة (۲۳۲/أ أصول محاكمات) على أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
ولم يتطلب القانون شكلاً معينة ينبغي أن يحصل فيه القبول، وكان الأجدر أن ينص المشرع على شكل معين يتم فيه القبول بالأحكام لتفادي النزاع في المستقبل حول حصوله أو عدم حصوله، وقد جرى العمل لدى المحاكم على حصول الإسقاط من حق الطعن، بورقة رسمية بعد صدور الحكم وأمام ذات المحكمة التي أصدرته.
ولا يقبل الرضوخ للحكم إلا بعد تفهيمه، إلا إن استخلص القبول السابق للحكم من صدوره موافقا لطلبات الخصم كما مر، فالطعن يرد شكلاً إذا قدم ممن رضخ للحكم.
ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان المنسوب إلى المحكوم عليه يستشف منه قبوله للحكم الصادر عليه أم لا يؤدي إلى هذا القبول، سواء أكان ما صدر منه عم ماديا أم تصرفا أو إجراء قانونياً، قضائياً كان أم غير قضائي، إنما يتعين على القاضي بكل الأحوال أن يتقيد في هذا الصدد بالقواعد العامة في الإثبات المقررة في قانون البينات، ولا يستخلص القبول بالحكم من مجرد سكوت الخصم المحكوم عليه عن الطعن، مهما طالت المدة مادام میعاد الطعن مازال مفتوحة.
وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم قبول الطعن ممن قبل الحكم المطعون فيه، وعليها أن تستخلص هذا القبول من تلقاء نفسها من مضمون الأوراق المقدمة إليها، فالفقه والقضاء قد استقرا على عد حكم المادة (۲۲۱) من النظام العام.