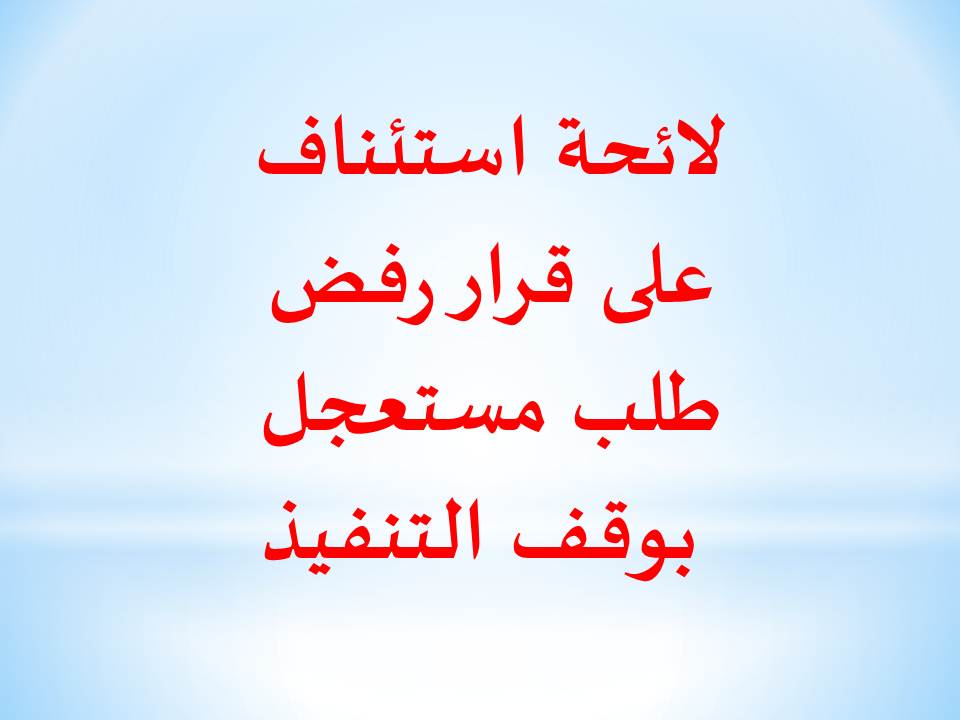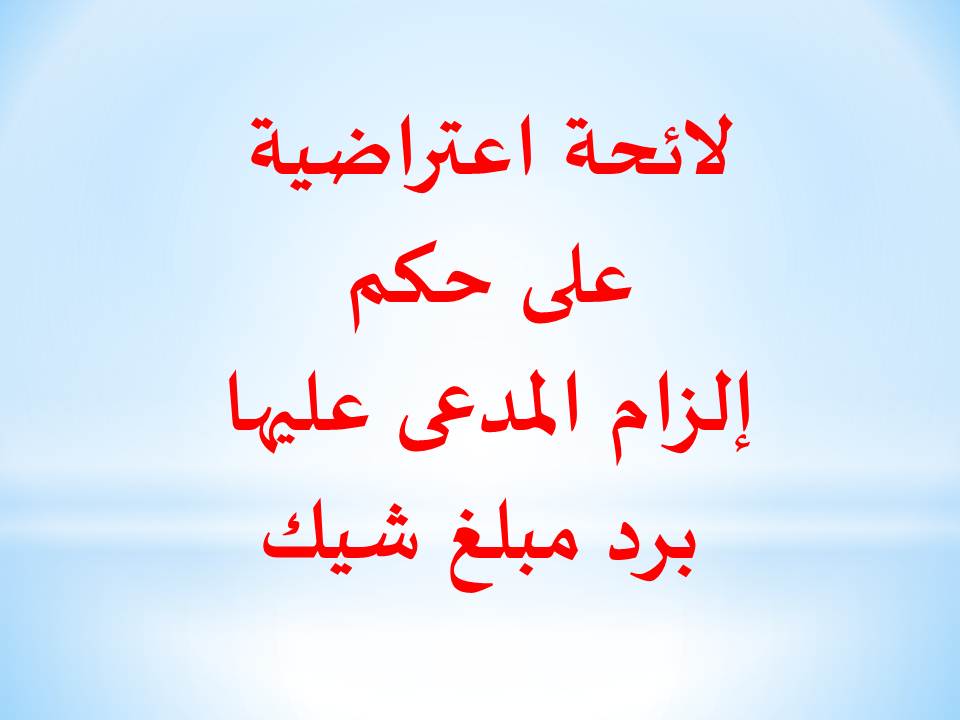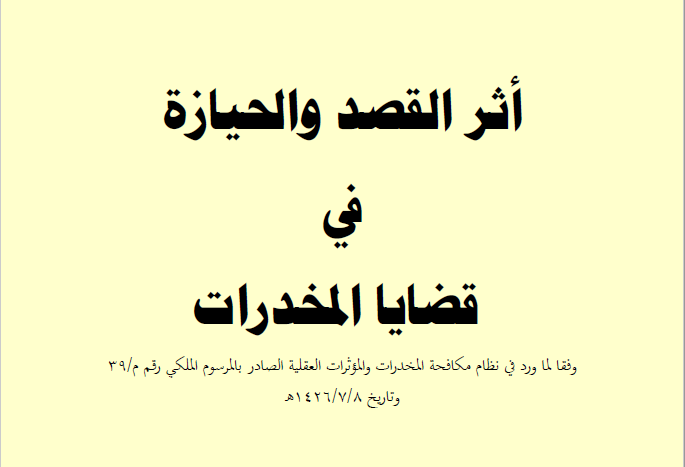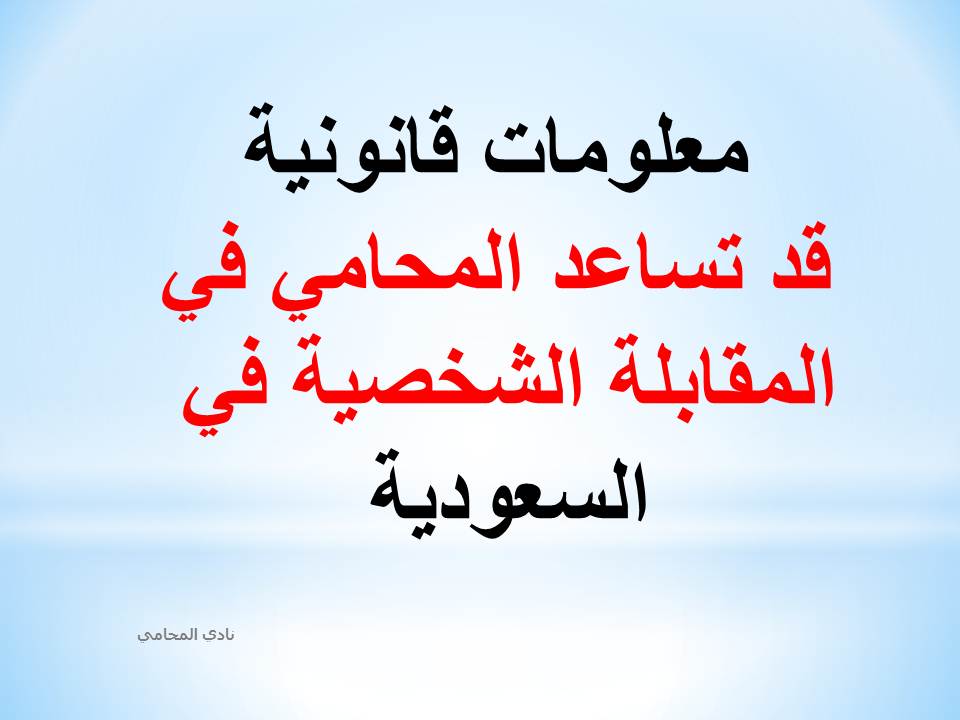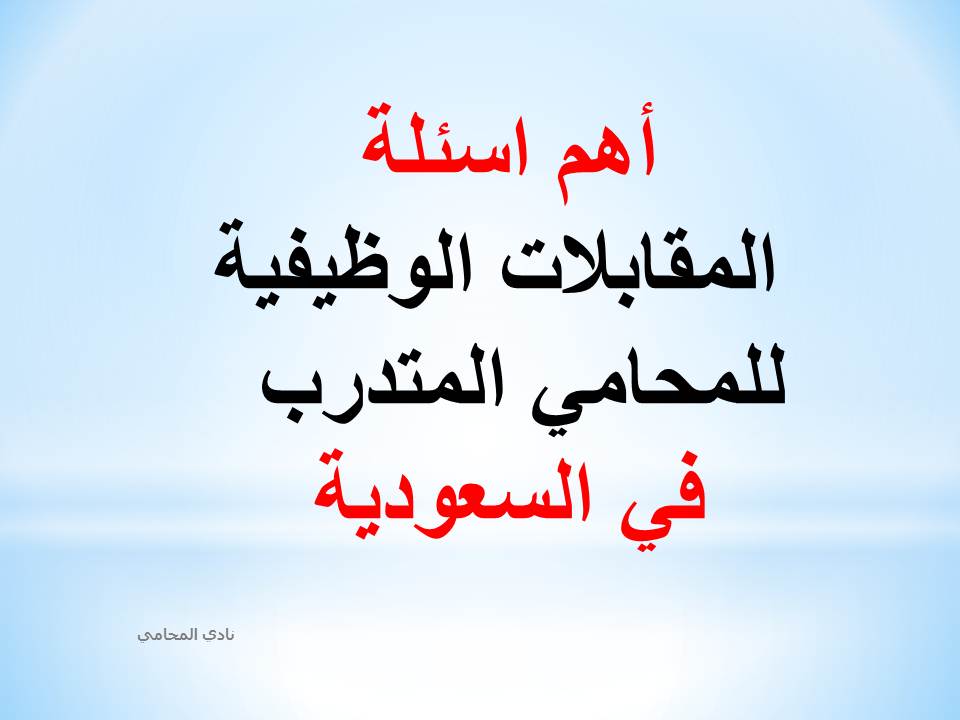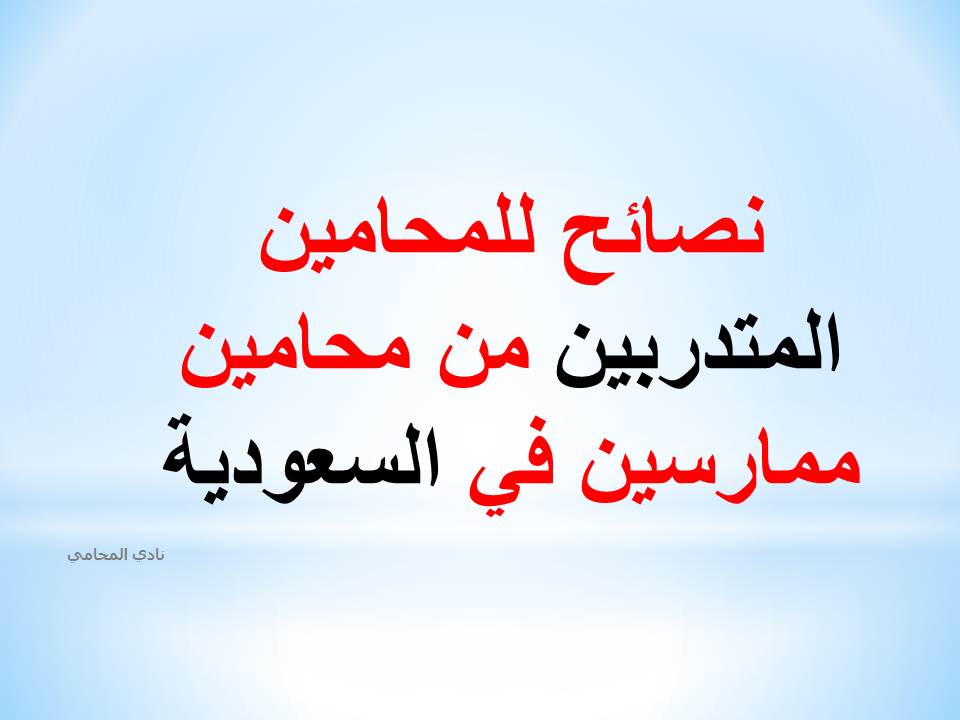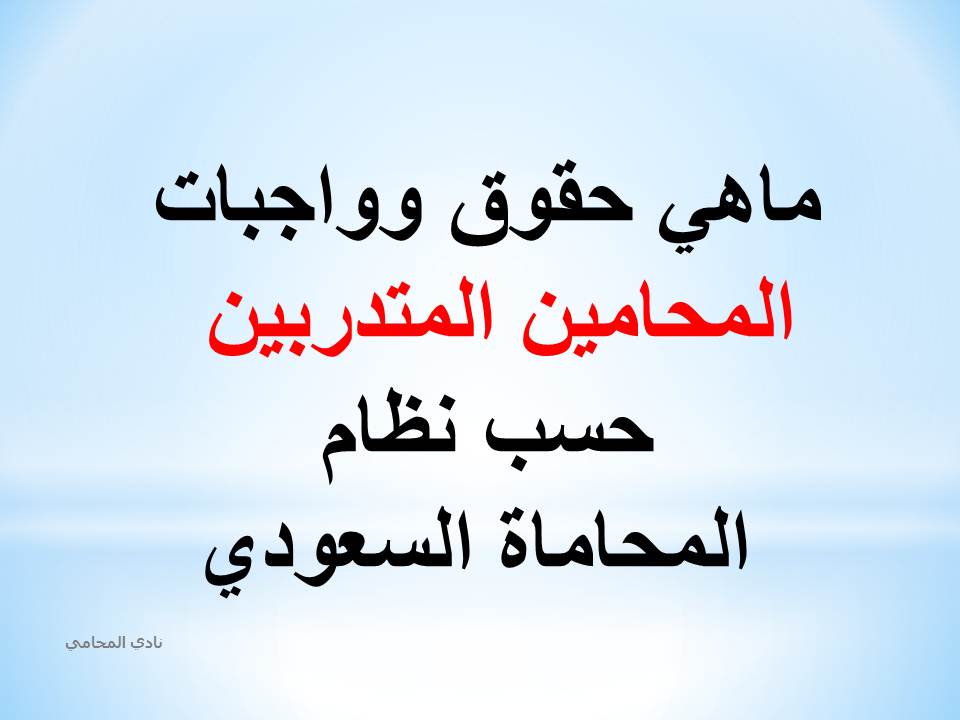لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ
صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛
حفظه الله
استئناف
مقدم من………………. (مدعي- مستأنف)
ضــد/ شركة………………(مدعى عليها ـ مستأنف ضدها)
الموضوع
بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي على قرار رفض الطلب المستعجل المقيد برقم…. . وتاريخ … المقدم في الدعوى رقـم ………….) الصادر من صاحب الفضيلة ……… الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد طلب المدعي المستعجل بوقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم…… وتاريخ … وحيث أن قرار فضيلته خالف أحكام الشرع والنظام مما دفع بالمدعي للاعتراض على القرار للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف :
أولاً: مخالفة أحكام النظام:
أن فضيلة ناظر الدعوى قـد حـاد عن جادة الصواب عندما قضى برفض وقف التنفيذ تأسيسا على ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة من نظام التنفيذ التي تضمنت ما مفاده إيداع شيك مصدق بقيمة الشيك كشرط لوقف تنفيذه وفي ذلك نوضح الآتي:
1- أن المادة سند القرار مستثنى منها قرارات وقف التنفيذ الصادرة من محاكم الموضوع وفقًا للفقرة (٦) من المادة السادسة التي نصت بين ثناياها على أن لا يحول وجود منازعة في موضوع السند التنفيذي مـن السير في إجراءات التنفيذ ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ.. ثم أضافت الفقرة (7) من المادة السادسة ما نصه ( مع مراعاة الفقرة (٦/٦) من هذه اللائحة يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة (التنفيذ ويفهم من هذا السرد أن تطبيق المادة (7) من المادة التي استند عليها ناظر الدعوى مشروط بمراعاة الفقرة (٦) والفقرة المذكورة استثنت القرارات الصادرة من قاضي الموضوع بوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.
٢- أن شرط ضرورة إيداع قيمة الشيك بحساب محكمة التنفيذ يسري أمام قاضي التنفيذ وعلى المنازعات التي تقدم أمام محكمة التنفيذ فقط وليس لها علاقة بقاضي الموضوع أو النزاع القائم أمامه والدليل على ذلك أن المادة التي استند عليها فضيلة ناظر الدعوى لم تتطرق لإيداع قيمة الشيك بمحكمة الموضوع أو أمام قاضي الموضوع ولو أراد المنظم سريان ذلك على قرارات وقف التنفيذ الصادرة من قاضي الموضوع لأفصح عن ذلك صراحة على غرار تشريعاته ونص صراحة على إيداع الشيك في محكمة الموضوع في حال وجود منازعة موضوعية بالنزاع وحيث أن نص الفقرة (٦/٦) من نظام التنفيذ جاءت مطلقة غير مقيدة على أي استثناء وأجازت لقاضي الموضوع وقف التنفيذ بأي حال، لذا لا يجوز لقاضي الموضوع الاستناد عـلـى نـص الفقرة (٧) من نظام التنفيذ في رفض الطلب نظاما.
٣- لو افترضنا جدلًا أن من شروط وقف تنفيذ الشيك لدى قاضي التنفيذ هو إيداع مبلغ الشيك بشيك مصدق لدى محكمة التنفيذ فإن النظر في الأمر ليس من اختصاص قاضي الموضوع حيث أن علة الطلب المستعجل في الدعوى وفقا للنظام هو النظر بصفة مؤقتة في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت في موضوع النزاع بين الطرفين وفقًا لنص المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ، وحيث أن طلب المدعي المستعجل تضمن موضوعه طلب وقف صرف الأجرة لعدم استحقاقها نظرًا لفوات المنفعة وفقًا لموضوع الدعوى الأصلية وأن الاستمرار في التنفيذ والحجز على المدعي فيه ضرر يخشى منه فوات الوقت وهو الدافع إلى تقديم الطلب المستعجل ، وعليه كان يجب على ناظر الدعوى بحث جوهر طلب المدعي فقط ركن الاستعجال والضرر) وهل كان يتوافر فيه شق الاستعجال من عدمه وليس بحث شروط وقف تنفيذ الشيك وفقاً لنصوص التنفيذ ، وعليه أن ناظر الدعوى لم يقم بما يلزم شرعًا ونظاماً في بحث الطلب المستعجل (بحــث ركــن الاستعجال والضرر وفقًا لأحكام الدعوى المستعجلة.
ثانيًا: عدم النظر في الكفالة المقدمة من قبل المدعي:
١- الثابت من القرار المستأنف ومن قرار التنفيذ قيام المدعي برهن عقارين تم التهميش على صكوكهـما لصالح محكمة التنفيذ بقيمة الشيك المطالب به وقيمتهما أعلى من قيمة الشيك محل المطالبة(مرفق مـا يفيد ذلك) ودفعنا بذلك لدى فضيلة ناظر الطلب المستعجل وتم تقديم ما يفيد ذلك إلا أن فضيلته لم
يلتفت إلى حجز هذه العقارات لصالح المدعى عليه والتي تمت وفقاً لنظام التنفيذ.
٢- أن تقديم الطلبات المستعجلة مشروط بتقديم كفالة للدين محل المطالبة كما هو منصوص عليه في نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية والمدعي قام بتقديم الكفالة التي تفي بسداد قيمة الأجرة محل النزاع لدى ناظر الطلب ومع ذلك لم يستجيب فضيلته إلى طلب المدعى رغم مراعاة شروط النظام في الطلب.
بناء على ذلك:
– نطلب من فضيلتكم – وفقكم الله . نقض القرار المستأنف وتوجيه نظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الطلب المستعجل وذلك للأسباب الواردة بعاليه أو التي يراها فضيلتكم.
سدد الله خطاكم في القول والعمل
مقدمه
وجب التنويه أن هذه المذكرة كتبت قبل تعديل اللائحة التنفيذ لنظام التنفيذ التي أضيف عليها صراحة بجواز وقف تنفيذ الشيك إذا رأى قاضي الموضوع ذلك، علما أن هذه اللائحة قبلت من محكمة الاستنئاف وأعيد الحكم وصدر فيها قرار بوقف التنفيذ قبل صدور التعديل على نظام التنفيذ الذي رفع اللبس في تطبيق المادة والاجتهاد عليها من القضاة.